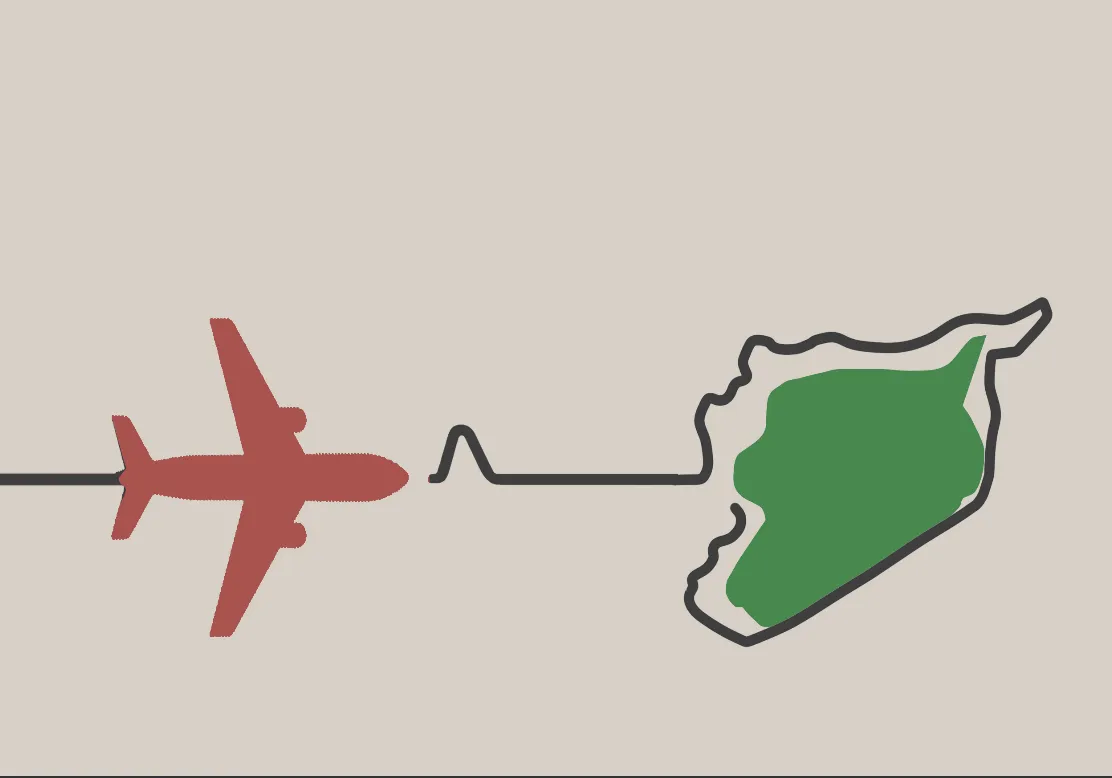١ يونيو ٢٠١٩
١ يونيو ٢٠١٩
أبرز نتائج تدويل القضية السورية هي خروج المواطن السوري عن دوائر الاطلاع، واقتصرت مهمة قادتهم على التنفيذ بصمت دون اعتراض، بينما تنحصر مهمة الناشطين والإعلاميين على نقل الأحداث والتعليق عليها والتكهن بمجريات الأحداث دون اطلاع.
تنحصر مهمة المواطن السوري في تلقي الرسائل وتصديرها بين الدول المؤثرة بالقرار السوري، وغالبا ما تكون الرسائل دموية مدمرة للبنية التحتية مهلكة لعائلات المتمسكين بالأرض والتراب.
تدويل القضية السورية سبب شحاً في المعلومات لدى الألسن الناطقة بالثورية ومن يسمون بالمحللين السياسيين وغاب الإعلاميين الغارقين بالفصائلية عن المشهد الكلي، لانشغالهم بتفكيك الألغام الشعبية ومخلفات القنابل التي تركتها الخلافات والمعارك بينها.
لا شك أن جميع الدول العظمى والإقليمية تحاول فرض مشاريعها ورؤيتها للحل السوري بالقوة كما يفعل الروس أو بالسياسات الناعمة المخففة للاحتقان والتي تمتاز بالصبر كعادة الأتراك، أو التحكم عن بعد الأقل كلفة كالحرب الصفرية التي تديرها أمريكا في المنطقة منذ أعوام.
للأسف إذا تتبعنا مخرجات تلك المشاريع نجدها لا تمت للحلم الثوري السوري بصلة، إلا إن بعضها يبتعد كثيرا كالمشروع الانفصالي الأمريكي، وبعضها الآخر دموي ساحق للثورة وحاضنتها الشعبية كما هو الحال في المشروع الروسي، بينما المشروع الإيراني طائفي بامتياز يفتك حتى بعناصر المصالحات المستسلمة للنظام ويدفعها للواجهة في مقابل الثوار.
بينما تقترب الرؤية الثورية من الرؤية التركية المناصرة للثورة السورية حتى اللحظة، وتشترك معها بالمخاوف، وتتقاطع معها في الأهداف، رغم كل موجات فقد الثقة التي عصفت بها، وروج لها من قبل عدة جهات مقربة من النظام، أو روجت لها جهات وقنوات خليجية معادية للسياسة التركية في المنطقة.
وجدت إدلب نفسها وحيدة مع هذا التصعيد الدموي الذي طال المناطق المحررة من العدوان الروسي والمليشيات الأسدية، مع ازدياد التصعيد تنعدم الآمال بالحل، وتسحق اللجان الدستورية ويتبدد حلم الانتقال السياسي، إلا أن المقاومة بالسلاح المضاد للدروع بدد حلم روسيا في عملية ريف حماة الشمالي الأخيرة، وهو السيطرة على الأوتوستراد الدولي بين حماة وحلب، ثم الحلم باحتلال مدينتي جسر الشغور وإدلب في مرحلة لاحقة، حيث بدأ فعلا الهجوم من محورين الأول في ريف حماة والثاني محور كبانة مطلع هذا الشهر.
ومضى شهر كامل على بدء تنفيذ الخطة، التي ادعى الروس من خلالها الحد من تهديد مطار حميميم ونقاطها الاستراتيجية في الشمال السوري، إلا أن الخسائر البشرية والثمن الباهظ الذي تكبدته في المعدات والآليات جمد خطوط الجبهة بعد معارك كر وفر على محور كفرنبودة المنطقة السهلية الساقطة حكما بنيران النظام، وتركز عمل الفصائل على الإغارات والكمائن والانغماس في صفوف العدو، بينما تركز الدعم الروسي على الاستطلاع لضرب نقاط الثوار لتخفيف الضغط عن خطوط التماس وتركز عمل مليشيات الأسد وراجماته مع الطيران على ضرب الحاضنة الشعبية في البلدات المدنية المحررة لتهجير السكان منها ولتشكل ضغط على الضامن التركي للقبول بهدنة يحتفظ فيها النظام بكفرنبودة والمناطق التي سيطر عليها في الشهر الأخير إلا أن الأتراك يصرون على دعم الجبهة الوطنية والجيش الوطني لاستعادة تلك المناطق ثم الجلوس على طاولة المفاوضات.
يبدو أن المنطقة سوف تلتهب مع العقوبات الأمريكية وقانون شيزر، والتهديدات الأمريكية لإيران، ووضع يدها على شرق الفرات السلة الزراعية ومخزون الثروات، ثم تأخر إعادة الإعمار وتعرقل عمل اللجنة الدستورية الهادفة لتعويم الأسد، كل ما سبق جعل الروس تفرغ غضبها ووابل أسلحتها المحرمة دوليا على البقعة المتبقية خارج السيطرة وخارج التفاهمات، فماذا يخبئ المستقبل لقلعة الثورة الباقية ومعقل الثوار الأخير، لا أظن أن الأمر سيكون نزهة لبقايا مليشيات الأسد وعناصر المصالحات، وما تخفيه الأيام أشد إذا ما حاول النظام التقدم إلى الجبال الوعرة حيث ينتظره الثوار.
 ٣٠ مايو ٢٠١٩
٣٠ مايو ٢٠١٩
خرج منذ عام آخر الثوار في دمشق وريفها من منطقة جنوب دمشق "بلدات-يلدا-ببيلا-بيت سحم"، لم يكن عدد الخارجين يساوي عدد المقاتلين وغيرهم من الفعاليات المنتمية للثورة أو المتحدثين باسمها أو المتسلقين على أكتافها والمستثمرين في أروقتها، في بداية التفاوض من أجل الخروج مع الفصائل كان العدد المقدر أكثر من ثلاثين ألف مواطن يتضمن الثوار وعائلاتهم، وخلال التفاوض أوعز نظام الأسد إلى عملائه لتثبيت أكبر عدد ممكن من سكان المنطقة وشرع بإرسال التطمينات أن الذي يبقى في المنطقة يعود كما ولدته أمه خالياً من "الذنوب" وسيسقط عنه كل تهم "الإرهاب" الموجهة له ولو قتل ألفَ ألف من عناصره، واستطاع استخدام جل مشايخ ووجهاء البلدات لإقناع الشباب بالبقاء في "حضن الوطن" مستغلين الوضع المتوتر في الشمال السوري واللعب على وتر تخويفهم من "الشيعة" في حال خروج معظم سكان الجنوب الدمشقي ستصبح لهم وسيستوطنون بها على غرار "ضاحية بيروت الجنوبية" التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني، وكأن بقائهم سيمنع ذلك في حال أراد نظام الأسد وحليفته "إيران" ذلك.
في بداية التفاوض كانت اللجنة المكلفة بذلك تقول إن بين الثلاثين والأربعين ألفاً يرغبون بالخروج إلى الشمال السوري، وكلما أقترب موعد بدء الخروج كان العدد يتقلص وينقص بين الساعة والتي تليها، فكان السؤال الأكثر طرحاً عندما تلتقي أحدهم "طالع أو لا" وللمفارقة أنك ترى أحدهم وتسأله فيخبرك أنه خارج ثم تراه بعد دقائق ليقول لك أنه سيبقى.
كما المشايخ كان تأثير العائلات كبيراً جداً على بقاء عدد كبير من أبناء البلدات الذين كان جلهم مقاتلين في صفوف الجيش الحر، ومجرد علمهم أن أحد أفراد عائلاتهم ينوي الخروج مع الثوار يذهب إليه "كبارية" العائلة ويستخدمون معه شتى أساليب الترغيب والترهيب من أجل أن يبقى، حتى أن بعضهم أنزلوا أبنائهم من باصات التهجير وأخرين قبلوا أيدي وأرجل أبنائهم من أجل الا يخرجوا، وعند إحصاء العدد النهائي للذين خرجوا إلى الشمال السوري تبين أن العدد أقل من 10 ألاف بقليل.
البعض من المقاتلين الذين كانوا في صفوف الفصائل نقلوا البندقية مباشرة إلى الكتف الأخر وأضحوا يتفاخرون بانضمامهم لتشكيلات جيش الأسد "الفرقة الرابعة وقوات النمر والحرس الجمهوري وغيرها" ويصورون أنفسهم وهم يتبادلون ألفاظ البذائة والتشبيح ظناً منهم أن مسارعتهم بالتشبيح مع الأسد سيعطيهم ميزات إضافية ويحميهم من خطر الاعتقال أو الموت، وباشروا استثمارهم مع هؤلاء كما كانوا يستثمرون مع الثورة.
أما القسم الأخر استفاد من وجود القوات الروسية في الستة أشهر الأولى التي كانت تحد من قمع قوات الأسد للسكان وتتلقى الشكاوى بخصوص ذلك وغالباً ما تستجيب وتعاقب المنتهكين منهم.
في المرحلة اللاحقة بدأت الملاحقة الأمنية لمعظم أهالي المنطقة وخاصة الشباب وزجهم في صفوف جيش الأسد في أبسط الأحوال وتعتقل أخرين في حالات أخرى حتى من الأشخاص المحسوبين عليها الذين ساعدوها في إتمام وتسريع السيطرة على المنطقة.
الخطر الأكبر على الشبان في البلدة في البداية لم يكن من نظام الأسد بجميع أجهزته بشكل مباشر، إنما من سكان المنطقة المنخرطين معه الذين أثروا العيش في مناطق سيطرته أثناء تبعية المنطقة لفصائل الثورة، وبمجرد دخولهم للمنطقة بدأوا يدبرون المكائد ويكتبون التقارير للجهات الأمنية المختلفة، بحكم علاقتهم القوية بأجهزة النظام الأمنية ومعرفتهم بقاطني المنطقة وقدرتهم الحصول على معلومات إضافية عمن وقف مع الثوار أو كان معهم.
تباعاً قامت قوات الأسد بالعديد من عمليات الدهم والاعتقال والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم.
قبل شهرين تقريباً استهدف الأمن العسكري بكمين له كل من "رامز حامد" الملقب أبو سليمان و"عبد الرحمن حامد" الملقب بـ سبيرو، تمكنت خلاله من القبض على الأخير وسوقه إلى الخدمة الإلزامية بعد عدة أيام من التحقيق معه، فيما تمكن رامز من بالفرار مع العلم أنه التحق بقوات الأمن والجيش من قبل خروج الثوار من جنوب دمشق وساعدهم مع أخرين في عملية القضاء على تنظيم "داعش" في جنوب دمشق وقاتل إلى جانبهم.
عمل رامز خلال فترة الثورة في تحويل العملات من الداخل إلى الخارج وبالعكس وحقق أرباح طائلة إلى جانب التجارة بقطع السلاح والذخيرة، وفي نهاية العام 2017 قام بتشكيل مجموعة مقاتلة من أولاده وأقربائه وانضم إلى الجيش الحر "جيش الأبابيل" من أجل حماية تجارته وتحصيل بعض الأموال العالقة له مع خصومه بالقوة.
اما "سبيرو" فكان كثير التحريض على الجيش الحر في الفترة الأخيرة "قبل التهجير" وقام بتدبير العديد من الاحتجاجات ضده وجعله في مواجهة الأهالي بتدبير المكائد وتحريف الحقائق وإلقاءه اللوم على الجيش الحر لما آلت إليه الأوضاع، وكل ذلك بأوامر مباشرة من "الشيخ صالح الخطيب" رئيس لجنة المصالحة" السابق عن بلدة يلدا.
كما داهم الأمن منزل الشاب "سامر سبيناتي" الذي كان يعمل مع فصيل أجناد الشام اثناء تمضية إجازته مع العلم أنه خضع للتسوية والتحق بصفوف الخدمة الإلزامية.
وفي بلدة "يلدا" أيضا في وقت سابق اعتقل "محمد البقاعي الملقب بـ "أبو رسلان" الذي كان يشغل نائب رئيس المجلس المحلي لبلدة يلدا، كما أفرج عن القيادي السابق في جيش الأبابيل اللواء الأول قبل أيام "مصطفى القصير" الملقب "أبو راتب القصير" بعد اعتقال دام شهر تقريباً بتهمة تزوير أوراق رسمية بالتعاون معقب معاملات من بلدة يلدا يدعى "سامح الغندور" ومصطفى تنقل في صفوف تشكيلات الجيش الحر بين "شام الرسول" بداية وانتهاءً مع "جيش الابابيل" كقائد كتيبة في اللواء الأول فيه، وكان سيء السمعة عرف باعتدائه على المدنيين مرارا، وانخرط في صفوف الفرقة الرابعة قبل خروج الثوار بأيام وضم العديد من الأشخاص معه تحت رايتهم.
واليوم تناقل ناشطون خبر إعدام الشاب "محمد ابو كحلة" ميدانياً في بلدة يلدا بسبب تهربه من الالتحاق بالخدمة الإلزامية غير مرة.
وفي بلدة "بيت سحم" عثر السكان مؤخراً على عبوتين ناسفتين وضعتا في أوقات متقاربة بجانب منازل قيادين سابقين في الجيش الحر والكتائب الإسلامية من الذين خضعوا للتسوية، بهدف قتلهم أو ارغامهم الخروج من البلدة، الأمر الذي يمنعه ارتباطهم المباشر مع ضباط من الأمن العسكري يمنعون باقي الأجهزة والتشكيلات من اعتقالهم أو الاقتراب منهم.
كما سجل أيضاً العديد من حالات الاعتقال أبرزهم كان "أحمد جعارة" الملقب بـ "أبو عماد بيكا" كان قائد مجموعة لدى "هيئة تحرير الشام" في نقطة المسبح بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك، كما تعرض زميله في الذي كان شرعياً في الهيئة "فهد فتيحة" الملقب بـ "أبو صبحي" إلى إطلاق نار من دورية للأمن أدت إلى شلل في يده، كما اعتقل ثلاثة شبان أخرين عرف منهم "أبو عمر هاون" من مجموعة "بلال جعارة" الملقب بـ "أبو نعمان" الذي أثر البقاء في حضن الوطن مع أنه شغل منصب قائد كتيبة في البلدة وتنقل أيضاً بين عدة تشكيلات فمن جيش الإسلام إلى حركة أحرار الشام وجبهة النصرة وانتهاءً بجيش الابابيل، وللمفارقة عند انتسابه للأخير طلبت منه قيادة الجيش الرباط على محور "حي سليخة" لكن دون أن يطلق النار لوجود اتفاق تهدئة مع قوات الأسد في ذلك الوقت، فرفض معللاً رفضه أنه لا يستطيع أن يرى جنود الأسد دون أن يقتلهم.
حتى رئيس لجنة المصالحة مع قوات الأسد في ذات البلدة "عدنان جعارة" الملقب بـ "أبو سامر" لم يسلم من الانتقام رغم جهوده في إعادة البلدة إلى "كنف الدولة السورية" إذ قامت عناصر البلدية ترافقهم عناصر أمنية بهدم أربعة طوابق له في بنائين مختلفين كان قد بناها ضمن فترة سيطرة الثوار على البلدة.
الآن وبعد مرور عام وعلى وقع المعارك الطاحنة التي يخوضها الثوار مع نظام الإجرام وحلفائه بلغ عدد قتلاه أكثر من 300 عنصر وضابط في أقل من شهر وعشرات الجرحى، الكثير منهم ممن خضع لما يسمى بالـ "التسوية أو المصالحة" معه الذين بدأت وسائل التواصل المحسوبة على نظام الأسد أو المقربة منه بنعيهم.
أبرزهم "وائل جمال الدالاتي" الذي تنقل بين العديد من التشكيلات والتنظيمات بداية بجبهة النصرة مروراً بداعش ومن ثم جيش الأبابيل ثم قتيلاً على جبهات الشمال على يد الثوار، الأخير ظهر منذ عدة أشهر في تسجيل مصور مع مجموعة من مقاتلي الفرقة الرابعة في بلدة "يلدا" أثناء تجهزهم للصعود في باصاتها للذهاب إلى جبهات القتال متفاخراً بذلك يقول "الفرقة الرابعة تابعة لـ الله"، فيما جرح أخرين ظهروا معه في ذات الوقت منهم "أبو بكر الحموي" أحد عناصر فصيل "أجناد الشام" في بلدة يلدا سابقاً و"أبو أنس البقاعي" عنصر في جيش الابابيل وأخرين لم يتم التعرف على أسمائهم.
منذ بداية العام 2014 تاريخ بدء المصالحة في جنوب دمشق حظيت لجان "المصالحة" بدعم مباشر من نظام الأسد فرع الدويات على وجه الخصوص لأن المنطقة تضع ضمن قطاعه حسب التقسيمات الإدارية للأفرع الأمنية، وكانت هذه اللجان على تواصل مباشر رئيس الفرع ويقومون بزيارة مكتبه كلما دعت الحاجة لذلك، حتى أنهم أقاموا ولائم عديدة دعوا إليها العديد من مسؤولي نظام الأسد بعد خروج الثوار من بلدات الجنوب الدمشقي.
لجنة المصالحة قامت مؤخراً بزيارة فرع واللقاء مع رئيس الفرع الجديد، وخلال اللحظات الأولى من اللقاء سألهم بتهكم عن سبب الزيارة، فأجابوه أنهم لجنة المصالحة عن جنوب دمشق، ليرد عليهم أن المصالحة قد تمت بالفعل ولم يعد لديهم عمل في هذا المجال "أي يطلب منهم ضمنياً عدم زيارته مرة أخرى".
 ٩ مايو ٢٠١٩
٩ مايو ٢٠١٩
يتكرر ذات المشهد المأساوي وذات الشعور بالخذلان لدى آلاف المدنيين في الشمال المحرر بعد أن بدأت تتكشف تفاصيل الحملة العسكرية على ريفي حماة وإدلب من قبل النظام وروسيا، وحالة التراخي التي أبدتها الفصائل العسكرية في صد الهجوم في تكرار لمشهد تسليم "شرقي سكة الحديد".
دخول قوات النظام إلى الجنابرة وتل عثمان ومن ثم التقدم السريع باتجاه كفرنبودة، وما تلاها اليوم من هدوء كامل للجبهات وتقدم قوات النظام التدريجي باتجاه قلعة المضيق والكراكات وما يتبعها من تقدم غير معلوم الوجهة، يشير لوجود اتفاق ضمني بين الضامنين أولاً والفصائل المسيطرة على المنطقة.
ويرسم المشهد الحاصل بكل تفاصيله استكمالاً لما تم الاتفاق عليه سراً بين الدول الراعية لمسار أستانة، وفق بازارات السياسة التي عقدوها على حساب المدنيين في الشمال المحرر، وتواطئ الفصائل التي رهنت نفسها وقرارها وكل ما تملك من إمكانيات للخارج، فباتت مسلوبة القرار تنفذ ما يملى عليها دون اعتراض.
تسليم "شرقي سكة الحديد" كان ضربة موجعة وكبيرة للثورة السورية ككل بعد أن مكنت النظام من السيطرة على مساحة أرض تقدر بنص محافظة إدلب في أرياف حماة وإدلب وحلب، ثم خرج بعدها قائد هيئة تحرير الشام ليبرر التسليم وينتقد تقصير الفصائل في المساندة وتقديم الدعم، متجاهلاً سحب السلاح الثقيل والمقرات لاسيما في مطار أبو الظهور قبل بدء المعركة بأسابيع.
وفي ذات الصورة وذات المشهد تتكرر اليوم المأساة، ويتكرر ذات الخذلان الذي عايشته آلاف العائلات من ريف حماة وإدلب الشرقية والتي لاتزال حتى اليوم تعاني مرارة النزوح، لتبدأ رحلة اغتراب جديدة لقاطني ريف حماة الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي بذات الوسائل وذات المشهد والسيناريو والخذلان .. فمن سيخرج غداً ليلقي الاتهامات بالتسليم ...؟.
من المسؤول اليوم عن هذا التسليم الحاصل، ومن هو الفصيل القادر على الخروج للعلن وكشف المستور وتبيان من باع وسلم وخذل، من المسؤول اليوم عن عذابات ألاف المدنيين المشردين في البراري دون مأوى، ومن المسؤول عن سحب السلاح الثقيل من أبناء تلك المناطق وتركهم عاجزين عن الدفاع عن مناطقهم بأسلحتهم الفردية، وهل ستنتهي عمليات التسليم هنا ولهذا الحد ومامصير باقي المناطق المحررة بعد ذلك وهل سنشهد بغياً جديداً على فصيل آخر بعد هذه المعركة ... كل هذه الأسئلة تحتاج إجابات واضحة وحقيقية وشفافة من أصحاب القرار فإين هم ...؟؟
 ١٦ مارس ٢٠١٩
١٦ مارس ٢٠١٩
لعل أصدق تصريح صادر عن حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، على لسان "أحمد لطوف" وزير الداخلية في تلك الحكومة، في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم، أن أحداً لايمكن أن يقف أمام إرادة الحرية التي أطلقها الشعب السوري من اليوم الأول في ثورته المباركة في 15 آذار 2011، في الوقت الذي تواصل فيه تلك الحكومة الوقوف في وجه إرادة الجماهير الثورية وتبني حراكهم وفرض نفسها كحكومة شرعية عليهم بقوة السلاح والترهيب.
إرادة الحرية وثورة الشعب السوري التي تحدث عنها وزير داخلية الإنقاذ كانت أمام علم مزيف للثورة السورية تبنته تلك الحكومة لنفسها وأهملت رمز الثورة السورية وعلمها وكفن شهدائها، وراية أبناء الحراك الشعبي في الساحات الثورية.
وأرجع وزير الإنقاذ في مؤتمره حول التطورات الأخيرة بمدينة إدلب والقصف الذي طال السجن المركزي ومقرات الإنقاذ والأحياء السكنية في المدينة، القصف الأخير إلى مساعي النظام لعرقلة ما أسماه "النشاط في المحرر خصوصاً بعد الشروع في بناء مؤسسات مدنية قوية ومتينة في مختلف المجالات كالتعليم العالي والتربية والصحة والعدل والإدارة المحلية والداخلية وشؤون المهجرين والاقتصاد"، في الوقت الذي فرضت فيه هذه المؤسسات بقوة السلاح وبسياسية الإقصاء التي تنتهجها.
وعملت حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها من قبل هيئة تحرير الشام على تصدير نفسها كمؤسسة مدنية شرعية في المحرر، في وقت حاربت فيه مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية الثورية المنتخبة في المدن والبلدات، وحاربت أبناء الثورة وكل مؤسسة مدنية مستقلة لتجعل الجميع تحت عباءتها في وقت تواصل الضغط على المجالس التي رفضت الرضوخ بشتى الوسائل المتبعة لتركيعها وضمها لحكومتها.
حكومة الإنقاذ اليوم وبعد ثماني سنوات من بدء الحراك الشعبي وأقل من عامين على تأسيس تلك الحكومة باتت تتحدث عن حراك الجماهير والثورة، وهي التي قوضت عمل المؤسسات المدنية وتبنت حراك الجماهير بسيف هيئة تحرير الشام، لتغدو حكومة أمر واقع مفروض على الشعب الثائر شاع لها مؤخراً تسميات عديدة من قبل النشطاء أبرها "حكومة الأتاوات"، ووصفت بأنها حكومة غائبة عن الواقع لما تقوم به من فرض أتاوات على المدنيين والفقراء في وقت لم تقدم أي خدمات أو مساعدات لألاف العائلات الهاربة من القصف.
كما أنها عجزت حتى عن حماية مدينة إدلب التي تعتبر مركز ثقلها الأمني من التفجيرات والمفخخات التي قتلت العشرات من المدنيين، ومن عمليات الخطف والابتزاز، في وقت تسلط قواها الأمنية على رقاب المعذبين وتحاول إثبات وجودها كحكومة مدنية شرعية دون انتخابات أو تشاركية ثورية، فكانت كلمة وزير داخليتها اليوم من أصدق ماورد عن تلك الحكومة بأنه فعلاً لن يكون هناك قوة تقف في وجه إرادة الجماهير الثائرة التي تحارب كل من يحاول تشويه صورة الثورة وتبني حراك الجماهير الشعبية.
 ١٤ مارس ٢٠١٩
١٤ مارس ٢٠١٩
نحن اليوم بأمس الحاجة من أي وقت مضى لبناء مجتمع مدني، وتأسيس القنوات التي تساهم بنشر ثقافة المشاركة والمساواة لدى أفراد المجتمع، مثل ( الرابطات والنقابات والجمعيات والأحزاب) وأبرز ما يترتب على تلك القنوات هو عدم إكراه أحد على الانخراط في هذه المؤسسات إلا برضاه التام، وغياب تام للأهداف الاقتصادية (الأرباح) لتتميز عن الشركات التي تؤسس من أجل الارباح بين الشركاء.
تلتقي مؤسسات المجتمع المدني حسب علم الاجتماع في الأدوار والوظائف التي تقوم بها، ومن أبرز الوظائف التي تشترك فيها:
1- وظيفة الإدماج و المشاركة: فهذه المؤسسات تساهم في إدماج الأفراد و مشاركتهم.
2- وظيفة التسيير: حيث تمكن من تدريب الأفراد على التسيير الإداري و المالي و السياسي.
3- الوظيفة التعبيرية: تعبير الأفراد عن آرائهم و الدفاع عن مصالحهم.
4ـ التمثيل والقيادة: تفرز هذه القنوات القادة والممثلين الحقيقيين وتقطع الطريق أمام المتسلقين في شتى المجالات.
5ـ تحرير المجتمع: تخفف من القبضة الأمنية المتسلطة على مجموع شرائح المجتمع لما تملكه من قوة ضغط.
جاءت فكرة النقابات لتسهيل وضع الأعضاء المنتسبين إليها، مثل رفع طلبات تتسم بالواقعية إلى رب العمل، وهي تدريب على العمل الجماعي والمنظم حيث يشارك بهذا الجهد عدد كبير من الموظفين والعمال.
وقد جاء حق وحرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي بعد تدافع قوي، وصراع مرير خاضته الطبقة العاملة منذ فترة غير يسيرة.
جاءت لتصمد وتقاوم الرأسمالية الصاعدة، التي شقت طريقها بصرامة ولم تكن تعرف الرحمة، وحققت أرباحها من عرق جبين العامل.
ونحن اليوم بحاجة للانطلاق في هذا المسار للتدريب على هذه الآلية، والوقوف في وجه المتسلطين والمتسلقين والأمنيين الذين يتصدرون منابر الثورة قهراً لغايات شخصية وانتهازية، والغريب أن معظمهم لا تعلم عنهم الجماهير أي شيء ولم تراها إلا متصدرة على شاشات ومنابر الثورة.
قبل الخوض في هذا الباب لابد من استعراض ثلاث حوادث تضيء دربنا وتقطع ألسنة الغلاة وهي:
الأولى: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت، قدم أبا بكر ليصلي بالناس رغم أن في القوم من هو أقرأ منه ولم يأمر أحداً ليرأسهم رغم تأييده بالوحي والفراغ الذي سيحدث بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى.
الثانية: بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وبعد انتقال مسألة الإمامة إلى سقيفة بني ساعدة، قال عمر رأيه وأوضح علة اجتهاده بتقديم أبي بكر فقال: (لا نؤخر من قدمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لديننا؟ ).
والغريب أن عمر بوب مسألة الخلافة والإمامة وصنفها أنها من أمور الدنيا وليس من مسائل الدين والأغرب أنه لم يخالفه أحد من الصحابة بهذا القول بل تابعه الجميع في البيعة.
الثالثة: تبعه الفقهاء على مر العصور وجعلوا الخلافة باب من أبواب الفقه وليس العقيدة كما يحاول السلفية تقديمها لأتباعهم وروى أيضاً بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: (كنت بين يدي أبي جالساً ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخية فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وذكروا خلافة علي بن أبي طالب فزادوا وأطالوا، فرفع أبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاء، قد أكثرتم القول في علي والخلافة إن الخلافة لم تزين علياً بل علي زينها.
مما تقدم نستنبط السبب الذي جعل الفقهاء على مر العصور في صف واحد، رغم اختلافهم في الكثير من المسائل، ولم نشهد صراعا فقهياً دامياً كما نشهده اليوم من معارك عبثية بين أبناء المدارس الفكرية تزهق أرواح الشباب من أجل وهم مستحدث، وكان الأولى بهم أن يجدوا مثل سقيفة بني ساعدة يجتمعوا فيها ويحلو فيها أمور دنياهم.
 ٩ مارس ٢٠١٩
٩ مارس ٢٠١٩
في طريق الانتقال إلى هيكلة الدولة؛ لابد للناشطين من تجاوز الأنشطة غير التقليدية من مظاهرات واحتجاجات ـالتي يؤدي معظمها للفوضى والتخريب- إلى الأنشطة التقليدية، مثل الاشتراك في توعية وتعبئة الجماهير عن طريق الندوات، وتنظيم المؤتمرات الحقيقية، ثم البدء بتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات، والسعي لتنظيم جماعات الضغط والمصالح المتخلفة (العمالية- المهنية - الإعلامية-…...) التي ينتج عنها الترشيح وتقلد المناصب العامة وتمثيل حقيقي يتجاوز الأسلوب الأمني والوصاية في تعيين ممثلين عن الثورة السورية.
سيطرت الفوضى على آلية التعيين في هياكل الثورة السورية ومؤسساتها منذ اندلاعها حتى اليوم، مما دلس على الناس حقيقة أولئك الأشخاص المعينين بطفرة أو مصادفة، وطرح حولهم الشكوك والعديد من الأسئلة:
هل هم مخلصون متطوعون دفعتهم معاناتهم؟
أم أنهم أصحاب قضية عادلة؟
أم ندبهم فصيل عسكري ليشاركوا قائده بالهدف والمصير؟
أم هم مجرد عملاء تم تعيينهم لحرف مسار الثورة؟
أم ليسوا إلا مرتزقة لا هم لهم إلا النوم في الفنادق وجمع الهبات وبيع المواقف في المؤتمرات؟
ومهما تكن الإجابة فإن الآلية عبثية، تجعل المعين ضعيف الشخصية، مسلوب الإرادة لأنه خرج طفرة (صدفة )، وليس له ما يتكئ عليه من مجلس استشاري يساعده في اتخاذ القرار، ولا قاعدة شعبية منظمة تدافع عن وجوده في حال تم تحييده لمواقفه النبيلة، ويتم اختيار بديل عنه بنفس الرسالة وذات الأهداف، و للوصول إلى هذه المرحلة لا بد من المرور بعدة مواقف تنظيمية جماهيرية أو شعبية تشبه الأحزاب و النقابات والجمعيات من أجل الوصول إلى ممثلين حقيقيين عن أصحاب القضية لا دمى متحركة.
لا ننكر ظهور العديد من التشكيلات والهيئات في الثورة، إلا أنها لم ترتقِ ولم تستطع النهوض وتحقيق الغاية السياسية منها، ورغم انتشار المجالس المحلية إلا أن تركيزها على الجانب الخدمي ساهم في استمرارها من جهة، وحيدها من جهة أخرى، وكان من الأفضل عزلها عن التجاذبات السياسية في المنطقة المحررة والالتفات إلى جوانب أخرى مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات.
وتعرف الجمعية بأنها: اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة اشخاص، لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم.
بينما الحزب السياسي يعني: تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية، ويُؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ، بقصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية لغاية غير توزيع الأرباح.
أما النقابة: هي جمعية تشكل لأغراض المفاوضة الجماعية أو المساومة الجماعية، بشأن شروط الاستخدام و رعاية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية، والالتجاء إلى العمل السياسي في بعض الحالات.
وكما استطاعت المجالس المحلية أن تشق طريقها لابد للناشطين من تنظيم صفوفهم للوصول إلى غاياتهم وأهدافهم وإلا فإن أعمالهم لن تتجاوز غرف الوتس ووسائل التواصل الاجتماعي.
 ١٠ فبراير ٢٠١٩
١٠ فبراير ٢٠١٩
فشل الغرب باستمالة الشعوب المسلمة وصبغها بالديمقراطية الراديكالية لتطويع المنطقة العربية وتدجين شعوبها، فما هي الخطة البديلة؟
بعيدا عن الاستلاب المعرفي والانبهار بالحضارة الغربية، وبدون الارتهان لنظرية المؤامرة وتحويلها إلى كابوس يقيد حرية الأفكار، محاولاً أن أكون حرا غير منصاع لأجندة أي نظام عربي أو غربي، أحاول سرد رؤيتي الخاصة عن أسباب تفجر الربيع العربي، أكتبها من داخل المنطقة السورية المحررة من كل الأنظمة العالمية حتى هذه اللحظة.
يحضرني في البداية، ما قالته كونداليزا رايس لدى سؤالها: ماذا ستفعل في حال تسلمها حقيبة الوزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٥م ؟. فأجابت بوضوح في الكونجرس الأمريكي (انتهت صلاحية حلفائنا في الشرق الأوسط واستهلكوا تماماً، ولا بد من استبدالهم بحلفاء جدد؛ تعتمد عليهم الولايات المتحدة الأمريكية).
لعل هذا القول يختصر العلاقة بين النظام العالمي والأنظمة العربية الوظيفية المستبدة، والتي فرضت على البلاد العربية والشرق الأوسط بعد سايكس بيكو وتبادل الأدوار بين الاتحاد السوفيتي من جهة ثم بريطانيا وفرنسا من جهة أخرى وانتهاء بدخول اللاعب الأمريكي الخشن إلى اللعبة مع إسرائيل الطفل المدلل لكل من سبق.
فشل النظام العالمي في تأسيس أنظمة ديمقراطية ليبرالية في المنطقة العربية والشرق الأوسط على غرار المناطق التي ينتشر فيها الإلحاد والمسيحية وباقي الديانات، وذلك بسبب انتشار الثقافة الإسلامية المعادية لها في المجتمعات العربية، هذا ما دعا الغرب لاعتماد أنظمة ترفع شعارات قومية لقمع من كان ولاؤه للدين، ويعتمد الحاكمية لله، ومفهوم الأمة متجذر في صميم فكره وعقيدته.
كانت قبل الربيع العربي تلك الأنظمة الاستبدادية تؤدي وظيفتها على أكمل وجه مع ما يقدمه لهم النظام العالمي من دعم وغطاء أمني، نظراً لاتساع الشرخ بين الحاكم والمحكوم، و نتيجة للانفجار السكاني، وانتشار البطالة والفقر، وتفشي الفساد والاستبداد في العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة، إلا أن إحكام القبضة الأمنية مع الاحتقان الشعبي سيولد الانفجار لا محالة وخاصة مع فشل تلك الأنظمة في نشر العلمانية والليبرالية في المجتمعات المسلمة الحاقدة على الغرب، وكل ما يقدمه من مشاريع تنموية، حتى أنه لا يزال العلمانيون والملحدون والليبراليون العرب يعيشون في عزلة شعبية حتى اللحظة، وتؤخذ اطروحاتهم للتندر والاستهزاء، ومن يلتف حولهم لقربهم من مراكز دعم المشاريع في المناطق المحررة يتركهم فور الانتهاء من العمل.
يراقب الغرب ما يحدث في المنطقة وقد نصب مراكز أبحاث متخصصة غنية بالمفكرين الاستراتيجيين والقادة السياسيين مع الاهتمام بما تقدمه من أبحاث عن العالم الإسلامي، لضمان استمرار التبعية وإحكام السيطرة واستيعاب أي انفجار محتمل لا بد من إعداد الخطط الوقائية لتجنب الحرب التي لن يتوانوا عن اللجوء إليها من قبل صناع القرار في حال استنفاذ الطرق السلمية كما حدث في الربيع العربي.
لم تأت الطائفية من فراغ، ولا بد منها لتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات أثنية وطائفية ومذهبية، تحكم القبضة الغربية على منطقة غنية بالثروات، ويصعب ترويض سكانها، فلا بد من تفتيتها إلى كانتونات، إرضاء لإسرائيل الحليف الاستراتيجي المؤثر في المنطقة، وهذا ما كرس له المستشرق برنارد لويس في أبحاثه، ويعد لويس مهندس تقسيم الشرق الأوسط، وهو يهودي من أصل بريطاني صاحب المقال: (جذور الغضب الإسلامي).
قال عنه السياسي الأمريكي ريتشارد بيرل: "إن برنارد لويس كان أكثر المثقفين تأثيرا فيما يتعلق بإدارة النزاع بين الإسلام الراديكالي والغرب، وكان هنري كيسنجر يرجع له".
يعد برنارد صاحب أخطر مشروع في هذا القرن لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى المغرب، والذي نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية في مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع "لويس" في 20/5/2005م قال الآتي بالنص: "إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون، لا يمكن تحضرهم، وإذا تُرِكوا لأنفسهم! فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمِّر الحضارات، وتقوِّض المجتمعات، ولذلك فإن الحلَّ السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم، وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية، وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة؛ لتجنُّب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان، إنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية".
وقال أيضا إنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية، ولا داعي لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم، ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك، إما أن نضعهم تحت سيادتنا، أو ندعهم ليدمروا حضارتنا، ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية، وخلال هذا الاستعمار الجديد لا مانع أن تقدم أمريكا بالضغط على قيادتهم الإسلامية -دون مجاملة ولا لين ولا هوادة- ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة، ولذلك يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها، واستثمار التناقضات العرقية، والعصبيات القبلية والطائفية فيها، قبل أن تغزو أمريكا وأوروبا لتدمر الحضارة فيها".
مما ورد نتبين حقيقة الصراع الإسلامي الغربي، ويبدو أن ما صنعته أمريكا في العراق من احتلال وتقسيم كان له دوافع وأسباب ضمن مخطط معلن لتفتيت العالم الإسلامي وتجزئته، وتحويل خارطة المنطقة إلى فسيفساء عرقية واثنية، تبعه مشروع تقسيم السودان ولا أظن أن سوريا ستخرج من الحرب الطائفية المستعرة دون تقسيم.
ورغم نجاح الخطة إلا أنه اعتراف ضمني بفشل الغرب بسلخ المسلمين عن دينهم، ولم يعتنقوا المسيحية، ولا يزال الخوف لدى الغرب من استيقاظهم رغم ضعفهم وإعادة الكرة على الغرب، فكل بقعة من البلاد الإسلامية مرشحة لأن تكون شعب أبي طالب، ولعل فئة صغيرة ربطت بطنها من الجوع تبعث الأمة وتعيد هيبتها، وتوقظ العالم الإسلامي لتبعث الحضارة الإنسانية الحقيقية من جديد.
 ١٤ يناير ٢٠١٩
١٤ يناير ٢٠١٩
تبقى الخلافات في المسائل الشرعية صحية؛ ما لم تتجاوز الكتب الفقهية وحلقات التعليم في المساجد وتسمى خلافات مذهبية كما هو الحال في المذاهب الأربعة، فإن تجاوزت تلك الخلافات الكتب الفقهية إلى كتب العقيدة، وتجاوزت حلقات التعليم إلى الشارع وساحات المعارك فهنا تقع الكارثة وهذا من أكبر أسباب الشقاق بين الفصائل المسماة بالإسلامية وصراعها على السلطة.
كما إن التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر فيه الكثير من المراجعات الفقهية، لكن هذه المراجعات لم تكن في مسائل أدت لقتلى بين المذاهب الفقهية المتصارعة كما يتحدث اليوم، وكان المؤرخ الناقل عنهم مراجعاتهم ينقل الروايتين المتناقضتين المنقولة عن الباحث نفسه قبل المراجعة وبعدها دون حرج والكثير من العلماء يعلنون تراجعهم على الملأ رافعي الرأس ويستدلون على صحة رأيهم الثاني بالأدلة والبراهين، وهكذا أقام الحجة على نفسه، ومنهم من كان يخلع ثوبه في المسجد أو في السوق، ويقول ها أنا انسلخ مما كنت أعتقد كما انسلخ من ثوبي هذا ويرميه كناية عن التغيير والانسلاخ من المعتقد القديم.
لكننا اليوم نشهد خلافات فقهية أو سياسية تؤدي لمعارك فصائلية يقتل فيها خيرة شباب الإسلام، ثم يتراجع الفصيل دون أن يذكر شيئا أمام أتباعه أو عائلاتهم التي خسرت أولادها في تلك المعارك العبثية الضالة.
ولو أن لأولئك القادة أهداف سامية لدفعتهم الأخلاق لإتخاذ موقف تاريخي في حياتهم، وبينوا لماذا انسلخوا من معتقداتهم وما كانوا عليه وعادوا لجادة الصواب ولتبرؤوا منها على العلن، بل أمام أتباعهم مقدمين الخوف من الله على خوفهم من الرأي العام ونظرة الأتباع المقدسة لهم.
نشهد اليوم بعض الفصائل تنقلب على نفسها وتراجع أحكامها الخاطئة على استحياء أو تفاوض خصومها في الأمس ومن حرمت التعامل معهم من تحت الطاولة، تاركة أتباعها رهينة أحكام قديمة خاطئة، قد يعيش ويموت العنصر التابع لهم وهو يعتقد أنه على الحق الذي لا يجوز الحيد عنه، أو لربما يقاتل ثم يقتل من أجله، بينما القائد والشرعي لتلك الفصائل يراجع نفسه ويبيح ما كان محظوراً على غيره، بل قاتل في الأمس القريب من كان يحمل هذا المعتقد، وأكبر دليل على تلك المراجعات هي العلاقة بين الثورة والأتراك، التي بدأها الجيش الحر منذ اندلاع الثورة، حيث إهتم بتلك الروابط من منطلق التحالف الاستراتيجي الذي لا بد للثورة حتى تصل إلى أهدافها.
تتقلب بعض الفصائل تارة تحرم التعامل مع الأتراك وتصدر بيانات تدعم رأيها بالأدلة وتارة تبيحها مع التحفظ وتارة تبيحها على الإطلاق أو تنفذ أجندتها من خلف الكواليس وهي تكسوها الكسوة الدينية وتستدل بالأدلة والحجج الشرعية على صوابها.
إذاً أين كانت تلك القواعد الشرعية والنصوص عندما قاتلت تلك الفصائل منافسيها من الجيش الحر الذي سبقها بإقامة تحالفات مع الأتراك؟ .... أم كان ذلك القتال من أجل السيطرة والسلطة لا أكثر؟
 ٨ يناير ٢٠١٩
٨ يناير ٢٠١٩
لا يخفى على أحد أن الشمال السوري بات مركز تجمع كبير لجل فصائل المعارضة الرافضة للتسوية مع النظام إضافة للفصائل المحلية في الشمال، والتي تعددت راياتها ومشاريعها بفعل الداعمين الذين استثمروا هذه الفصائل لأجنداتهم ثم تركوها تواجه مصيرها اليوم.
اجتماعات عدة عقدت في تركيا قبل أشهر بعد دخول القوات التركية لإدلب بهدف حمايتها من روسيا والنظام وفق اتفاق خفض التصعيد، وكانت مطالب الجانب التركي لجميع قادة الفصائل بضرورة التوحد تحت قيادة واحدة ليسهل التعامل معها وتنظيم وضع المنطقة مدنياً وعسكرياً، ولكن جميع المحاولات ورغم كل الضغوطات لم تنجح في التوصل لاتفاق مشترك، وتمسك كل قائد فصيل بموقعه وطالب بموقع قيادي في التشكيل الجديد فباءت كل المحاولات بالفشل ....
لاحقاً لمسنا توحد فصائل الجيش الحر والصقور والزنكي والفيلق والأحرار وعدة مكونات أخرى تحت قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير"، واستبشر خيراً في هذا الفصيل الذي جمع جل المكونات العسكرية وبات في موقع موازي لهيئة تحرير الشام، إلا أن الاندماج كان شكلياً وبقي كل فصيل بقيادته ومناطقه وعقليته، الأمر الذي عقد الموقف أكثر في الشمال جراء تضارب المواقف من أي قرار يتعلق بالمنطقة، مع فشل محاولات تشكيل كيان مدني موحد أيضاَ.
نتيجة تعنت الفصائل وبعض المواقف التي تحسب عليها دولياً، يبدو أن الدول المعنية بدعم الفصائل والتي تسعى لتوحيدهم سحبت يدها وتركت كلاً لمصيره، ويبدو أن ورقة حركة الزنكي سقطت بشكل كامل لمواقف عديدة ترتبط بالفصيل لاسيما أنه كان تحت قيادة هيئة تحرير الشام في مرحلة ما وثم انشق عنها ثم واجهها ولكنه لم يستطع كسر الحاجز الذي سببه انضمامه للهيئة مع فصائل الجيش الحر، ولأسباب أخرى فكانت نهايته سريعة خلال أيام على يد الهيئة.
وللأسباب السابقة يرجع تباطؤ قيادة فيلق الشام في مساندة الزنكي وربما يكون ذات الموقف في مساندة أحرار الشام والصقور، مع الحفاظ على موقف غير تصعيدي مع هيئة تحرير الشام التي يبدو أنها ستكون شريكة المرحلة القادمة في الشمال السوري، يتشارك فيها الفيلق والفصائل المنضوية معه في الجبهة الوطنية مع قيادة هيئة تحرير الشام في إدارة المنطقة مدنياً وعسكرياً، كون الهيئة قابلة للتغير وفق ماتتطلبه المرحلة ومايريد اللاعبين خارجياً لتضمن الاستمرار وتضمن الخروج من التصنيف لاحقاً في حال استجابت لكل المطلوب.
"صقور وأحرار الشام" هي الهدف الثاني لهيئة تحرير الشام بعد إنهاء الزنكي، والسياسة المتعبة هي "الإنهاء أو الركوع" والتي ستكون خياراً صعباً أمام الطرفين، فإما مواجهة الهيئة وحيدين وربما تتمكن من إنهائهما على غرار الزنكي، أو التوصل لحل وسطي يضمن "الرضوخ" وقبول الانحلال بشكل كامل ضمن الجبهة الوطنية للتحرير، ولعل الأيام القليلة القادمة توضح إلى ما ستؤول إليه الأمور مع إصرار الطرفين على المواجهة عسكرياً والتي يبدو قد بدأت.
ولعل البعض يوجه الاتهام لدول جارة أو أخرى بعيدة بأنها هي من دفعت الهيئة لإنهاء الفصائل، لكن هذا الكلام لايمكن الأخذ به، ولكن الراجح أن تلك الدول قد عجزت في توحيدها كما أسلفنا سابقاً، وبالتالي رفعت يدها، وهي تراقب مجريات الوضع، فهي تحتاج في النهاية لقيادة حقيقية تجلس معها وتحاولها وتتفق وإياها على إدارة المنطقة، وفق قواعد وأسس هي تحددها لتضمن تجنيب المنطقة ويلات الحرب وتضمن إنهاء كل الحجج الروسية لاجتياحها وفق مرحلة لن تكون قصيرة.
والتعويل اليوم في المرحلة الحرجة في الشمال السوري - وفق متابعين - على مدى قدرة هيئة تحرير الشام على تغيير سياستها وإنهاء التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها تجاه الحاضنة الشعبية والتخفيف من سطوة حكومتها الإنقاذ مدنياً، وتقديم شيئ حقيقي يضمن لها تأقلمها مع المناطق الرافضة لها والتي لاتتمتع فيها بأي شعبية كريف حلب الغربي والأتارب ومعرة النعمان ومناطق عديدة هي تحت سيطرتها أصلاً، لتستطيع حقيقة أن تجلس على طاولة التفاوض وتقول أنها تمثل هذه الفئات والمناطق، إضافة لمدى جديتها في التعامل مع المطالب الدولية لتقبلها والتعامل معها مستقبلاً بشكل حقيقي، وإلا ستكون نهايتها على غرار من أنهتهم بيدها ولكن هذه المرة بقرار ومشاركة دولية.
قراءة: أحمد نور
 ٦ يناير ٢٠١٩
٦ يناير ٢٠١٩
منذ اليوم الأول للحراك الشعبي كان شعار الجماهير ومطلبهم هو التوحد في مواجهة النظام بين المدن والبلدات الثائرة، فخرجت كل المدن السورية نصرة لدرعا، ثم نصرت درعا دمشق ونصرت دمشق حمص وساندت حماة إدلب وخرجت حلب دعماً لحماة دير الزور والرقة وتشتت النظام بين المدن السورية وبدأت تخرج فصائل الجيش السوري الحر تباعاً وتحرر في المناطق السورية حتى وصل النظام لمرحلة عصيبة وحوصر في دمشق والساحل، وبدأ يستنجد الحلفاء .....
ما حصل لاحقاً أن شعار التوحد بات مجرد عبارات نرددها شعبياً وآيات قرآنية ومواعظ نسمعها على ألسنة القادة وشرعييهم، ولكن لم يطبقها أحد، فظهر أكثر من 150 فصيلاً من الجيش الحر براية واحدة وأفكار متضاربة وداعمين متفرقين، وبدأت تظهر الفصائل الأخرى المتشددة والوسطية و وووو ... وبات كل طرف يحارب الآخر ولو استطاع عليه لما تركه.
وهنا بدأت التحالفات لإنهاء الخصوم، وساهمت جميع الفصائل في إنهاء بعضها البعض إما بالمشاركة عسكرياً أو الصمت أو التآمر أو ....... ولنا أمثلة كثيرة من الغوطة وإدلب ودرعا وحلب وحماة على غدر الفصائل بعضها ببعض، وفي كل مرة كان هناك طرف أقوى يتغلب بتحالفاته حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تراجع وانكسار يتحملها جميع القادة دون استثناء، كون أي منهم لم يتنازل للأخر لتحقيق التوحد الحقيقي وجعلوا من أنفسهم مطية للدول الغربية والعربية يسمعون وينفذون وعندما تسقط ورقتهم لا يجدون من يساندهم في وجه الفصيل الباغي عليهم.
ألم يحارب الجميع داعش ولكن هناك من ساندها، وحاربت جبهة النصرة وجند الأقصى جبهة ثوار سوريا وهناك من التزم الصمت ومنهم الحياد ومنهم دعم من وراء حجاب، وحاربت جبهة النصرة حزم وصمتت باقي الفصائل، ثم جاء الدور على الفصائل الأخرة فكانت نهاية اللواء السابع جيش المجاهدين والجبهة الشامية وصولاً لانقلاب الهيئة على جند الأقصى، ومن ثم أحرار الشام وآخرها الفصائل الذي انضوى تحت عباءتها وساعدها في تشكيل هيئة تحرير الشام فصيل الزنكي فكانت نهايته على يد حليفه الأسبق، في وقت تهدد باقي الفصائل، واحدة تلو الأخرى كيف لا وهي الفصيل المتغلب على الجميع، ثم ألم تسقط الغوطة بسبب خصام أبرز فصيلين فيها جيش الإسلام وفيلق الرحمن، وكذلك ريف حمص ودرعا ووو..
ولعل ما أوصلنا لمرحلة تغلب تحرير الشام على الجميع سببه تشرذم الفصائل وتعدد داعميها، في وقت كان الجولاني واعياً بما يخطط له وعارف بما ينتهج، لتحقيق مبتغاه في السيطرة الكاملة وإنهاء جميع الخصوم، فاستغل الفصائل واحدة تلو الأخرى باتفاقيات "خفض تصعيد" سرية، فأنهى الأول والتفت للثاني وهكذا حتى تغلب على أبرز حلفائه من داخل هيئة تحرير الشام وأنهاهم وأجبرهم إلا التسليم والرضوخ أو الخروج بدون سلاح لتتم له السيطرة المطلقة.
الثورة اليوم أكلت نفسها، وقتلت بعضها البعض، لأجل بقاء القادة وبقاء المناصب ورفضاَ للتنازل، فكان مصير الجميع واحدا، عندما أكلنا بعضنا وتركنا عدونا الحقيقي ينتظر إنهاء أبناء الثورة أنفسهم، ويتغلب بعضهم على بعض، في وقت تستمر عذابات المدنيين وتشردهم ويصلنا يومياً قوائم بعشرات الأسماء للمتوفين تعذيباً في سجون النظام، ونحن نغفل عنهم ونحارب أنفسنا بأيدينا ونقتل بعضنا البعض وننهي ثورة شعب قدم كل مايملك من دماء وعذاب ينال الحرية ويسقط نظام مستبد، فلم نستطع نصرته ولا حتى نصرة أنفسنا في وجه الباغي الأكبر، بل صنعنا مستبدين جدد بأيدينا.....
 ٥ يناير ٢٠١٩
٥ يناير ٢٠١٩
لعل مئات الآلاف من المدنيين يراودهم سؤال واحد اليوم، آلا وهو "متى يبغي الجولاني على الأسد" ويعلنها حرباً تسير لها الجيوش التي يسيرها منذ 2014 ضد فصائل الجيش السوري الحر التي أنهى منها أكثر مما استطاع الأسد خلال ثماني سنوات مضت من عمر الثورة، مقدماً للنظام وحلفائه خدمات مجانية بقتل أبناء الثورة وزيادة التشرذم والتفكك بمكونات الثورة وحاضنتها.
أكثر من عامين على سقوط مدينة حلب وتوقف معارك حماة، وهيئة تحرير الشام تزيد من سيطرتها وتملكها على المحرر الذي بات محصوراً في بقعة جغرافية صغيرة في ريف إدلب، سلمت ربع تلك المساحة خلال أيام وتخلت الهيئة عن مناطق واسعة شرقي سكة الحديد، لتعاود في كل مرحلة انهزام تجييش عناصرها ضد فصيل عسكري جديد، وبدعوى وحجج جديدة.
"نصرة الدين وإخراج المعتقلين في السجون، وتحرير القدس، وفتح دمشق" باتت شعارات من الماضي، أكل عليها الزمن وشرب، وبات تحرير المحرر وتملك مقدراته هو السمة البارزة لدى الجولاني وعناصره وشرعييه، ليسفك المزيد من الدماء المعصومة بفتاوى القتل بالرأس، وليسجد أبو "اليقظان" على مشارف دارة عزة التي حررها من أهلها، وكأنه في ساحة سعد الله الجابري.
وفي كل مرة يسوق الجولاني حجة جديدة للتغلب والبغي على الفصائل، ويدعي أن هذا لمصلحة الساحة، وأن الفساد قد استشرى في منطقة الخصم، ليتوى هو محاربته وسفك الدماء وتسيير الجيوش والدبابات، التي صوبت فوهاتها باتجاه المحرر، وتركت النظام آمناً مطمئناً، إلا من بضع عمليات مسكنة يطبل لها ويدعي فيها الانتصار ومقارعة النظام والتنكيل به.
"متى يعلن الجولاني أن الأسد فاسد، وأن هناك فساد أعظم وحرمات تنتهك في سجونه، ويسير الجيوش لنصرة المستضعفين، ويحرر المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا الفصائل، ومتى نرى أبو اليقظان والفرغلي وغيرهم من مشرعي سفك الدم يفتون بحرمة التعامل مع الأسد وتبادل المعابر والبضائع، ومتى يفتون بوجوب إنهاء الأسد وتخليص سوريا من رجسهم وظلمهم وفسادهم الأعظم، ألم يحن الوقت بعد ....!!
 ٢ يناير ٢٠١٩
٢ يناير ٢٠١٩
تدخل الثورة السورية في عامها الثامن في ظل انتكاسة كبيرة لم يسبق أن سجلها التاريخ، بعد كل ماقدمه الشعب السوري من تضحيات ودماء وعذابات، ليعلن الأسد "انتصاره" على ركام المدن السورية وجثث الأطفال وعذابات السوريين، وفي الطرف المقابل لايزال نزيف الدم السوري ينزف وتتوسع جراحه باقتتالات داخلية أعطت للأسد وحلفائه المزيد من الوقت لمواصلة القتل وساهمت بشكل كبير في إضعاف الفصائل الثورية وإنهاء تأثيرها على الأسد.
منذ اليوم الأول لإعلان تشكيلات الجيش السوري الحر، كان الشعب السوري متفائلاً بقدرة الثوار القلائل مع الضباط والعناصر المنشقين على قهر الأسد والدفاع عنهم في وجه طغيانه، وبنى آماله وحماهم وناصرهم رغم وجود بعض الاختراقات التي شوهت مسيرة الصادقين منهم في سنوات لاحقة، وبالفعل تمكن الجيش الحر الذي تعددت فصائله ومناطق انتشاره من تحرير جل المناطق السورية وبات الأسد محاصراً في الساحل ودمشق يناشد حلفائه للإسراع في إنقاذه.
لم يكن التدخل الإيراني والروسي وحده من قتل الثورة وساهم في تراجعها، بل إن الاقتتال الداخلي هو القاتل الأول لعزيمة الثوار والمدنيين، بعد أن تشتت كلمة أبناء الثورة وباتت الدماء المحرمة تسيل في طرقات المناطق المحررة، فسيرت الأرتال وحشدت الجيوش كل مرة بحجة لإنهاء فصيل من الجيش الحر والسيطرة على مقدراته.
ولعل أول من بدأ البغي والتعدي على الفصائل كان تنظيم داعش، تبعه "الجولاني" قائد جبهة النصرة ليكمل الطريق بالبغي وراء البغي على فصائل الثورة، فأنهى خلال أربع سنوات مضت أكثر من 30 فصيلاً عسكرياً، مقدماً للأسد وروسيا جل المناطق المحررة على طبق من ذهب بعد أن أنهى فصائلها وساهم في إضعاف جاضنتها، ابتداءاً من الجنوب السوري حتى إدلب وحلب وشرقاً حتى دير الزور والرقة، لتتوالى الانسحابات بعدها من المناطق المحررة وتحاصر المعارضة في بقعة جغرافية صغيرة في الشمال السوري اسمها "إدلب".
ورغم كل ماوصل إليه الحال من التراجع والانكسار في الثورة السورية، ورغم أن كل الشعارات التي رفعها الجولاني كانت كلاماً عابراً، ورغم أن آلاف المعتقلين في السجون لم يخرجهم أحد، ورغم أن مئات الآلاف مشردين في خيم مهترئة في البراري ومناطق اللجوء، إلا أن الجولاني لم يشبع من دماء الفصائل الأخرى، ففي كل مرة تبرم الهدن مع النظام ويهدأ القصف عن أجساد المدنيين، يحرك أرتاله لبغي جديد، ويزهق أرواحاً بريئة بفتاوى الفرغلي وأبو اليقظان والشرعيين المتسترين وراء حجاب.
ولطالما نادى الأحرار بضرورة التكاتف والتوحد بين جميع الفصائل لمواجهة مطامع الجولاني في السيطرة وإنهاء أبناء الثورة، إلا أن الشقاقات الداخلية كانت الحاجز الأكبر أمام توافق الجيش الحر والفصائل الأخرى في التوحد لمواجهة البغي، لا بل ساند بعضهم الجولاني في بغيه على الفصائل، فهذا الفصائل يهادن والآخر يصمت والثالث يساند سراً، حتى تمكن الجولاني من الاستئثار بالفصائل واحداً تل الآخر وصل الحال لأبرز المقربين منه ليس أحرار الشام وإنما رفقائه في البغي على الجيش الحر من جند الأقصى وحتى المنضوين في صفوف تحرير الشام ممكن قرروا الانشقاق عنه لينال منهم.
ورغم أنه بات واضحاً رفض التحاكم للشرع لعشرات المرات ورفض دعوات العلماء لحقن الدماء ونداءات المدنيين لعدم اقتحام المناطق المحررة بالدبابات، إلا أن الفصائل حتى اليوم تأخذ دور المتفرج وهو يواصل القتل والإنهاء، وكأن هؤلاء المدنيين في مناطق لاتخضع لسيطرتهم لايعنون لهم بشئ، فيستبيحها الجولاني وينهي فصيلاً كان يقاتل النظام ويسد ثغرات كبيرة، ليعد العدة فيما بعد لإنهاء الفصيل المتفرج وهذا ماحصل لعشرات المرات إلا أن الفصائل لم تتعلم فنال منهم آحادى والدور قادم على من بقي منهم إن لم يردعوه اليوم ويوقفوا استباحة الثورة السورية بشعارات الدين ونصرة المستضعفين.