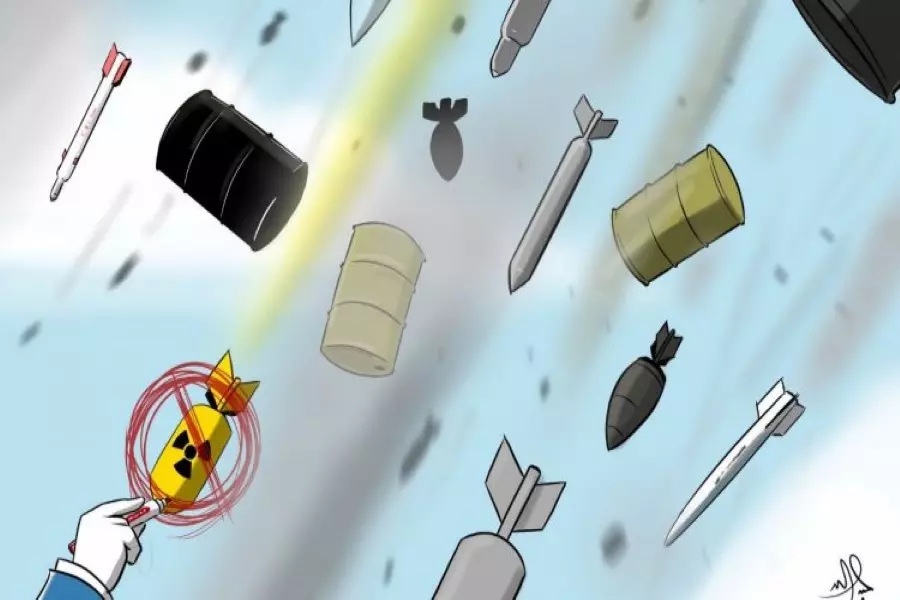 ٩ أبريل ٢٠١٧
٩ أبريل ٢٠١٧
من حق البسطاء أن يفرحوا بالضربة الأمريكية… لكن ماذا بعد؟
ينكر البعض على البسطاء تعبيرهن البريء عن فرحتهم؛ لرجم الصواريخ الأمريكية أحد مطارات “الضرار”، وإخراجها عن الخدمة ليلة ال7 /4 /2017م ،نعم فعلها ترامب، وقصف أحد المطارات الذي كان يوزع الموت والرعب والدمار يوميا على سائر المناطق المحررة بلا انقطاع.
ما إن أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ الضربات، حتى دخل الكثير من السوريين سكان المناطق المحررة في غمرة الفرح، ومنهم من سكنه ولا يريد لأحد أن يخرجه منه.
لكن البعض اصطدم بواقع لا يمكن تجاهله، ولا بد من التفكير به لبعض الوقت مع استحضار التجارب السابقة.
ما سبب هذا التقلب السريع في السياسة الأمريكية؟، وهي الدولة المنحدرة من سلالة الدول المستعمرة، والتي لا تتصرف بمنطق العاطفة ولا تدفعها الحماسة كما يحدث معنا نحن العرب، ولا تهتم حتى بردود الفعل العالمية أمام تحقيق مصالحها،
أمريكا هي البلد التي حصدت الملايين من المساكين في دولة عربية مجاورة، من أجل تنفيذ مشاريعها، وسلب ثرواتها.
فالأخلاق والإنسانية آخر همها إذا حضرت المصالح القومية، وما التصريحات الإعلامية إلا سلعة تعرض في سوق المجتمع الدولي، بينما يسيطر على سياستها الغموض، وما عليها إلا افتعال الأزمات في الدول ومن ثم توجيهها، و التحكم بها لصالحها.
لكن لماذا تلك الضربات المفاجئة في هذا الوقت؟
هل فشلت أمريكا في إسقاط الأسد سياسياً، وقطعت الأمل برحيله رغم كل الدعوات السابقة؟
لا شك إن لم يستفد العرب من تجاربهم مع الأمريكان في العراق والجزائر والصومال وغيرها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل، وتعد من أجل ذلك دراسات وأبحاث ضخمة بكوادر علمية وإمكانات مادية، للاستفادة من كل شاردة وواردة في مختبر الشرق الأوسط.
التذبذب والضبابية سمة عامة وأصل السياسة التي تنتهجها أمريكا، وستكون مع مصالحها حيث تكون لا حيث يكون الواجب الإنساني أو الضمير كما يظن البعض.
ستة أعوام من عمر الثورة السورية كفيلة لكي يتعلم أولي الألباب كيفية التعامل مع الذبذبة الأمريكية، وضرورة أخذ أعلى درجات الحذر منها عندما تكون معك وتتظاهر أنك تهمها وتعمل من أجلك.
لم يعجب أمريكا منجزات الديمقراطية في المنطقة؛ التي جلبت “مرسي” لمصر و”حماس” لفلسطين و”أردوغان” لتركيا. فدعمت الانقلابات على الشرعية، وحاصرت من اختارها، وفشلت في تركيا أخيرا.
أيضا لم يعجبها التمدد الأيراني الشيعي في العراق ولا تريده أن يخرج عن السيطرة فدعمتهم في العراق ضد صدام، وتتظاهر بدعم السنة في سوريا ضد الأسد بدعم محدود يضعف الخصوم، ولا يجهز عليهم، وتقتل شبابهم بحروب طائفية لا نهاية لها، أمريكا مضطرة دائما لإيجاد حاضنة تثق بها من العملاء.
وخاصة بعد سيطرتها على آبار النفط والغاز لتضمن إعادة إعمار هادئ، والاستجمام بالثروات بلا منازع، فكان الحل بالتظاهر في دعم الثورة، ولا يحتاج صمود هذا الشعب الأسطوري، إلا لشريك غربي يخطف ثورته وكفاحه ويتوج انتصاره بمسرحية التبني الخبيثة.
ولو أنها أرادت إنهاء النظام، لضربت رأس الأفعى في قصره ولم تتجه إلى الذيل أصلا.
ففعلتها في مطار “الشعيرات” المختلف عليه بين إيران وروسيا، كما سرب عنهم من قبل، وما هذت المسرحية إلا مسألة تصفية حسابات، وتقسيم ما تبقى من الكعكة، ويثبت هذا أيضا انفرادها بالضربة من بين جميع الدول، وهذا يعني أن بوسعها فعل ما تريد خارج مسرح مجلس الأمن.
وإن كانت الضربة قد أفرحت الكثير وانتهى الأمر، إلا أن الأمر الذي لم ينتهي هو ما بعد الحضور الأمريكي الفظ والغليظ بقيادة ترامب.
 ٩ أبريل ٢٠١٧
٩ أبريل ٢٠١٧
لن يقضى على أي تنظيم إرهابي له أرضية في الدول العربية كتنظيم داعش في سوريا والعراق، وتنظيم القاعدة في اليمن، ونظام الأسد معهم الذي لا يتورع عن استخدام الكيماوي لقتل الأطفال إلا بقطع أذرع إيران التي نمت ورعت جميع تلك التنظيمات الوحشية.
إنما لن يكبح جماح إيران وتُحجّم عبر مزيد من العقوبات على الشعب الإيراني، بل تقطع أذرعها التي نمت خارج حدودها، فإيران تمارس الإرهاب عبر أذرعها الممولة من ميزانية معزولة عن موازنتها الخاصة، ومصادر تمويل بعض تنظيماتها الإرهابية هو الأخماس التي تدفعها بعض الطوائف في بلداننا العربية التي ترى ما يرتئيه خامنئي، والتي تصل قيمتها إلى ما يقارب الخمسة والتسعين مليار دولار، سبعة مليارات ونصف المليار دولار هي ما خصصتها إيران لنشر الإرهاب في العالم حين خصصت هذا المبلغ لأكبر تنظيم إرهابي على وجه الأرض «الحرس الثوري»؛ ليرعى هذا التنظيم كل الميليشيات الشيعية التي تعيث في الأرض فساداً.
وليس سراً أن متنفذين في الحكومة العراقية والحكومة اللبنانية وما تبقى من الحكومة السورية عاجزون عن لجم «خدم إيران» في دولهم، فـ«حزب الله» اللبناني يحكم القبضة على لبنان ويقاتل إلى جانب نظام الأسد جنباً إلى جنب الميليشيات المرتزقة الآسيوية التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» العراقي ومعه ميليشيات الحشد الشعبي يداران أيضاً من قبل الحرس الثوري الإيراني، وجميعهم قوات عربية تدين بالولاء لإيران، تلك القوات هم دولة داخل دولة، وبفضل التسليح الإيراني والتمويل الإيراني، فإنهم خارج نطاق التغطية القانونية، إذ يبدو أنه لا عون ولا العبادي، وبالتأكيد لا الأسد بقادرين على مراقبة أو التحكم في تلك الميليشيات المسلحة التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني مباشرة وتمول من قبله.
إيران بأذرعها هذه هي من يهدد أمن الخليج العربي وأمن البحر المتوسط وأمن البحر الأحمر، ويهدد باب المندب ومضيق هرمز، ويهدد أمن البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت بشكل مباشر، وهي من يدرب الميليشيات الإرهابية على الأراضي العراقية، وتنطلق الأسلحة والمتفجرات العسكرية التي عثر عليها في البحرين وفي السعودية تمر عبر العراق بطرق ملتوية، لذا يفترض قطع دابر الإرهاب والتغول الإيراني في المنطقة، أي في سوريا والعراق.
فإن كانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا صادقتين في رغبتيهما في القضاء على الإرهاب ومقتنعتين بأن إيران هي الداعم الأساسي للإرهاب، وأن تحجيم إيران ووقف عربدتها في المنطقة هو أول طريق مكافحة الإرهاب، فإن تحجيم إيران لا بد أن يبدأ في لبنان والعراق وسوريا، لا من الداخل الإيراني.
والنصيحة الأميركية التي دعت إلى احتواء هاتين الدولتين العربيتين نصيحة نقدرها ونثمنها، وهي في محلها ونتفق معها، فلا نتمنى يوماً أن نرى هاتين الدولتين العربيتين رهينتين تحت يد إيرانية، إنما بشرط أن تعمل الدولتان اللتان نصحتنا بتوثيق العلاقة (أي بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية) على الضغط على الحكومتين العراقية واللبنانية لتتحملا مسؤولية كبح جماح الميليشيات المسلحة داخل دولتهما وتدخلاتهما غير المرحب بها في دولنا الخليجية. ذلك الضغط وحده من ستستمع له الحكومتان؛ إذ من الواضح أنه لا تقريب العبادي ولا تقريب عون كانا مجديين أو أتى بنتيجة إلى حد الآن، ونحن في انتظار الحسم في هذا الموضوع.
نتفهم أن يتأخر هذا الضغط الأميركي على العراق ولبنان إلى حين الانتهاء من القضاء على «داعش» أو أي تنظيمات إرهابية أخرى، بل إن الدول الخليجية تساهم في التحالف الدولي للقضاء على «داعش»، إن كان التأخير وتأجيل المواجهة مع تلك الميليشيات أمراً مرحلياً وتكتيكياً ينتظر الانتهاء من خطر أولي، ومن ثم الالتفاف على الخطر الآخر، لولا أننا نثق بأن إيران لن ترغب في القضاء على «داعش»؛ لأن ذلك يعني انتفاء حجتها ومسمار جحا الذي تدعي أنها موجودة في المنطقة بسببه، فإن قضي عليه فلا بد أن تخرج وتعود إلى دارها، وهذا ما لا تريده، فأصبحت المعضلة البيضة قبل الدجاجة، أم الدجاجة قبل البيضة.
وإن صحت المعلومات التي تشير إلى أن سبب تأخير المواجهة في الرقة والموصل وتلعفر بين التحالف الدولي وبين «داعش»؛ لأن التحالف يبحث عن بديل يسد الفراغ أولاً قبل إخلاء المنطقة من «داعش»! - أصبحت إذن «داعش» مطلوبة الآن يا للسخرية القدر - فإن إيران ستعيق حتماً أي اتفاق على بديل، لتتضح الصورة أكثر، ويتأكد العالم أن إيران هي الداعم الأساسي لـ«داعش».
الخلاصة، أنه ما زالت «داعش» هي حجة إيران لبقائها، وما زال لخدم إيران اليد العليا في العراق وسوريا ولبنان، فسيبقى «داعش» وسيستمر التمدد الإيراني، وسيمتد الإرهاب إلى منطقتنا وبقية العالم كما هو حاصل الآن. القضاء على «داعش» يبدأ بقطع كل نظام أو تنظيم تدعمه إيران.
 ٩ أبريل ٢٠١٧
٩ أبريل ٢٠١٧
في أقل من أسبوع نجح بشار الأسد في تحويل دونالد ترامب من رئيس انعزالي لا يعير اهتماماً لما يجري في العالم إلا بالقدر الذي يفيد أميركا ومصالحها، ويدعو الى ترك مصير الرئيس السوري في يد السوريين، الى رئيس مستعد لاستخدام القوة لمواجهة الجريمة التي ارتكبها النظام السوري ضد أطفال خان شيخون ونسائها وشيوخها بقصفهم بالأسلحة الكيماوية.
نجح الأسد في تغيير الصورة التي كوّنها العالم عن ترامب. صار المشككون بقدرات الرئيس الأميركي مضطرين للدفاع عن قراره. بفضل الأسد صار ترامب نقيضاً لباراك أوباما. لا يطلق التهديدات الجوفاء. لا يقف متفرجاً أمام مشاهد الأطفال الذين يختنقون نتيجة تنشق السموم التي أنعم بها رئيسهم عليهم. لا يضع علاقته مع موسكو في موقع الأولوية التي تسبق مسؤولية الولايات المتحدة كدولة عظمى عن حماية الأمن العالمي. بفضل بشار الأسد استيقظ دونالد ترامب على حقيقة ما يجري في العالم من حوله، خارج الحدود الأميركية، وخصوصاً على حقيقة دور روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في البلطجة الدولية التي يمارسها، والتي انتهت بالرئيس الروسي الى التحالف مع اسوأ الأنظمة في العالم ومع أسوأ السياسيين العنصريين والشعبويين.
في قراءته الحمقاء لمواقف دونالد ترمب، اعتبر بشار الأسد أن كلام الرئيس الأميركي وأركان إدارته عن أولوية الحرب على تنظيم «داعش»، وترك مصير الأسد للسوريين ليقرروه، بمثابة ضوء أخضر يسمح للنظام السوري أن يفعل بالسوريين ما يشاء. لا بد أن الأسد قرأ ايضاً أن ترامب اعترض أيام باراك أوباما على التدخل الأميركي في سورية، بحجة أن هذا التدخل لا يخدم المصلحة الأميركية. لا بد أنه اعتبر ايضاً أن التصريحات الايجابية التي اطلقها ترامب عن بوتين، حليف الرئيس السوري، تشكل غطاء كافياً يحمي الأسد ويوفر له المظلة الدولية التي تمدّ بعمر نظامه وتقطع الطريق على مطالب المعارضة بإزاحته عن السلطة. ولا شك في أن هذا الاستقواء هو الذي دفع بشار الجعفري، ممثل النظام في مفاوضات جنيف الأخيرة، الى شن هجماته على ممثلي المعارضة، معتبراً انهم إرهابيون، لا يستحقون الجلوس الى مقاعد التفاوض حول مستقبل سورية.
قد يسأل البعض، من المدافعين عن بشار الأسد ونظامه: لماذا يقدم الأسد على «خطأ» مثل الذي ارتكبه في خان شيخون، فيما هو يدرك أن الظرف الأميركي والدولي مواتٍ له الآن؟ ويتجاهل هؤلاء أن هذه الحماقة ليست الأولى التي يرتكبها رأس النظام السوري خلال السنوات الست الماضية. كما ينسون أن جريمة خان شيخون ليست أولى جرائمه الكيماوية في حق السوريين. واذا كان 80 شخصاً ماتوا في خان شيخون، فقد قتل الأسد 1300 في غوطة دمشق، التي حماه بوتين بعدها من «الخط الأحمر» الذي رسمه أوباما، ليتبيّن الآن أن إخراج الأسلحة الكيماوية من سورية كان التزاماً كاذباً لم ينفذه النظام، بدليل استخدامها مرة جديدة في خان شيخون.
منذ بداية التظاهرات في درعا كان في وسع بشار الأسد استيعابها بطريقة لا تصل الى تهديد النظام وتدمير سورية. وعلى امتداد هذه السنوات كان في وسع الأسد أن يواجه المعارضين بسلوك مختلف عن ارتكاب المجازر، ما دفع التيارات المعتدلة في المعارضة الى الاصطفاف مع المتطرفين، بعدما لم يترك لها النظام خياراً آخر. غير أن الأسد اختار أن يصنف الجميع في خانة الإرهابيين، معتقداً أن هذه الطريقة تحميه وتدفع العالم الى الوقوف الى جانبه.
من أسوأ أقدار السوريين أنهم باتوا مضطرين للرهان على حماية رئيس مزاجي مثل دونالد ترامب، لإنقاذهم من جرائم «رئيسهم». من أسوأ أقدارهم أيضاً أن قصف مطار الشعيرات يمكن أن يكون بداية مسلسل حربي لا يد لهم فيه ولا حيلة. إذ لا أحد يستطيع أن يحدد منذ الآن مصير العلاقات الأميركية الروسية بعد هذه الضربة، ولا المدى الذي يمكن أن يصل اليه التدخل الأميركي، وما اذا كان سيبقى في حدود قصف محدود يشكل درساً للنظام، أم يتدهور هذا التدخل الى مقدمة لحملة واسعة تعيد الى الأذهان سيناريو غزو العراق، بعد أن فتح العالم عيونه على جرائم صدام حسين، بعد قصف أكراد حلبجة بالسلاح الكيماوي.
 ٩ أبريل ٢٠١٧
٩ أبريل ٢٠١٧
هل هذا هو ترامب الآخر، ترامب الصارم والجاد والمخيف أيضاً، الذي فاجأ الجميع بمن فيهم شخصيات بارزة من الحزب الجمهوري، عندما اختار بطريقة "أضرب حديداً حامياً"، أن يوجّه مجموعة واسعة من الرسائل والإشعارات النارية عبر قاعدة الشعيرات السورية التي دمرها ولم يُصب جندياً روسياً واحداً من الذين كانوا فيها؟
الحجم السياسي الذي أحدثه القصف الصاروخي المحكم، أكبر بكثير من الحجم العسكري، ولو صارت الشعيرات ثانية قواعد سوريا العسكرية، بما فيها من مقاتلات روسية حديثة، وأولى الرسائل جاءت من أميركا المرتاحة لعودة هيبة واشنطن بعدما تراجعت كثيراً أمام موسكو. فقد أشاد جون ماكين وليندسي غراهام وماركو روبيو وبوب كروكر بترامب الذي دفن سياسة التخاذل الأوبامي، عندما قطف اللحظة المناسبة من بوابة الحس الإنساني بعد مجزرة خان شيخون الكيميائية، ليقول للأسد وحماته الإقليميين وحلفائه الروس "كفى، الأمر لي، أميركا تنتصر للعدالة"!
الأضرار السياسية للعملية ستكون عميقة وفادحة في روسيا، بعدما كان فلاديمير بوتين قد مضى بعيداً فوق رقعة تخاذل واشنطن، تغيرت قواعد اللعبة كلها ولا معنى لحديث موسكو عن تغيُّر في قواعد الاشتباك فوق سوريا. حاول الروس حفظ ماء الوجه بالإيحاء بأن واشنطن أعلمتهم سلفاً بالعملية، فرد جيمس ماتيز فوراً بالنفي، ولكن يكفي ان لافروف يأمل "ألا تتضرر العلاقات مع واشنطن"!
بعد مجزرة الغوطتين تمكن بوتين من تكبيل أوباما باتفاق نزع ترسانة الأسد الكيميائية، أمس تمكن ترامب من تكبيل تفرّد بوتين بسوريا وبغير سوريا، فلا يفلّ الحديد إلا الحديد، وكل الصراخ الروسي الذي سمعناه وسنسمعه لا معنى له، أكثر من يعرف ذلك هو بوتين الذي كان ارتعد لمجرد تهديد أوباما بالقصف عام ٢٠١٣، ولكن ها هو القصف ينزل جراحياً، فقط ستة قتلى ودمار قاعدة كبيرة وليس من نقط دم روسية!
مضحك تهديد موسكو بجلسة طارئة لمجلس الأمن الذي عطّلته بالفيتو ثماني مرّات لمنع الحل وانحيازاً الى النظام، مضحك أكثر القول إن التحضير للقصف سبق مأساة خان شيخون، التي حاولت موسكو التعمية عليها بذرائع لا تليق بدولة مثل روسيا!
الإيرانيون الذين كانوا أكثر حذراً بعد خان شيخون، عندما نددوا بالعملية من أين أتت ولم يدافعوا عن حليفهم الأسد، تلقوا أمس رسالة قوية ليس لأنهم يتخذون الشعيرات قاعدة مهمة لإدارة عملياتهم في سوريا والعراق فحسب، بل لأن صواريخ ترامب الذي يهاجمهم ويعِد بردعهم، تستطيع ان تقصف تحدياتهم في مضيق هرمز وباب المندب.
كوريا الشمالية وصلتها رسالة حامية عبر الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي كان مجتمعاً مع ترامب في فلوريدا عندما أنطلقت الصواريخ، لأن ترامب يقول "سنسوي ملف بيونغ يانغ إن لم تفعل الصين".
 ٩ أبريل ٢٠١٧
٩ أبريل ٢٠١٧
فعلاً لا قولاً، أصبح الأسد سيد العالم، وإليكم بعضاً من مئات البراهين التي تعتمد على مسلمات هندسية واضحة.
منذ زمان طويل كنت أقول إن الصهيونية هي المتربعة على عرش الماسونية، والماسونية هي التي تقود أميركا وتوجهها، وأميركا هي التي تجر العالم إلى حيث تريد الصهيونية.
لكن قناعتي تغيرت منذ قيام الثورة السورية وحتى مجزرة الكيماوي التي حدثت في خان شيخون يوم الثلاثاء 4 / 4 / 2017، فالأسد الآن، كما أزعم، هو الأمين العام المطلق للماسونية العالمية، وهو الآن يتربع على عرش العالم، وسوف تظل هذه القناعة راسخة في ذهني إلى أن يثبت العكس.
منذ الأشهر الأولى لانطلاقة الثورة السورية السلمية، حمل الأسد بوقه الذي يشبه بوق إسرافيل في طوله وعرضه، وبدأ ينفخ فيه محذراً العالم من قدوم الإرهابيين، فها هم الآن ينتشرون في شوارع المدن السورية، ويدعون إلى ترهيب الأسد وسلطته، ويطالبون بإسقاطه، ثم يقول الأسد: وغداً سينطلقون لتدمير العالم إذا لم تساعدوني في توطيد عرشي الذي ورثته عن والدي، قدّس الله سره.
شنّف العالم آذانه عند سماع صوت بوق الأسد الذي يلف الكرة الأرضية، وأخذ الكل يفكر ويتفكر، ففي كل نبرة من نبرات البوق ينطلق منها خمسة ملايين معلومة مخابراتية.
عرف الأسد ببصيرته العمياء أن العالم بدأ يميل إلى التصديق بأن الإرهابيين هم الذين يشعلون الشوارع بالمظاهرات، فراح يرشّهم بالرصاص أولاً. ثم كان صمت العالم هو الضوء الأخضر للأسد، فاستمر صعوداً في قتل الشعب السوري، بدءاً من رصاص البندقية إلى الرشاش إلى قذائف الدبابات والمدافع وصواريخ الطائرات وبراميلها المتفجرة.
خجل العالم من صمته المشبوه، فأراد تبييض صحيفته المشوّهة، فطلع بعبارته الشهيرة.!!: الأسد فقد الشرعية ". واستمر الجميع يلوكون هذه العبارة حتى اشمأزت النفوس من تكرارها. أما الأسد فيقول عبر لقاء صحفي: كل ما يقال عن رحيلي عن السلطة أرميه في سلة المهملات، أي أنه يدير قفاه لكل زعماء العالم الكبار، ويقول لهم: طاء زاي عليكم.
واستمر الحال هكذا من القتل والتدمير، دون أن يرتدع الشعب السوري بالعودة إلى حضن الوطن والقبول بالأسد إلى أبد الآبدين، حتى فكر بسلاح جديد لم يسبقه إليه أحد من عباد الله الطالحين، لأن ضرب الشعب الخارج عن الطاعة بالمدافع والدبابات والصواريخ والطائرات لم يعد يُشبع طموحاته المستقبلية، فقام في شهر آب من عام 2013، برش أهل الغوطة بالمبيدات السامة فسقط في يوم واحد أكثر من 1500 ضحية من نساء وأطفال ورجال.
عندئذ اخنقّ وجه أوباما وارتفع ضغطه غضباً من الأسد، وبدأ يهدد ويتوعد، وأيقنت القارات الخمس أن البطشة الكبرى بذلك المجرم الذي يقتل شعبه، ستحدث بين عشية وضحاها. لكن أوباما فجأة لوى عنان أساطيله البحرية والجوية، واتجه صوب "الغرب الأميركي"، بعد أن حصل على جائزة ترضية، مقدارها تدمير سلاح الأسد الكيماوي، مع رسم خط أحمر، صار يُعرف بخط أوباما الأحمر.
وبعد أن تم تدمير ذلك السلاح، بقيت منه بقايا، كانت كافية لارتكاب المزيد من الحماقات. وهكذا ظل الأسد يستخدم الأسلحة المحرمة، وعلى رأسها الكيماوي دون وازع أو مانع أو رادع، حتى أن خط أوباما الأحمر الشهير بات يُضرب به المثل بالمهزأة والمسخرة من قبل العامة والخاصة، فهذا السناتور الأميركي جون ماكين الذي قال: سبق للأسد أن شن هجوماً كيماوياً، والرئيس أوباما فعل ما هو أسوأ من مجرد الوقوف مكتوف الأيدي، فقد هدد ولم يفعل شيئاً، فأعطى الأسد الضوء الأخضر لممارسة المزيد من القتل وسفك الدماء.".
ويوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، ظل دم الشعب السوري يستمر بالنزيف، حتى وصل عدد الضحايا والجرحى والمشردين إلى أرقام خيالية لن يصدقها عاقل، لولا أنها أرقام حقيقية وموثقة، تراها العين بأوضح صورة وأبشعها.
ثم رحل أوباما بعُجَره وبُجَره، وتعلق الناس بغُرّة ترامب الشقراء، وانتظروا منه الأمل والخلاص، بعد أن غلّف نفسه بظاهرة صوتية أشبه بفقاعة الصابون، وأخذ يتحدث عن مناطق آمنة في سورية. إنما فيما يبدو قد جاءه "العلم بالشيء" من المحفل الماسوني، فانفجرت الفقاعة الصوتية الترامبية عن تصريحات، مختصرُها المفيد: تغيير نظام بشار الأسد ليس من أولوياتنا". وهذا التصريح جاء برداً وسلاماً على قلب الأسد، فبعد وقت قصير قام بترجمة تلك العبارة إلى زرع بلدة خان شيخون بالأسلحة الكيماوية السامة، والنتيجة وقوع نحو مئة ضحية عدا المصابين، معظمهم من الأطفال والنساء.
هذه الفعل الشنيع وغيره نابع من منهجية الأسد وقناعته، فهو الذي يقول: ليس أمامنا خيار سوى الانتصار، وإن لم ننتصر فهذا يعني أن سورية سوف تُمحى من الخارطة، لذلك نحن مستمرون ومصممون على النصر "، لكي لا تُمحى سورية من الخارطة.!!..
أليس هذا هو الشعار الذي رفعه منذ بداية الثورة أنصار الأسد وكلابه المسعورة: إما الأسد أو نخرب البلد.!؟.
والآن بعد أن نُكبت خان شيخون بالكيماوي السام، ماذا فعل العالم.!؟.
في البداية لا شيء في الأفق سوى الإدانة والاستنكار. وربما ينجرّ الكثيرون وراء أكاذيب روسيا الملتقطة من الإعلامي الموالي حسين مرتض، فطائرات الأسد قصفت مصنعاً للإرهابيين كان ينتج المواد الكيماوية في خان شيخون، وتبرّر روسيا كذبتها بأن سحابة الكيماوي البيضاء انطلقت من داخل المصنع، وليس من فوقه، أي أن الطائرات بريئة، فلم تقصف الكيماوي.
ودعمت روسيا كذبتها المستوردة من مرتضى بما زعمته من أن طفلة صغيرة من خان شيخون شاهدت بوضوح طائرة تقصف أحد الأبنية، واخترقت القذيفة سطح البناء، ثم ارتفعت سحابة بيضاء ".
هكذا اعتمدت المخابرات الروسية وأعلامها على الكاذب حسين مرتضى، وعلى حديث متوهم من طفلة صغيرة، دون أن يتساءلوا كيف مات أكثر من مئة، ولم تمت الطفلة طالما كانت قريبة جداً من مكان الانفجار وانتشار الغبار السام .!؟.
لكن الكاذبين لا يفكرون بمثل هذه الأسئلة، فهم يلقون بأكاذيبهم وينتظرون، فلعلها تلتصق بذهن من يشتهي أن لا يكون الأسد هو من ضرب الكيماوي فعلاً، وهذا ما يمكن أن نتلمّسه من موقف فرنسا وبريطانيا، فالأولى دعت إلى جلسة طائرة لمجلس الأمن لبحث ما " يُشتبه" بأنه هجوم كيماوي في محافظة إدلب، والثانية طالبت بمحاسبة الأسد " في حال ثبت.!!. أنه مرتكب المجزرة"، وهذا يعني أن الدولتين لا تزالان تشككان بمسؤولية الأسد عن ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.. أليس هذا ما تعنيه ألفاظ الدولتين.!؟.
أما ترامب فاستشاط غضباً وأخذ يتوعد الأسد، تماماً كما فعل أوباما، لكن معظم المطلعين استبعدوا أن يقوم بعمل عسكري ضد الأسد، ونبشوا أفكاره ومواقفه المنشورة، ومنها هذه التغريدة التي كتبها عام 2013، وفيها يخاطب أوباما بعد أن أوهم العالم آنذاك أنه سوف يضرب الأسد: إلى رئيسنا الأحمق، لا تهاجم سوريا، وإذا فعلت، ستحدث الكثير من الأمور السيئة للغاية، ولن تحصل الولايات المتحدة على شيءٍ من هذه المعركة.!".
ومع ذلك ارتفع اللغط بين المحلّلين والمراقبين، منهم من زعم أن ترامب سيبطش بالأسد، ومنهم من نفى ذلك، وأنا من النافين. ولكن أبو علي ترامب لم يترك الناس يتجادلون طويلاً، فصباح يوم أمس الجمعة، أي بعد يومين من حدوث المجزرة، بطش بالأسد، ودمر له مطار الشعيرات، حيث انطلقت منه الطائرة التي قصفت الكيماوي على خان شيخون.
حسناً.. لنتأمل المشاهد التي تواردت فيما بعد.
ــ أميركا أبلغت روسيا بالضربة مسبقاً، وهذا يعني أن روسيا أوعزت للأسد بترحيل ما يمكن ترحيله بعيداً عن المطار، من طائرات وعساكر ومتاع وخلاف ذلك.
ــ ترامب اكتفى بضرب مطار الشعيرات، ولم ولن يضرب غيره من المطارات أو قواعد الدفاع الجوي بحسب ما قاله قادة ترامب.
ــ الضربة كانت مسرحية استعراضية، والدليل أن طائرتين انطلقتا من المطار نفسه صباح اليوم السبت، كما انطلقت طائرات أخرى من مطارات أخرى لتقصف العديد من المدن والبلدات المحررة.
ــ مندوبة أميركا في اجتماع لمجلس الأمن قالت: ممنوع على الأسد استخدام الكيماوي، يعني أن أميركا لا تكترث فيما إذا الأسد استخدم البراميل المتفجرة، والقنابل الفوسفورية، والعنقودية، والارتجاجية، والصواريخ العابرة للمحافظات، لقتل الشعب السوري. فهذه الأسلحة لا تدخل في قائمة الممنوعات بمفهوم أميركا.
هذه المشاهد وغيرها تبقيني، أنا العبد الفقير لله تعالى، مقتنعاً أن الأسد لا يزال متربعاً على عرش العالم، ما لم يتقدم ترامب بمعطيات جديدة، وينفذ الخيار الأكثر قوة والمطروح على طاولة البيت الأبيض، وهو كما يسمونه: ضربة " قطع الرأس" على قصر الأسد الرئاسي بدمشق، وما لم تؤدي هذه الضربة، إن حدثت، إلى خلع الأسد من جذوره الدكتاتورية والطائفية.
 ٨ أبريل ٢٠١٧
٨ أبريل ٢٠١٧
أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تركيز دور بلاده في العالم، في سعيه إلى "أميركا عظيمة". 59 صاروخاً من نوع "توماهوك" على مطار الشعيرات، شرقي حمص السورية، كانت كفيلة بتأييد أغلبية دول الكوكب الإدارة الأميركية الجديدة. أعلن ترامب عن وجوده بهذه الضربات، معيداً "الهيبة" الأميركية إلى الساحة الدولية، الهيبة التي سقطت بفعل تردّد سلفه باراك أوباما.
قبل إتمام المائة يوم الأولى في عهده، كشف ترامب عن نياته السورية. يريد التفاوض هناك مع الروس، لا مع غيرهم. ضرب مطار الشعيرات يُمكن وصفه بأنه خطوة شبيهة بقصف بارجة نيوجيرسي الأميركية مواقع في لبنان، في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990). مع فارق أن الضربة التي حصلت عام 1983 لم تؤدِّ إلى فعل عسكري محدّد، بل أفسحت المجال أمام قيام محاولات سياسية لإنهاء الحرب في البلاد. لم ينسّق الأميركيون في حينه مع أحد، ما أجّج نيران الحرب اللبنانية، أما أمس، فإن غارات ترامب من المفترض أن تفضي إلى تسريع الجهود السياسية في سورية.
وفقاً لكرونولوجيا الضربات الأميركية، فإن ترامب أبلغ الروس والإسرائيليين ومعظم دول الغرب بالضربة. لا الروس حرّكوا منظومة "إس 300"، ولا ترامب قصف أماكن وجود القوات الروسية في الشعيرات. كل شيء بدا "مرسوماً" بين الفريقين، فالرئيس الأميركي سبق له أن أكد "عدم نيته مواجهة روسيا، بل التعاون معها". كما أن الردّ الفعل الروسي تجلّى في عبارة للكرملين سبقت الضربات، جاء فيها إن "دعم موسكو بشار الأسد ليس غير مشروط".
بهذه الضربات، أفهم الأميركيون الجميع، خصوصاً إيران ودول الجوار السوري، أن "القرار في سورية يعود للأميركيين وللروس". بالتالي، ستتخذ المفاوضات السياسية منحىً أكثر ليونةً من كل الأطراف السورية، في سبيل الوصول إلى حلّ سياسي، بحسب النظرة الأميركية ـ الروسية المشتركة سورياً. ما سيؤدي إلى تراجع ميداني مفترض، لكل القوى العسكرية غير المحسوبة على الروس أو الأميركيين، ويقطع الطريق على نوايا "الحشد الشعبي" العراقي مواصلة الطريق إلى سورية، حسبما أعلن مسؤولوه في وقتٍ سابق، بعد "تحرير الموصل العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". ومن المفترض أن يلي تلك الضربات تنسيق ميداني بين الروس والأميركيين في معركة الرقة المرتقبة.
ثنائية أميركا ـ روسيا في سورية ستكون أساس التعاون المشترك عالمياً، من سورية إلى كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وأوكرانيا وأفغانستان وإيران واليمن وغيرها. استعاد البلدان لغة الثنائية القطبية، في ظلّ تضعضع الهيكل الأوروبي، ومنعاً لبروز قوى أخرى كالصين مثلاً. أما العتب المتبادل فليس سوى أداة أساسية في رفع سقف الشروط بين واشنطن وموسكو، لا يتجاوز سقفها التفاهم غير المعلن بينهما.
الأساس في سورية أن الضربات لا تهدف لا إلى دعم المعارضة السورية، ولا إلى إسقاط النظام السوري، بل إلى ترسيخ النفوذ الأميركي، تماماً كما حصل في العام 2015 حين قصف الجيش الروسي من بحر قزوين 24 صاروخاً في سورية، معلناً أنه "سيد المنطقة الممتدة من بحر قزوين إلى البحر المتوسط"، شاملاً إيران وتركيا والعراق وسورية ولبنان. ترامب فعل الأمر نفسه، للقول إن في سورية سيدين لا ثالث لهما: هو وفلاديمير بوتين.
ليست الصواريخ الـ59 مجرد أدوات لقصفٍ محدود في سورية فقط، بل رسالة تفيد بأن أميركا ـ باراك أوباما انتهت إلى لا رجعة، وأن أميركا ـ دونالد ترامب تعمل وفقاً لشعار "أميركا أولاً". ترامب رجل أعمال أولاً وأخيراً، لا يهمه ما يحصل خارج الولايات المتحدة إلا في سياق انعكاسه على الداخل، وعلى المنظومة الاقتصادية التي يعمل على تغييرها. كما كسب معركته الخاصة في الكونغرس وداخل حزبه الجمهوري. هو ليس ملاكاً مرسلاً، فمرسوم الهجرة ضد ست دول إسلامية ما زال "صامداً".
 ٨ أبريل ٢٠١٧
٨ أبريل ٢٠١٧
يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مساحات كبيرة من أراضي سورية اليوم، ربما تصل إلى ما يفوق 35% من مساحة سورية، صحيح أنها أراض في معظمها غير مأهولة بالسكان، لكن "داعش" تمكّن من السيطرة على مدن ومراكز حضرية مهمة، أهمها الرقة وأجزاء كبيرة من مدينة دير الزور، بالإضافة إلى مدن أخرى خسرها في معاركه ضد أطراف مختلفة، مثل عين العرب (كوباني) ومنبج في معركته ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وأخيراً خسر مدينة الباب في معركته ضد الجيش الحر، مدعوما من القوات التركية. السؤال الآن: من الذي سيقود عملية تحرير الرقة؟ ومن سيحكم الرقة بعد تحريرها؟
بدأ الخلاف الأميركي – التركي يتصاعد بسبب اختلاف وجهات النظر حول من سيقود عملية تحرير الرّقة، تركيا قدّمت خططها للولايات المتحدة، وأعلنت أنها مستعدةٌ لقيادة معركة تحرير الرقة، بمشاركة فصائل الجيش السوري الحر التي شاركت في عملية درع الفرات في تحرير مدينة الباب من "داعش"، واشترطت في الوقت نفسه عدم مشاركة "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تشكل وحدات الحماية الكردية القسم الأكبر منها، والتي تصنفها تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية، وتعتبرها مجرد امتداد سوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا.
يبدو أن الولايات المتحدة كأنها فضلت الاعتماد على قوات سورية الديمقراطية، بدلا من الاعتماد على حليفها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تركيا، كما تفيد التقارير الصحفية، وبالتالي، ستكون تداعيات تحرير الرقة خطيرة للغاية، وذات تداعيات إقليمية كبيرة، وعلى ذلك يمكن تصور سيناريو تحرير الرقة كالتالي:
الأول: إذا ما رفضت الولايات المتحدة أي دور تركي في عملية تحرير الرقة، واكتفت بدعم قوات سورية الديمقراطية (المكونة بشكل رئيسي من الكرد)، فإن عملية تحرير الرقة ستستغرق وقتاً أطول ربما يصل إلى شهور، مع احتمالات توقفها أو تأخرها لأسباب كثيرة، منها لوجستية، وفي مقدمتها رفض تركيا السماح بالمساعدات الإنسانية والعسكرية بالمرور عبر أراضيها، فتركيا الآن رفضت تراخيص أكثر من عشر منظمات دولية، لاتهامها بأنها تعمل في المناطق الكردية في سورية، تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا حزباً إرهابياً. وفي الوقت نفسه، ربما يعزّز هذا الإهمال الأميركي لتركيا تصاعد المواجهات العسكرية بين تركيا وقوات الحماية الكردية في منبج وغيرها من المناطق، ما يضيع البوصلة بشكل كامل في الحرب ضد "داعش"، ويطيل أمد الحرب الأهلية السورية، وقد يتحول إلى نزاع إقليمي مع اصطفاف النظام السوري إلى جانب قوات الحماية الكردية في معركتها ضد تركيا.
الثاني: فيما إذا قرّرت الولايات المتحدة الاعتماد على حليفها التركي، وقوات درع الفرات المكونة من الجيش السوري الحر التي نجحت في تحرير الباب من قبضة "داعش"، فإن مؤشرات كثيرة تدل على قصر عمر المعركة في الرّقة بسبب احترافية الجيش التركي وقوته، مقارنة مع مليشيات قوات الحماية الكردية. وفي الوقت نفسه، بسبب التنسيق التركي – الروسي المستمر، فربما تستطيع روسيا تحييد قوات النظام السوري إلى حين تحرير الرقة، وهو ما سيعجل من العمليات العسكرية. وفي الوقت نفسه، يسهل عمليات إخلاء المدنيين من الرقة، بسبب المعارك المحتملة، فهناك أكثر من 150 ألف مدني سوري على الأقل يعيشون في الرّقة تحت حكم "داعش". وبالتالي، قيادة تركيا العملية ستجبرها على الأخذ بالاعتبار عمليات إجلاء المدنيين، وهو ما لم يتم في حال إشراف وحدات الحماية الكردية التي ليس لديها أي منفذ حدودي مع تركيا في الوقت الحالي، ولن تسمح لها تركيا بكل الأحوال الإشراف على عملية الإخلاء الإنساني، كي لا تعزّز سيطرتها في مناطق الشمال السوري.
الثالث: وهو يتطلب صفقة أميركية – روسية – تركية، بمعنى نجاح كل من الولايات المتحدة
وروسيا المتحالفتين مع قوات حماية الشعب الكردية في إقناع تركيا في تحييد خلافها مع الكرد مؤقتا، والقبول بمشاركتها مع قوات الحماية الكردية في الحرب ضد "داعش". وتبدو احتمالات هذا السيناريو ضعيفة للغاية، بسبب الموقف التركي المتشدّد أولا. وثانيا تضعضع الثقة بين تركيا والولايات المتحدة، والأهم من ذلك كله أنه لا يوجد إلى الآن تنسيق أميركي – روسي عالي المستوى، يسمح بإعطاء الضمانات الضرورية لتركيا بقبول هذا السيناريو. ولذلك تبدو فرص هذا السيناريو كما ذكرت ضعيفة للغاية.
يبقى القول إنه، وبغض النظر عن السيناريو المحتمل لتحرير الرقة، فإن العملية لن تكون نهاية "داعش" في سورية، فالتنظيم المذكور ما زال يسيطر على مراكز مدنية، كأجزاء من مدينة دير الزور والبوكمال وغيرها. وبالتالي، ربما يتحول باتجاه التركيز للاحتفاظ بتلك المناطق بشكل مستميت للغاية. وفي الوقت نفسه، اتباع استراتيجية انتشار الخلايا، بحيث تتمكّن هذه الخلايا من الضرب، بغض النظر عن الهدف، مدنيا كان أم عسكريا. وفي كل منطقة، تتمكّن من القيام بذلك، وهو ما سيزيد من شعبيته، ويمكّنه من الحفاظ على قوته الأيديولوجية، وعدم انطفائها بشكل نهائي.
 ٨ أبريل ٢٠١٧
٨ أبريل ٢٠١٧
فعلها “الدونالد” ولَم يتردد في إحياء الردع الأحادي الأميركي انطلاقا من الساحة السورية في قلب الشرق الأوسط الملتهب. عبر هذه الضربة التحذيرية والمحدودة ضد قاعدة الشعيرات الجوية التي انطلق منها سرب طائرات قامت بالمجزرة الكيميائية في خان شيخون، نلمس تمهيدا لتغيير في قواعد اللعبة إن لناحية عدم إفلات المنظومة الحاكمة من العقاب أو باتجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالذات الذي استفاد من تساهل الإدارة السابقة كي يكرس انتدابا على سوريا بالتناغم مع النفوذ الإيراني. وبالطبع يتوجب الحذر من استنتاجات متسرعة قبل اتضاح مآل الحوار المنتظر بين الجانبين الأميركي والروسي قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو.
لن تعدل هذه الضربة، التي فيها جانب استعراضي، في أولويات واشنطن. لكن بالإضافة إلى رسائلها المتعددة الاتجاهات، ستلي هـذا التطور على الأرجح بلـورة سياسة أميركية متماسكة وفعالة في الملف السوري.
ما بعد الهجوم الكيميائي في خان شيخون ليس كما قبله، ومما لا شك فيه أن هول الصدمة إزاء الشراسة وقتل الإنسانية وعدم احترام اتفاق العام 2013 دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليعلن من دون مواربة أن “سوريا باتت مسؤوليتي” وسرعان ما تغيرت اللهجة في واشنطن.
بشا
لم يعد يسري مفعول تصريحات الأسبوع الماضي عن ترك مصير بشار الأسد معلقا مع إمكان التسليم ببقائه أو بتأهيل نظامه، وبات خيار إزاحتـه في مرحلة لاحقة مطروحا.
وهناك بالطبع من يتساءل عن أسباب إقدام النظام السوري على القيام بهجوم كيميائي، بينما ميزان القوى يميل لصالحه وهو غير مضطر عسكريا إلى ذلك، وعلى الأرجح ارتكب بشار الأسد خطأ في التقدير واعتبر أنه غير خاضع لأي عقاب ممكن وأنه يملك رخصة مفتوحة للقتل بعد تصريح أميركي عن عدم أولوية إسقـاط النظام، وهكذا يشبه هذا الوقوع في المحظور ما ارتكبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عندما فسر كلام السفيرة الأميركية إبريل غلاسبي في يوليو 1990 بـأنه نوع من الضـوء البرتقالي للمغامرة في الكويت وكانت النتيجة المعروفة. بيد أن تمادي النظام في استخدام كل أساليب القتل ومتاعبه العسكرية في ريف حماة ليس بعيدا عن تمركز حاضنة قاعدته السياسية، ربما يفسر سبب هذا التهور والثقة الزائدة بالنفس.
مقابل هفوة أو خطيئة المنظومة الحاكمة في دمشق، والتي حصل الكثير مثلها في السنوات الأخيرة، أتت المفاجأة من ردة الفعل الأميركية لأن إدارة دونالد ترامب المتعثرة وجدت ضالتها عند ارتكاب النظام السوري هذه الحماقة كي تتحرك، تماما ولو وفق مقاييس أخرى كما حصل إبان الحرب العالمية الثانية عندما شن الجنرال الياباني ياماموتو هجوم بيرل هاربر الذي كان سبب دخول أميركا الحرب.
إزاء إقلاع صعب للرئيس الجديد إن في موضوع قراراته التنفيذية حول الهجرة وتأشيرات الدخول، أو في موضوع التأمين الصحي الذي أقره باراك أوباما، وأمام حملة الشكوك المحيطة بعلاقة فريق ترامب الانتخابي مع روسيا بوتين وخاصة بعد إقصاء الجنرال مايكل فلين عن مجلس الأمن القومي وإبعاد ستيف بانون المثير للجدل (المستشار الاستراتيجي للرئيس) عن المشاركة في عضويته، أثرت هذه العوامل الداخلية في قرار ترامب الذي انتهز الفرصة كي يثبت بعده عن “بوتين”، وفي نفس الوقت يسترجع هيبة أميركا كما وعد خلال حملته الانتخابية.
ونظرا لأن ترامب وعد أيضا باحتواء إيران ويعمل على فك الارتباط الاستراتيجي بين موسكو وطهران، أراد الرئيس الأميركي من وراء هذه الرسالة العسكرية المحدودة (حتى هذه اللحظة لأن التتمة تتوقف على ردة الفعل الروسية وتفاعلات هجوم التوماهوك) توجيه رسـائل سياسية قـوية عن القيادة الأميركية ومحاولة تبييض الصـورة بالنسبة للـدفاع عـن القيم الإنسانية.
ومن رسائل هذه الضربة رسالة واضحة من المؤسسات الأميركية فحواها أن موسكو لا تتحكم لوحدها بالورقة السورية، وأن واشنطن مصممة على استرجاع زخم فقدته إبان إدارة أوباما.
ومن الرسائل الأميركية الأخرى هناك طمأنة واشنطن لحلفائها الإقليميين وتبين ذلك من ردود الفعل المرحبة من المملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل في آن معا.
بعد أقل من مئة يوم على بدايات صعبة ومتعثرة لولايته، يلبس الرئيس دونالد ترامب ثوب القائد الأعلى ويُقلد سلفه الجمهوري دونالد ريغان حينما أمر بضرب ليبيا في العام 1986، بعد اتهام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بالوقوف وراء الاعتداء على ملهى في برلين الغربية، سقط فيه جنود أميركيون.
وبالطبع ستكون لهذه الضربة ضد مطار الشعيرات مفاعيلها على مدى أسرع مما كانت انعكاسات ضربة ريغان.
وفي خطابه بعد الهجوم كان دونالد ترامب واضحا عندما قال “لقد فشلت سنوات من المحاولات السابقة لتغيير سلوك الأسد، وقد فشلت فشلا ذريعا، ونتيجة لذلك، لا تزال أزمة اللاجئين تتفاقم، ولا يزال استقرار المنطقة يتزعزع ويهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”.
هكذا لم يعد اقتلاع تنظيم داعش ومحاربة الإرهاب الأولوية المطلقة بشكل معزول عن باقي أوجه المأساة السورية.
انطلاقا من السيطرة على مطار الطبقة والانطلاق إلى الرقة ودير الزور تأمل واشنطن في التحكم في منطقة حيوية بعد طرد داعش منها، والسعي بعد هذه الرسالة القويـة إلى الحوار مع موسكو لتقليص الدور الإيراني وإبعاد الميليشيات الموالية لإيران. وتحقيق هذين الهدفين يسهل إنجاح العملية السياسية وفق القرار 2254. بيد أن هذا التصور الأميركي الأولي لإستراتيجية عمل في سوريا سيخضع لتداعيات ضربة السابع من أبريل وتفاعلاتها.
 ٨ أبريل ٢٠١٧
٨ أبريل ٢٠١٧
«أحياناً لا تجد الإجابات عن الأسئلة التي تحاصرك، فلا تملك إلا التململ أو التجاهل أو الوقوف على سطح مبنى قديم؛ لتتأمل زرقة السماء، وحركة المجرات، وتعُد النجوم، وأنت ترتشف قهوة داكنةَ السواد، تشبه واقع الحال العربي «المقطع الأوصال»، ثم تزفر من قسوة الصورة، تظل واقفاً «بائساً» «مختشباً»، على شرفة عربية «آيلة للسقوط»، وأنت تستعرض شريط الأحداث السياسية، والشعارات والكلمات والتصريحات، ثم تدير ظهرك لتلك النافذة «الخجولة»، مصوِّباً عينيك على الشاشات الإخبارية، لتشاهد أخباراً مأسوية عاجلة تنقل عمليات قتل واغتيالات ومآسي ومذابح، لا يسلم منها أحد حتى النساء والأطفال الأبرياء.
تحل نوبات البكاء، وتمسح عينيك بمنديل من دم، ويظل قلبك يرتجف، ورئتاك تنهمران بالدموع. هكذا هي الحال في سورية وأنت تشاهد الموت والجثث وأشلاء الأطفال الأبرياء في كل البلدات وتحت الأنقاض».
هكذا بعض ما كتبت متلوعاً في عام 2012، على وقع حمام الدم في سورية.
تأملوا.. بعد مضي أعوام عدة لم يتغير شيء، فما لبثت أن وقعت مجزرة «الكيماوي» في الغوطة الشرقية (21 أغسطس 2013)، التي راح ضحيتها 1127 مدنياً سورياً، 201 منهم نساء، و101 طفل، ها أنا أكتب الآن على وقع مذبحة خان شيخون في 2017 التي لقي فيها أكثر من 100 مدني مصرعهم، بينهم 20 طفلاً بريئاً وبالكيماوي نفسه!
ما أظلم النظام البعثي في سورية وما أكثر جرائمه، وما أظلم القوى التي تدعمه: روسيا وإيران وتابعها «حزب الله» وتلك الميليشيات الطائفية. لا شك أن الضربة الأمريكية لنظام الأسد تبعث الأمل لكنها ليست كافية بل تحتاج إلى تكتل وتكامل دولي لإسقاط نظام المجرم.
وعلى رغم مرور أكثر من ستة أعوام.. لا يزال العالم غارقاً في الجدل أمام نفس الصورة، وعاجزاً في أكبر مؤسساته الأممية (مجلس الأمن) عن اتخاذ قرار ينقذ شعباً.
وتنتهي الاجتماعات المغلقة والمفتوحة إلى دماء وإحباطات.
روسيا مسلحة بالفيتو، وتتنزه بالطائرات في أجواء سورية كل يوم لإفناء شعب لا ذنب له. كم من السوريين هجِّروا من ديارهم بسبب النزاع؟ ثمانية ملايين سوري يعيشون لاجئين ومشردين، كأتعس ما تكون الحال. آلة بشار الأسد العسكرية التي تعززها الطائرات الروسية والميليشيات الإيرانية الأصيلة والوكيلة أبادت 500 ألف سوري، نصفهم من الأطفال والنساء..
والعالم يتفرج.. والجامعة العربية تجتمع وتنفضّ.. ومجلس الأمن يتلقى لطمات الفيتو الروسي مذبحة تلو مجزرة، والسوريون يموتون، وبراميل المتفجرات، وبراميل الغاز السام، وقذائف
الدبابات وصواريخ الطائرات لا تتوقف. والأسد يتفنن ويتلذذ بأكل لحم شعبه مشوياً، ومشوهاً، ومُدمىً.
عام سابع بدأ وبارود ونيران بشار وحلفائه لا تنتهي. و«داعش» يجز الرؤوس. والسوريون يُهجَّرون ويشردون وينزحون نحو موت جديد. ستة أعوام مضت وروائح الجثث أضحت مقيمة في كل بلدة وقرية ومحافظة سورية.
أين إرادة المجتمع الدولي لإسقاط نظام المجرم؟ ماذا أصاب العرب بعد أيام فقط من لقاء قادتهم على شط البحر الميت حيث رفرفت أعلام النظام السوري القاتل؟
كيف تجرأ النظام الأسدي على زيادة وتيرة سفك الدماء، وتدشين المجازر والمذابح، ونحر النسوة والأطفال، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها؟ لقد تجرأ على تلك الفظائع؛ لأنه أَمِن العقاب الدولي، مطمئن إلى أن هناك قوى أكثر شراً منه تدعمه لا تبالي مثل «نيرون» تتفنن بحرق النظام العالمي في سبيل ضمان هيمنتها، وتحقيقها ما تعتبره نصراً على القوى التي تنافسها.
كيف يمكن إرساء مبدأ العدالة للشعوب لئلا تجد الأمم المتحدة مصير عصبة الأمم، وتصبح شريعة الغاب، و«القروش الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة» أساساً للنظام العالمي في القرن الـ 21.
الأكيد أن سورية تقطع من الوريد إلى الوريد، وأضحت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تكون، أو لا تكون.
إما أن يرفع العالم المعاناة عن شعبها، وإما نشيعها إلى مصير قاتم.
السؤال اليوم..
هل العالم على شفير مواجهة عالمية كبرى على الأراضي السورية؟!
هل سيبقى الدور العربي على الهامش حيال كارثة تواجه شعباً عربياً؟. الموقف السعودي السريع المؤيد للضربة العسكرية الأمريكية ضد نظام الأسد مهم و«متقدم»، ولو كانت الضربة محددة.
المخالب الأمريكية تعود للمنطقة.. والدب الروسي يدرس حلوله مع القتلة، ولكنه يعرف أن «نزهة أوباما ولت» وصرامة ترمب حضرت.
ترمب قال وفعل.. الرسالة الأمريكية وصلت للكرملين والملالي والأسد، لكنها ليست كافية قبل الشروع في خطة إسقاط نظام المجرم بشار الأسد ووضعه في «الزنزانة» ومحاكمته كمجرم حرب.
عهد ترمب ليس كعهد أوباما. المرحلة مختلفة. المنطقة ملتهبة، ومقبلة على المزيد من النار والبارود، والتضحيات، والمواجهات الكبيرة لحسم الملفات المؤجلة والمعلقة.
 ٧ أبريل ٢٠١٧
٧ أبريل ٢٠١٧
نام السوريون أمس على فراش وسير من الإشاعات والتكهنات ملأت صفحات التواصل، إثر اجتماع مجلس الأمن، والتسريبات الواردة من أمريكا التي لم تثبت حتى الصباح عندما استيقظ الجميع على ضربات التوماهوك الأمريكية للنظام السوري.
تتكرر هذه الحالة مع كل تلويح بتهديد يستهدف النظام الأسدي، فتعود أسطوانة انشقاق فاروق الشرع، وهروب الضباط من دمشق إلى الساحل، واستنفار أمني في محيط مشفى الشامي بدمشق، وسماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق.
من المضحك والمبكي في آن واحد!
أن تلامس فرحة ضربات التوماهوك الأمريكية لمطار الشعيرات قلوب الملايين، فانطلقوا للتعبير عن فرحتهم بكافة الطرق على وسائل التواصل المتاحة.
يرى الكثيرون أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف النظام، وضرب البنية التحتية له لا أكثر، بهدف فرض مناطق آمنة مستقبلاً، أو إجباره على الانحسار للساحل تمهيداً لفرض مناطق الحكم الذاتي التي ظهرت ملامحها في الآونة الأخيرة.
بينما يستبشر آخرون، ويعتبر ما حصل بداية حرب روسية أمريكية، ستوجع إيران حتماً، وتوقف احتلال المليشيات الشيعية لمناطق السنة، وتهجير أهلها أمام أعين المجتمع الدولي.
مما سيؤدي لقطع الحاضنة الشيعية في لبنان عن أختها في العراق، والتي كانت ستصل بحاضنة مصطنعة في سوريا بعد سياسة هدم مناطق السنة وتهجير أهلها منها.
كما أنها ستؤدي حتماً لإضعاف مليشيا حزب الله في المنطقة.
فهل ستصدق أمريكا وتتابع العمل، أم ستكتفي بتلك الضربات، لتكون رسالة لنظام الأسد، وعملية لابتزاز الروس والحصول على حصة أكبر؟
هذا ما سيظهر قريباً.
 ٧ أبريل ٢٠١٧
٧ أبريل ٢٠١٧
يوم 4 – 4 – 2017 هو يوم مأساة في سوريا، وسيكون أيضاً يوم واجه دونالد ترمب حقيقة أن يكون رئيساً للولايات المتحدة الأميركية!
ما حدث قبل ذلك كان انتخابات وخاضها ترمب بكل قوته وذكائه وماله. دخل واشنطن مثل قائد روماني عاد منتصراً من أرض المعركة، ودخل إلى البيت الأبيض بعقلية صانع التغيير في الولايات المتحدة وفي الساحة الدولية، ومن حينه حدثت أشياء.
أولها أن الرئيس الجديد أمر بعملية كوماندوس في اليمن، وقد قتل جندي أميركي من الوحدات الخاصة. ذهب ترمب لاستقبال الجثمان والتقى أهل الجندي القتيل. تحدث ترمب عن تلك التجربة، وقد ضاع منه الكلام، وقال "إن ما رآه كان جميلاً جداً".
بعد ذلك أخذ ترمب قرارات مهمة، مثل الذهاب مع "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الرقة، وزيادة عدد المستشارين العسكريين في سوريا والعراق، وبدا حذراً جداً وكأن تجربة اليمن كانت درساً أول.
يوم 4 – 4 - 2017 قصف النظام السوري خان شيخون، وشاهد دونالد ترمب صور الأطفال القتلى! مات أكثر من ستين سورياً على يد نظام الأسد، ومات أيضاً "المرشح" في دونالد ترمب.
خلال المؤتمر الصحافي مع الملك عبدالله الثاني في حديقة الورود بالبيت الأبيض قال ترمب ما ترجمته حرفياً "وأقول لكم إن الهجوم على الأطفال أمس كان له أثر كبير عليّ، أثر كبير!". وأضاف أن أمراً آخر حدث "وهو أن موقفي تجاه سوريا والأسد تغيّر كثيراً".
كلام ترمب هذا يجب أن يثير لدينا بعضاً من المرارة، لأن كل الرؤساء الأميركيين يصبحون رؤساء فعلاً، بعد أسابيع من حفل تنصيبهم ودخولهم البيت الأبيض. دونالد ترمب مثله مثل أي رئيس قبله تصنعه اللحظات ويصبح إنساناً آخر عندما يقف أمامه مستشار الأمن القومي أو كبير الموظفين وهما يخبرانه أن مأساة وقعت، ومسؤوليته الآن هي التعاطي مع الواقع.
كلام ترمب يجب أن يذكّرنا أن المجرمين هم الذين يفرضون على الرؤساء الأميركيين الواقع المر حول العالم، وهذا ما فعله بشار الأسد عندما استعمل سلاحاً كيمياوياً في خان شيخون، وهذا ما فعله رئيس كوريا الشمالية عندما أطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان في اليوم ذاته، وهذا ما فعله أسامة بن لادن عندما شنّت القاعدة هجوماً رباعياً بالطائرات المخطوفة يوم 11 – 9 –2001.
يجب القول الآن إن كل ما سمعناه من ترمب وعن ترمب أصبح من الماضي.
دونالد ترمب واجه حقيقة أن يكون رئيساً للولايات المتحدة، ومن الآن فصاعداً عليه أن يقرّر إرسال جندي أميركي إلى ساحة المعركة أو يترك العالم في مصائبه؟ أن ينغمس أكثر في سوريا أو يحبس أميركا خلف البحر ووراء السياج؟
يوم 4 – 4- 2017 سقط فلاديمير بوتين الحليف من عقل ترمب وجاء بوتين الذي يتحمّل المسؤولية عن تصرفات الأسد! ويوم 4 – 4 – 2017 كان يستعد رئيس الصين لزيارة ترمب في فندقه للتحدث إليه عن التجارة وأصبح رئيس الصين الذي عليه أن يتحدث عن ضبط صواريخ.
كوريا الشمالية ومنعه من تهديد اليابان وكوريا الجنوبية والسفن الأميركية في المياه الدولية!
يوم 4 – 4 – 2017 مات الأطفال وصار لنا رئيس يعرف الآن أن البيت الأبيض ليس استوديو تلفزيون، ويعرف أن العالم مليء بالمجرمين!
 ٧ أبريل ٢٠١٧
٧ أبريل ٢٠١٧
حاول إيران اختراق الدول العربية عبر مسارات ثلاثة تؤدي إلى نتيجة واحدة، أولها: تقديم نفسها بديلاً عن الحكومات والأنظمة القائمة في مقاومة العدو الإسرائيلي، مستغلة تعاطف الشعوب العربية والإسلامية مع القضية الفلسطينية، وذلك عبر دعم فريق على حساب آخر، وعلى عكس ما يحدث داخل إيران من تمتع النظام الحاكم بسلطة مطلقة، ورفض للمعارضة، فإنها في الدول العربية «تشرعن» وتدعم وجود ميليشيات، والنماذج ماثلة أمامنا في كل من: لبنان، والعراق، وسوريا، واليمن، أي أنها تعمل على تفتيت الدولة الوطنية العربية، وتحل بدلاً منها جماعات متصارعة.
المسار الثاني: تحويل القومي الوطني لديها إلى دافع مذهبي داخل دولنا العربية، حيث تطرح الدين كمنطلق لنصرة المستضعفين في مواجهة «استكبار» تراه في الأنطمة العربية الحاكمة، مع عملية فرز لتلك الأنظمة، فهي لا تشمل من يدور في فلكها، ولا من يؤيِّدها أو يُهادنها، والتعامل معها متغير وليس ثابتاً، ويمكن القول: إن هذا المسار يجمع بين السياسي والأيديولوجي والعقائدي، وهو خاص بالتابعبن لها بشكل مباشر، أو أولئك الذين تعتمد عليهم لترجيح الكفة لصالحها، وخاصة في دول الجوار العربي.
المسار الثالث: ثقافي، وهو يخصُّ الدول العربية البعيدة بداية من السودان التي أغلقت كل مراكزها منذ انطلاق حرب اليمن وانتهاء بموريتانيا، وعلى درجة أقل من هؤلاء تأتي مصر، وعلى درجة أكبر بعض دول غرب أفريقيا، ويتجلَّى هذا المسار أكثر في تلك العلاقات التي قامت في الماضي مع ليبيا أثناء حكم معمر القذافي وإن تم التخلي عنها بعد سنوات، وفي الحاضر نراها جليّة على المستوى الرسمي بين إيران وكل من: تونس والجزائر، والتي هي محل نقاش، وقد تتمُّ مراجعتها في المستقبل بعد تصريحات لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني ذكر فيها تأييد كل من القيادتين في الجزائر وتونس للدور الذي تقوم به إيران في الوطن العربي!
نحن اليوم أمام موقف علني غير معهود من تونس والجزائر تجاه إيران، جاء في نفي الناطق باسم الرئاسة التونسية رضا بوقزي، بقوله: «إن التصريحات التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية عن كون إيران هي حامية العالم الإسلامي من إسرائيل، والتي نسبت للرئيس الباجي قايد السبسي خلال لقائه بوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني رضا صالحي أميري، لا تمُت إلى الحقيقة بصلة»، وأيضاً في تصريح الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف: «تجدر الملاحظة بادئ ذي بدء بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإيرانية بخصوص فحوى المحادثات التي تمت خلال المقابلة التي حظي بها وزير الثقافة والإرشاد الإيراني من قبل الوزير الأول رئيس الوزراء عبد المالك سلال لا يعدو كونه نقْلاً غير سليم واستنتاجاً غير مطابق لحقيقة ما تمّ تداوله من مواضيع وما ورد من تصريحات خلال هذا اللقاء».
وهذا النفي الرسمي من تونس والجزائر لما جاء على لسان وزير الثقافة الإيراني يتناغم مع الموقف الشعبي العام في البلدين، نتيجة ما تقوم به إيران في المنطقة من محاولات تشييع حقَّقَت بعضاً من نتائجها ميدانياً، ولو أنها بنسبة ضئيلة، ومع ذلك فهي تُسْهم في صدام مستقبلي مع القوى الاجتماعية الرافضة، عِلْماً بأن هناك رفضاً لدى الغالبية في تونس والجزائر، وباقي الدول المغاربية الأخرى، لهذا التواجد الإيراني في منطقة أنشأت الدولة العبيدية، وتخلَّت عنها باختيارها، ولن تقبل بعودتها، وهو ما يجب أن تُدْرِكْه إيران.






