 ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
إذا صدقت استطلاعات الرأي المرجحة فوز رئيس الحكومة الفرنسي السابق فرانسوا فيون في انتخابات الجمهوريين التمهيدية لاختيار المرشح الفرنسي للرئاسة، فسيعكس ذلك صورة عن وجود تشدد واستياء إزاء الإسلام. ففيون ركز خلال حملته على انتقاد الديبلوماسية الفرنسية، قائلاً إن «هناك ضرورة لإعادة التوازن فيها بالتقارب مع إيران بدل الحلف مع دول الخليج».
وهو واكب موجة شعبية في اليمين الفرنسي تندد بدول الخليج، كما يفعل الإعلام منذ العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد العام الماضي، على رغم أن جميع الإرهابيين الذين قاموا بهذه العمليات هم من أصول شمال أفريقية وعاشوا ونشأوا في ضواحي بلجيكا وفرنسا. وهم أبناء مهاجرين عُزلوا في ضواحي دول أوروبية تعاني مشاكل اجتماعية منذ سنوات وفشلت كل الحكومات الفرنسية في معالجتها. هؤلاء ليست لهم أي علاقة من بعيد أو قريب بدول الخليج. فجزء كبير منهم زار سورية التي غذت الحرب فيها، وصعود «داعش»، هذه الموجة من الإرهاب التي ارتكبت أعمالاً شنيعة وكارثية باسم الإسلام.
اعتقاد فيون بأن التقارب مع إيران يفرض نفسه خطأ في التقدير، إذ إنه ينسى أن هذا البلد أصل تصدير الثورة الإسلامية إلى الشرق الأوسط منذ وصول الخميني إلى الحكم.
يقول فيون إن هناك تيارين في سورية فقط، أحدهما «داعش» والآخر بشار الأسد، وهو يختار بقاء الأسد. إنه منطق شعبوي مبسط لفرنسيين يجهلون الواقع في منطقة الشرق الأوسط.
يقول فيون إنه يناضل من أجل حماية مسيحيي الشرق. لكن هؤلاء هُجّروا من بلدانهم بسبب حروب في سورية والعراق وفي الأراضي الفلسطينية والقدس منذ عقود. وقمع بشار الأسد في سورية في 2011 مظاهرات مدنية مسالمة تطالب بالحرية هو ما أدى إلى الحرب. فكيف لا يرى فيون، وهو سياسي فرنسي محنك، أن مسيحيي الشرق مهددون في مصيرهم في سورية دمرها الأسد وحاميه صديق فيون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطائراته وقنابله؟ وكيف لا يرى أن الأسد وإيران مع وكيلها في لبنان «حزب الله» هم الذين دفعوا بحربهم الوحشية في سورية باتجاه نشوء مجموعات وحشية مثل «داعش»؟
ينبغي على فيون إذا فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب اليميني أن يعود بعض الشيء إلى الوراء في تاريخ عائلة الأسد في لبنان وتعاملها مع المسيحيين هناك والجرائم التي ارتكبتها فيه وتقسيم الصفوف المسيحية والاغتيالات المتتالية من رؤساء جمهورية مسيحيين مثل بشير الجميل ورينيه معوض إلى زعماء مثل داني شمعون وعائلته وبيار أمين الجميل.
ألا يدرك فيون أن الأسد هو الذي فتح السجون وأفرج عن إرهابيين كانوا أصل نشاة «داعش» في سورية؟ إن الأصولية والعنف والإرهاب تنمو كلها من حكم استخباراتي عنيف وإرهابي مثل حكم النظام السوري. وتبسيط الوضع السوري بأنه - كما لخصه فيون - بين «داعش» وبشار الأسد رؤية خطيرة لرجل يطمح إلى الوصول إلى سدة رئاسة دولة مثل فرنسا.
الديبلوماسية الفرنسية الحالية إزاء سورية صائبة. ولو أن صوت فرنسا لا يسمع لصعوبة الوضع الاقتصادي وقلة إمكاناتها. لكن مواقف الرئيس فرانسوا هولاند إزاء الحرب السورية تتماشى مع القيم الفرنسية، كما هي الحال مع مواقف منافس فيون رئيس الحكومة السابق عمدة بوردو آلان جوبيه الذي إذا خسر المعركة الانتخابية تكون فرنسا خسرت وجهاً لامعاً للاعتدال في المواقف إزاء مسلميها والشرق الأوسط. لكن يظهر لسوء الحظ أن عهد العالم الجديد مع دونالد ترامب في البيت الأبيض هو عهد للتشدد والتطرف في المواقف.
 ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
لا نفتعل اثارة مسألة لا نجد لها أثرا في مجريات الانهماك بترتيب الهيكل السياسي الجديد إن تساءلنا ماذا تراه يكون عليه الموقف اللبناني من إحدى أفظع المجازر الانسانية التي ترتكب في مدينة حلب ؟ نعلم تماما الجواب المعلب من انه لا يتوقف على لبنان وطبقته السياسية ونخبه المدنية ان يعوضوا أفظع ما يواكب مجازر حلب من قصور دولي وتواطؤ مشين في حق الانسانية قاطبة جراء هذا الذي يجري والذي تقشعر له الأبدان . ولكن هل كان الامر كذلك في السوابق حين كان لبنان يحتفظ لنفسه دوما بميزة الصراخ حيال مجازر كهذه وهو الذي لا تزال المجازر التي ارتكبتها اسرائيل ضد شعبه ومناطقه ترسم ندوبا لا تمحى ؟ وهل ثمة فوارق بين مجازر ترتكب اليوم في حلب مهددة بأبشع الاستباحات ضد البشر والعمران في إحدى اعرق المدن قاطبة فيما يطبع لبنان تجاهل مريب وهو البلد الذي طبع على خصائص مناهضة الظلم والعدوان والفظائع والنزاعات الدموية المجنونة التي تسكر على أنهار الدماء ؟
لا نسوق الامر من زاوية سخافة مقاربة السياسات الخارجية للدولة اللبنانية التي لا نزعم كيف سيمكنها رسم اتجاهاتها مع ولادة حكومة جديدة يراد لها ان تحشر في تركيبة الـ24 محظيا كل تناقضات الواقع السياسي والامتدادات الاقليمية الشديدة الالتهاب . نترك هذا الاستحقاق للمنخرطين في معركة تحديد الأحجام والتوازنات وما ستفضي اليه مع تمنياتنا المقرونة بالدعاء الصادق لأصحاب اللهفة على العهد والحكومة بان يوفقوا في ابتكار يحول دون ولادة حكومة تحمل في بذورها عناصر تفجيرها . ما يعنينا هنا هو مساءلة قوى سياسية تقيم على رفع حقبة جديدة موعودة في لبنان وتلتزم معايير التواطؤ الدولي نفسها في الصمت عن المجازر الجارية في حلب مهددة بفناء حقيقي وكأنها غير معنية لا بتنديد ولا بصراخ ولا باستنكار ولا بتحرك . لم يكن لبنان هكذا يوما ، وثمة قوى فيه كانت حتى الأمس العابر فقط تحمل لواء الثورة السورية كثورة على الطغيان . وليس ممكنا ولا مقبولا ولا مبررا تبرير الصمت أو التجاهل حيال هذه المجازر بتمرير الفترة الانتقالية الجارية منذ بداية العهد الجديد لئلا يتفتق الانقسام الكامن حول مسألة تورط " حزب الله " في الحرب السورية . هل تراها حتى قوى 14 آذار ( السابقة ! ) اختطت لنفسها خيارات النأي بالنفس حتى عن موقف صارخ من هذه المجازر ؟ وماذا تراها فاعلة قوى الحكومة الجديدة كما العهد الجديد اذا حصل المحظور الأكبر المترائي وراء كثافة الغارات التدميرية للنظام وداعمته روسيا بلوغا الى المجزرة الكبرى ؟ لعلنا نتوهم أن أحدا سمع بالامس ان مجاعة بدأت تضرب المحاصرين في شرق حلب وان حرب الفناء شارفت المأساة النهائية . فالمحاصصة الطالعة لا تبيح هذا الترف!
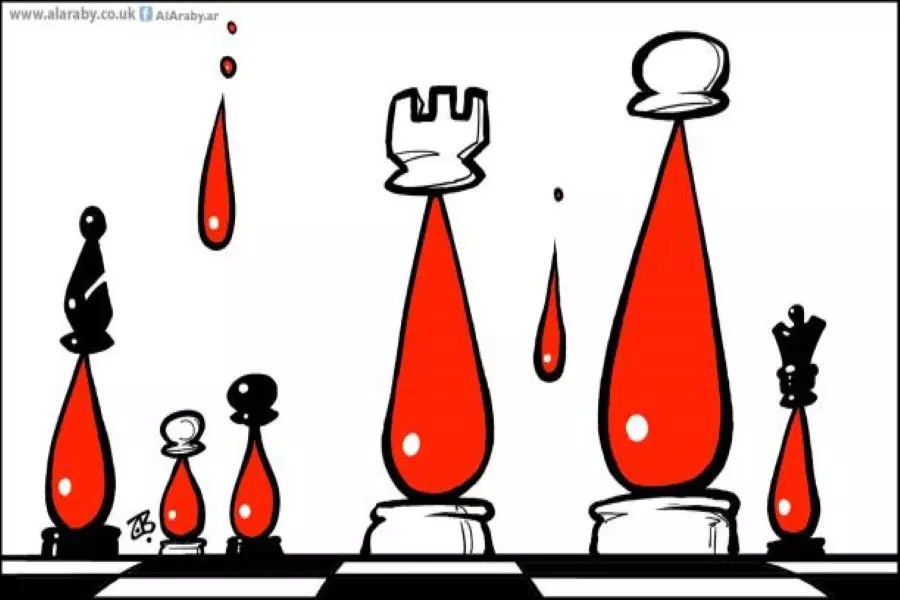 ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
بعد أن وزّعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور "لائحة العار" التي تضمنت أسماء 12 ضابطاً رفيعاً في جيش النظام السوري وأجهزته الأمنية، واتهمتهم بـ "الإشراف على ارتكاب انتهاكات جسيمة، وجرائم بحق الشعب السوري" تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، فإن تساؤلات عديدة تطرح حول ما إذا كان هؤلاء المتهمون سيقدمون إلى المحاكم الدولية، لنيل ما يستحقونهم من عقوبات على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري أكثر من خمس سنوات، وذلك احتراماً لأرواح الضحايا وعذابات ذويهم، وتحقيقاً للعدالة.
ويأتي اتهام السفيرة الأميركية في وقتٍ يمعن فيه النظام الأسدي والروس والإيرانيون في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق سكان مدينة حلب الشرقية، ومناطق عديدة في محافظة إدلب وريف دمشق وحمص وسواها، لكن قائمتها لم تتضمن أسماء ضباط روس أو إيرانيين أو عناصر من مليشيات حزب الله اللبناني، وسواهم من المليشيات الإرهابية الذين تزجّهم إيران في الحرب ضد الشعب السوري، وارتكبوا أبشع الجرائم بحق السوريين.
ويفيد واقع الحال بأن قادة النظام الأسدي وحلفاءه في النظام الروسي ونظام الملالي الإيراني لم يتوانوا، سنوات عديدة، عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو أمر وثقته هيئات أممية ودولية، وجمعت دلائل وقرائن عديدة تثبت إدانتهم، لكنهم ظلوا بعيدين عن المساءلات والمحاكمات، وجرى تعطيل السبل المؤدية إلى محاكمتهم في المحاكم الدولية.
ويشعر سوريون كثيرون بالخذلان واليأس من تعامل الساسة الغربيين مع الكارثة السورية التي سببها تعامل النظام الأسدي مع الثورة السورية، ولديهم مخاوف واقعية من أن الساسة الأميركيين اتفقوا مع الساسة الروس على إنقاذ النظام الأسدي، بالنظر إلى مواقف الإدارة الأميركية، وتردّد (وتشوش) مواقف أصحاب القرار فيها، وخصوصاً الرئيس الأميركي، باراك أوباما. وبالتالي، فإن تحذير باور هؤلاء المجرمين من الملاحقة والمحاسبة يبدو فارغاً في المدى المنظور، خصوصاً أن إدارة أوباما ستغادر البيت الأبيض قريباً، ولم تفعل شيئاً طوال أكثر من خمس سنوات مع هؤلاء المجرمين وسواهم، عبر السعي إلى تشكيل محكمة دولية خاصة للنظر في جرائم مرتكبة في سورية، الأمر الذي أدى إلى انسداد السبل أمام كل المحاولات الهادفة إلى إطلاق مبادرات مستقلة، وخصوصاً المبادرة التي أطلقتها لجنة العدالة الدولية والمساءلة التي نجحت في تسريب 600 ألف وثيقة، تدين النظام السوري، وتوثق عمليات التعذيب والقتل الممنهج داخل أقبية أجهزة النظام والجيش، تنفيذاً لأوامر عليا، موقعة على الأرجح من بشار الأسد.
وكان إنشاء محكمة الجنايات الدولية في لاهاي المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب وإدانتهم في سياق تحقيق العدالة، قد تمّ على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأميركية المحكمة ومهامها. واستطاعت المحكمة أن تتجاوز أنظمة الأمم المتحدة والمعارضات الدولية، وأن ترسي مفهوم التدخل الإنساني الذي صار أمراً أخلاقياً رفيع المستوى، الأمر الذي عزّز الأمل في عولمة الحقوق، وإضفاء طابع إنساني على العولمة الذي تطالب بتحقيقه أغلبية البشر على كوكب الأرض. وجاء توقيف مجرم تشيلي، الدكتاتور بينوشيه، ليشكل بدايةً لمحاكمة مجرم ارتكب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب التشيلي، لكن محاكمته أجهضت بفعل معيارية قوى الهيمنة وسطوة تراتبية القوة في العالم. ثم جاء اعتقال الصربي سلوبودان ميلوسيفتش، لكي يجدّد الأمل في عولمة العدالة، والاقتراب من عدالة عالمية، تمنع أي مجرم آخر بحق الإنسانية من التصرف كما يحلو له في الحرب ضد شعبه، أو في الحروب ضد الشعوب الأخرى.
وتتعدّد جرائم النظام السوري التي لا تنحصر في جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني، وكلها يدخل ضمن تعريف نظام روما الأساسي للجرائم ضد الإنسانية التي يحدّدها في مجموعة من الأعمال التي ترتكب في شكل هجوم ممنهجاً أو عاماً يستهدف مجموعة من السكان المدنيين بطريقة مباشرة، إضافة إلى جرائم أخرى، يرتكبها النظام بحق غالبية السوريين، بشكل آخر من أشكال جرائم الإبادة الجماعية، من خلال منعه دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وخصوصاً في حلب ومضايا والزبداني والمعضمية والوعر وسواها، وتندرج جميعها ضمن ما نصّ عليه نظام روما الذي اعتبر جريمة حرب كل عمل يفضي إلى حرمان السكان المدنيين من الحصول على الطعام والدواء.
مع ذلك، سيعطي مثول بشار النظام ومجرمي الحرب في سورية للعدالة معنى عالمياً متجدّداً، يتجسّد في ملاحقة مجرمي الحرب، سواء تعلق الأمر بجرائم راهنة أو قديمة أو بجرائم الأمس القريب، وسيؤسس مساراً كونياً للجريمة ضد الإنسانية، وللتوبة والاعتراف بالذنب والتكفير عن الخطيئة. وسيواجهون تهمًا عديدة، بموجب اتفاق جنيف، تشمل القتل المتعمد، والتدمير الوحشي للحجر والبشر لأسبابٍ عسكرية، والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، والهجمات المتعمدة ضد الأطباء والكوادر الطبية والناشطين الإنسانيين، وقصف مدن وقرى منزوعة السلاح، وقتل المعتقلين وسجناء الحرب، وقصف الأسواق والمدارس والمساجد والمستشفيات، واستعمال الأسلحة الكيميائية، وحصار المدنيين وتجويعهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم .
غير أن دخول روسيا إلى جانب النظام في حربه ضد غالبية السوريين، وانخراطها في عمليات القصف والقتل، وتدمير الأحياء والبلدات والمدن التي تسيطر عليها المعارضة، وقصف المستشفيات والمدارس والمراكز الطبية، جعلها شريكةً في الجرائم المرتكبة بحق السوريين، لكنه جعل إمكانية جرّ مجرمي النظام إلى المحاكم الدولية وملاحقتهم قانونيًا شبه مستحيلة، بسبب امتلاكها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، واستخدامها هذا السلاح بوجه أي مشروع قرار دولي، يهدف إلى ملاحقة المجرمين، الأمر الذي سمح بتحويل سورية إلى مسرح لجرائم حرب دولية، يتمتع فيها مرتكبو الجرائم بحصانةٍ دوليةٍ تامةٍ حيال أية ملاحقة قانونية. يذكّرنا ذلك كله بما جرى، وما يزال يجري في التاريخ الطويل والمديد للقضية الفلسطينية التي تشكل معلماً بارزاً على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وما يزال يرتكبها، جنرالات إسرائيل وساستها بحق الشعب الفلسطيني.
ويكشف التستر على هذه الجرائم بصورة واضحة مدى التواطؤ الذي تعقده قوى الهيمنة، والسيطرة في العالم مع الجرائم الإسرائيلية، ويفضح معيارية حقوق الإنسان التي تنادي بها. وعلى الرغم مع أن ملفات مجرمي الحرب في سورية وفلسطين وسواهما ما زالت مغلقة، ولا تسمح تراتبية القوة في عالم اليوم بفتحها، إلا أن مستقبل العدالة وأفقها لا بد أنه سيتناول هذه الملفات في يوم ما، وستجري محاسبة المجرمين على ما ارتكبوه.
 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
لا يهدف الخبر الذي سرّبته المخابرات السورية لصحيفة لبنانية موالية، عن وجود عسكري مصري إلى جانب قوات بشار الأسد، إلى إحراج نظام عبد الفتاح السيسي، فالرجل كان قد أعلن، بالفم الملآن، أنه يدعم "الجيش" السوري ضد من أطلق عليهم تسمية "القوى المتطرّفة"، والتي ليست سوى فصائل الثوار، بدليل أن جغرافية تحرّك المستشارين العسكريين المصريين لم تكن في الرقة حيث "داعش"، بل في درعا وحماة.
وكان السيسي قد طرح، في وقت سابق، ما سماها "رؤية" للحل في سورية، وهي خلطة من مصطلحات خشبية عن الدولة والمؤسسات والحل السلمي، وضعها مستشاروه الحاذقون الذين فاتهم رؤية أن في سورية أيضاً شعباً يجري ذبحه بدم بارد وبكل أنواع الأسلحة، وأحط الأساليب العسكرية، وأنها أيضاً تشهد عملية تطهير ديمغرافي لشعبها، وفق خطّة إيرانية معلنة وصريحة.
ليس موقف السيسي منفصلا أو طارئاً عن سياقاتٍ مصرية في هذا الخصوص، ثمّة حملة شرسة، تقودها مراكز أبحاث وصحف ومواقع إلكترونية، داخل مصر، أو يديرها خبراء مصريون في الخارج، على الثورة السورية والربيع العربي الذي جاءت في إطاره، وتدّعي وجود مؤامرةٍ على الجيوش "الوطنية" تحديداً، وتلمّح إلى وقوف أطراف عربية وراءها، بل وصل الأمر بها إلى القول إن الشعوب العربية لا تليق بها الديمقراطية، وإن تأييدها الإستبداد والقهر موقف عقلاني (!).
أي جيش سوري ذلك الذي يتحدّث عنه السيسي ويريد دعمه؟ لقد فكّك نظام الأسد بنى ذلك الجيش، حتى قبل الثورة، وزوّر عقيدته، وحوّله إلى مليشيا مافياوية طائفية، همّها الأساسي، وباعتراف إعلام نظام الأسد نفسه، سرقة بيوت السوريين، بعد قتلهم أو تهجيرهم، والمفترض أن خبراء مصر العسكريين الذين يفهمون معنى مؤسسة الجيش أنهم على إطلاع فعلي على الوقائع، وأكثر دراية بالحقائق الساطعة.
لم يعرف عن السيسي أنه رجل مبدئي، لديه مواقف متماسكة، ومنظومة قيمية، بدافع عنها. هذا الأمر خارج النقاش، حتى قبل تسجيلات الرز الشهيرة، وليست لديه نوازع قومية. لم يدّع السيسي نفسه يوماً أنه قومي، ولا تختلف سورية بالنسبة له عن الإكوادور أو نيبال. عدا عن ذلك، وعلى فرضية أن السيسي يذهب إلى سورية مدفوعاً بحسّه العربي، فلا شك أنه يصرّف نوازعه في المكان الخاطئ، ذلك أن بشار الأسد أعلن طلاقاً بائنا مع العرب والعروبة، وبات إعلامه يصفهم بالعربان الذين يشربون بول البعير! وأنه ومؤيديه ينتمون لحضارات تاريخية سالفة، اعتدى عليها الأعراب وشوهوها.
ثم ما المقصود بإبراز أن تحرّك مستشاري السيسي العسكريين يجري في إطار الجبهة الجنوبية، والمعلوم أن هذه الجبهة تحت سيطرة تحالف عربي؟ لماذا لا يهتم السيسي بدمشق، وهي رمز عربي، وهذه المدينة تكاد تتفرّس (تصبح فارسية) أو في منطقة القلمون التي تم تهجير ملايين السكان منها لتحويلها إلى جسر عبور إيراني إلى لبنان، أو حتى حلب، حيث تطبق مليشيات إيران الحصار على 300 ألف من سكانها العرب، وتهدّد بإبادتهم جهاراً نهاراً، إذا كانت خلفيات تحرّك السيسي عربية قومية؟
من جهة ثانية، لم يعرف عن السيسي أنه استراتيجي لديه حساسية عالية تجاه الجغرافيا السياسية، حتى يفكر في تحقيق أحزمة أمان لمصر، بدليل أنه لم يهتم بأصول مصر الإستراتيجية، أمن البحر الأحمر المرتبط بأمن قناة السويس، والذي تعمل إيران على انتهاكه. وكانت مفاوضاته مع إثيوبيا بشأن حصة مصر من مياه النيل قد كشفت حجم العطب في التفكير الإستراتيجي، ليس لدى السيسي وحده، بل ولدى النخبة الانقلابية المصرية بكامل عدّتها الفكرية والسياسية والعسكرية. أما اهتمامه بالملف الليبي، فيأتي خارج هذه السياقات تماماً، ولا يؤشر إلى وجود بعد إستراتيجي لديه، فهو يقارب الحالة الليبية بوصفها احتياطي "رز" لنظامه ليس إلا.
والواقع أن وجود السيسي، عنصراً عسكرياً، في سورية لا يشكّل إضافة مهمّة للأسد. وفي الأصل، لا الروس ولا الإيرانيون ولا حزب الله يقبلون منحه دوراً مهماً، ولا حتى يثقون به، كما أن بشار الأسد يعرف أنه لا يملك الصلاحية، ولا القدرة لتوزيع أدوار الأطراف التي تقاتل في سورية. مسرح الحرب تديره إيران وروسيا، ولا أمكنة شاغرة لديهما للجيش المصري. القضية بإختصار أن السيسي يتجحّش مع الأسد للضغط على السعودية، لإعادة الارتباط به بعد الطلاق البائن، وأن الأسد يتجحّش بالسيسي، لكي يتبجّح بأن أكبر الدول العربية تقف معه، وسيبارك إعلام المجحّشين هذه العملية التي ستلد، برأيهم، السيف الذي سينقذ حاضر الأمة، مع أن السيف الوحيد الذي يحمله السيسي والأسد مصوّب على خاصرة الأمة.
من حق العرب أن يحزنوا على وقع مثل هذه الأخبار، ليس على شعب سورية الذي بالأصل تتكالب عليه قوى الشر، ولن تعمل قوات السيسي سوى إضافة بعض الألم على جرحه، بل الحزن على الجيش المصري الذي يُراد زجّه في مقتلةٍ قذرةٍ ليصطف إلى جانب مليشيات إيران في قتل أطفال سورية، أيّ شرف ذلك الذي يريد السيسي إكسابه لجيش مصر، أن يكون شاهد زور على اغتصاب سورية حتى الموت؟ هل من يخبر السيسي أن تلك فضيحة أخلاقية، نربأ نحن العرب أن يتم لصقها بجيشٍ خرج من صلبه جمال عبد الناصر.
 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
يكره معظم من يحبون سورية وصف ما يجري فيها بـ "الأزمة"، لاعتقادهم أن سورية في ثورة، والثورة لا يمكن أن تكون في أزمة. ويتجاهل هؤلاء أنه تكون هناك أزمة، حين ينشأ ويستمر "وضع ليس أو لم تتوفر بعد حلول لمشكلاته"، هو وضعٌ دخلت الثورة فيه منذ بدايتها، لكونها حملت مشكلاتٍ بقيت من دون حل إلى اليوم، ولأن المعارضة لم تقدّم لها برامج تتضمن حلولاً تبلغ بمعونتها هدفها: حرية الشعب ووحدته، ولم تعرف كيف تحول دون نجاح النظام في بلورة بديل أصولي/ إرهابي لها، صنعه من أخرجهم من سجونه وشكلوا، كما أراد وتوقع، تنظيمات مسلحة، مذهبية ومتطرفة، رفضت مثله نزعة الثورة السلمية ومطالبتها بالحرية ووحدة الشعب، ولأن العالم أدار ظهره لحل الأزمة السياسية، على الرغم من أنه رسم في وثيقة جنيف خريطة طريق واضحة إليه، قبل أن تتولى روسيا إفشاله عبر دعمها الأسدية، ثم نشر جيشها في أراضي سورية، وزرعه بمطارات وقواعد برية وبحرية، تلازمت مع ابتعاد أميركا عن ثورة السوريات والسوريين، وتبنّيها مخططاً تقسيمياً اعتمدت في تنفيذه على حزبٍ سلحته ودربته، قدم معظم مسلحيه من تركيا وإيران، لإلحاق أجزاء من أرض سورية الوطنية بمشروع إقليمي يقوده مركزه التركي. لواشنطن مقاصد بعيدة المدى في مساعدته على احتلال منطقةٍ تقطنها أغلبية عربية وكردية تعارضه، وتتعرّض لرصاصه وقمعه.
عندما تواجه ثورةٌ مشكلاتٍ تعجز قياداتها عن إيجاد حلول لها، تكون إما في أزمة أو هي الأزمة. عندئذ يجب أن يعي "قادتها" أنها تصير ثورةً، بقدر ما يضمنون لها شروط النجاح، ويتعاملون معها بصدقٍ وموضوعية كأزمة، بدل أن يتنكّروا لواقعها ويتجاهلوا نتائجها، وكذلك ضرورة أن يبادروا إلى صياغة الأفكار والبرامج ووضعها، وامتلاك الأدوات الكفيلة بإخراجها من احتجازها كأزمة، وتحويلها إلى ثورة.
بعد انطلاقتها الأولى، بدا وكأن الثورة ستنتصر في فترة قصيرة لا تتعدى الشهر. وها هي تواصل عامها السادس، وسط مصاعب موضوعية وذاتية، تغلب فرص تعثّرها على فرص نجاحها، لأسباب بينها نهج قياداتها الذي لا يغطي معظم قضاياها، أو يستجيب لحاجاتها، وحرب روسيا وإيران المفتوحة عليها، واستمتاع أميركا والعالم بجرائم الأسدية ومرتزقة موسكو وطهران ضد شعبها. ولئن كان السوريون ثاروا للتخلص من أزمة تاريخية مستعصية، مثلتها سياسات نظام الاستبداد الأسدي وممارساته، وكانت تناقضات وصراعات عربية وإقليمية ودولية قد أدخلتهم في أزمة جديدة ومركبة، أضافت مشكلات خطيرة الأبعاد إلى مشكلات الثورة المحلية التي حالت تدخلات الخارج المتنوعة ضدها دون نجاحها في إسقاط الأسدية، مثلما حال افتقارها إلى قيادة موحدة وخبيرة، وإنهاكها بانقسامات ساستها وعسكرها، وارتباط موازين القوى بينها وبين النظام بإرادات قيدت إرادتها وحسابات أبطلت حساباتها، وازدياد الضغط عليها من جيوش محتلة وغازية، تمتلك تقنيات فائقة التقدم، وأسلحة وذخائر لا مثيل لها، واحتياطيات استراتيجية تستحيل مواجهتها بتنظيماتٍ فصائلية محدودة العدد والسلاح. واليوم، وقد تخطت الثورة أوضاعها حدثاً داخلياً أساسا، حده الأول النظام والثاني الشعب، ودخلت في حالٍ خطيرةٍ يجسّدها عجزها المتزايد عن مواجهة الغزاة، وما يطرحونه عليها من تحدياتٍ تتخطى إسقاط النظام إلى إنقاذ الوطن، بابتكار حلول تعالج ما ينتجه تداخل مهامها، كثورة ديمقراطية تكابد انحرافاً مذهبياً وثورة تحرّر وطني، يتطلب اندماجهما تطوير برامجها وآليات عملها وأنماط صراعها، لتتخطى ما كانت عليه في طورها الأول، ولتتمكّن من مبارحة أزمته والارتقاء إلى مستوى ثورتين في ثورة، لا بد أن تقودهما جهة ثورية وموحدة، من "الائتلاف" والتكوينات السياسية الأخرى.
تفاقمت أزمة الثورة الديمقراطية والوطنية وتعقدت. وإذا كانت مواقف قواها السياسية والعسكرية وممارساتها لم تحقق أهدافها، حين كان طابعها الديمقراطي سمتها الغالبة، وكان مجتمعها داعما في معظمه لها، فإنها لن تستطيع الصمود من الآن فصاعداً، وتتجاوز المخاطر، إذا ما تمسّكت بأساليب عملها الراهنة، ووعيها السياسي الذي أملاها، وعلاقاتها التي غرّبتها عن الشعب، وفشلت في القيام بواجبها الوطني والثوري في الطور الجديد، بما يحتمه من جهد إنقاذي يدرس أزمتها من مختلف جوانبها، ويقدم أجوبة عملية وفاعلة عليها، بالتعاون مع الائتلاف، أو من خارجه، يعيد إنتاج المشروع الثوري واستئنافه، ويوطنه في الشعب، لكي لا يستمر في الغرق وينقلب تماماً إلى كارثةٍ وخيمة العاقبة.
 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
تؤشر وقائع مسرح العمليات العسكرية في حلب بين تحالف النظام والمعارضة إلى احتمال نتائج مأساوية في تلك الحرب، ومما يدعم هذا الاحتمال وقائع سياسية مرافقة في المستويات الداخلية والخارجية.
ففي الوقائع الميدانية، هناك تقدم ظاهر لقوات حلف النظام على جبهات حلب الشرقية المحكومة بالحصار المشدد بعد عدة أشهر من حصار منع دخول أي من المساعدات، بينما يستمر القصف الجوي العنيف بالبراميل المتفجرة من قبل نظام الأسد، وبأحدث الأسلحة والذخائر من البحرية والطيران الروسي، وسط عجز المعارضة المسلحة عن شن هجمات فاعلة من خارج طوق الحصار على حلب، مما يعني أن الأخيرة متروكة لمصيرها الذي يسعى المحاصرون إلى إفشاله، أو إلى تأخيره في أقل تقدير.
أما في الوقائع السياسية، فإن ثمة إصرارًا من تحالف نظام الأسد مع روسيا وإيران وميليشياتها على السيطرة على حلب، التي شدد عليها رأس النظام في تصريحات أخيرة، فيما أكدها عمليًا مع حلفائه الروس والإيرانيين عبر تحشيد قواتهم البرية والجوية، وتكثيف هجماتهم بصورة غير مسبوقة، وهو ما ترافق مع انسحاب روسي من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، مما يشير إلى رغبة الروس في تجنب إحالة حربهم وجرائمهم في سوريا أمام تلك المحكمة.
أهمية هذا الشق من الوقائع السياسية المحيطة بالهجوم على حلب، أنها محاطة بعطالة دولية، وكأن ما يجري في حلب من مجازر ودمار يتم في كوكب آخر، ووسط عالم لا يهتم بإعلاناته عن السلام وحقوق الإنسان ومنظماتها بما فيها مجلس الأمن الدولي الذي تتركز مهمته في حفظ السلام والأمن الدوليين، ولا يخفف من العطالة الدولية السائدة، تصريحات الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا عن احتمالات تدمير حلب.
وسط تلك الوقائع، تبدو حالة المعارضة السورية بالشقين السياسي والعسكري في أضعف حالاتها، سواء لجهة أوضاعها الداخلية أو في علاقاتها مع القوى «الصديقة» في المستويين الإقليمي والدولي. ففي الجانب الأول، ما زالت الانقسامات قائمة من الناحيتين السياسية والتنظيمية على مستوى الكل السياسي والعسكري، الأمر الذي أدى إلى صراعات سياسية ومواجهات عسكرية في أكثر من موقف وموقع لم تمنعهما هجمات النظام في الشمال ولا في غوطة دمشق، بل الأوضاع الداخلية لقوى المعارضة، ولا سيما في التنظيمات الرئيسية، تعاني من مشكلات وارتباكات سياسية وتنظيمية، وليس من جهود قادرة على تجاوز تلك المشكلات والارتباكات.
ولا يقل الأمر سوءًا عما سبق لجهة علاقات المعارضة مع القوى «الصديقة» في المستوى الإقليمي والدولي؛ فـ«الأصدقاء الإقليميون» محكومون بظروفهم وعلاقاتهم مع الدول الكبرى، التي بات من الصعب تجاوزها في ظل تحديات قائمة داخليًا وإقليميًا، وأبرزها تحدي الإرهابيين والمتطرفين، إضافة إلى الصراعات في دول الجوار، التي يعتبر الصراع السوري أحدها، فيما القوى الدولية «الصديقة»، تعاني من ارتخاء موقف رأسهم الأميركي، وتحدي الإرهاب والتطرف.
والمشترك الرئيسي في موقف كل القوى الصديقة للمعارضة، تأكيدهم هامشية وهشاشة قوى المعارضة السورية وعجزها عن القيام بدورها، وهذا ما سمعه قادة المعارضة السياسية مرات في الأشهر الأخيرة في لقاءات مع مسؤولين كبار من الدول الصديقة.
وسط تلك اللوحة السوداء للصراع في سوريا، تبدو المعارضة على مفترق طرق، موضوعة بين خيارين لا ثالث لهما؛ أولهما الاستمرار في واقعها الراهن سيرًا إلى موت معلن أو موت سريري في الحد الأدنى عبر خسارتها لموقعها الحيوية في حلب وإدلب وغوطة دمشق وبقية المناطق المحاصرة، والثاني القيام بتحول سياسي جذري، يركز على نقاط أساسية في استراتيجيتها للصراع مع النظام وحلفائه، من أبرزها في المستوى الداخلي تبريد الخلافات البينية، ورفع الغطاء السياسي عن جماعات الإرهاب والتطرف، خصوصًا جبهة فتح الشام، والتوجه نحو توحيد القوى الرئيسية للمعارضة، وبالحد الأدنى، خلق مركز تنسيق موحد وفاعل، تكون التشكيلات المسلحة تحت إمرته، يعلن برنامجًا للحل السياسي، يقوم على مراحل، وصولاً إلى الخروج من نظام الاستبداد والقتل والدمار إلى نظام وطني ديمقراطي، يوفر الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين.
وبطبيعة الحال، فإن الخطوات الداخلية، لما يمكن أن تقوم به المعارضة، لا تنفصل عن خطوات خارجية، ينبغي القيام بها، والجوهري فيها إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية لكسب التأييد والدعم الدوليين لقضيتها وأهدافها.
إن القيام بالتحولات المطلوبة من جانب المعارضة ليس أمرًا سهلاً، إنما هو عمل جبار يواجه صعوبات وتحديات كبرى، لكن ليس من طريق آخر للمعارضة، إذا قررتَ مواجهة تحدي الموت سواء كان معلنًا أو سريريًا، فالنتيجة واحدة وستكون مؤلمة بكل الأحوال.
 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
في يوم الأحد، قد يفوز رئيس وزراء فرنسا الأسبق فرنسوا فيون في الانتخابات التمهيدية في تنظيم الحزب الجمهوري الفرنسي وحلفاء تيار الوسط، لكي يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية التي تعقد في العام المقبل.
وبقدر اهتمامي بالأمر فإن هذا قد يكون من قبيل الأنباء السارة، إذ إن البرنامج الانتخابي الذي طرحه فيون يعكس كثيرًا مما أؤمن بأن فرنسا تحتاجه للتغلب على الأزمة النفسية والسياسية والاقتصادية الراهنة. كما أنني كنت من المعجبين بالسيد فيون واستقامته في الوقت الذي تعاني فيه السياسة، حتى في الديمقراطيات الراسخة، من انخفاض المعايير الأخلاقية. ويمتلك السيد فيون كثيرًا من الخبرة التي تمكنه من تولي أعلى منصب سياسي في البلاد. فلقد ترأس ولسنوات طويلة لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، قبل أن ينضم إلى كثير من مجالس الوزراء في عدة مناصب وزارية مهمة، وأخيرا تولى منصب رئيس وزراء البلاد لمدة خمس سنوات متتالية.
التقيت للمرة الأولى، على سبيل المصادفة، مع السيد فيون عندما كنت في زيارة لمسقط رأسه في مدينة لومان عام 1987 في جزء من رحلة قمت بها في مختلف المدن الفرنسية للتسويق لكتابي حول آية الله الخميني.
ومن الفعاليات التي شهدتها في لومان كانت عبارة عن مقابلة شخصية مع الإذاعة المحلية في المدينة، وفي نشرة الأخبار الرئيسية التي كان السيد فيون، وهو عضو وقتها في البرلمان الفرنسي عن مدينته، مدعوًا لإجراء مقابلة شخصية هناك للحديث عن السياسات المحلية. وعقب البرنامج الإذاعي دعانا المذيع إلى تناول طعام الغداء برفقة السيد فيون ثم استقللت القطار عائدًا إلى باريس.
وكانت الرحلة القصيرة بمثابة الفرصة السانحة لأقترب من شخصية الرجل والتعرف على اتجاهاته السياسية وطريقته في التفكير.
وأكثر ما لفت انتباهي وحاز إعجابي في شخصيته كان اعتقاده أن الأحزاب المحافظة في الديمقراطيات الغربية حققت أفضل نجاحاتها عندما منحت رؤيتها ورسالتها بعدًا اجتماعيًا، وبعد أن وجدت مفاهيم مثل ساعات العمل المنظمة، وتشكيل اتحادات العمال، وإعانات البطالة، مكانًا تحت الشمس في عهد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ دزرائيلي من القرن التاسع عشر. وفي فرنسا، وضعت حكومة الجنرال ديغول الأولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية أسس الرعاية الاجتماعية في الدولة الناشئة.
ولذا، عندما أذهب للتصويت في الانتخابات التمهيدية الفرنسية يوم الأحد المقبل، سوف أمنح صوتي ولا بد إلى السيد فيون في مواجهة ألان جوبيه، وكان هو الآخر يشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي، الذي، بقدر اهتمامي بالأمر، يعيبه أنه بدأ حياته السياسية ربيبًا لجاك شيراك غير المأسوف على فترات حكمه.
ورغم ما ذكرت، فإنني أجد صعوبة بالغة في الموافقة حتى على شخصية السيد فيون. والسبب في ذلك يأتي في كلمة واحدة: سوريا.
بالنسبة لي، فإن سوريا أصبحت الاختبار القاسي الآني، ليس فقط للسياسة الخارجية ولكن للإنسانية بأسرها. ويشير موقف السيد فيون، وربما هو الموقف المرتبط باعتقاده أنه ينبغي على أوروبا عقد صفقة ما مع روسيا تحت زعامة فلاديمير بوتين، إلى أننا يجب علينا قبول بشار الأسد، بكل مثالبه ومآسيه، باعتبار أنه أهون الشرين وأقل الضررين في الأزمة السورية الراهنة. ولقد طرح فيون كثيرًا من الأسباب لتعزيز موقفه.
أول مجموعة من الأسباب يمكن أن تحمل اسم «السياسة الواقعية». فسواء نحب الأسد أو نكرهه فهي نقطة غير ذات صلة بالواقع الحالي، فبعد كل شيء تقبلت الديمقراطيات الغربية الزعيم السوفياتي ستالين حليفًا لها ضد الخطر الأعظم المتمثل في أدولف هتلر وجيشه النازي. لذا، إذا ما أرادت الديمقراطيات الغربية هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه، فعليهم اعتبار بشار الأسد حليفًا لهم في ذلك.
والمجموعة الثانية من أسباب السيد فيون يمكن وصفها بضيق الأفق، وهي تتضمن المزاعم بأن بشار الأسد هو حامي حمى الأقليات في سوريا، ومن أبرزها الأقلية المسيحية في الشرق الذين تحمل فرنسا حيالهم التزامًا تاريخيًا بالدفاع عنهم وحمايتهم، وفقا لقول السيد فيون.
وأعتقد أن كلتا المجموعتين من الأسباب، التي يستشهد بها السيد فيون في مقاربته حيال سوريا، هي أسباب معيبة. كما يسهل كثيرًا دحض والتخلص من أسباب «السياسة الواقعية». ومرة أخرى، بشار الأسد ليس هو جوزيف ستالين.
في عام 1941، عندما تم قبوله حليفًا لبريطانيا، كان الطاغية السوفياتي يملك قدرات عسكرية جبارة تحت تصرفه. ولأنه كان يحارب قوات الغزو الأجنبية في «الحرب الوطنية العظمى»، كان يمكن لستالين توحيد شعبه ورعاياه من مختلف الأعراق بطريقة، كان النظام الشيوعي ذاته يعدها ضربًا من ضروب المستحيل قبل اندلاع الحرب. وعلاوة على ذلك، وباعتبارها أكبر دولة على وجه البسيطة آنذاك، كان الاتحاد السوفياتي عبارة عن محيط كبير من الفضاء الأرضي الذي يمكنه ابتلاع القوات النازية تمامًا وحتى الفناء. ولا يملك بشار الأسد أيًا من تلك الأشياء.
وفي حقيقة الأمر، اشتكى بشار الأسد في مناسبات كثيرة من النقص المزمن في القوة البشرية التي تمكنه من البدء في حملة عسكرية مستدامة ومتواصلة. ولقد اعتمد بصورة متزايدة على قوات مرتزقة من لبنان التي يوفرها تنظيم «حزب الله»، إلى جانب المتطوعين من الشيعة الأفغان والباكستانيين والعراقيين فيما عُرف إعلاميًا باسم «متطوعي الشهادة»، الذين أشرفت طهران على تجنيدهم وتدريبهم وتمويلهم، ناهيكم بذكر الآلاف من الجنود الإيرانيين الذين أرسلوا إلى سوريا لحماية نظام حكمه المتهالك.
يروي علينا الجنرال الإيراني حسين همداني الذي لقي حتفه في حلب، في كتابه الذي نُشر بعد وفاته، ويحمل عنوان «مذكرات من سوريا»، كيف أن رجاله أنقذوا نظام حكم بشار الأسد في الساعة الحادية عشرة «بعدما هرب الجميع، بمن في ذلك المستشارون العسكريون الروسيون».
وفي عام 1941، كان السواد الأعظم من المواطنين السوفيات على استعداد للقتال إلى جانب ستالين ضد قوات الغزو الأجنبية. وفي سوريا اليوم، يقاتل بشار الأسد ضد السواد الأعظم من الشعب السوري الذي يرأسه. ولقد أصبح ما يقرب من نصف الشعب السوري إما لاجئين وإما مشردين، مما يُؤكد أن السواد الأعظم من الشعب السوري لا يرغب قط في القتال إلى جانب بشار الأسد.
كان جوزيف ستالين متيقنًا من وجود ما يكفي من القوات تحت إمرته لتطهير أي أراض يكتسبها في حربه ضد النازيين، ثم السيطرة عليها. ولكن بشار الأسد يفتقر أيما افتقار إلى أن يفعل الشيء نفسه حتى وإن تسلم سوريا بأكملها على طبق من فضة.
وعلى أي حال، فإن بشار الأسد ومؤيديه من الإيرانيين والروس لا يقاتلون تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية، لكنهم يركزون في قتالهم على تدمير خصوم النظام الحاكم من غير المنتمين إلى تنظيم داعش. إن بوتين والأسد ينفذان المذابح المروعة بحق سكان حلب، وليس الأتباع المسلحين للخليفة الموتور المزعوم فحسب.
وبصرف النظر تمامًا عما قد يسفر عنه هذا الصراع الدامي أو كيف ستكون نهايته، ليست هناك من أقلية أبدًا تحلم مجرد الحلم ببسط سيطرتها مرة أخرى على سوريا، ناهيكم بإعادة بناء البلاد الممزقة، حتى مع الدعم والمساعدة من جانب القوى الدولية.
ومرة أخرى، على العكس من ستالين، لا يسيطر الأسد إلا على مساحة محدودة من أراضي سوريا، وتتراوح التقديرات بين 5 و20 في المائة فقط من إجمالي مساحة البلاد، وهي مساحة ليست بالكافية لمنح طائفته التي ينتمي إليها المناطق الداخلية الكافية من الناحية العسكرية.
والسبب الآخر لدى السيد فيون لتحمل الأمر على علاته وقبول الأسد حليفًا للقوى الغربية لا يقل وهنا عن سابقه. فلقد قتل بشار الأسد كثيرًا من مسيحيي الشرق بأكثر مما صنع أي حاكم آخر في تاريخ سوريا المستقلة.
وإليكم وصف الشاعرة السورية هالا محمد للموقف هناك:
«لقد ذبحت الحرب سوريا،
وذبحت معها ذكريات أعز الأمهات،
ما عادت بلادنا تلد شيئا...».
وكان النظام البعثي السوري مسؤولاً أيضًا عن حرمان أقلية أخرى، هي الأقلية الكردية التي تشكل 10 في المائة من سكان البلاد من جنسيتهم وتركوهم بلا وطن وبلا هوية. إن المعارضة للنظام السوري الحاكم تتألف من طيف من أغلب الأقليات السورية، بما في ذلك أقلية التركمان، وحتى أبناء الطائفة العلوية التي تنحدر منها أصول بشار الأسد وعائلته. (لم تشترك الأقلية الدرزية أو الإسماعيلية في الصراع، ولكنهم من أبعد المؤيدين والمناصرين للأسد وسياساته). والعشيرة الكلبية التي ينتمي إليها بشار الأسد ليست إلا أقلية في حد ذاتها وسط الطائفة العلوية الكبيرة التي تضم تحت مظلتها عشائر أخرى مثل العشيرة الكلازية والحيدرية والمرشدية.
وفي «السياسة الواقعية»، فإن عقد الصفقات مع الشيطان قد يكون معقولاً، شريطة أن الشيطان المعقودة معه الصفقة سوف يفي بالتزاماته حيالها.
وفي سوريا، اليوم، ليس بمقدور الأسد أن يفي بأي شيء مهما كان باستثناء مزيد من الموت والخراب.
عزيزي السيد فرنسوا فيون، أنت مخطئ بشأن سوريا.
لإنقاذ سوريا من مزيد من المآسي المروعة، ولحفظ ماء وجه الإنسانية من مزيد من الخزي والعار، فلا بد من رحيل الأسد.
 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
لم يخجل مسؤول في البيت الأبيض، حينما صرّح بأنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحدثا لمدة أربع دقائق عن سورية وأوكرانيا، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك). ولم يبدُ عليه أي انفعال وهو يردّد كالببغاء بأنّ أوباما شدّد على ضرورة أن يستمر وزيرا خارجية البلدين في «متابعة المبادرات مع المجتمع الدولي للحدّ من العنف وتخفيف معاناة الشعب السوري».
ولا يبعث هذا التصريح الذي يكشف حقيقة الواقع العارية، أي إحساس بالدهشة، بمقدار ما يسرّع في فقدان الأمل بقدرة الإرادة الدولية على انتشال الشعب السوري من مفرمة الموت التي تفتك بأشلائه في حلب، بعدما زارت طائرات الموت وبراميله المتفجّرة كل أحياء سورية، وحوّلت غالبيتها إلى ركام من الدم والأنقاض والصرخات المخنوقة.
وكلما عظم الرهان على ضغط أميركي يضع حداً لهذه المحرقة السورية، زاد الإحساس العدمي الذي يكتشف، بعد وصول القهر منتهاه، أنّ واشنطن استقالت منذ زمن بعيد من مسؤولياتها الأخلاقية نظاماً وشعباً، ولعل في انتخاب دونالد ترامب ما يشي بأنّ التواطؤ على مأساة السوريين أضحى أمراً مضمراً لدى غالبية المجتمع الأميركي، وهذا أمرٌ مخيّب للأمل، وباعث على تصدّع المنظومة الافتراضية الحالمة للأسرة الكونيّة.
وحتى لا يتورّط المرء في استجداء التعاطف من لدن الأغيار الذين لا يعنيهم ما يجري في حلب، فإنّ من الأجدى أن يلوم المرء نفسه والمقرّبين منه، ويسأل: ماذا فعلنا، عرباً ومسلمين، من أجل سورية. ماذا فعل السوريون من أجل سورية، وماذا فعلت المعارضات المتمزّقة من أجل الوطن المدمّى النازف؟
طالعنا تصريحات المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب، بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي، فألفينـــاها لا تختلف عن تصريحات أي مسؤول أممي، فهي تكتفي بالإدانة، وتعيد المعزوفة ذاتها الباحثة عن «سبل رفع الحصار الذي تفرضه قوات الأســد والميليشيات الطائفية التابعة لإيران على المدن والبلدات السورية، وضرورة الاستجابة للتحذيرات الدولية من احتمال حصول مجاعة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية لدى المحاصَرين».
العالم لا يسمع صوت المتردّدين. والأصابع المرتجفة لا يمكنها الضغط على الزناد، والرهانات البائسة على تحرك المجتمع الدولي، ويقظــة الحميّة العربية والإسلامية، ليست أكثـــر من محض هراء، فلا «معتصم» بمقدوره أن ينهـــض مــن غبار التاريخ، فينتشل الأطفال الذين تتلذّذ الطائرات الروسية في اصطيادهم، فيما ينتشي الأسد وهو يحصي عدد الأشلاء والأطراف المبتورة، فيرفع كأس الدم في صحة الموت!
وفي عتمة هذا الصمت الكريه، وفي غياب أي ضوء يعدنا به آخر نفق هذا الألم السوري الطويل، تتبرّأ الإنسانية من ذاتها، وتتخشّب اللغة التعاطفية مع ذلك الرضيع الذي نجا من البراميل المتفجرة، فحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى الذي كانت تحدق فيه طائرة روسية أفرغت حمولتها في جسد المستشفى والمبنى والمعنى، وظلت تنتظر على أحرّ من الجمر عبارات الاستنكار، وبيانات الحضّ على ضبط النفس.
الدقيقتان اللتان قضاهما أوباما وبوتين لمناقشة الأزمة السورية، هما الزمن الذي تستحقه هذه المأساة غير المسبوقة في التاريخ، في ذهن رئيسيْ أكبر دولتين في العالم. لذا لا عجب إن تمّت الإبادة الجماعية للشعب السوري من أجل تمرير مخططات بوتين والولي الفقيه، وترسيم الخرائط الطائفية في منطقة تنجب الموت والانتحاريين وفاقدي الإحساس بطعم الحياة، والناقمين على «الأسرة الكونية»، والمزنّرين بأحزمة الانفجار، والحالمين بانتصار ضئيل ويائس كطعم الانتصار الذي يهرسه بشار الأسد تحت أضراسه «الدراكيولية»، فينزف هزائم مسربلة بالعار.
 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
الحقيقة التي لا يمكن انكارها هي أن حلب في وضع غير مسبوق على الاطلاق، وعلى كافة الأصعدة دون استثناء أي صعيد، سواء أكان انساني أم ميداني أو معنوي، و قد لا نبالغ أن الأمر تجاوز حالة الوهن و فاق درجة المرض ، و لكن هل حلب تموت ..!؟
من الممكن أن يكون لطبيعة عملي، دور في اتاحة الفرصة للاطلاع على تفاصيل دقيقة و غاية في السرية في بعض الأحيان، و كذلك أمور أخرى سطحية، و كثيراً ما أصطدم مع التلفيق و التزوير، و لكن في حالة اليوم نقف شبه عاجزين عن التمييز بين عشرات الأصوات التي تصل إلينا، هل هي صادقة تماماً و ما نسبة “التبهير” ، و إلى أين يرنو صاحبها منها، سيما مع الواقع الميداني المتذبذب و الفاقد للسيطرة.
الأمر الذي يمكن تلخيصه أن أحياء حلب المحررة و المحاصرة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، تُركت تماماً وحيدة دون أي معين سواء أكان من المحيط الضيق أم من المحيط الأوسع (العالم)، و حتى نبرة التنديد و التحذير (طبعاً الكلامي)، قد صمتت بشكل مريب، وكأن القرار أن تترك هذه البقعة بسكانها و مساكنها حتى تنهار، أو كما أحب المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا استخدام وصف “السحق”.
هذا الترك فتح المجال و على كافة مصاريعه أمام الأسد و حلفاءه و بدأوا حملة غير مسبوقة ، عدة وعتاداً ، و الأهم عناصراً ، اذ يرصد المتابعون للمليشيات الخارجية الموالية للأسد في حلب ، وجود 35 ميليشيا مدججة بحقد أزلي سواء من الناحية الطائفية أو القومية أو الاجرامية ، اذ تجد في أحياء حلب المحررة بوابة تفتح أمام السرقات و الغنى بدون أي رقيب أو حسيب.
هذا الكم الذي حُشد على رقعة جغرافية مكتظة بالسكان و محشورة داخل طوق مسيّج بالموت و النار، يجعل من قضية الحفاظ على منطقة أو نقطة استراتيجية مركز عليها الهجوم أشبه بعملية استشهادية، صاحبها ميت لا محال، وحتى هذه الخطورة و النهاية الحتمية يوجد المئات ممن يقبل عليها غير آبه أو مرتجف.
في حلب المحاصرة قصص بطولية تنسج، و رجال يقاتلون بأبسط المعدات و تقليل بالذخائر، ونسيان قضية العلاج لأي اصابة قد تحدث لأن لا مشفى متبقي و لا طبيب يستطيع العلاج مع انتهاء الأدوية و تدمير المعدات، و رغم ذلك لازال يقاوم.
المعادلة في حلب لاتعرف التوازن اطلاقاً، و بنفس الوقت لاتنبئ بنهاية حتمية ونهائية، اذ أن الأمور لطالما سارت في كثير من المناطق نحو ذات الانحدار ، و لكنها لم تندثر ، بل انقلبت بشكل معاكس.
رسائل الانهزام سواء من الداخل أم من المحيط الضيق و حتى الدولي، يقابلها وعود واثقة ثقة عمياء أن كل ماحدث عبارة عن كبوة بين شطري الاستبداد و الحرية ….
 ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
في الربع الأخير من القرن العشرين، جرت عدة أحداث كبيرة، لها دلالة ثقيلة على الواقع العربي والإسلامي، أولها:
قيام ثورة الخميني في إيران عام 1979، ورفع شعار تصدير الثورة الإيرانية إلى دول الجوار كالعراق ودول الخليج العربي وبلاد الشام، وبعد عام واحد اضطر الرئيس العراقي صدام حسين أن يخوض حرباً مريرة ضد إيران لمدة ثماني سنوات، استطاع فيها القضاء على أحلام الخميني، ولكن إلى حين.
وثانيها: تم استجرار صدام حسين لاحتلال الكويت، فسارع الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، لإخراجه من الكويت بضربة عسكرية باطشة، وفرض عليه حظراً جوياً في جنوب العراق ذي الأغلبية الشيعية، وشماله حيث التواجد الكردي، وهكذا أصبح العراق شبه محتل من قبل الأمريكان وإيران معاً.
وثالثها: احتلال الاتحاد السوفييتي لأفغانستان، وهذا ما أغضب أميركا، فبدأت تعمل على إلحاق الهزيمة بذلك العدو التقليدي، وكان لها ما أرادت عبر نفخ الروح الجهادية في الإسلاميين المتشددين.. وهكذا ظهر بن لادن وتنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية الأفغانية، واستطاعوا طرد السوفييت من أفغانستان.
وفي عام 1985 استقبل الرئيس رونالد ريغان مجموعة من الرجال الملتحين في البيت الأبيض تكريماً لهم لانتصارهم على الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، ثم تحدث إلى الصحافة، وأشار إليهم، قائلاً: هؤلاء هم المعادلون الأخلاقيون لآباء أميركا المؤسسين ".
هذا ما ذكره الكاتب الباكستاني أحمد إقبال في محاضرته " إرهابهم وإرهابنا" التي ألقاها في جامعة كولورادو في الثامن عشر من تشرين الأول عام 1998، قبل مماته بعامين.
وظل رونالد ريغن يحتفي ببن لادن ورفاقه المجاهدين.!!. ويعدّهم المعادل الأخلاقي لجورج واشنطن وتوماس جيفرسون، حتى انقلبوا على أبناء أولئك الآباء المؤسسين، وتعهدوا بالقضاء على أميركا وعلى عالم الكفر في العالم كله.!!.
كانت استراتيجية أميركا والغرب واضحة المعالم، وفد كشفت عنها رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، حين قالت: الآن قضينا على الاتحاد السوفييتي، وبقي علينا القضاء على الإسلام في القرن الواحد والعشرين ".
إن انهيار الاتحاد السوفييتي بعد هزيمته المذلة في أفغانستان، وإخراج صدام حسين من الكويت، دفع بجورج بوش الأب لأن يعلن عن قيام النظام العالمي الجديد ذي القطب الواحد. وأول أهدافه القضاء على الإرهاب، أينما وجد.
كانت الفوضى تعم الصومال العربي المسلم بعد وفاة رئيسه زياد باري، وكثرت فيه الفصائل المتناحرة، وأصبح مرتعاً لعناصر تنظيم القاعدة، عندئذ سارعت الأساطيل الاميركية لمطاردتهم والقضاء عليهم، لكن جورج بوش تلقى عدة ضربات مؤلمة، كان أكثرها إيلاماً تلك التي قتل فيها أكثر من ستة وثلاثين جندياً أميركياً، فقرر صاحب مقولة النظام العالمي الجديد.!!. سحب أساطيله والخروج من الصومال، مع التهديد والوعيد بأن يُغرق الصومال بالحروب والفتن والخراب، وها هم الصوماليون لم يستطيعوا حتى الآن أن يعيدوا بناء دولتهم، ولو على أبسط الأسس والمعايير الدولية.
وما إن أطل القرن الواحد والعشرون، حتى جرت أحداث الحادي عشر من ايلول، وتدمير برجَي نيويورك، وأعلن بن لادن مسؤولية القاعدة عن التفجيرين، ولا ندري تبجحاً وغباء أم لغاية متفق عليها من وراء الكواليس.!!.
وهنا نورد ما قاله مورغان رينولدز الأستاذ بجامعة تكساس والعضو السابق بإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش: إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت عملية زائفة وأكذوبة كبيرة لها علاقة بمشروع الغرب للهيمنة على العالم ". والهيمنة التي يعنيها مورغان هي القضاء على العالم الإسلامي قبل أي عالم آخر.
من هنا دقّ جورج بوش الثاني طبول الحرب على الإسلام، بحجة محاربة الإرهاب، واحتل أفغانستان في عام 2001، ودمّر وقتل من جراء ذلك عشرات الآلاف، وبعدها بعامين احتل العراق بالحجة نفسها، وقد تبين فيما بعد أن العراق كانت خالية من أي " إرهابي " تابع للقاعدة، لكن جورج بوش قضى على المعالم الحضارية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك البلد، وقتل بحسب المصادر أكثر من مليون عراقي، معظمهم من الطائفة العربية السنية، ومنهم الكثيرون قضوا بقنابل تحتوي على اليورانيوم المنضّب.. كل ذلك انتقاماً لضحايا برجي نيويورك التي أثبتت الأدلة أن التفجيرات كانت بفعلٍ مدبّر، ولا علاقة لصدام حسين بذلك.
وفي عام 2011 بدأ ربيع الثورات العربية، واستبشر الناس خيراً بخلع الأنظمة الدكتاتورية، لكن ذلك الربيع العربي تحول إلى شتاء قارس، فالقضاء على الإسلام بدأ خطواته المتسارعة.
في تونس نجحت الثورة، وسقطت سلطة زين العابدين بن علي، وبدايةً عاش ذلك البلد تجربة ديمقراطية لابأس بها، لكنها سُرقت بفضل المال الخليجي، وهي الآن على كف عفريت.
وفي ليبيا قُتل القذافي وسقط نظامه، لكن ليبيا اليوم لم تستقر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بل هي الآن أقرب إلى الفوضى، ويتدخل فيها الشارد والوارد من الدول الغربية والعربية.
وفي مصر نجحت الثورة وسقط حكم مبارك، وجرت انتخابات ديمقراطية سليمة، لكن الغرب لعب لعبته، وجاءت الصهيونية بقريبها عبد الفتاح السيسي، ليكون سيد مصر المعظم.!!. وأقول قريبها، فالسيسي ابن يهودية كما تذكر بعض المصادر، وابن اليهودية يهودي بحسب شريعة بني إسرائيل، ومصر الآن مرشحة للانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. أما رئيسها المنتخب محمد مرسي، فهو قابع في السجن، ومهدد بالإعدام بتهمة التخابر مع دولة عربية..!!.. تصوروا.!!.
أما ثورة اليمن فأدى انتصارها الهزيل إلى استفحال أمر الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح بدعم إيراني غير محدود، واستهتار خليجي، وبقي الأفق في اليمن السعيد مسدوداً، وأظنه سيظل كذلك إلى أمد بعيد، بالرغم من مساندة التحالف العربي للحكومة الشرعية.
كما وقع العراق منذ احتلاله عام 2003 تحت استعمارين؛ أميركي وإيراني، وكانت النتيجة أن تقطعت أوصاله وانهارت بنيته الاجتماعية وارتمى في قاع العشائرية وجحيم الطائفية الدينية والعرقية، وأدى كل ذلك إلى دمار المناطق العربية السنية وقتلهم وتشريدهم بمباركة تنظيم داعش رضي الله عنه.
هذه هي الفوضى الخلاقة التي بشر بها جورج بوش الثاني.
أما في سورية فالنكبة التي حلت بها لا تفوقها نكبة في ماضي العالم وحاضره. لقد قام الشعب السوري بثورته العادلة يطالب بحقوقه المشروعة عبر المظاهرات السلمية، لكنها تحولت إلى حرب، لا أحد يستطيع وصفها، لسوء ما آلات إليه من أهوال لا تبقي ولا تذر.
لقد كثر الدخلاء فيها من عرب وعجم، وأصبح ما يجري على أراضيها أشبه بالحرب العالمية الثالثة. فأميركا دخلت إليها بألاعيبها، وروسيا بأسلحتها التدميرية الفتاكة، وقد القت حتى الآن من طائراتها وبوارجها الحربية على رؤوس السوريين ما يعادل أو أكثر من قنبلة نووية.
كما دخلت ميليشيات شيعية شتى من إيران ولبنان والعراق، وحتى من أفغانستان واليمن، وكذلك دخل خبراء مهرة من الصين وكوريا الشمالية، والكل جاء لمحاربة داعش ومساندة الأسد، والكل يرى أن من يعارض ذلك الأسد وابن الأسد من الشعب السوري هو داعشي وابن داعشي.
أما داعش فلا يعرف أحد كيف انزرعت ولا كيف انتشرت في العراق والشام، وقد تحوّل جهادها ضد الكفر والمرتدين.!! وبالاً على الشعب العربي السني، فلقد اتفق العالم كله على محاربتها، والنتيجة دمار هائل وسفك فظيع للدماء في المناطق العربية السنية.
ولو كرّرنا المكرّر نقول باختصار: إن الشعب السوري الآن يتعرض لأفظع إبادة شهدها العالم. فعدد الضحايا حتى الآن يقترب من المليون، والدمار في المدن السنية بزيد على 70% والمشردون داخل الوطن وخارجه يزيد عن عشرة ملايين، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد سكان سورية كلهم. فأي حرب أقسى على الإسلام من هذه الحرب التي تجري الآن.!!.
ولا نغفل هنا دور إسرائيل في الأزمة السورية، فهي " المايسترو "الذي يقود الجوقة الموسيقية العالمية، وهي التي تحرك خيوط اللعبة كلها من خلف الكواليس، وهذا هو دورها، فهل هناك دور أعظم من هذا الدور في هذه المسرحية ــ الكارثة.!!؟.
أما الرابح الأعظم من كل هذه الفوضى الخلاقة.!! فهي إيران الفارسية الشيعية وذراعها الطويل حزبُ الله، وواقع العراق وسورية اليوم يكشف عن ذلك بوضوح، فإيران نجحت في مخططها الباطني، ففي البداية أعلنت العداء لأميركا، وسمّتها الشيطان الأكبر، ورفعت شعار الموت لإسرائيل، ووعدت المسلمين قاطبة بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، ولذلك أصبحت عند أميركا وإسرائيل العضو البارز في محور الشر ورأس الإرهاب!!..
وفي النهاية تبين أنها الصديق الباطني لأميركا، وأنها شريكتها في احتلال أفغانستان والعراق، ثم بغمضة عين انحصر الإرهاب في الإسلام السني دون الشيعي، فتطهرت إيران وأتباعها من ذلك الرجس، وأصبحت المدللة عند أوباما، وشريكته في الحرب على الإرهابيين التكفيريين، وتحولت استراتيجيتها من تحرير فلسطين إلى تحرير سورية من شعبها.
وهكذا التقى أحفاد الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية واتفقوا على القضاء على العرب المسلمين في القرن الواحد والعشرين.
فهل تستمر الحرب الكونية على العرب السنة في سورية، أم أن بلاد الشام ستلفظ غزاة الحاضر، وتردهم خائبين، كما فعلت مع أشباههم عبر التاريخ.!؟.
 ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦
٢٦ نوفمبر ٢٠١٦
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام بشار الأسد وروسيا الاتحادية وإيران وحلفاؤها وميليشياتها في مدينة حلب، تجاوزت كل الحدود، إنْ كان للجرائم حدود، بحيث باتت تتطلب وقفة للتأمل في هذه الحالة المزرية التي تحولت إلى ظاهرة بشعة تبعث على الحزن والصدمة، في ظل هذا التخاذل الدولي.
فهذه مدينة عربية تدمر بالكامل، مدينة تحدثنا كتب التاريخ أنها، مع دمشق، أقدم موقع على الأرض سكنه البشر ولا يزالون. ولذلك فإن الخراب الذي لحق بهذه المدينة فمحاها، أو كاد يمحوها، ليس فحسب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ارتكبتها القوات المسلحة التابعة للأطراف الثلاثة نظام بشار الأسد، وروسيا، وإيران، ولكنها جريمة ضد الحضارة، بكل ما في هذا التوصيف من دلالات عميقة. فهل كان هذا التدمير الكاسح الشامل لمدينة حلب من أجل محاربة الإرهابيين المزعومين وتطهير المدينة منهم، وهم في واقع الأمر عناصر المعارضة السورية التي تسعى إلى إسقاط النظام الدكتاتوري المستبد في دمشق؟ أم أن الهدف الذي لا هدف غيره، هو تدمير هذه المدينة، كما دمرت من قبل مدن وقرى أخرى في سورية، لمحو أي أثرٍ باقٍ للحضارة في هذا البلد؟
إن ما يجري اليوم في سورية المنكوبة التي أصبح أكثر من نصف سكانها لاجئين ونازحين وما يفوق نصف المليون من مواطنيها شهداء، هو حرب شرسة ضد الحضارة الإنسانية، بالمفاهيم الشاملة للحضارة، وبكل مظاهرها وتجلياتها، يشنّها مجرمو حرب ينبغي أن يحاكموا عاجلاً وليس آجلاً، طبقاً للقانون الدولي.
إن جرائم الحضارة أشنع وأفظع من جـــرائم الحرب والجـــرائم ضد الإنسانية، لأن الحضـــارة عطاء الإنســـانــية المتوارث عبر الأحقاب، وما يجري اليوم في حلب التي لم تعد شهباء، بل حمراء بسبب الدمــاء المسفوحة، يجسّد أخطر الجرائم التي يرتكبها البشر خلال هذه الحقبة، في حق الإنسان والعمران والتاريخ والجغـــرافيا والقيم السامية الخالدة التي جاءت بها الرسالات السماوية.
وخراب المدن وتدميرها على رؤوس ساكنيها ومحوها من الخريطة جرائم لا تقاس بأخرى، تَتَجَاوَزُ كونَها ضد الإنسانية إلى ما هو أخطر من ذلك بمسافات بعيدة. وهو ما نصطلح عليه بجرائم ضد الحضارة.
فكيف يصمت المجتمع الدولي ولا يكاد يحرك ساكناً، أمام هول ما يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، ومعهما حكام إيران الذين يعطون الأوامر للميليشيات التابعة لهم، من جرائم هي وصمة عار في جبين الإنسانية حقيقةً لا مجازاً؟ لقد عطلت روسيا مجلس الأمن فأصبح رهينة بيدها، فلم يعد يمارس المهمة المخولة له والتي تتلخص في حفظ الأمن والسلم الدوليين. والولايات المتحدة الأميركية باتت عاجزة عن التحرك في اتجاه حماية الشعب السوري قياماً بدورها في حفظ السلام العالمي. وثمة أكثر من مؤشر إلى أن الإدارة الأميركية المقبلة لن تكون في خدمة السلام في منطقتنا. ولا في مناطق أخرى من العالم.
وإلى حين ظهور مؤشرات إيجابية، وهو أمر ليس مستبعداً على أية حال، فإن الحرب ضد الحضارة الإنسانية ستتواصل في سورية، وبالأخص في حلـــب التي أجهز عليها المجرمون العـــتاة من إرهابيي الدولة، الذين يزعمون أنهم يحاربون الإرهابيين ويتصدون لتنظيم داعش، بينما هم في حقيقة الأمر، يعيثون فساداً ودماراً وخراباً في سورية أمام مرأى ومسمع من العالم كله.
وذلك منتهى الإجرام، يقابله منتهى الخيانة لمبادئ القانون الدولي من العالم الصامت العاجز المتردد الخانع.
 ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦
٢٦ نوفمبر ٢٠١٦
هل كان مفاجئاً ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دعمه الجيش السوري النظامي، بمعنى تأييده رئيس النظام بشار الأسد في حربه على شعبه؟ كان منطق الأمور سيؤدي بالضرورة إلى الإجابة بـ "لا"، فما قاله السيسي لقناة التلفزيون البرتغالي ليس بعيداً عن سياق تصرفات السياسة المصرية تجاه الوضع السوري. ربما الجديد في الأمر هو الإعلان صراحة، وللمرة الأولى، على لسان أرفع مسؤول في النظام المصري، أن موقف القاهرة من الأوضاع في سورية هو الوقوف إلى جانب نظامها.
هل كان من المفترض أن يكون موقف السيسي غير ذلك؟ وهل هناك من توقع أن يحمل قائد الانقلاب العسكري في مصر، وأحد رموز الثورات المضادة، موقفاً مناهضاً لحكم عسكري مماثل له، وينفذ تماماً ما نفذه هو، ولكن بأسلوب مختلف؟ هل هناك من يتذكّر موقفاً رسمياً مصرياً واحداً يعلن فيه النظام في القاهرة إدانته المجازر التي تحصل في سورية، ويرتكبها النظام وحلفاؤه؟
معطيات مثل هذه ليس من المفترض أن تؤدي إلى المفاجأة التي أحدثها تصريح السيسي، ولا سيما أنها جاءت في خضم شبه الأزمة التي تعيشها العلاقات المصرية السعودية، وهي العلاقة نفسها التي منعت النظام المصري، في السابق، من المجاهرة برأيه في الوضع السوري، على الرغم من أنه من المفترض أن يكون معلوماً لصناع القرار في العالم العربي.
فبغض النظر عن كل ما قيل ونشر حول التنسيق الأمني المصري السوري، ومشاركة جنود مصريين في المعارك السورية إلى جانب النظام، والذي قد يكون صحيحاً والأرجح ألا يكون، إلا أن أموراً أخرى كثيرة كانت ستقود، بالتحليل، إلى النتيجة نفسها، وهي أن بشار الأسد والسيسي يقفان في خندق واحد.
ربما الجزء الأول من التحليل يجب أن ينظر إلى الخلفية التي جاء منها السيسي، ومقارنتها مع الخاصة برئيس النظام السوري، فالاثنان عملياً يشكلان امتداداً للحكم العسكري الذي عاشت دول عربية كثيرة، وبعضها لا يزال، تحت نيره، وبالتالي، فإن مسار الدعم، والذي يمكن أن يقال إنه متبادل، يصب في خانة "الحفاظ على السلالة العسكرية الحاكمة". ويمكن أيضاً أن نضع دعم السيسي اللواء المتقاعد في ليبيا، خليفة حفتر، في سياق تمكين الحكم العسكري، وتأكيد أنه الأقوى والأقدر على البقاء في وجه الثورات التي طالبت بالحرية والعدالة والديمقراطية.
من هذه الثورات يمكن الدخول إلى الجزء الثاني من التحليل، فالاثنان يقفان على المسافة نفسها من الحركات الاحتجاجية التي شهدتها عدة دول، وهما تعاطيا معها وفق المنطق نفسه، بغض النظر عن الأدوات. فإذا كان الأسد لجأ إلى البراميل والمليشيات والغارات، فإن السيسي عهد إلى الجيش لفض الاعتصامات، وهو مستعد للذهاب أبعد من ذلك، في حال تطورت الأوضاع لاحقاً، وبالتعاون مع الشركاء أنفسهم.
هؤلاء الشركاء يمكن أن يكونوا الجزء الثالث من التحليل، والذي من الأفضل أن يركّز على حركة السيسي في الأيام الأولى من انقلابه، وقبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، والزيارة التي قام بها إلى موسكو، والتقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. زيارة من الواضح أنها جعلت مصر جزءاً من المحور الذي يشكله الرئيس الروسي في المنطقة، وهو محور بدأت تتكشف أطرافه وامتداداته شيئاً فشيئاً. وما التصويت في مجلس الأمن إلى جانب القرار الروسي إلا جزءاً من هذه الامتدادات. التقرّب من المحور لم يقف عند روسيا، بل انتقل أيضاً إلى إيران والعراق، ولا سيما بعد أزمة الوقود الأخيرة، والتي ربما كشفت عن مسارات ومفاوضات كانت تجري سابقاً تحت الطاولة، وحان الوقت لظهورها إلى العلن.
نقاط كان يجب أن تكون واضحةً، منذ البداية، للدول المؤيدة للثورة السورية، وأن تضع السيسي والأسد في خندق واحد، وعدم انتظار تصريح يكشف عملياً عما هو معلوم. لكن، بعد فوات الأوان.






