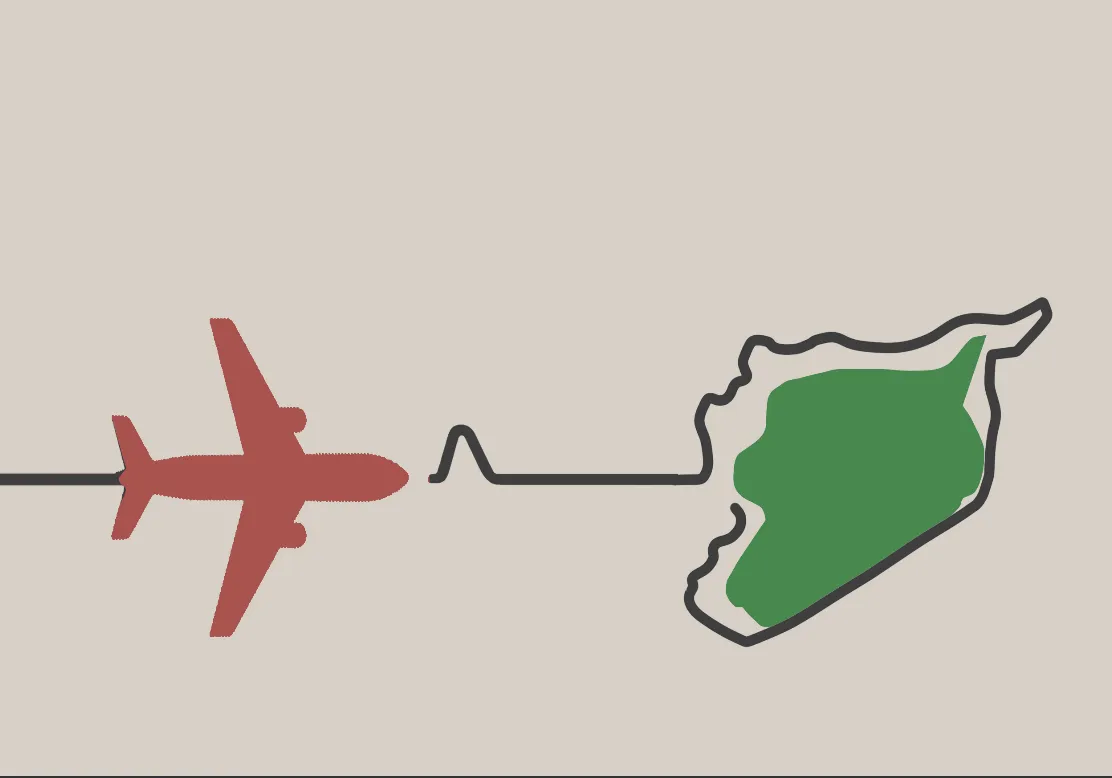١٣ نوفمبر ٢٠١٤
١٣ نوفمبر ٢٠١٤
مع تزايد الإهتمام السوري والدولي بمقاومة كوباني وصمودها البطولي في وجه إرهاب دولة البغدادي، وطرح بعض كتائب الجيش الحر فكرة إرسال قواتها للدفاع عن كوباني، ودخول قوات البيشمركة عبر الاراضي التركية، أعلنت جبهة النصرة حربها على الكتائب المعتدلة التي تمثل الثورة والثوار كحركة حزم و جبهة ثوار سوريا..، مستغلة فرصة انشغال العالم و على وجه الخصوص التحالف الدولي في تحديد قدرات داعش، للانقضاض على هذه الكتائب المعتدلة في كل من جبل الزاوية الاستراتيجي، و خان السبل ، و استطاعة النصرة مع جند الاقصى وأحرار الشام من الإستيلاء على غالبية المنطقة، والتي تعتبر عقدة المنطقة الغربية و الشمالية الغربية الجويوعسكرية.
جبهة الجولاني ( النصرة ) التي تعتبر فصيل تابع للقاعدة رسميا، دافع عنها قسم كبير من المعارضين السوريين و بعض التشكيلات العسكرية، على اعتبارها أحد أركان المعارضة العسكرية الرئيسية ضد نظام بشار الأسد، كشفت عن وجهها الحقيقي في ظل إنشاء تحالف عسكري عريض على الأرض انطلاقاً من كوباني لتشمل العراق و الشمال السوري، و بدأت في كسر اتفاق الهدنة بينها و بين الفصائل المعتدلة، مبادرة الى الهجوم على المقرات، و توسيع رقعة الولايات و السيطرة على العقدة الاستراتيجية.
الجولاني تلميذ البغدادي السجين السابق لدى النظام، أحدث إطلاق سراحه مع البغدادي شكوكاً كبيرة، وضعتهم امام اتهامات واضحة، واسألة كثيرة. برفض الجولاني مبايعة البغدادي كان اعلان انشقاق النصرة عن داعش، والتي كانت الاولى منها ناجحة في اظهار المرونة في التعامل مع المعارضة، و الشدة مع النظام، الا ان النظام كان يحتفظ به كورقة بديلة في حال فشل داعش، و ان لم يكن الانشقاق جدياً، فالخريجان من سجون الأسد والمالكي يتلقون الاوامر من القيادة الشيعية –العلوية، المسيّر الفعلي للقاعدة وداعش..! في ظل اختفاء طال أمده لأيمن الظواهري الذي لم تبدر عنه أي تصاريح لا بشأن انتصارات دولة البغدادي على حساب النصرة-القاعدة، ولا بشأن انكساراتها في كوردستان العراق وكوباني، ولا حتى بشأن الاقتتال الدائر بين (المسلمين ) أنفسهم في جبل الزاوية !! .
بعد ملحمة كوباني الكوردية، مفخرة حلب الشهباء، بدأت جبل الزاوية معقل ثورة القائد إبراهيم هنانو برفع لواء التصدي للتنظيم (جبهة النصرة و جند الاقصى و حلفاءهم) في الطرف الآخر من ساحة القتال المحتدمة، و هنا تستحق جبل الزاوية بجدارة أن تكون " كوبانية " إدلب، ملحمة التصدي و الصمود الادلبية. بشكلٍ متزامن تتعرض الآن الكوبانيتان الى هجوم شرس و مرّكز من المنظمات الإرهابية صنيعة نظام بشار ومخابراته، بعدما أزعجه تقدم القوى العسكرية المعارضة في المنطقتين و باتت وبالاً عليه.
على كافة القوى السياسية والعسكرية التي تؤمن بالثورة السورية وأهدافها أن تدافع عن " كوبانية " جبل الزاوية لدحر الإرهاب والإرهابيين عنها ، والتصدي لجبهة النصرة و حلفائها، ذلك الخنجر المسنون على خاصرة الثورة السورية، والعمل على تدويل النضال والمقاومة فيها كما هي الحال في كوبانية حلب، لتمتد ضربات التحالف إليها، لأن جبهة النصرة وداعش وجهان لعملة واحدة صنعها النظام.
كمان ان على الثوار ألا ينخدعوا بجبهة النصرة و حلفائها كما انخدعوا بداعش وينتبهوا إلى الاعيبها ومخططاتها التي لن تخدم سوى النظام، لذلك يتطلب من المعارضة التي تسعى لإسقاط الطاغية و بناء دولة العدالة والحرية و الديمقراطية أن تحدد موقفها بجلاء، وأن تطالب التحالف الدولي بضرب هذه التنظيمات و راس الافعى المتمثل بالنظام مع عملياتها التي تخص فقط داعش، فثالوث الإرهاب في سوريا والمنطقة - النظام السوري، داعش جبهة النصرة- خطير عالمي، لا يهدد فقط العراق و الشام.
يمكن تحديد ملامح بدأ المخطط الارهابي القاعدي بالنقاط التالية:
1- اعتداء النصرة على مقرات حزم ذات السمعة الجيدة، التي توجه كل طاقاتها ضد النظام السوري
2- انسحابهم من جبهات القتال في كل من حلب ومورك و ترك ثغرة ادت الى تغول النظام و تقدمه
3- اعتقال شخصيات وقيادات في ادلب لها تاريخ نضالي !
4- رفضت وساطة لواء الحق الذي يعتبر احد الفصائل المقربة من النصرة.!
هذه النقاط توضح فكرة وجود اصرار و مخطط لاقامة امارات موازية لداعش، و تحولي المنطقة الى ولايات لا تخدم سوى النظام السوري...
في حال سيطرة جبهة النصرة على ادلب وأعلنت إمارة ادلب التابعة للقاعدة فهذا سيشكل قوة للقاعدة في المنطقة اكبر من قاعدتها في افغانستان حيث ستكون في موقع استراتيجي لا يستهان به.!
النقاط التي عملت عليها جبهة النصرة، لتدعيم موقفها و ترسيخ قواعدها في المنطقة، خدما لمصلحتها و مصلحة الداعم لمشروعها:
- الحاضنة الشعبية حيث ان النصرة حافظت على علاقة جيدة مع المواطنين و لم تعمل كما فعلت داعش!
- تحالفات النصرة : جند الاقصى - جيش المهاجرين والانصار - جيش الخلافة،
- تأثير كبير على الجبهة الاسلامية عن طريق حركة احرار الشام الاسلامية
- تحييد فصائل مثل جيش المجاهدين و فيلق الشام و التي قررتا الابتعاد.
- سيطرتها على معبر أطمة و بالتالي قطعت امداد جيش الحر
ان نجح التحالف الدولي في الحد و لو جزئيا من قدرات داعش، و لعب دور اساسي في انقاذ كوباني الشهباء من السقوط، عليه ايضا نجدة كوباني الادلبية، قبل فوات الاوان و ارتفاع تكلفة دحر القاعدة من سوريا
 ١٣ نوفمبر ٢٠١٤
١٣ نوفمبر ٢٠١٤
يتكرر الحديث، أخيراً، عن حوارات ومشاريع للتوصل إلى حل في سورية، وعادت موسكو لكي تمسك الملف، بعد أن فلت منها. حيث زار وفد معارض موسكو، وتوافق جون كيري ولافروف على العودة إلى مسار جنيف، كما أن الحوار الأميركي الإيراني يتناول الحل في سورية. وكان التسريب يمرر حلولاً متناقضة، من توافق على استمرار الأسد في المرحلة الانتقالية، حتى قبول إيران وروسيا إزاحته. لكن، أيضاً، تتعزَّز الأوهام لدى السلطة بأنها قادرة على الحسم، ولا تحتاج، بالتالي، إلى حل. وتلعب إيران بالورقة السورية في سياق الحوار الذي يجري بينها وبين أميركا، بعد أن باتت هي الممسك بالقرار في سورية، وتفعل ذلك لتحقيق مصالحها على ضوء الضغط الأميركي عليها بالعقوبات التي طالت البنك المركزي، وجعلتها لا تستطيع الحصول على أموال النفط، وبالتالي، أن تعيش في أزمةٍ، تدفعها إلى الوصول إلى حل، على رغم أنها لا زالت لا تقبل أي حل، بل تريد أن يجري الاعتراف بدورها الإقليمي، وبتأثيرها في العراق على الأقل، وفي سورية إنْ استطاعت.
لا شك في أن نقل أميركا للصراع "ضد داعش" إلى سورية لا يرتبط بداعش بذاتها، بل يرتبط بالتأثير في الورقة السورية خلال الحوار مع إيران، وهذا ما يطرح ما قد تقرره هي، هل هو الموافقة على السيطرة الإيرانية على النظام السوري، أو الوصول إلى توافق مشابه لما حدث في العراق، أي بتقاسم التأثير في السلطة، أو القبول بعودة التأثير الروسي ضمن ترتيب العلاقة الأميركية الروسية بعد أن تصدعت، بعد أزمة أوكرانيا.
وفي المعارضة، يبدو أن حسم أن الائتلاف الوطني ممثل للثورة تراجع أميركياً، وأن السياق يسير نحو إشراك أطراف معارضة أخرى، أو إشراك هذه بالتشارك مع الائتلاف، بما في ذلك أطراف كانت أقرب إلى السلطة، مثل جبهة التحرير والتغيير. وبالتالي، نشهد سيولة في أدوار المعارضة، وتفاعلاً مع مجموعات متعددة، من دون التفاعل الجدي مع الائتلاف.
هل يمكن أن يتحقق حلٌّ باستمرار وجود الأسد؟ هذا ما لعبت وتلعب عليه روسيا وإيران، وقد تقبل به أطرف في المعارضة مخرجاً من الوضع المرعب الذي باتت تعيشه سورية. لكن، ربما يكون ذلك ممكناً في الشهر الأول من الثورة، لكنه لم يعد ممكناً بعد ذلك، خصوصاً بعد جرائم السلطة ووحشيتها، والقتل والتدمير والنهب والسلطة الذي قامت به. ربما حتى "الموالاة" لم تعد تشعر بأنها قادرة على قبول استمرار الأسد، بعد الفظاعة التي طالتها من الشبيحة، وبعد خسائرها البشرية. وفي وضعٍ يشهد تعدد الكتائب المسلحة، ووجود قوى سلفية بشعة، ليس من الممكن أن يقبل المسلحون الذين يقاتلون السلطة حلاً لا يحقق إنهاء سلطة بشار الأسد. كذلك، يمكن أن يقول الأمر نفسه لاجئون كثيرون فقدوا أبناءهم.
بالتالي، يجب أن يكون واضحاً أن الحل يقوم فقط على إنهاء سلطة بشار الأسد و"الحاشية" التي بشّعت ونهبت، وقررت، منذ البدء، "القتال إلى النهاية". وهذا يفترض تقدّم أطراف أخرى في السلطة لكي تفكّ هذه العقدة، أو أن تقوم بذلك، بالتوافق مع قوى إقليمية مؤثرة، أي لإيران وروسيا. فهذا هو المدخل لحلّ ممكن، يمكن أن يقود إلى إنهاء الصراع الدموي، ومحاصرة القوى "الجهادية"، وتهميش القوى الأصولية التي لا يمكن أن يكون لها دور في سورية المستقبل. وهذا المستقبل يمكن أن يصير أمراً واقعاً، فقط بإنهاء سلطة بشار الأسد، وتشكيل هيئة انتقالية من قوى في السلطة والمعارضة. على الرغم من أن هذا الحل ليس الأخير، فالصراع سيستمر، وإنْ بشكل آخر من أجل بديل حقيقي، يفرضه الشعب الذي تآمرت كل القوى الإمبريالية والإقليمية والمعارضة، من أجل تدمير طموحه للتحرر والتطور.
 ١٣ نوفمبر ٢٠١٤
١٣ نوفمبر ٢٠١٤
لا يترك الرئيس الأميركي، باراك أوباما، فرصة للتعبير عن عدم رغبته في التورط في القضية السورية، إلا واستغلها. وفي آخر مقابلة له مع محطة "سي بي إن" الأميركية، لم يخطئ المسار، فأكد ما كان قد ردده، في الشهر الماضي، ست أو سبع مرات على الأقل، أن التزامه في الشرق الأوسط اليوم يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، وليس له علاقة بنظام الأسد، وأن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وإنما من خلال تسوية سياسية. مضيفاً، هذه المرة، جملة معبّرة، ومثيرة للقلق في الوقت نفسه، هي: أن هذه المسألة "بعيدة المدى"، ما يعني أننا لا ينبغي أن نتوقع حتى ممارسته الضغط للتوصل إلى مثل هذه التسوية، وما على السوريين إلا التحلي بالهدوء والصبر، وتحمّل البراميل المتفجرة.
يريد أوباما من هذه التصريحات أن يبرهن على أنه صادق مع نفسه، ولا يقبل أن يغشّ السوريين، أو يعطيهم وعوداً كاذبة لا يمكنه الوفاء بها. والحال أن الولايات المتحدة لم تكفّ عن الإخلال بوعودها والتزاماتها في السنوات الثلاث والنصف الماضية من عمر الثورة السورية، تجاه المعارضة وتجاه الشعب السوري وتجاه العالم وتجاه الضمير الإنساني، فقد كانت قد التزمت، قبل مؤتمر جنيف وبعده، تجاه المعارضة، بتغيير موازين القوى العسكرية على الأرض، لدفع الأسد إلى قبول التفاوض الجدي على تطبيق بيان جنيف، ولم تقدم شيئاً يذكر في هذا المجال. وها هي تقبل أن تستقيل نهائياً من الموضوع، وتترك الأمر للمبعوث الدولي، دي ميستورا، ليرتب مسائل الهُدن المحلية التي تكمل ما قامت به ميليشيات الدفاع الوطني السورية، لتفكيك المقاومة، وتقسيم صفوفها وعزلها عن بعض.
وأخلّت الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه الشعب السوري، عندما تركته فريسة للقنابل والصواريخ والمدفعية الثقيلة، على عكس ما كانت تفرضه عليها العهود الدولية التي وقّعت عليها من التزام بحماية الشعوب المعرّضة للمجازر، أو جرائم الإبادة الجماعية، وهو ما يحصل أمام أعين العالم أجمع في سورية، منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأخلّت بالتزاماتها تجاه العالم، عندما لحست الخط الأحمر الذي رسمته لاستخدام السلاح الكيماوي، في حملات قمع سياسية، وسجلت سابقة في تاريخ البشر السياسي، تتعلق بتطبيع استخدام السلاح الكيماوي، للقضاء على الاحتجاجات السياسية. وهي تخون، كل يوم، تعهداتها الدولية القانونية والسياسية، عندما تقبل الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء مذبحة يوميةٍ، تنقل صورها وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، من دون أن تحرك ساكناً، أو تتحرك لوقفها، بذرائع واهية لا تقوم على برهان. وهي تتحدى المنطق والضمير الإنساني، عندما يردد قادتها، كل يوم وفي كل مناسبة، أنه لا حل للمذابح الشنيعة التي يرتكبها الأسد وميليشياته إلا بقبول الضحية بتقبيل أيدي جلاديها، والجلوس معهم على طاولة مفاوضاتٍ، ليس هدفها تغيير النظام القاتل، وإنما مشاركته الحكم.
"
لم تكفّ الولايات المتحدة عن الإخلال بوعودها والتزاماتها في السنوات الثلاث والنصف الماضية من عمر الثورة السورية
"
في كل خطاباته وتصريحاته، حرص الرئيس الأميركي، في السنوات الثلاث والنصف الدموية الماضية، على تطمين الأسد وترطيب خواطره، والتأكيد له بأنه لن يكون هناك أي تدخل أميركي أو دولي، كما لو كان هدفه إطلاق يديه، وتشجيعه على الخروج عن كل قيد أو معيار أخلاقي، أو سياسي، في الفتك بشعبه وتدمير بلده. وحتى بعد تكرار الأسد استخدام السلاح الكيماوي، على الرغم من افتراض تدميره، تعامت الإدارة الأميركية عن كل الخروق، واكتفت بالتذكير بها في المناسبات. وتذرّعت بالخوف من سقوط الأسلحة في يد الإرهاب، لكي ترفض تقديم السلاح إلى المعارضة الديمقراطية، فكان لها الدور الأكبر في نمو القوى المتطرفة، وتحويل الإرهاب إلى القوة الرئيسية في سورية والمشرق كله. وأصرّت على أنه لا حل إلا سياسياً للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، فكانت النتيجة دعم خيار الأسد في الحسم العسكري، وتمديد أجل الصراع، وترك الأسد يحقق حلمه في الانتقام وتدمير البلاد، كما لم يحصل لبلد من قبل. وبدل الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، تم تقويضها من الداخل، قبل أن تحتلها الميليشيات الممولة والمسلحة والموجهة من طهران، كما تم تحويل جيشها نفسه إلى ميليشيات متنافسة ومتنازعة على نهب الأفراد والجماعات. ومع ذلك، وبعد كل ذلك، لا يكفّ الرئيس أوباما، بمناسبة ومن دون مناسبة، عن تذكيرنا بأنه لن يتدخل، ولا يقبل التدخل، ولا يؤمن بالتدخل، لثني الأسد عن جرائمه، أو ممارسة أي ضغط عسكري، أو سياسي، على مَن يقف وراءه، ويدعمه بالمال والسلاح والرجال. كان دائماً يضعه على المستوى نفسه من المسؤولية عن الحرب والدمار مع خصومه، وربما أصبح اليوم يفضّله عليهم.
لا يمكن أن يكون كل هذا التهاون مع الأسد نتيجة خطأ في الحسابات أو التقديرات، أو بسبب مخاوف مشروعة من التورط في حروب خارجية، قررت الإدارة الأميركية الخروج منها، أو ثمرة الخوف من الالتزام تجاه الشعب السوري وقضيته المعقدة، كما يقال. بالعكس، يبدو مع مرور الزمن أكثر فأكثر، أنه نتيجة التزام عميق، لكن ليس بدعم الشعب السوري، وإنما بعدم التعرّض للأسد مهما كان الحال. والسؤال يتعلق فقط بالجهة التي اتخذ الرئيس الأميركي تجاهها هذا الالتزام: هل هي إسرائيل أم إيران، أم كلاهما معاً؟ يقول المتنبي: وَمِن نَكَدِ الدُّنيا عَلى الحُرِّ أَن يَرى عَدُواً لَهُ ما مِن صَداقَتِهِ بُدُّ.
 ١٢ نوفمبر ٢٠١٤
١٢ نوفمبر ٢٠١٤
بين يدي الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قصة ملفتة وواضحة، لكنه لا يجيد تسويقها، ويعمد، كلما سنحت له الفرصة، إلى إضفاء مزيد من الغموض والتعقيد عليها، غير عابئ بنصيحة غابرييل غارسيا ماركيز للمبتدئين، أن يتمرّنوا على إضفاء مزيد من الوضوح على ما يريدون تسويقه، وليس مزيداً من الغموض والتعقيد.
هو يعرف، وقد عرف باكراً، أن "غزو العراق سيسعر لهيب الحرائق في الشرق الأوسط، ويشجع أسوأ الدوافع في العالم العربي، ويقوي ذراع مجندي القاعدة"، بحسب ما ذكر في كتابه "جرأة الأمل"، هو لا يريد أن يقر بما تنبأ به، كما لا يريد أن يلقي بالمسؤولية في ظهور "تنظيم الدولة" على سياسات أسلافه، وخصوصاً جورج بوش الذي زعم أن لديه تفويضا من السماء لغزو بلد آمن ومستقر، وارتكابه، وجنوده من "ذوي القبعات الزرق"، فظائع ترقى لأن تكون "جرائم حرب وإبادة"، وقد أثبتوا أنهم "داعشيون"، قبل أن يظهر "داعش". هو لا يريد، أيضاً، أن يتعلم من نصائح جيرانه اللاتينيين، ولا من تجربته في "البيت الأبيض" المليئة بالعثرات، وهو على وشك أن يخلفها وراءه، وفي نفسه شيء من حتى!
أوباما لم يستطع تسويق خطته للقضاء على داعش، على الرغم من أنه جيّش أكثر من ستين دولة، بصمت بأباهيمها على تحالف يخفي من الأسرار أكثر مما يعلن، وقد ظل مترددا في الكشف عن الأهداف السياسية لخطته، طرح أهدافاً غامضة، ألمَح إلى أنه لا يريد دوراً لإيران، ثم بعث رسالة "غزل" إلى خامنئي، يدعوه فيها إلى شراكة إيرانية-أميركية في مواجهة "داعش"، أرسل 300 عسكري إلى العراق، لتقديم المشورة والتدريب فقط، زاعما أنه لن يرسل قوات قتالية برية، لكنه زاد عدد جنوده إلى أكثر من ثلاثة آلاف، مزودين بمعدات ثقيلة ومتوسطة، وأسلحة مختلفة، ومعدات اتصال، ووحدات دعم لوجستي، ومروحيات قتالية وطائرات نقل، سيحتلون خمس قواعد رئيسية، قصفت طائراته مدناً عراقية، قتلت مدنيين وأحرقت بيوتا، وهجّرت عشرات الألوف، ولم يزل "داعش" حيا! أفشلت قواته خطة لداعش في السيطرة على مطار بغداد، بحسب أحد مساعديه، وآخر نفى الواقعة جملة وتفصيلاً، ثالث انتقد ضعف كفاءة القوات العسكرية العراقية، ورابع أشاد بانتصاراتها! البنتاغون قدر تكلفة الحرب بنحو ثمانية ملايين دولار يومياً، وستبلغ عدة أضعاف عند نشر قوات برية، وخبراء قالوا إن العرب الذين يؤدون دور "الكومبارس" سيدفعون الجزء الأكبر منها، كالعادة!
" البنتاغون قدر تكلفة الحرب بنحو ثمانية ملايين دولار يومياً، وستبلغ عدة أضعاف عند نشر قوات برية "
أنابت صحيفة "نيويورك تايمز" نفسها عن أوباما، وحدّدت هدف خطته بـ"كسر احتلال داعش مناطق في شمال العراق وغربه، والتأسيس لسيطرة حكومية على مدينة الموصل والمراكز السكانية الأخرى، فضلاً عن طرق البلاد الرئيسية، وحدودها مع سورية"، لاحظ "كسر" الاحتلال وليس إنهاءه، و"التأسيس" لسيطرةٍ، وليس ضمان السيطرة. وذكرت أن الخطة تتضمن أيضا "تشكيل قوة مهام خاصة، بقيادة الجنرال جيمس تيري الذي يشرف على القوات المسلحة الأميركية في الشرق الأوسط، من مقر قاعدته في الكويت، وسوف يكون له مقر ثانوي في بغداد، للإشراف على مئات المستشارين والمدربين الأميركيين"، و"سوف تمتد رقعة وجود القوات الأميركية من بغداد وأربيل إلى مناطق أخرى، لتشمل قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرباً، وإلى التاجي شمالي بغداد".
الأخطر، والأخطر يأتينا من أميركا دائماً، أن الخطة تبشرنا بأن "بعض جيوب المقاومة ستبقى"، و"الحرب ستكون طويلة"، وربما لعقود أخرى، وهذا يعني أن علينا أن نستسلم لحكم بالاحتلال المؤبد لبلداننا، وأن نسلم بالقبول بخارطة جديدة للمنطقة، تعطي للقياصرة الكبار ما يريدونه، ولا تترك لعباد الله سوى الفتات!
إنها أشبه بفيلم هوليودي طويل، يكون جاهزاً للعرض، بحسب الصحيفة، نهاية عام 2015، لإعادة العراق إلى المربع الأول الذي ألقي فيه في التاسع من أبريل/نيسان 2003، ولوضع العالم كله تحت مرمى النيران، وآنذاك، ربما يستعيد أوباما في قرارة نفسه وصيته "إذا أردنا أن نجعل أميركا أكثر أماناً وأمناً، فعلينا أن نساعد في جعل العالم أكثر أمنا وأمانا"، لكننا نخشى أن تكون فرصته في تطبيق وصيته قد ضاعت منه إلى الأبد!
آنذاك، أيضا، سوف نكون أمام سيناريو جديد، يصنعه خلف أوباما المنتظر الذي سيكون جمهورياً على أكثر التوقعات، وسوف نشاهد نحن كيف يتغير العالم حولنا، وسوف نضحك كثيراً لرؤية الدمى التي صنعت بطريقة فنية ذكية في مطابخ المخابرات، وهي تتهاوى أمامنا، لتحل محلها دمى جديدة، بمقاسات وميزات أكثر تطوراً، وهذا ما يجعلنا حذرين دائما، فليس كل من يضحك أخيراً، يضحك كثيراً!
 ١٢ نوفمبر ٢٠١٤
١٢ نوفمبر ٢٠١٤
نقلت وكالة أنباء النظام الأسدي عن بشار الأسد قوله إن اقتراح وسيط السلام الدولي ستيفان دي ميستورا لتنفيذ اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار تبدأ من مدينة حلب شمال سوريا، هي اقتراحات «جديرة بالدراسة، وبمحاولة العمل بها». فهل هذا تطور في موقف الأسد؟ يخطئ من يعتقد ذلك!
الحقائق تقول لنا إن الأسد، ومنذ بدء الثورة السورية، كان دائم التلاعب بكل مشروع يطرح، حيث كان يوافق على كل مبادرة أو مشروع يطرح لحل الأزمة، لكنه يباشر في تفريغ كل ما يطرح من محتواه تماما، ويضيع الوقت في التسويف والمماطلة، فلعبة الأسد الشهيرة، ومنذ خلف والده، هي إغراق الخصوم بالتفاصيل، وبالتالي وأد كل مشروع، ودون أن يقول لا، وإنما كان يجيد عملية الهروب إلى الأمام، تارة بالتصعيد، وتارة أخرى بتعقيد الملف. فعل الأسد ذلك بملف المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الراحل رفيق الحريري، وفعل الأمر نفسه تجاه المبادرة العربية بسوريا، بعد الثورة. وفعل نفس الأمر مع فريق المفتشين العرب، ثم تلاعب بالمبعوث الأممي كوفي أنان حتى استقال، والأمر نفسه فعله بحق المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي، ومارس الأسد كل ألاعيبه هذه بمؤتمري جنيف، الأول والثاني، فطوال حكم الأسد، وطوال الأزمة السورية، وحتى في عملية التخلص من أسلحته الكيماوية، كان الأسد يتلاعب، ويماطل، ويضيع الوقت دون الالتزام بشيء، عدا قصة الأسلحة الكيماوية والسبب في التزامه بهذا الملف واضح جدا وهو الضغط الروسي، وليس الأميركي، من أجل أن يسلم الأسد مخزونه من الأسلحة، وليس بمقدور أحد التأكد أصلا من أن الأسد قد قام بتسليم كل ما لديه من المخزون الكيماوي!
وعليه، فلماذا على المجتمع الدولي الآن، أو المنطقة، أن تصدق تصريح الأسد الأخير بأن مقترحات وسيط السلام الدولي ستيفان دي ميستورا لتنفيذ اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار تبدأ من حلب هي اقتراحات «جديرة بالدراسة، وبمحاولة العمل بها»؟ الحقيقة أنه لا شيء يدعم ما يقوله الأسد الآن عن جدارة المقترحات بالدراسة، فالأسد فاقد للمصداقية بكل امتياز، ولم يف، أو يلتزم، بأي وعد قطعه منذ خلف والده في حكم سوريا، فلماذا نصدقه الآن؟ المؤكد أن الأسد يحاول تفريغ مقترحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وكما فعل مع كل المبعوثين من قبله، وسيواصل الأسد، ومن خلفه إيران، وميليشيات الشبيح الكبير حسن نصر الله، قتل المزيد من السوريين، ولذا فإن لا شيء يرجح مصداقية الأسد، ومن يقف خلفه، خصوصا أن شعارهم واضح، ومنذ بدء الثورة، وهو: الأسد أو لا أحد!
وبالتالي فإن كل ما نسمعه الآن من الأسد حول مقترحات إيقاف إطلاق النار في حلب ما هو إلا مضيعة للوقت، فطالما أن لا جهد دوليا حقيقيا لإيقاف جرائم الأسد فإن كل هذه المقترحات التي نسمع عنها، وترحيب الأسد بها، ما هي إلا مضيعة للوقت، وإطالة لأمد الأزمة السورية.
 ١٢ نوفمبر ٢٠١٤
١٢ نوفمبر ٢٠١٤
على طريقة المعتصم بالله منح الخليفة المفترض ابو بكر البغدادي بعض الاكراد الذين بايعوه خليفة للاسلام والمسلمين حق الاقامة الدائمة في دولة الخلافة مع توفير حماية عبر جيش أوله في كوباني وآخره في كركوك.
حتى هذه اللحظة يحق للخليفة ما لا يحق لغيره لكن السؤال الذي تردد في ذهني يتعلق بمنسوب المنافع لهذا الجيش العظيم اذا ما قرر الامريكيون مثلا ارسال صاروخ عابر للابحار والمحيطات والانهار لاغتيال احد الاكراد الذين حظيوا رغم انفهم للحماية.
في عالم اليوم يغتال المرء بمعجون الاسنان كما حصل مع فيصل الحسيني في الكويت او بالخنق الصامت كما حصل في دبي او بقلم حبر جاف او حتى بزهرة كما نرى بالافلام الامريكية.
تكنولوجيا القتل اليوم لا تعترف بالمسافات ولا بطول الجيوش وعرضها فطائرات التحالف الامريكي ومعها شقيقاتها العربيات يمارسن التسلية في سماء العرب وهن ينتخبن اهدافا وهمية تقصف على انها داعشية.
معنى الكلام هو الاستغراب من ترديد معلبات لا تغني ولا تسمن ولا تحترم عقل الانسان خصوصا عندما تكون مفعمة بالغلاف الديني، الامر الذي يستهوي بالعادة البسطاء والسفهاء والسذج.
لا تستطيع قوات عربية او اسلامية بصرف النظر عن عددها او فكرتها تأمين حماية اي انسان من تكنولوجيا القتل الحديث فكيف سيضمن اصحاب دولة الخلافة للمرعوبين الاكراد اي حماية من اي نوع.
وفي الوقت الذي عرضت فيه هذه الحماية كانت الانباء تتوالى من بغداد عن وصول فريق الاغتيال الامريكي الذي قتل الشيخ اسامة بن لادن بعد مطاردة شهيرة لكي يتولى الشيخ ابو بكر البغدادي.
اشعر تماما باني امام حلقة جديدة من مسلسل امريكي ممل وطويل على النمط التركي اما نحن الرعاع فعلينا ان نصدق بان فريق الاغتيال الامريكي المتخصص الذي يحمل معدات خاصة في التعقب وتحديد الهوية من حرارة الجسم سيغرقنا في مطاردة جديدة لعدة اسابيع قبل ان يتحف الجميع برواية مفبركة جديدة لا يمكن تصديقها يغيب بعدها الشيخ البغدادي عن واجهة الحدث.
اغلب الظن والتقدير ان فريق الاغتيال الامريكي حضر على نفقة مشايخ دول الخليج ويبدو ان الاخوة من حكام بعض الدول الخليجية كبالع السكين تماما ففواتير التحالف تصلهم جميعا وبعدالة وبشكل مكثف وبعض السفراء اشتكوا لي شخصيا من ان دولهم تضطر للدفع بدون نقاش في عملية ابتزاز رخيصة للنظام الرسمي العربي المرعوب والمركوب بنفس الوقت.
تخويف الانظمة العربية من قوى التطرف والتشدد والارهاب يأتي كجزء ثان من المسلسل الامريكي ففي الحلقات الاولى من نفس المسلسل تمول فجأة هذه التنظيمات المتشددة وتحصل على سلاح امريكي ويتاح لها التمكن وتنسحب امامها جيوش وتملأ الدنيا ضجيجا لكي يرتعب المرعوبون على كراسي الحكم العربية فيأتي دور الجزء الثاني من المسلسل لاكمال السيناريو والحوار على اساس ان الخطر الارهابي سيطيح بمؤسسات الحكم العربية الرشيدة.
تجارة رابحة بكل الاحوال للتحالف السري لشركات صناعة الاسلحة الامريكية ولسماسرة البنتاغون وتجار الحروب الطائفية والجهوية والدينية في واشنطن اما الوقود فهم الابرياء سواء اختاروا الدخول الى الجنة عبر بوابة هذه الخلايا المتطرفة او من المدنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب الهوليودية.
العالقون وسط الانتاج الامريكي الهوليودي كثر .. شعوب باكملها تضطرب حياتها وتتعرقل مسيرتها وتفقد الاحساس بالمستقبل وتقف بدون حراك امام معضلة التنمية لان المنتج السينمائي الامريكي اختلق الوحش على حساب اموال هذه الشعوب واحضر فرقه العسكرية لمطاردة هذا الوحش فيما تمول اموال عربية العملية برمتها وهي بكل الاحوال اموال منهوبة ومسروقة من نفس الشعوب.
مازلت على قناعتي بان خيارات الاخوة الزعماء العرب بائسة وسقيمة فاقامة شكل من اشكال العدالة الاجتماعية في الحكم ستحقق لهم ثلاثة اهداف غير مكلفة حيث تعلي من شأنهم وتحترمهم شعوبهم ثم تحول دون البيئة الخصبة للتطرف وتعفي ذواتهم من ابشع عملية ابتزاز تمارسها القوة الامريكية الطاغية المتغطرسة.
لكن زعماءنا لا يريدون الحل الاسرع فثنائية الاستبداد والفساد هي التي تحكمهم رغم ان قوانين الرياضيات والفيزياء تبلغ الجميع بان اعلان الحرب على بعض الفاسدين المتكرشين من الخدم والحشم والوسطاء والرعايا كلفتها المالية بسيطة جدا قياسا بالفواتير التي تدفع للامريكيين وغيرهم تحت عنوان حماية تلك الطبقات الفاسدة.
كنت افضل ان يقتصر الفساد في عالمنا العربي على الرمز القائد وعائلته لكن تحول هذا الفساد الى ثقافة سائدة تنتج يوميا عشرات الفاسدين وتنتهي بمراكز قوى نافذة اقوى حتى من الزعيم نفسه.
لو منع الزعماء العرب بعض السرقات وانفقوا على هوامش الفقر في المجتمعات العربية قليلا لما ظهر التطرف اصلا ولتحققت العدالة ولو نسبيا و لما احتجنا لدولة خلافة لا تعترف بالرأي الاخر وبالنتيجة لما احتجنا الكابوي الامريكي الذي حضر لبغداد بحثا عن رأس الخليفة.
 ١١ نوفمبر ٢٠١٤
١١ نوفمبر ٢٠١٤
حين يتعلق الأمر بالملف العراقي، من الصعب على المراقب أن يلمس الكثير من الفرق بين مواقف المحافظين في إيران وبين الإصلاحيين، فالعراق يمثل خاصرة إيرانية، والمعركة فيه مهما شرّقت وغرّبت لن تغير في حقيقة الوضع الديمغرافي الذي يمنح الشيعة أغلبية نسبية إذا تذكرنا أن الأكراد يعيشون ما يشبه الاستقلال، وإن ظلوا إلى الآن ضمن إطار الدولة العراقية.
من يتابع تصريحات روحاني أو جواد ظريف فيما يتعلق بالسياق العراقي لا يراها تختلف كثيرا عن تصريحات المحافظين، لكن الموقف يبدو مختلفا في السياق السوري، إذ يتبدى الخلاف بشكل واضح. ونتذكر في هذا السياق تصريحات الرمز الأكبر للتيار الإصلاحي (رفسنجاني) التي أطلقها العام الماضي، وحمّلت بشار الأسد المسؤولية عما جرى في سوريا.
حين كنا نتحدث عن هذا البعد، كان البعض يرفض ذلك مصرا على أنه لا خلاف بين الفريقين حيال الملف السوري، لكن وليد المعلم، وزير خارجية النظام السوري ما لبث أن كشف المستور في مقابلته قبل أيام مع صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله.
حين سئل المعلم عن العلاقة مع إيران قال إن «أي مساس بهذا التحالف في إيران غير مقبول من قبل الإمام الخامنئي ونهجه. العراقيل الممكنة هي التي تأتي من جهة النهج الليبرالي. وفي كل مرة يحصل فيها ذلك، يحسمها الإمام ومجلس الشعب والحرس الثوري لصالح سوريا». وأضاف «زوّدتنا إيران، وتزوّدنا، باحتياجاتنا من السلاح، خصوصا من الذخائر المتوفرة من صناعة إيرانية؛ كذلك، تدعمنا طهران سياسيا واقتصاديا وماليا». وردا على سؤال الصحيفة حول ما إذا كان يعتبر «المحافظين المتدينين هم أقرب الحلفاء لسوريا العلمانية؟»، رد المعلم «بالطبع، لأنهم يدركون المصالح الاستراتيجية الإيرانية، وهم متحررون من الميول نحو الغرب».
في الكلام الآنف الذكر تصريح لا لبس فيه بشأن الخلاف بين المحافظين والإصلاحيين فيما خصَّ الملف السوري، والأهم من ذلك أن الخلاف يسبب ضيقا للنظام السوري، وثمة خشية من أن يؤدي إلى تغيير الموقف.
هذا الكلام الصريح اضطر حسن أمير عبداللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي يبدو أقرب إلى المحافظين منه إلى الإصلاحيين (لا يُستبعد أن يكون مفروضا من المرشد على روحاني)، اضطره إلى إطلاق تصريح في ذات اليوم الذي نشرت فيه المقابلة يقول فيه إنه لا خلاف بين القيادات العليا في إيران حيال «دعم سوريا في مواجهة الإرهاب».
وإذا جئنا نفتش عن أسباب الخلاف، فإن الأمر يتعلق ابتداءً وانتهاءً بعموم السياسة الإيرانية الخارجية، وحيث يرى الإصلاحيون أن المعارك الخارجية كانت ولا تزال مكلفة، هم الذين يدركون أن الناخب الإيراني إنما لجأ إليهم من أجل الاهتمام بالملف الداخلي (الاقتصادي على وجه التحديد)، ويتذكر الجميع كيف هتف الإصلاحيون في انتخابات 2009 في الشوارع: «لا غزة ولا لبنان، كلنا فداء إيران».
على أن الإصلاحيين يبدون أكثر إدراكا لعبثية المعركة السورية؛ إذ مهما وضعت إيران من ثقل فيها، فلن يحالفها النجاح على الأرجح، ولن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، كما يدركون كم تستنزف تلك المعركة من مقدرات إيران، وحيث تدفع عمليا كلفتها كاملة، لأن أحدا لا يساعدها على هذا الصعيد (روسيا تبيع ولا تساعد بالمجان).
بقي القول إن الخلاف المذكور لن يغير في السياسة الإيرانية حيال سوريا، لأن المرشد يحسمها كما قال المعلم، لكن تطور المشهد السياسي الداخلي، ونجاح مفاوضات النووي في تأمين صفقة مع الغرب، ربما سيمنح الإصلاحيين قوة أكبر تمكنهم من التدخل بشكل أكثر وضوحا في السياسة الخارجية، ولعل ذلك هو ما يدفع المحافظين؛ ليس إلى التشدد في مفاوضات النووي وحسب، بل أيضا إلى المضي في البرنامج الخارجي بروحية التمدد، لأن الخسارة ستعزز فرص الإصلاحيين داخليا، وبالطبع بعد تأكيدها لنظريتهم حول عبثية مشروع التمدد وأولوية الملف الداخلي.
 ١١ نوفمبر ٢٠١٤
١١ نوفمبر ٢٠١٤
الرئيس الأميركي باراك أوباما متحمس لبدء تاريخ جديد مع إيران، وإعادة العلاقة الجيدة مع طهران التي كانت حليفا مهما في عهد الشاه حتى سقوطه. ولهذا يلتقي الأميركيون والأوروبيون مع الوفد الإيراني في العاصمة العمانية في سباق زمني للتوصل إلى حل لطموح النظام الإيراني النووي.
ولنا، في منطقة الشرق الأوسط، مع هذه المفاوضات إشكالات جدية؛ أولها السرية! فقد تعمدت إدارة أوباما التكتم على اتصالاتها مع طهران ومفاوضاتها، حتى عن حلفائها الإقليميين. وهو أسلوب يخالف نهج الولايات المتحدة في اتصالاتها، مثل مفاوضاتها مع كوريا الشمالية؛ حيث شاركت الدول المعنية في المنطقة الأسرار والقرار، فأدخلت الغرفة كوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وروسيا، مع وفد الولايات المتحدة. أما في مفاوضاتها مع إيران فقد أغلقت الباب في وجه دول حليفة ومعنية مباشرة، مثل مجموعة دول الخليج، وتركيا، ومصر، وكذلك إسرائيل.
وثانيها أن ما صدر عن الإدارة الأميركية من تطمينات بعدم تقديم تنازلات اتضح أكثر من مرة عدم صحته، وكان آخرها تنازلها عن موقفها بألا يسمح بأكثر من 500 جهاز طرد لنجد أنها قبلت بـ1500. إضافة إلى سلسلة تنازلات قدمتها واشنطن في مجال المقاطعة والأموال المجمدة.
وثالثها ما تحدث به الإيرانيون عن مطالبهم بأن يسمح لهم بمد نفوذهم في المنطقة.
ومع أن واشنطن تنكر أنها ستقبل بمثل تلك الشروط، فإن في المنطقة تشككا في أن تترك إيران حرة تخرب المنطقة، بأكثر مما تفعل حاليا. والذي يعزز هذه الشكوك المواقف الأميركية التي تميل لصالح إيران في العراق وسوريا، وآخرها تصريحات الرئيس أوباما حول سوريا؛ فقد تعهد أوباما بمحاربة تنظيم داعش رافضا عقاب النظام السوري الذي هو مصدر الأزمة، وقد أفنى أكثر من ربع مليون إنسان، وشرد أكثر من 8 ملايين سوري.
ورابعها المشروع النووي نفسه. فالولايات المتحدة يبدو أنها تراجعت عن تعهداتها المتكررة السابقة، بمنع النظام الإيراني من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، وهذا سيتسبب في تغيير ميزان القوى في المنطقة بشكل خطير جدا. نحن ندرك، مثلما يدرك الغربيون، حقيقة أن إيران ليست في حاجة إلى الطاقة النووية لتلبية حاجاتها من الطاقة، فهي الدولة الرابعة في العالم في احتياطات مؤكدة من البترول، تسبق العراق والكويت والإمارات. فلماذا تنفق مبالغ هائلة على الطاقة النووية، وهي تستطيع إنتاج البترول بتكلفة رخيصة جدا؟ السبب، إيران تسعى لبناء سلاح نووي، ودولة بمثل هذا التفكير، والإصرار، تعني أنها ذات نوايا عدوانية خطيرة.
وإذا رضخ المفاوضون في مسقط للسماح لإيران بحق الاستمرار في مشروعها النووي، فإننا نكون بذلك قد دخلنا عهدا خطيرا جدا. سيعني اختلال ميزان القوة الإقليمية، مما سيضطر دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية وتركيا ومصر، إلى البحث عن وسيلة لبناء قوة ردع نووية موازية لإيران. وهذا سيجعل منطقة الشرق الأوسط التي تهدد العالم بـ«داعش» و«القاعدة» أكثر خطرا على العالم، بـ5 دول نووية، بينها إيران وإسرائيل. لماذا أوباما حريص جدا على إبرام اتفاق مع إيران؟ لا يوجد سبب معقول. لقد شاهدنا كيف أن العقوبات الأميركية نجحت جزئيا في إرهاق النظام، وأوصلته إلى مرحلة التفكير بأن مشروعه النووي قد يعرض كل النظام للانهيار لاحقا. إلا أن الكوة، التي فتحتها إدارة أوباما للنظام في طهران، دفعت الأميركيين، وليس الإيرانيين، لتقديم المزيد من التنازلات مقابل وعود من نظام خامنئي، في مجملها لا توقف المشروع النووي، بل تبطئ من سرعة تنفيذه فقط. وعندما ننتقد المفاوضات، فليس لأننا نرفض أن تتوصل الدول الغربية إلى اتفاق ينهي الأزمة مع إيران، بل إن أي اتفاق يروض التفكير السياسي الإيراني العدواني، وينزع سلاحها النووي، هو في صالح المنطقة كلها، لكننا لا نعتقد أن الاتفاق المطروح حقا يقلّم السلاح النووي، ولا يردع التفكير الفوضوي الذي تمارسه طهران بلا توقف منذ الثمانينات. والذي يجعلنا نشك هو أن الأميركيين غيّبوا دول المنطقة عن المفاوضات، وتبادلوا إرسال رسائل سرية، كما فضح أمرها الإسرائيليون، بأنه تم تبادلها مع المرشد الإيراني شخصيا. وفي الوقت نفسه، نحن نرى كيف تتبنى واشنطن مواقف منحازة لإيران في سوريا والعراق!
مفاوضات مسقط توحي بأن الاتفاق بات قريبا؛ بحيث يسابق الموعد النهائي المضروب في هذا الشهر، والذي إن تم قد يغير تاريخ المنطقة.
 ١١ نوفمبر ٢٠١٤
١١ نوفمبر ٢٠١٤
ألم يستوعب حزب الله بعد، وإيران من خلفه، أن تدخلهما في سوريا سيكونان وبالا عليهما وسيدخلان اللبنانيين ودولتهم والمنطقة في فوضى أمنية وهجمات انتقامية كان لها أول ولا أظن أن لها نهاية في القـريب المنظور.
ألا يرى الحزب، وكل جهة تدخلت طائفيا في سوريا، أن الدم حين يُزهق دون سبب سيكون نارا ولعنة على كل من أهدره؟ أين هي مخابرات حزب الله التي كان يفتخر باكتشافها لخلايا التجسس الإسرائيلية، وأين هي شبكة اتصالاته التي كاد أن يدخل لبنان في حرب أهلية بسببها؟ هل ما زالت على قوتها، أم أن حربها السورية قد استهلكتها، وهل ما زال الحزب يملك من القوة على الساحة اللبنانية ليفرض العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية في ظل تشتته بين الشأن الداخلي والسوري؟
حزب الله وكل من تدخل ضد ثورة الشعب السوري سيدفع الثمن، وسيعلم الذين ظلموا كيف أدخلهم نظام طهران في خندق مظلم أوله نور وآخره هلاكٌ لهم، ولن تكون الخسائر اليومية لمقاتليهم على الصعيد البشري وحدها من سيخلخل الإجماع الشعبي حوله، بل التكلفة المالية للحرب والتي ستقلل من تدفق الأموال التي كان الحزب يستخدمها في الإنفاق على برامجه الاجتماعية والتنموية، وعملت على الدوام على التفاف الجموع الفقيرة حوله، وهي التي تشكل أغلب أتباعه.
القتيل والمشرد والمصاب السوري الطامح منذ أكثر من ثلاث سنوات للحرية سينتقم لنفسه بقدر ما يستطيع ومتى ما سنحت له الفرصة، وبقدر ما يراه هدفا مشروعا له، واستهدافه لأهداف لبنانية وإيرانية أو تابعة لها هي رسالته لطهران، التي يريد أن يخبرها من خلاله أن سياستها في تصدير ثورتها التي تدعي إسلاميتها، ستحرقها أيضا، ولن تنفعها قنبلتها النووية، التي تسعى لها، في حمايتها من كل الشعوب التي عانت من تدخلاتها وظلمها وتجبرها عليها.
سوريا التي كانت دوما أولى الوجهات السياحية المفضلة للعرب باتت الآن دولة مدمرة، تخيم عليها أجواء القتل وتزكم الأنوف روائح البراميل التي تلقيها مروحيات النظام في كل يوم، حاصدة العشرات من الأرواح البريئة، بدعم عسكري لم يعد خفياً، والهدف منه هو الإبقاء على نظام حزب البعث في الحكم، حتى لو كان سبيل ذلك دماء السوريين، الذين لن ينسوا، أبدا، تدخل حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية والحرس الثوري الإيـراني في قتالهم إلى جانب النظام ودعمهم له وهو الذي كان آيلا للسقوط بيد قوات المعارضة المسلحة.
آجلا أو عاجلا ستنتقل الحرب، وما يتبعها من إرهاب ودمار وخراب واقتتال وتفجيرات واغتيالات، من سوريا لتستهدف جميع الأطراف التي تدخلت في الشأن السوري وسينقل السوريون ثأرهم للداخل اللبناني، وسيعي حينها مؤيدو الحزب ومن تخاذل عن ردعه حجم الضرر الناتج عن ذلك، ولن تجدي نفعا عملية ينفذها مقاتلوه تجاه إسرائيل في استعادة شعبيته التي ضحك بها على العامة سابقا، ولن تعيد له مكانته “البروباغندا الثورية” التي يريد أن يثبت من خلالها أنه ما زال نصير المقاومة، رغم أنه لم يتجاوب مع حماس في حرب غزة الأخيرة ورفض طلبها قصف إسرائيل، فهو لم يتلقّ التعليمات من طهران لذلك، وهو الذي يتبع لها بالولاء عقيدة وأيديولوجيا حسب البيان التأسيسي للحزب الذي ينص على: “الالتزام بأوامر قيادة حكيمة متمثلة بالولي الفقيه، وتتجسد بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الإمام الخميني”.
فرض حل للأزمة السورية ليس بالأمر المستحيل، بل من الممكن وبسهولة إن حصل الإجماع الدولي على ذلك، ولكن بالطبع ليس على غرار مفاوضات جنيف واحد وإثنين، التي وجد النظام فيها وسيلة للمناورة والعبث وتسويق سيناريو الإرهاب الذي لا يُصدق، وإنما عبر قرارات أممية ملزمة ووفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومع فرض حظر جوي وعزل السلطة الحاكمة وتسليم السلطة لحكومة انتقالية، تقوم على إعادة اللحمة الوطنية وتأسيس جيش وطني لا عقائدي، وسحب السلاح من الجميع، ومحاكمة ثورية للوردات الحرب، وتأسيس للعدالة الانتقالية على غرار ما فعلت أول حكومة سوداء في جنوب أفريقيا عقب تسلمها للسلطة من البيض. حينها وإن حصل، سيكون لنا حديث آخر، لكن الآن، وعلى ما يبدو، بعد أن دخلت “داعش” على خط الأزمة، فسيبقى الحال للأسف على ما هو عليه، وستبقى الأزمة السورية نارٌ تحرق، وطائفية تفرّق، ومفرخة للإرهاب الذي يصفه كلٌ حسب تفسيره ورؤياه.
 ١١ نوفمبر ٢٠١٤
١١ نوفمبر ٢٠١٤
يبدو، بحسب جريدة «الأخبار» اللبنانية، أن حركة «حماس» تتجه إلى إحداث تغيير كبير يطاول ميثاقها الشهير الذي اعتُمد في 1987. ففي موازاة تصاعد العدوانية والاستفزاز الإسرائيليين المصحوبين باندفاعة جديدة للاستيطان، وفيما التصدع يضرب من جديد علاقات «فتح» و»حماس»، تناقش الأخيرة مراجعة هذا الميثاق الذي لم يُراجع منذ نشأته قبل أكثر من ربع قرن. وهذا علماً بأن الزمن الفاصل عن 1987 شهد تحولات هائلة الضخامة فلسطينياً وعربياً ودولياً، كما سجل تحولات لا تقل ضخامةً طرأت على الأفكار والمعاني، سلباً وإيجاباً على السواء. فالميثاق ينطوي على فقرات تحرم «ما يُسمى الحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية»، وهو ما يتعارض مع «عقيدة حركة المقاومة الإسلامية». فوق هذا، يضج الميثاق بأحكام وعبارات لاسامية، بالغة الابتذال والعنصرية، هي أقرب إلى ترجمات رديئة عن أدبيات اللاسامية المسيحية في أوروبا. وكثيراً ما استُخدمت تلك العبارات لتهميش القضية الفلسطينية نفسها، وليس «حماس» وحدها، وحشرها في خانة عنصرية لا تدعو إلا للتنصل.
وهذا التحول إذا ما أُنجز حقاً سيكون عرضة لنقد مفاده أن الحركة الإسلامية الفلسطينية تتنازل للغرب، وربما لإسرائيل أيضاً، من أجل أن تنضوي في عملية تسووية ما. ذاك أن الغرب وإسرائيل يقولان ما قد تتجه المراجعة الحمساوية، مباشرةً أو مداورةً، إلى قوله.
والنقد ذاته قد يهب، ولو اختلف النقاد، في مواجهة القرار الشجاع الذي نسبه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى سلطات المناطق الكردية في سورية. فالأخيرة، بحسب «المرصد»، أصدرت مرسوماً يضمن للنساء حقوق الرجال ذاتها في المجالات جميعاً، بما فيها الإرث. والمساواة هذه إنما تشمل أيضاً حق العمل والأجر والشهادة أمام المحاكم. كذلك يقضي المرسوم إياه بمنع تعدد الزيجات أو تزويج الفتاة قبل بلوغها الثامنة عشرة من دون رضاها. وقد جُرم القتل بذريعة الشرف واعتُبر العنف والتمييز ضد المرأة جريمة يعاقب عليها القانون. وإلى هذا أكد المرسوم على «منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة، وذلك لثلاث ولادات».
صحيح أن مرسوماً بالغ الثورية والتقدم كهذا قد ينطوي على بُعد دعائي وتسويقي يستهدف الخارج، وأنه قد لا يكون المرآة الأصلح لقراءة واقع العلاقات الأهلية للأكراد واستعداداته. مع ذلك فإن خطوة كتلك تفتح الباب أمام آفاق أوسع للأكراد وللمنطقة، كما تُثمر نصاً تأسيسياً يسبغ الشرعية على الإنجازات الموعودة فيما تجعل كل محاولة لتجاهلها أو للنكوص عنها لاحقاً أصعب وأعقد.
نعم، سوف يتقاطع ما قد تقوله «حماس» وما تقوله القيادة الكردية في سورية مع ما يراه الغرب. لكنْ ليس من الضروري، ولا من المفيد، أن نقول إن الأرض مسطحة كلما قال الغرب إنها مستديرة. وهذا إلحاح يضاعفه اليوم ما يهب علينا من ثقافة «داعش» و»النصرة» وأضرابهما، ومن الاحتمالات المتاحة لتوسع هذه الثقافة الرديئة. ورداً على ذلك، فإن ما قد يوصف بأنه «تنازلات» لا يُقدم للغرب، بل يقدم للحقيقة، ولحجز موقع لنا في معاصرة عصرنا، ناهيك عن فوائد سياسية، للفلسطينيين وللأكراد، لا يرقى إليها الشك.
 ١٠ نوفمبر ٢٠١٤
١٠ نوفمبر ٢٠١٤
كنا كيساريين علمانيين ...نصدق علمانية (الأقليات ) ونعتبرهم أقدر على اليسارية والعلمنة، بسبب أنهم لا يملكون تاريخا فقهيا رسميا مؤسساتيا كثيفا ومكتظا بالفتاوى والتفاسيركالمذهب الإسلامي (السني ) الحاكم الأكثري عبر اربعة عشر قرنا الذي ربما شكل عائقا أمام الانخراط في الحداثة...
ومن ثم المذهب (الشيعي ) الأقرب كمدونة وترسيمة فقهيا للمذهب السني رغم أنه الاقل عداء سياسيا عن الآخرين ... لكنه الأكثر حضورا وقوة عددية من الأقليات الإسلامية ، الذي تم تأسيسه بوصفه ردا معارضا على المذهب الرسمي الأكثري السني ...
النخبة العلوية (ومنهم جد آل اسد ) في توقيعها على الوثيقة الداعية إلى بقائهم تحت الاستعمار الفرنسي ، تحدثت عن نفسها كطائفة مستقلة عن (المسلمين )، وشبهت نفسها بالمظلومية ( اليهودية ) ، أي بأنها طائفة مضطهدة كاليهود في فلسطين الذين يتعرضون لإرهاب المسلمين الفلسطنيين على حد تعبير الوثيقة ..
كنا من منظور وطني سوري نرفض النظر إلى الطائفة العلوية بوصفها طائفة (غير مسلمة )، وربما من هذا المنظور الوطني لنظام الاستقلال السوري ، تم إعدام (سلمان المرشد ) عندما ادعى الربوبية ( الرب سليمان )، وذلك دفاعا عن إسلامية الطائفة العلوية ، التي كانت نخبها تعاني أزمة هوية بين سوريا العربية المسلمة، وبين البقاء في ظل الاستعمار الفرنسي ...
ولربما أن النخبة الوطنية السورية، كانت تضمر تأييدا لانتصار التيار البعثي العروبي من خلال (حافظ الأسد ) الذي أظهر خياره مع القومية العربية على خياره (القومي السوري ) من جهة، ومن جهة اخرى، كان يعلن ويظهر انتسابه إلى ( سوريا : عربية كانت أم سورية "إسلامية" حتى ولو في حدود الهوية الحضارية غير الدينية !!! ) ...وهي ذات التجربة القلقة مع الهوية السورية، التي يعيشها معهم اليوم فصيل (البي كيكي ) الكردي ( العلوي التركي) من خلال علاقته التحالفية العضوية الطائفية مع الأسدية ..
.لقد رفضنا كوطنيين سوريين- قبل الثورة أم بعدها - الأطروحة الانكليزية الشهيرة التي تتحدث عن أن لا جامع ( فكريا أو دينيا أو مذهبيا ) بين العلويين كطائفة سوى (عدائهم وكرههم للمسلمين السنة ) ...!!!
رفضنا هذا التوجه الانكليزي، كوطنيين يساريين عرب أو مسلمين، وذلك قبل أن تتكشف لنا الباطنية الأسدية عن كل هذا الكره الاستثنائي نحو العرب والمسلمين، مما لم نعرفه منذ زمن المغول مرورا بالعهد الاستعماري الأوربي الفرنسي ، وصولا إلى زمن السيطرة والهيمنة الإسرائيلية على العرب والمسلمين والفلسطينيين اليوم ...
هذا التمويه الطائفي الذي يتخفى تارة وراء ( ربوبية المرشد )، أو وراء توقيع النخب العلوية (بما فيها الأسدية بالبقاء تحت الاستعمار الفرنسي ) ،الذي يؤكد صدقية نظرية الانكليز، بأن ما يجمع العلويين، هو الكره لسوريا ووحتها ووحدة شعبها، هذه الوحدة الوطنية السورية التي تآلفت عليها كل القوى الوطنية الديموقراطية الثورية ...تحت شعار (واحد واحد الشعب السوري واحد )، في ثورة الحرية والكرامة لسوريا وللسوريين ، والتساوي المواطني بين جميع الديانات والمذاهب والمكونات السورية الدينية والمذهبية ...
هذه الفلسفة الانكليزية في احتواء العلويين منذ إعداد الأسد الأب (كعميل )، وابنه المعتوه للاستيلاء على سوريا، فإنه يعاد انتاجها العصري اليوم (انكليزيا وامريكيا وإسرائيليا) ، تحت تسمية العلوية، بأنها ( مذهب فلسفي )، لكن عماده كره المسلمين والوطنية للسوريين الوطنيين الداعين لوحدة سوريا كشعب وكوطن ..
وقد بدأ الإعلان عن هذه التسمية (الطائفية الفلسفية) تحت يافطة يسارية علوية منذ شهور، يحمل صاحبها شهادات السجن من جماعة (حزب العمل الشيوعي !!!) بل ورئاسة حقوق الإنسان، حيث كان رئيسها في يوم ما...
والأطرف ما في الأمر أن كل الطوائف الأقلية الإسلامية الباطنية ( الدروز والاسماعيلية ...الخ )، تحمل بعض أمشاج الفلسفة العرفانية الغنوصية الأفلاطونية المحدثة تاريخيا إلا العلويين... الذين تقوم عقيدتهم (الفلسفية" على فكرة (تأليه علي ) ، وعلى أن الله قد "حل في علي" ، وانه يقيم في القمر، وأن الرعد صوته، والسحاب وجهه وتجليات وجهه ...وغير ذلك من الخرافات البدائية الفانتازية الممتعة تخييليلا، رغم فقرها الحسي البدائي الجبلي بالخيال الإبداعي إذا ما قورنت بالفانتازيا اليونانية .!!..
الطائفة العلوية هي أفقر الطوائف السورية بالفلسفة المادية والميتافيزيقية، وأغزرها بالشعر الغنائي (الأنوي) لاتصاله بعالم الغريزة حسب أرسطو، إن أن الشعر (الغنائي الأنوي غير الدرامي) حسب أرسطو، هو الألصق بعالم الحس والغريزة والأشياء المغللة بالسحر والغرابة والشذوذ، حيث بدأت به (المحاكاة اليونانية ) الحسية البدائية قبل نشأة (محاكاة الدراما) ،وقد وكان معادل الشعر الغنائي المعبر عن اندفاعات الذات العاجزة عن المعرفة العقلانية الفلسفية للعالم، هي التي اعتبرها ارسطو عبر طه حسين: المعادلة سياسيا تاريخيا للنظام السياسي الاستبدادي الطغياني ...
وربما هذا ما يفسر لنا الهستيريا السنوية الإعلامية العلوية الطقسية نحو أدونيس، إذ يريدون للعلوية أن يكون لها مفكر ولو واحد في تاريخها الرعاعي القناني ...حيث لم يعرف التاريخ الإنساني إلا الفلاسفة الأحرار ...فالرعاع والأقنان لا ينتجون فلاسفة ومفكرين ...
مهما حاول العلويون أن يضعوا كل دعمهم الاعلامي الأمني الأسدي ...في خدمة مواهبهم الفكرية والفلسفية وأمالهم الحداثية، بين يدي شاعر (غنوصي)، لم يستطع يوما الانفكاك عن عالم الحس البدائي، لكي يعتبروه الساحر الذي يملك كل أسرار العلوم والمعارف التي تؤهله لنيل جائزة (نوبل )...
وكبير سحرهم هذا (أدونيس) لم يتناقض يوما في (شعبذاته وطلاسمه) الشعرية التي يظنونها فلسفة : شعرا ونثرا مع النظام الميليشي التشبيحي الأسدي حتى في ذبح الأطفال... وفق ترسيمة أرسطو عن البدائية الشعرية التي لم ترتق للفلسفة قط، كما يتوهم بعض العلويين المكلفين بالمعارضة والانشقاق وقيادة حقوق الانسان، وتأسيس (علوية فلسفية ميلودرامية ) لتفسير الطقوس الأسدية بالذبح والقتل والتدمير والإبادة والإرهاب والجريمة كفلسفة ممنهجة ..ولعل المثل المعرفي والفكري الأكثر تمثيلا لهذه الفلسفة العلوية : "فيلثوفها المتحذلق " الثأثاء الأسدي سليل (الفلثفة) الخنزيرية الأسدية السفاحة
 ١٠ نوفمبر ٢٠١٤
١٠ نوفمبر ٢٠١٤
عرضت محطات التلفاز وشبكات التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً لشاب لبناني يحمل سكيناً، يهدد به أطفالاً يرتجفون هلعاً، وهو يسألهم بالتتابع، والسكين تقترب من حنجرة كل منهم: هل أنت داعش؟ ومن تريد أن يكون أول من يذبح؟ فيما بعد، علمنا أن أم الأطفال تركتهم في عهدة الشاب، ريثما تعود من السوق، وأن كل طفل رد على سؤال حامل السكين، متوسلاً أن لا يكون أول المذبوحين.
هل نحن "داعش"؟ هل السوريون جميعهم "داعش"؟ ألسنا متهمين بـ"داعش"، مع أنها لم تنشأ عندنا، ودخلت بلادنا عنوة واقتداراً، ومن دون إذن منا، وكنا أكثر ضحاياها عدداً، ولم تقاتل أحداً كما قاتلتنا، ولم تقدم لنا أية خدمة غير إخراج الجيش السوري الحر والمقاومة من مناطق كانا قد طردا النظام منها، لكننا، وعلى الرغم من ذلك، متهمون بأننا "دواعش"، لمجرد أننا سوريون!
لماذا يعتقد لبنانيون كثر أننا "دواعش"، بدءاً بالشاب، الذي زعم أنه كان يمازح الصغار، وصولاً إلى حزب الله، الذي لا يمازحنا أبداً، وقطاع كبير من لبنان الشعبي والرسمي كان قد استقبل لاجئينا بالتعاطف عند قدومهم إلى لبنان، ثم بدأت الشكوك تساوره حول ما إذا كانوا إرهابيين أو مشاريع إرهابيين، قبل أن تتحول تهمتهم إرهابيين إلى واقعة مثبتة، جعلت شاباً غير مسيس، لا يجد وسيلة لـ"ممازحة" سوريين صغار غير تهديدهم بالذبح، لأنهم ليسوا فقط من "داعش"، بل هم "داعش" نفسها؟ وهل اعتقد هذا الغرّ أن ذبح أطفال سوريين يعني ذبح "داعش"؟ ألهذا الحد، صار السوري يتماهى مع الإرهاب والإرهابيين، حتى وهو طفل صغير؟
لا أعرف إن كان في الأمر تضخيم للأمور، لكنني أعلم أن صورتنا، كسوريين، تعرضت لتشويه خطيرٍ، لأسبابٍ بينها سرعة تحول ثورة قمنا بها، طلباً للحرية، إلى اقتتال متعسكر/ مطيف وممذهب، والسهولة التي تم بها هذا التحول، الذي لم يلق ما كان يستحقه من مقاومة شعبية ووطنية، وعلى يد هيئات وجهات ومجالس وائتلافات وأحزاب وشخصيات غير أصولية، لطالما ادعت تمثيل الثورة ومعاداة الإرهاب، واعتقدت أن كل من ليس أسدياً وحمل بندقية هو مع الشعب وحريته، حتى إن تبنّى أيديولوجية مذهبية ورؤى تكفيرية، وأعلن عداءه الصارخ للحرية والديمقراطية ولدولة ومجتمع سورية. بدل أن يصارع "ممثلو" الشعب هؤلاء، وخصوصاً منهم رجال الدين الإسلامي، التيار التكفيري/ الأصولي عقائدياً وإعلامياً، وينبهوا إلى تعارض خياراته مع الإسلام ورهانات الثورة، ويشرحوا للشعب تناقض ما يدعو إليه مع عقيدة الحرية عميقة الجذور في روح المؤمن، وما ينبثق عنها من قيم ومعايير، مغايرة جذرياً لقيم الأصولية ومعاييرها، لفلفوا القصة، وقفزوا عن الخيارات المتناقضة، التي يفضي التياران إليها، والأوضاع المتعارضة التي ستترتب عليهما، بحجة الحرص على وحدة من يقاتلون الأسد، والخوف من إضعاف "الثورة"، مع أن المذهبيين كانوا يعلنون رفضهم إياها في كل كلمة يقولونها، ويلاحقون أتباعها، ويجتثون حاضنتها المجتمعية في جميع المناطق التي سيطروا عليها.
"
ألهذا الحد صار السوري يتماهى مع الإرهاب والإرهابيين، حتى وهو طفل صغير؟
"
بسبب تقصير الهيئات الدينية الرسمية والشعبية، وجمهور السياسيين والمثقفين، ودفاع بعض قادة المعارضة عن الأصولية، ورفضهم طرح قضيتها على بساط النقد، ترسخ الانطباع بأن الثورة لم تكن غير ما قاله بشار الأسد: مجرد غطاء لأصولية استغلت شعارات الربيع العربي، كالحرية والعدالة والمساواة، كي تفقس في حاضنة مجتمعية واسعة، قبل أن تسفر عن هويتها الحقيقية، وتأكل غطاءها، وتقتل أو ترعب أنصار الحرية الحقيقيين. بسبب هذا التطور، صار من المشروع أن نطرح سؤالاً مليئاً بالدلالات المفزعة: "ألسنا حقا داعش"؟
يقول بعض متابعي الشأن العام إن قرابة ثلث السوريين يؤيدون "داعش"، ويسوغون فظائعها. ويقول تحليل دولي معتمد في أميركا والغرب وقطاعات واسعة من العالم الإسلامي إن "داعش" هي التعبير السياسي والعسكري عن رفض أهل السنة إقصاءهم عن الحكم والسلطة، والرد على التنكيل، الذي تعرضوا له في نصف قرن، وخصوصاً في العراق وسورية، حيث ظهرت ونمَتْ بسرعة. ويضيف التحليل إن "داعشيتنا" ليست فقط مشكلة محلية، بل دولية أيضاً. لذا، كان من الضروري أن يأتي ردنا واضحاً وقاطعاً عليها، كي لا نجد أنفسنا، ذات يوم، متهمين دولياً بما هو أكثر من قبولنا إياها بصمت، ومعاقبين على ما ليس منا، ولسنا منه، خصوصاً وأن قصة "داعش" تكتسب أبعاداً نرى بدايتها، ولا نعرف نهاياتها.
إذا كنا لا نريد حقاً أن نكون "داعش"، لا يكفي من بدء الحرب ضدها فصاعداً أن ننكر انتسابنا إليها ومعارضتنا إياها. ولا بد من أن نبادر إلى القيام بخطواتٍ، تتجاوز مجال علاقاتنا المباشرة معها أو ضدها، وأن نطور رؤية واستراتيجية تقنعان العالم بأننا نعمل ما علينا لتحصين أوضاعنا، ووضعه ضد الإرهاب، ونعمل لدحره في مكامنه المجتمعية ومنابعه الايديولوجية: المذهبية القديمة المرتبطة بالحراك الأصولي، والحديثة المرتبطة بنظم "تقدمية" و"ممانعة" و"ثورية" و"علمانية" تقتل الناس بالجملة، ولا تقل إرهابا بأية حال عن أية اصولية إرهابية، إن لم تكن أكثر إجراماً منها بكثير، أبرزها وأخطرها النظام السوري.
هل نحن، كقوى سياسية وعسكرية، وكائتلاف ومجلس وطني ومعارضة، في وارد عمل كهذا؟ هل نحن، إذا لم نكن كذلك، إذن، "دواعش"، وسنظل ننتج الداعشية، التي ما سكتنا عليها، وتعاطف كثيرون منا معها، إلا لأنها تعبر عنا وعنهم، مهما حاولنا نفي ذلك وإنكاره!