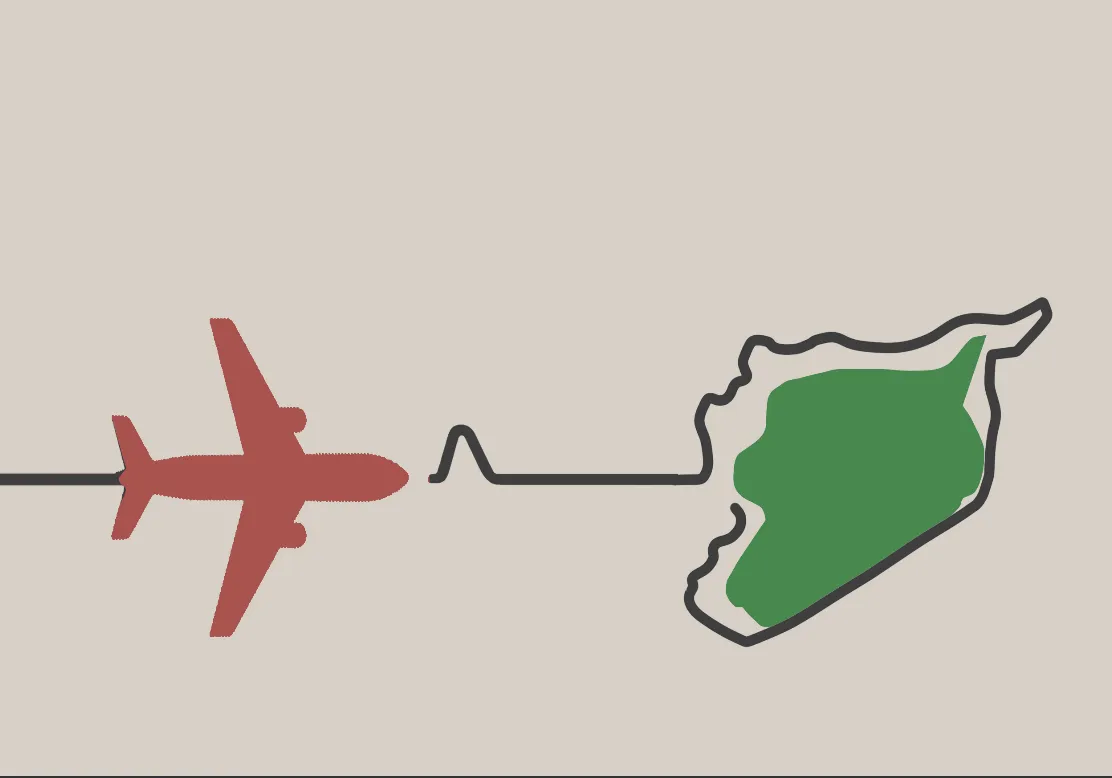١٦ نوفمبر ٢٠١٤
١٦ نوفمبر ٢٠١٤
حين أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن «جبهة النصرة ليست منظمة إرهابية»، اعتقد البعض أن الأمر لا يتعدى لحظة المزاج السيئ الذي كان يشعر به القائد السابق للحركة الوطنية اللبنانية في ذلك الوقت، حتى وصل الأمر إلى اتهامه بمحاولة إنقاذ أو حماية طائفته من أتون الحرب السورية التي باتت نيرانها تهدد البيت اللبناني بشكل جدي، نتيجة لمشاركة «حزب الله» بفعالية أكثر في تأجيج هذه الحرب.
وكلام جنبلاط، وما تبعه من جولات في العرقوب (20 أيلول 2014) وحاصبيا وشبعا، جاء ليؤكد أن استشعاره للخطر كان في محله حول منطقة العرقوب التي تقع في جنوب لبنان وتضم قرى شبعا، كفر شوبا، الهبارية، كفر حمام وراشيا الفخار وتعتبر إحدى المناطق ذات الأغلبية السنية في جنوب لبنان إلى جانب قرى حاصبيا ذات الأغلبية الدرزية.
إذن المنطقة تتمتع بموزاييك طائفي مثالي، إلى جانب التنوع السياسي الذي ورثته من خلال كونها مركز ثقل المقاومة الفلسطينية، ومنها انطلقت الحركة الوطنية، والمقاومة الوطنية اللبنانية سابقا.
أما الآن فقد تغيرت الخارطة الجيوسياسية للمنطقة، واختلفت الأدوار، فحزب الله هو القوة المهيمنة على امتداد الجنوب اللبناني، تشاركه بعض الأحزاب الموالية للنظام السوري كالحزب الديموقراطي والحزب السوري القومي الاجتماعي.
وفي الجهة المقابلة في الجولان والقنيطرة، الجبهة التي كانت تنعم بالهدوء والاستقرار طوال فترة سيطرة النظام السوري عليها أصبحت الآن في كنف جبهة «النصرة» والجيش الحر، ومقاتلي المعارضة، إلى جانب إسرائيل التي تراقب عن كثب ما يجري.
وحزب الله بدوره يراقب إنما بحذر أكبر، فهذه الجبهة تختلف عن شقيقتها في عرسال، والنظام السوري لا يملك فيها أي قوات تذكر، وطيران النظام يفقد فعاليته أمام «الخطوط الحمر» التي قد تضعها إسرائيل في تلك المنطقة في حال كبر حجم المواجهات.
وللنظام السوري بدوره أساليبه، فبعد انهزام قواته في تلك الجبهة عمد إلى الزجّ بالطائفة الدرزية السورية في المنطقة، في مواجهة مع جبهة النصرة وقوات المعارضة في عدد من البلدات في جبل الشيخ من الجانب السوري مما ترك أثرا في قرى حاصبيا والعرقوب وصولا إلى العمق الدرزي في جبل لبنان، ولا سيما بعد سقوط 27 مقاتلا وعشرات الجرحى من الدروز السوريين.
بالطبع هناك بعض الدروز اللبنانيين الموالين للنظام السوري من خلال قيادتهم التي ارتبطت بهذا النظام في زمن الوصاية، وهم أقلية بالنسبة إلى النسيج الدرزي الوطني الواسع، قد تغريهم إعادة اعتبارهم من قبل النظام السوري، من خلال البحث عن ثقب يخرجون عبره مجدداً إلى المشهد السياسي في لبنان.
والزعيم الدرزي وليد جنبلاط يعرف حقا تكاليف الحرب، والأثمان الباهظة التي يمكن أن يدفعها أي طرف درزي يحاول الوقوف مع النظام ضد الثورة في سوريا. ومن هنا تأتي ثوابت موقفه السياسي تجاه الحدث السوري ووقوفه إلى جانب الثورة وإيمانه المطلق بحتمية انتصارها.
وحين يدعو جنبلاط دروز سوريا إلى تحديد موقفهم من الثورة السورية: «لقد آن الأوان لاتخاذ القرار الجريء بالخروج من عباءة النظام الآيل إلى السقوط عاجلاً أم آجلاً والالتحاق بالثورة التي من الأساس رفعت شعارات الحرية والكرامة والتغيير وهي شعارات محقة ومشروعة لكل أبناء الشعب السوري”.
هو يدرك أيّ منزلق قد يودي بطائفته على امتداد سوريا ولبنان، وهو يدرك أيضاً أن النظام السوري مازال يراهن على الأقليات في سوريا ولبنان والدفع بها نحو حربه المجنونة، وضرب كل أشكال التعايش بين طوائف المنطقة .
كان جنبلاط واضحاً في كلامه المكتوب بافتتاحية جريدة “الأنباء” الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو كلام لم يقله نتيجة ردة فعل سياسية على موقف ما. فالكلام يلزم صاحبه في محطة تاريخية يدرك جنبلاط أهميتها تجاه الثورة السورية، ففي لبنان من يعتقد أو استشهد من أجل فكرة أنه لا مستقبل للبنان، بما يمكن أن يشكله من تعايش في ظل وجود النظام السوري الحالي .
وبالتأكيد لن يكون دروز سوريا وفلسطين ولبنان، الطائفة الثانية التي قد تحمل البندقية في مواجهة حركة التغيير في سوريا. وما حدث في جبل الشيخ والعرقوب، ليس سوى «بروفة» لاستحداث جبهة جديدة قد تشكل إغراءً لـ«حزب الله» في تأمين المزيد من الغطاء الميداني لوجوده على الأراضي السورية تحت شعار محاربة “العدو الإسرائيلي”.
في حين أن وحدات من «حزب الله» تعمل في البقاعين الشمالي والغربي، على «تجنيد» شبان مسيحيين ومسلمين سنة ودروز، وتعرض عليهم التدريب والتسليح لمواجهة خطر «داعش» وأخواتها. والعنوان المرفوع «مصيرنا واحد وعلينا التصدي معا». وهو شعار يعتقدون أنه أكثر جاذبية من التصدي للعدو الإسرائيلي. ولا يقتصر الأمر على لبنان، ففي سوريا أيضا تجنيد لمسيحيين وعلويين ودروز، لكن تسمية «سرايا المقاومة» تغيب. هناك تطوع مباشر مع الحرس الثوري الإيراني برواتب شهرية تتراوح بين 1500 و2500 دولار.
أمام هذا البذخ الهائل من النظام الإيراني، والتجييش المتصاعد للأقليات بقيادة «حزب الله»، تحت مسميات عديدة، هل يمكن لكلام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن يجد طريقه إلى «العقلاء» من أبناء الطائفة الدرزية، والسير بحتمية التاريخ، أن الطغاة سيسقطون عاجلاً أم آجلاً.
 ١٦ نوفمبر ٢٠١٤
١٦ نوفمبر ٢٠١٤
بعد مرحلة طويلة من المعاناة مع خيار قومي أخضع بعض الشعب العربي لحكومات مارست عليه ضروباً شتى من الاضطهاد والعسف، ندخل، اليوم، إلى مرحلة من المعاناة مع خيار مذهبي/ طائفي، يشترك مع النزعة القومية التي عرفناها، خلال نيّفٍ ونصف قرن، في نقطتين رئيستين هما: أدلجته التي تجعله يرى الواقع، عبرها وبدلالتها، وعداؤه للإنسان ككائن يتعرّف بحريته ورفضه المواطنة، كحاضنة سياسية للدولة والمجتمع، وتصميمه على إخضاع مجتمعاتنا لسطوة شموليةٍ، يشرف عليها حركيون معصومون، لا يأتيهم الباطل، يعني رفضها عصيان أمر قدسي، وتمرداً عاقبته القتل.
تأتي هذه المرحلة عقب طورٍ عانى العرب، في أثنائه، الأمرّين في معظم بلدانهم، أنتجه وسوّغه أيديولوجياً مفهوم أمة مجردة وضد تاريخية، كتلية لا تعرف أي تراتب بنيوي وعمق إنساني، تعرض المحكومون بسببه لسطوة نظام مذهبي الهوية، فرز الشعب إلى أخيار وأشرار، وشن حرباً منظمة ضده، أدت في سورية، آخر بلدانه، إلى هلاك جسدي وروحي طاول ملايين المواطنين الذين قتلوا بحجة الدفاع عن قومية هولوكوستية، عجزت عن مواجهة أي عدو غير شعبها الذي صادرت إرادته وغيّبته عن الشأن العام، لكي تبرر ما مارسته عليه من إجرام منظم ودائم.
بالتشابه العميق بين هاتين المدرستين المذهبيتين والمؤدلجتين، النافيتين للحرية والإنسان، وبإفشال مشروع الحرية، الذي قدمه الشعب نفسه وقدم أغلى التضحيات في سبيله، يكون من الطبيعي أن يحل محل النظام القومي بديل من جنسه، وإن حمل اسماً آخر، وعبّر عن نفسه بواسطة مفردات مختلفة، تكثر من الحديث عن المقدس، كأن رئيس النظام القومي لم يكن مقدساً، أو لم يمارس أعمالاً جرمية ضد مواطنيه، وإنْ بأدواتٍ مغايرةٍ لأدوات قادة التيار المذهبي/ الوثني الديني الكلام الذي يبطش بالسكاكين بمن قتلهم صنوه القومي بالبراميل المتفجرة والصواريخ المجنحة والسلاح الكيميائي.
بنفي الإنسان وحقوقه وهيمنة أيديولوجيا معصومة، يعاد إنتاج الواقع، أو تصحيحه في ضوئها، وبدلالتها بما هي معيار الخير ضد الشر، نكون أمام انفجار من حلقتين متماسكتين: أنضجت القومية منهما كل ما كان ضرورياً، لتمزيق أواصر العرب، ولتدمير مجتمعاتهم ودولهم، وها هي المذهبية/ الوثنية تحصد بسكاكينها أعناق الذين نجوا من قذائف صبّها عليهم خلال قرابة أربعة أعوام جيش "قومي"، رفض البديل الديمقراطي الحر الذي طالبوا به، وقاموا بالثورة من أجله، وفضّل أن يجعلهم أصوليين يكرهون الحرية، ويرفضون حكم الدستور والقانون، من الأفضل له أن يصيروا وثنيين بلا هوية فردية أو حقوق.
انفجر العالم العربي، وتفتت أطرافه، وانهار مركزه بالتلازم مع صعود وانهيار رهان قوميٍّ، استأثر خلال نصف قرن باهتمام وحراك قطاعات شعبية ونخب سياسية وازنة. وها هو الرهان المذهبي/ الوثني اللابس لبوس الدين يحقنه بعصبياتٍ تدمر وجود الإنسان نفسه، يجسدها عبر ممارساتٍ، إن نجح في تعميمها بقوة سلطته المفرطة الأدلجة، أوقع العرب في هاويةٍ، لن يخرجوا منها في زمن منظور، هي نهاية الإنسان العاقل والصانع، منتج مفردات الحضارة البشرية والتقدم الإنساني الذي سيخلي مكانه لوحش "داعش" الذي سيقضي على كل شيء أبدعه خلال الخمسين قرناً المنصرمة من تاريخ البشرية.
لم يعد المشروع الديمقراطي/ الوطني، الإنساني/المدني، القائم على الحرية والعدالة، مجرد شأن سياسي. غدا، بالأحرى، مطلباً وجودياً وإنقاذياً للشعب والأمة، ما دام استمرار المشروع القومي في نسخته الأسدية يقتلنا، وانتصار صنوه وبديله الوثني يعد بالإجهاز التام علينا: جماعات وأفراداً.
 ١٦ نوفمبر ٢٠١٤
١٦ نوفمبر ٢٠١٤
يبدو أن لعبة الشطرنج التي تجري، منذ سنة، بين الولايات المتحدة وإيران، على رقعة الشرق الأوسط، راحت تزداد تعقيداً مع قرب انتهاء الوقت المحدد للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني في 24 نوفمبر/تشرين أول المقبل، جراء مجموعة عناصر استجدت، في مقدمها الظهور "المفاجئ" لتنظيم داعش الذي تمدد من سورية، ليجتاح شمال العراق، ويتحول إلى "بعبع" للمنطقة بأكملها، ويضع أيضاً الطرفين، أي واشنطن وطهران، في مواجهته، أقله في المعلن.
ومن الواضح أن المفاوضات لم تعد تدور حول النووي فقط، أو بالأحرى، يتم التفاوض عمليّاً حول كل شيء، من العراق إلى سورية ولبنان، ومن الثورات إلى الأنظمة وثوراتها المضادة، ومن المصالح والنفوذ في هذه الدول، ودور الدول المحيطة والمؤثرة، إلى "داعش" بيت القصيد، وخالط كل الأوراق والحسابات.
انطلقت المفاوضات في 24 نوفمبر/تشرين ثاني 2013، من إطار عام، يقضي أن توافق إيران على التزامات طويلة المدى، تتعلق بتقليص برنامجها النووي، في مقابل رفع متدرج للعقوبات المفروضة عليها. بمعنى آخر، تلتزم إيران تعاقديّاً التزاماً طويل المدى، في مقابل أن يستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، صلاحياته الرئاسية لتقليص العقوبات الاقتصادية الحادة المفروضة على إيران، وأن يستأذن الكونغرس في إلغاء قانون العقوبات على إيران، بحلول نهاية عام 2016.
ولهذا الغرض، باشرت إيران، بعد انتخاباتها الرئاسية، العام الماضي، التفاوضَ حول ملفها النووي مجدداً، وأفلحت في إبرام "اتفاق إطار" مع مجموعة (5 + 1)، أي الولايات المتحدة، فرنسا، انكلترا، روسيا والصين + ألمانيا، مدته ستة أشهر، إلا أنه بسبب الفجوة الكبيرة التي استمرت تفصل مواقف الأطراف، ورغبة الجميع في استمرار التفاوض، فقد تم تمديد المهلة ستة أشهر إضافية، إفساحاً في المجال للتوصل إلى اتفاق نهائي. وستنتهي هذه المهلة الإضافية، بعد نحو عشرة أيام، ولا يزال الاتفاق بعيد المنال.
إن النووي قبل "داعش" ليس كما بعده! فواشنطن وطهران تقفان عمليّاً، اليوم، في خندق واحد، في مواجهة هذا الوحش، كل من موقعه وحساباته المختلفة. فقد عمل نظام الملالي، في البداية، على تغذية ظاهرة "داعش" التي أطلقها حليفهم وربيبهم، بشار الأسد، في سورية، ثم مهد الطريق لـ"داعش"، لكي يغزو العراق عبر ربيبه الآخر، نوري المالكي، من أجل أن تتحول الثورة إلى إرهاب واقتتال سني-سني. في الوقت عينه، سعت الإدارة الأميركية إلى استغلال الظاهرة الآخذة في التمدد، وتوظيفها في أكثر من اتجاه، بهدف ابتزاز الخصوم والحلفاء على السواء. حاولت التعويض عن تخاذلها وإطلاق الوعود الكاذبة تجاه (إسقاط) النظام السوري، وكذلك تجاه دعم المعارضة السلمية، ثم المقاتلة، على الأرض.
" عمل نظام الملالي، في البداية، على تغذية ظاهرة "داعش" التي أطلقها حليفهم وربيبهم، بشار الأسد، في سورية "
فكان أن "انقلب السحر على الساحر"، وتحول "داعش" إلى وحش دموي كاسر، يتهدد الجميع، وفرض نفسه بقوة على طاولة المفاوضات النووية. فقرر أوباما التدخل عسكريّاً، عبر الغارات الجوية التي تشنها قوى التحالف، منذ أكثر من شهرين على "داعش" في العراق وسورية على السواء. رفضت إيران المشاركة، على الرغم من صراخها وإعلانها، هي وحلفاؤها بشار في سورية و"حزب الله" في لبنان، والمليشيات الشيعية في العراق، الحرب على الإرهابيين والتكفيريين. كيف لها أن تشارك في المعركة إلى جانب من تصوره لجماهير "المستضعفين" على أنه "الشيطان الأكبر"، ومنبع "الاستكبار العالمي"؟ وأين لها أن تجد بعدها الخصم الذي يعبئ به علي خامنئي ملايين الإيرانيين، أو حسن نصرالله، حشود الممانعين الشيعة في لبنان... علماً أن الأسد عرض خدماته على "الشيطان الأكبر" أوباما من أجل التعاون والتنسيق في مقاتلة "الإرهابيين"، على الرغم من عدم تصديه، ولو بغارة واحدة، على "داعش".
في المقابل، يعكف مستشارو البيت الأبيض، في الأيام الأخيرة، على وضع استراتيجية جديدة، بعدما تبين للرئيس الأميركي أن لا جدوى من الغارات الجوية فوق الرمال المتحركة، وأن القضاء على "داعش" يفترض التحرك، أيضاً، باتجاه إسقاط نظام الأسد. وهذا يعني إعادة خلط الأوراق مجدداً باتجاه مزيد من التعقيد والتوتر، وربما التفجير في أكثر من ساحة، إلا أن اللافت في هذا المجال هو دخول روسيا على الخط، عبر تسريب ديبلوماسيتها معلومات عن استعدادها التخلي عن الأسد في مقابل تشكيل حكومة انتقالية، تضم المعارضة المعتدلة، وبعض القريبين من النظام، شرط الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش. فهل هذا يعني أن موسكو باتت مقتنعة أن استمرار الرهان على بشار أصبح رهاناً فاشلاً، وأنه مازال يقف على قدميه فقط بفعل الدعم العسكري الإيراني والمليشيات اللبنانية والعراقية التابعة لطهران؟ وبالتالي، من الأفضل ملاقاة واشنطن في منتصف الطريق للحفاظ على موطئ قدم على شرق المتوسط.
هذه التطورات المتسارعة وضعت نظام الملالي، المتمرس في التفاوض، والمعروف بنفسه الطويل في "حياكة السجاد"، أمام اختبار لا يحسد عليه. واشنطن تمارس ضغوطها عبر الملف النووي، وموسكو تترك فجأة طهران الحليفة في منتصف الطريق. والخيار هو بين الملف النووي وبقاء بشار الأسد في السلطة، أي بين ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة عن نظامها وشعبها أيضاً، والحفاظ على نفوذها ومطامعها التوسعية على ضفاف المتوسط بعد أن امتدت أذرعها إلى معظم الدول العربية!
قد يتم ربما في اللحظة الأخيرة إيجاد حل مؤقت للنووي، عبر التمديد للمفاوضات، لكي تبقى العصا مرفوعة في وجه طهران، ولكن، كيف يمكن لها أن توفق بين القضاء على "داعش" وبقاء الأسد.
 ١٦ نوفمبر ٢٠١٤
١٦ نوفمبر ٢٠١٤
بين آخر الأخبار المتعلقة بنزيف النخبة السورية ودمارها، كان خبر مقتل 4 من الخبراء السوريين في مركز البحوث العلمية القريب من دمشق إلى جانب خامس كان معهم قيل إنه إيراني الجنسية، وبغض النظر عن التفاصيل الملتبسة، التي أحيط بها مقتل الخبراء العاملين في أهم وأخطر مؤسسة علمية في سوريا، فإن مقتلهم يمثل حدثا جديدا في ظاهرة نمت واستشرت منذ بدء الأحداث السورية، هي ظاهرة نزيف ودمار النخبة السورية في مسار حرب بدأها النظام ضد السوريين، قبل أن تشارك فيها أطراف محلية وأخرى إقليمية ودولية من مواقع مختلفة ولغايات وأهداف متباينة.
بدأ المسار العام للظاهرة مع خروج السوريين للمطالبة بالحرية متظاهرين ومحتجين، وكان من الطبيعي، أن ينضم إلى المتظاهرين والمحتجين رموز من النخبة السورية في تكويناتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها، وكغيرهم من المحتجين والمتظاهرين، تعرضوا إلى قمع النظام قتلا وجرحا واعتقالا وملاحقة، وهو اختصار للنهج الذي سار عليه النظام وما زال في التعامل مع الحراك السلمي والمدني الذي أطلقته ثورة السوريين، وتحولاتها إلى العمل المسلح.
وتطورت مشاركة قطاعات النخبة في الفعاليات المناهضة للنظام مع تطورات الأزمة السورية وصولا إلى الصراع المسلح، فكانت فعاليات الإغاثة ومساعدة المتأثرين بحملات النظام العسكرية والأمنية في تشريد السكان وتدمير مناطقهم السكنية، فنشأت أنشطة الدعم الإنساني في مجالات الغذاء وتأمين السكن للمشردين، ثم امتدت الأنشطة في مساعدات طبية ودوائية لمواجهة ظروف الجرحى والمرضى في مناطق العمليات الأمنية والعسكرية وحولها، وتزامنا مع تلك الأنشطة، كان نشاط المحامين والحقوقيين الذي تزايدت مهماتهم في الدفاع عن المعتقلين والبحث عن المختفين قسرا لمعرفة مصيرهم، وارتبط ذلك كله بالحاجة إلى أنشطة إعلامية ساهم فيها أفراد وجماعات، أرست أشكالا مختلفة من نشاطات إعلامية دعاوية عبر مؤسسات غير رسمية، ولدت في خضم تطورات الحدث السوري.
ولم يكن بالإمكان القيام بهذه الأنشطة دون توفير إمكانات مادية ومالية، الأمر الذي تطلب دخول بعض الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية لجمع التبرعات المالية والعينية لمعالجة أوضاع السوريين وخصوصا ضحايا قمع النظام ومساعدتهم في التغلب على ظروف حياتهم الجديدة، فنشأت شبكات جمع التبرعات وتوزيعها في الأنحاء السورية المختلفة.
وكما هو واضح من تلك الأنشطة، فقد تطلبت الحالة انخراط مجموعات مختلفة من النخبة السورية، التي لا شك أنها انقسمت بين قوة، انتمت إلى ثورة السوريين، وقلة وقفت إلى جانب النظام أو وضعت نفسها خارج معادلة الصراع، وإن كانت أقرب إلى موقف النظام وسط موقف الحياد.
إن آلافا من شخصيات النخبة السورية انخرطوا في فعاليات الثورة، أو أعلنوا الوقوف إلى جانبها، مما وضعهم في مسارات حياتية ومهنية وعملية مختلفة عما كانت عليه أوضاعهم قبل الثورة. بعضهم اعتقل أو اختفى دون معرفة مصيره، وهذا ما أصاب أطباء ومحامين وفنانين ورجال أعمال من اعتقال وقتل تحت التعذيب وخطف بسبب أنشطتهم ومواقفهم.
ولم تكن ممارسات النظام وميليشياته بما فيها عناصر «حزب الله» اللبناني والميليشيات العراقية وحدها التي ألحقت القتل والجرح والاختفاء القسري، بل امتد ذلك إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، التي وجدت فيها التشكيلات المسلحة للمعارضة، وفي المناطق التي سيطرت عليها قوى التطرف والإرهاب من أخوات «القاعدة» أمثال تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، حيث قتل وجرح واختفى مئات من رموز النخبة الذين عارضوا نظام الأسد أو مواقف القوى والجماعات المسلحة وخصوصا المتطرفة.
وباستثناء هذا النسق من استنزاف وتدمير النخبة السورية، فإن تطورات الوضع السوري فتحت نسقا آخر لا يقل خطرا على مصير النخبة من سابقه. فاندفع مئات آلاف من كل الاختصاصات بما فيها الاختصاصات النادرة وبينهم أساتذة في الجامعات وأطباء ومحامون ومهندسون ورجال مال وأعمال وكتاب وسياسيون وصحافيون وغيرهم لمغادرة البلاد، بسبب الملاحقة الأمنية أو طلبا للعمل وللسلامة ورغبة بالخروج من حمام الدم المتزايد الانتشار، فأصبحوا لاجئين ومقيمين في دول الجوار وفي الأبعد منها، وسط ظروف صعبة وغير إنسانية.
لقد خسرت سوريا في 3 سنوات ونصف، قسما كبيرا من نخبتها في المجالات المختلفة، وباستثناء الأثر الإنساني الذي لن يمحى بما فيه من آلام ومعاناة شديدة، فإن الأثر المادي كبير أيضا، وستحتاج سوريا إلى عقود من السنوات حتى تعوض ما فقدته من قدرات النخبة، ليس ممن قتلوا وجرحوا واعتقلوا أو اختفوا قسرا، بل أيضا بالنسبة لمن ذهبوا في لجوء مؤقت أو دائم ولا أحد يعرف إذا كانوا سيعودون في المستقبل أم لا؟
 ١٦ نوفمبر ٢٠١٤
١٦ نوفمبر ٢٠١٤
كان من المتوقع أن يظهر بشار الأسد على شاشة المحكمة الدولية التي تتواصل جلساتها في هولندا لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري. لكن أن يكون هذا الظهور من خلال هاتفه المباشر من ضمن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ جريمة 14 شباط 2005، كما ورد في تغطية الزميل فارس خشان في "المستقبل"، ينطوي على مفاجأة مدوّية. وإذا استغرب أحد هذه الواقعة وشكّك فيها فهناك ما يماثلها في القضية نفسها عندما كشف التحقيق الدولي في الجريمة ان محمود عبد العال، وهو من جمعية "الأحباش" المعروفة، اتصل من هاتفه الخليوي قبل دقائق من ساعة وقوع الجريمة بالهاتف الخليوي لرئيس الجمهورية في حينه إميل لحود. ولا داعي للتذكير بأن حصول فرد من المجموعة المتهمة باغتيال الحريري أو أكثر على الرقم الشخصي للأسد مثلما كان حال عبد العال مع هاتف لحود يدلان على أن رئيس النظام السوري وزميله اللبناني كانا حريصَين جداً على تتبّع وقائع الجريمة مع منفّذيها أو المشاركين فيها، ولو كان هؤلاء في مرتبة دنيا مقارنة بمرتبتيْ رئيسيْ جمهوريتي لبنان وسوريا. وسيكون فهم الجميع كافياً لكي يسقط من الاحتمالات أن يكون المشتبه فيهم في الجريمة من أصدقاء الأسد ولحود لتحصل بينهم جميعاً أحاديث ودّية ليس بينها اغتيال الحريري!
يأتي هذا التطور المثير حول الهاتف الخليوي للأسد فيما كانت الزميلة "السفير" ولا تزال تنشر فصولاً من كتاب النائب في كتلة "حزب الله" حسن فضل الله والذي يُغطي مرحلة اغتيال الحريري وحرب العام 2006. وما نُشر من فصول يدلّ على ان "حزب الله" لا يكترث لاغتيال الحريري بل يهتمّ فقط في إظهار سعي الحريري الى إزاحة الرئيس نبيه بري من منصب رئاسة مجلس النواب كما حاول أيضاً لاحقاً نجل الحريري الرئيس سعد الحريري. لم يحرّك هذا الأمر ساكناً في أوساط الرئيس بري الذي كان حتى يوم أمس على تواصل مع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة ومدير مكتب الحريري السيد نادر الحريري. وفي الفصول المنشورة حتى إعداد المقال حشد من الاتهامات لحكومة الرئيس السنيورة في فترة حرب تموز عام 2006 وكذلك لقوى 14 آذار بالتواطؤ لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية ونزع سلاح المقاومة. ومثل هذه الاتهامات التي تستأهل أشد الإدانة للرئيس السنيورة وفريق 14 آذار، تحتاج فقط إلى أدلّة لم تكن موجودة إطلاقاً كحال رواية المؤلف حول سعي الرئيس رفيق الحريري وبعده الرئيس سعد الحريري إلى إزاحة الرئيس بري من موقع رئاسة البرلمان والتي لم يُسند إليها أي إثبات. في هذه الحال يمكن القول إن الكتاب يمثّل حالة بائسة ليست هي الأولى من حالات بؤس وقعت في روايات الحزب في مسائل عدة يطول تعدادها. وحبّذا لو كانت لفضل الله أدوات "ويكيليكس" الشهيرة التي زلزلت العالم طويلاً. وفي أضعف الإيمان لو أعاد قراءة البرقيات حول بري وعدد من أعوانه وما قالوه في "حزب الله" لهانت عنده ما قاله مالك في الخمرة.
 ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
١٥ نوفمبر ٢٠١٤
ثمّة رأي واسع منتشر اليوم في عديد من البلدان العربيّة، مستقياً حججه من الإحباط الراهن، ومن نشأة «داعش» و»النصرة» وأضرابهما. مفاد هذا الرأي أنّ قيام الثورات العربيّة، وخصوصاً منها السوريّة الأعلى كلفة والأكثر تعقيداً، هو ما أفضى إلى تلك الظاهرات الكارثيّة وإلى ما ترتّب وقد يترتّب عليها.
وهذا رأيٌ أسوأ كثيراً، في التحليل كما في النوايا الكامنة تحته، من الرأي المضادّ له الذي يحصر أسباب «داعش» و»النصرة» بالأنظمة القمعيّة التي قامت الثورات لإطاحتها. ذاك أنّ الرأي الأخير يقع في جوهرانيّة سياسيّة تختصر كلّ شيء في «النظام»، وربّما في امتداداته إلى «أنظمة» إقليميّة أو دوليّة فحسب، بينما الرأي الأوّل يجمع بين الجوهرانيّة الثقافيّة في إطلالها على الاحتمال العنصريّ وانتهازيّة الغرْف من الأمر الواقع، ما دام أنّه «ليس في الإمكان أحسن ممّا كان». وهذا ناهيك عن التزكية لـ»طبيعة إنسانيّة» شديدة التحمّل وذات سقف بالغ الانخفاض.
واقع الأمر أنّ ردّ الوضع البشع الراهن إلى فشل الثورات يبقى أقرب إلى الحقيقة من ردّه إلى قيام الثورات. صحيح أنّ نجاح الأخيرة ليس بذاته الدواء السحريّ المرتجى في ظلّ الافتقارات المعروفة إلى الإجماعات الوطنيّة وإلى البدائل السياسيّة والتنظيميّة، وهي افتقارات فاقمتها أوضاع إقليميّة ودوليّة شديدة الرداءة. أمّا ردّ وضع كهذا إلى اندلاع الثورات فيغفل عن حقائق عدّة في عدادها أنّ الأنظمة المعنيّة كان من الصعب جدّاً أن تستمرّ، لأنّ الموت أحد أكبر احتمالاتها، وذلك بغضّ النظر عن آرائنا ومواقفنا منها. لكنْ قبل هذا، سيكون عارياً من الأخلاق مَن يقول للسوريّ أن يقبل بنظام نشأ في 1963 وصار وراثيّاً في 1970، حارماً شعبه، عقداً بعد عقد، الخبز والحرّيّة والكرامة الإنسانيّة في وقت واحد. والشيء نفسه يصحّ، ولو بأقدار من التفاوت، في سائر البلدان التي خضّتها ثورات «الربيع العربيّ». فهناك خلف هذه الواجهة الكلاميّة مطالبة للكائن الإنسانيّ بأن ينزع إنسانيّته، وأن يقبل، راضياً مرضيّاً، صيغ المهانة والإذلال والإفقار كلّها. إنّه مشروع لتسريح الإنسانيّ الذي ندّعي وجوده فينا وإحالته إلى البطالة.
غير أنّنا نندفع هنا إلى مسألة أعقد: فالثورة تعريفاً ثورةٌ على سلطة دولة، وطموحٌ إلى انتزاعها. لكنْ حين ترتدّ تلك السلطة إلى مجرّد عصابة لا يهمّها من الداخل سوى عدم اعتراضه عمليّات مقايضتها مع الخارج، تاركةً المجتمع يتعفّن ويتفسّخ عاماً بعد عام، ومتيحةً لأسوأ ما في تراثاته وتقاليده أن تنمو وتقوى، من دون أيّة رغبة منها في أن تعيد صياغته على نحو أو آخر، عند ذاك تصبح الثورة نفسها مشروعاً في غاية الصعوبة، إن لم يكن في غاية الاستحالة.
فالأنظمة إذ تفشل فشلاً ذريعاً في أن تكون أنظمةً، تؤول إلى إفشال الثورات في أن تكون ثورات. في حالة كهذه تتحكّم مترسّبات التاريخ بالواقع فيما تنسدّ الآفاق أمام المستقبل، كلّ مستقبل. وربّما كانت هذه حالنا اليوم، وحال استحالتنا الكبرى، وهي تعريفاً أعقد كثيراً من تحميل الثورات المسؤوليّة عن انفجار الانحطاط في وجوهنا.
 ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
١٥ نوفمبر ٢٠١٤
وجهت غالبية الشعب الأميركي ضربة موجعة إلى الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الأخيرة حيث حافظ الجمهوريون على السيطرة على مجلس النواب، وانتزعوا الأكثرية في مجلس الشيوخ، وهذا الأمر لم يحدث منذ سنوات.
طبعاً هذا تصويت عقابي أو تأديبي لأوباما، للتعبير عن عدم رضا أكثرية الشعب الأميركي عن سياساته ومواقفه سواء في الداخل أو في الخارج، وتحديداً في الشرق الأوسط لجهة الفشل في تأمين استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، أو للإرباك الذي يسود إدارته في التعاطي مع أوضاع سورية والعراق والفشل في مواجهة «داعش»، وأمور أخرى مرتبطة بالشرق الأوسط الذي يعيش أزمة غليان واضطراب خطيرين.
ويطرح أحد الأسئلة: كيف سيمضي أوباما ما تبقى من ولايته الثانية (قرابة السنتين) مقيد السلطات في مجلسي الشيوخ والنواب؟ وكيف ستكون السياسة الأميركية في المنطقة خلال هذه الحقبة الزمنية الآتية؟
في ما يتعلق بمواجهة «داعش»، أعلن أوباما أن أجهزة الاستخبارات المركزية لم تزوده بـ»المعلومات الدقيقة»! مضيفاً: «إن مقاومة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ستحتاج إلى وقت طويل» قد يمتد إلى عقود.
وبالإضافة إلى ذلك فشل أوباما فشلاً ذريعاً في التعاطي مع سورية ونظام الرئيس بشار الأسد، وانتقل من مطالبته بالاستقالة والتنحي إلى إغفال تام لهذا المطلب تاركاً لروسيا حرية الحركة والتصرف بـAالملف السوري».
وحول تطورات الوضع في سورية أجريت اتصالاً بالصحافي الأميركي البارز الصديق ديفيد اغنيشس وهو كاتب المقالات الافتتاحية في «واشنطن بوست» ويتمتع بنفوذ كبرى لدى دوائر القرار في واشنطن. وأفادني بالمعلومات التالية:
«حيال مطاردة «المعارضة المعتدلة» المدعومة أميركياً، من أكثر من طرف في سورية، طرحت مجموعة وساطة أوروبية استراتيجية بديلة لوقف إطلاق النار والتخفيف التدريجي من تصاعد أعمال العنف في دولة لا مركزية في المستقبل».
ويضيف: «الحل على المدى القصير لا يكمن في تشكيل حكومة انتقالية ولا في تقاسم السلطة بل في تجميد الحرب. والإقرار بأن سورية أصبحت دولة لا مركزية في فوهة البندقية». ويقول: «وقف إطلاق النار سيسمح بالتحرك نحو إيجاد حل سلمي وإجراء عملية انتقال سياسي عبر التفاوض».
ويضيف التقرير الأوروبي الخاص بالوضع في سورية: «نظام بشار الأسد يعلم أنه لا يمكنه استعادة كل أجزاء البلاد أو الرجوع بالزمن إلى الوراء»، و«في الوقت الذي طرد فيه الثوار المعتدلون في الجيش السوري الحر من معاقلهم في شمال البلاد، ولم تنجح مناشدة الثوار المعتدلين للولايات المتحدة لتقديم المساعدة للحيلولة دون تكبد الخسائر الكبيرة». وجاء في التقرير ما حرفيته: «إننا نواجه صعوبات كبيرة في مواجهة مقاتلي «جبهة النصرة» في إدلب... إننا بحاجة ماسة إلى الدعم الجوي». وفي تقرير صادر في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي ورد: «إن المعنويات منخفضة، ومن شأن الدعم الجوي أن يعمل على عدم وقوع كارثة». وتشير هذه الانتكاسة الأخيرة إلى أنه من دون الدعم الذي ما زالت إدارة أوباما غير مستعدة لتقديمه، تعد الاستراتيجية الأميركية التي تدعم المعتدلين من أجل إلحاق الهزيمة بالمتشددين «مجرد خيال».
ما الحل؟ يقول التقرير: «الحل الوحيد يكمن في إجراء مصالحات محلية، ويجب إعادة الدولة السورية كلها، ويتعين أن يكون هناك احترام لحقوق وكرامة الجميع بمن فيهم الثوار، مقابل احترامهم للدولة ومؤسساتها». وفي الختام يرى أنه «تكمن المعضلة الكبيرة في توصيات المجموعة من أن الثوار ربما يعتبرون هذا النهج استسلاماً. كما أن الرئيس الأسد أصبح بمثابة نقطة جذب للمتشددين، وطالما أنه لا يزال في السلطة فمن الصعب أن نتصور أن ينظر الثوار إلى أي شكل من أشكال المصالحة أكثر من كونه مجرد هدنة موقتة».
ومع ذلك تقول مجموعة الوساطة: «هناك مسار متاح يمكن بموجبه الخروج من ذلك الجحيم»، بينما يختم أغنيشس بالقول: «إذا كانت إدارة أوباما لديها استراتيجية بديلة متماسكة فدعونا نستمع إليها».
وحيال ما يشبه حال العجز من جانب الولايات المتحدة تجاه الوضع في سورية، تعمل روسيا على توظيف «الأخطاء الأميركية» في هذه المنطقة وتحاول وضع اليد كاملة على الملف السوري، وهذا ما حدث في الأسابيع والأيام الأخيرة.
وفي العودة إلى الماضي القريب نتذكر أنه منذ اندلاع شرارة الحروب في سورية كان الموقف الروسي داعماً ومتعاطفاً مع النظام، وقد جنّبه الدعم الروسي صدور أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يدينه، لأن الفيتو الروسي كان بالمرصاد لكل قرار. ومع التقلبات التي شهدتها فصول الحرب، استمر التحالف السوري- الروسي بقوة، مقابل الإرباك الذي ساد لدى الجانب الأميركي. وشهد الواقع السياسي في واشنطن وجود العديد من الخلافات بين أوباما وكبار مساعديه ومنهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي خصصت فصولاً مطولة عن اختلاف وجهات نظرها مع أوباما، خصوصاً حول سورية. وهي تشير إلى «الخطأ القاتل» الذي ارتكبه عندما هدد بتوجيه ضربات عسكرية، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة.
«وكان لهذا التصرف رد فعل سلبي» كما تقول كلينتون، التي تُعد ولو بهدوء لإمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية بعد نهاية ولاية أوباما بعد سنتين. وتوجه اللوم لأوباما بأن المواقف والسياسات التي اعتمدها أساءت إلى الحزب الديموقراطي ككل، وإلى حظوظه في إمكانية الفوز في الانتخابات المقبلة.
ومقابل هذا «التفكك» ظهر التماسك في الموقف الروسي، خصوصاً بين الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي لمع نجمه في السنوات الأخيرة، ويذكر البعض أن لافروف تفوق على وزير الخارجية السوفياتي البارز أندريه غروميكو والذي نال شهرة واسعة في حينه.
واستناداً إلى معلومات من مصادر موثوقة تتحرك موسكو باتجاه عقد اجتماعات مع مختلف التيارات السورية أملاً في التوصل إلى حل يبدأ بوقف إطلاق النار كمرحلة أولى تتبعها مصالحات بين مختلف الفصائل. ومنذ اندلاع الأزمة السورية حدثت تطورات وظواهر، منها تدفق عدد غير قليل من الشبان والشابات للمشاركة في القتال. وهكذا وجدنا خلال السنوات الخمس الماضية انضمام مجموعة من جنسيات غربية مختلفة إلى المقاتلين، والآن تشكل هذه المجموعات إشكالية كبيرة للدول التي أتوا منها والتي يعودون إليها تدريجياً. ومن حين لآخر يصبح الشرق الأوسط أشبه بــ«أكاديمية لتخريج الإرهابيين» عبر تنظيمات عابرة للقارات والأماكن.
ويظهر هذا التطور مقدار مخاطر دعم الإرهاب الذي اعتمدته بعض الدول في مرحلة سابقة وكأن السحر انقلب على الساحر، حيث تشعر الدول الداعمة للإرهاب أن مكافحة هذه الآفة ليست بالمهمة السهلة. وأدركت هذه الدول ولو متأخرة أن تعاطيها مع الإرهاب والإرهابيين لم يكن في مستوى هذا التحدي الكياني والمصيري.
كذلك سقط الشعار الذي اعتمده البعض والقائل بمكافحة هذا الإرهاب في جغرافيا بعيدة عن هذه الدول. فالتجارب أكدت الارتباط العضوي بين ما يجري في حضرموت والربع الخالي من نشاطات إرهابية وكيف عرّضت ولا تزال تعرض للخطر الأمن القومي في كافة دول العالم من دون استثناء.
وبعد...
أولاً: كل ما يجري يندرج تحت عنوان عريـــض وهو رواج «بيزنس العصر» وازدهـــار أسواقه إقليمياً ودولياً، إضافة إلى ملاحظة هامة مستمدة من الواقع المعـــاش: وجـــود سوق رائجـــة من المرتزقة العاطليــن من العمل توفر فرصة عمل بدل البطالة في بلاد المنشأ التي أتوا منها.
ثانياً: مع حــــدوث هــذه التطورات لا بد مـــن التعــــرض لاجتماعات العاصمة العمانية مسقط بين الأميركي والإيراني تحت العنوان العريض: الملف النووي الإيراني. وظهرت معلومات عن المداولات التي شهدتها الاجتماعات المشتركة بين جون كيري وزير الخارجية الأميركي، ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وانضم إليها وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله والمفوضة الأوروبية كاترين أشتون. فاجتماعات مسقط، مع أنها لم تُزل كل العقد المحيطة بالملف النووي الإيراني، فقد «باتت الأمور المتفق عليها أكثر من المختلف عليها»، بحسب قول أحد المتابعين عن قرب للمفاوضات لـ«الحياة». ويبقى انتظار الموعد الكبير المقرر خلال أيام قليلة في فيينا، خصوصاً أن العديد من الدول والمراجع يعلق الآمال العريضة على أي «تفاهم نووي». وآخر المراهنين على النجاح هو رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، الذي قال: إن أي نجاح في «النووي» من شأنه أن يسهل الطريق نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول في لبنان، ألا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. ولكن على كل المنتظرين في صفوف طويلة من الطوابير لرؤية أي تفاهم أن يدركوا حقيقة موقعهم من سلم أولويات الإقليم والمنطقة والعالم، وألا يبالغوا في تقدير هذا الموقع.
وفي ما يتصل بفوز الجمهورين الكاسح في الانتخابات الأخيرة، علينا أن ننتظر تحولات في الموقف الأميركي العام وبخاصة في الشرق الأوسط. والسؤال هو: بعد التخبط والإرباك في الموقف الأميركي وبخاصة حيال الأوضاع البركانية السائدة في المنطقة، أي موقف أميركي علينا أن ننتظر بعد سقوط أوباما في موقع «البطة العرجاء»؟
 ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
١٥ نوفمبر ٢٠١٤
كشفت صحيفة «النهار» اللبنانية أن حزب الله يسعى لـ«تجنيد شبان مسيحيين ومسلمين سنة ودروز، ويعرض عليهم التدريب والتسليح لمواجهة خطر (داعش) وأخواتها»، من باب: «مصيرنا واحد وعلينا التصدي معا». وتضيف الصحيفة أن الحزب يسعى للتجنيد بشعار «أكثر جاذبية من التصدي للعدو الإسرائيلي لأن الخطر أقرب»!
كما كشفت الصحيفة أن عملية التجنيد هذه لا تقتصر على لبنان، وإنما سوريا أيضا، مع غياب تسمية «سرايا المقاومة»، وأن هناك عملية «تطوع مباشر مع الحرس الثوري الإيراني براتب كبير، ومع الحزب أقل، وهو نفسه مع الحزب السوري القومي الاجتماعي لمن يجد في الهوية المذهبية لحزب الله عائقا»، مضيفة أن «القادمين للبنان يروون عن عشرات الحالات من أقاربهم يحاربون البطالة ويدافعون عن وجودهم برواتب شهرية بين 1500 و2500 دولار»! وعملية التجنيد هذه بالطبع تعني ابتزازا، وشراء لمرتزقة، وكما تفعل جماعات الجريمة المنظمة.
وهذا ليس كل شيء، فهذا الخبر يكشف عن أمرين مهمين؛ الأول هو ورطة حزب الله بالمنطقة، وسوريا، فمن الواضح أن الحزب بات يدرك أن كذبة «المقاومة والممانعة» قد انكشفت، وأن مساعي إيران للوصول لاتفاق نووي مع أميركا تتطلب الآن التخفيف من لهجة التصعيد ضد إسرائيل، ففي حال توصلت إيران لاتفاق مع الأميركيين، وبأي صيغة، فذلك يعني تحول حسن نصر الله إلى حامٍ للحدود الإسرائيلية مع لبنان مثله مثل الأسد، الأب والابن. وورطة حزب الله هذه التي دفعته لعملية تجنيد المرتزقة ليست بسبب إيران وحدها، وإنما هي مؤشر أيضا على أن حجم خسائر الحزب البشرية بسوريا كبيرة، وأن حزب الله بات بحاجة لغطاء طائفي يبرر وجوده هناك، وللقول بأنه لا يقاتل وحيدا دفاعا عن المجرم الأسد، أو فقط امتثالا للأجندة الطائفية الإيرانية، وإنما وجوده هناك هو جزء من طيف أكبر يقاتل دفاعا عن سوريا ككل. ومن الواضح أن حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، قد استوحوا هذه الفكرة من التحالف الدولي ضد «داعش»، الذي اشتمل على مظلة عربية سنية، وهذه لعبة مكشوفة. كما أنها تأكيد على ورطة الأسد، وخصوصا بعد أن نشرت صحيفة الـ«واشنطن بوست» الأميركية عن تململ العلويين بسوريا من الأسد.
والأمر المهم الثاني الذي يكشف حماقة حزب الله بعملية تجنيد المرتزقة هذه، هو أن من شأنها أن تؤدي إلى أمرين؛ الأول هو اختراق الحزب أمنيا من قبل عدة أجهزة استخبارات، كما أنها تعني أن حزب الله شرع الآن بتربية «الوحش» الذي سيبتلعه لاحقا، وهذه قصة مألوفة بحالة كل من حاول استغلال العنف والإرهاب لتحقيق مأربه. ولذا فإن عملية التجنيد هذه التي يعتزم حزب الله القيام بها ما هي إلا حماقة سيثبت خطؤها بقادم الأيام، وبالطبع فإن أحدا لن يأسف على حزب الله الطائفي الإرهابي، أو مسؤوليه.
 ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
١٥ نوفمبر ٢٠١٤
لم يتطابق السياسي والعسكري منذ قامت الثورة السورية، واتسمت علاقاتهما إما بافتراق ظهرا معه، وكأنهما جهتان تنتميان إلى ثورتين مختلفتين، وليسا وجهين متكاملين ومتلازمين لثورة واحدة، أو بتبعية فصائل وهيئات عسكرية لهيئات وفصائل سياسية، متناقضة المواقف والرهانات، حصرت أنشطتها، في معظم الأحيان، بتفريق المقاتلين وانتزاعهم من تنظيماتهم الأصلية، ونقل خلافاتها إليهم، لتزيدهم تمزقاً على تمزق، وضياعاً على ضياع.
باختلاف النشأة بين السياسي الذي اقتصر، في البداية، على حراك مجتمعي سلمي، شمل مختلف مناطق سورية، وكان يعتقد أنه سيكون قصيراً وحاسماً، وبين العسكري الذي نشأ بفضل انفكاك عسكريين عن جيش النظام، بعد أن شرع يقتل مواطني"ه"، ويدمر قراهم ومدنهم، وقع تطور سار فيه السياسي على نهج، والعسكري على آخر ، بينما افتقر كلاهما إلى قيادة تجمعهما وتنظم علاقتهما، وتحدد ما هو متكامل أو متناقض بين أنشطتهما ومهامهما، وتجعل سياساتهما ومواقفهما الموحدة تنبع من خطة شاملة للحراك، وتستجيب لحاجاته، لكي لا ينجح النظام في تحويله إلى صراع مسلّح، متزايد العنف، يضعف السياسي، الضعيف أصلاً، لصالح العسكري، المتخبط والمجزأ، ويحل تدريجياً "المجاهد" محل المتظاهر السلمي، ويقيد حراكه، ويقلبه أكثر فأكثر إلى عنف مسلّح غير هويته، على الرغم من أن نجاحاته كانت تعوض بعد الشيء عن النتائج الوخيمة لتشتته المكاني.
بدل أن يقوي السياسي العسكري والعسكري السياسي، أضاف كل منهما نواقصه وعيوبه الكثيرة إلى مصاعب الآخر، الذاتية والخاصة، فتناقض العسكري البادئ بارتباك مع حراك سلمي مضطرب ومتخبط سياسياً، تقوده جهات محلية، تفتقر إلى الخبرة والتجانس، وإلى تفاهم يتخطى مكانيتها الضيقة، تدعمه رؤى جامعة: متقاربة أو متشابهة فكرياً وعملياً، في حين تعارض السياسي مع صراع عسكري، تختلف شروط نجاحه اختلافاً كبيراً عن شروط نجاح ما افترض أنه الحاضنة السياسية التي نشأ فيها. هذا الانتقال المفعم بالنواقص والعيوب، قام على افتراق العسكري عن السياسي، فعزز عيوب وضعيهما، وإيجاد بيئة شك وارتياب بينهما جعلت هم السياسة، بعد تأسيس المجلس الوطني بصورة خاصة، اختراق العسكر واستمالة مجموعات أو أفراد منهم، وأخذ موطئ قدم للنفوذ وكسب الولاءات بينهم، في حين لعب المال السياسي القادم من الخارج دوراً مدمراً في تنمية ميل عسكر الحارات والشوارع، المعزولين غالباً بعضهم عن بعض، إلى تنمية استقلالية مزعومة في مواجهة السياسي، أو بعيداً عنه، أخذت صورة تمزق أصاب ما كان يجب أن توحده التطورات والمصالح الوطنية، وأبرزت عقلية المفاضلة بين السياسي والعسكري، متجسدين في داخل مسلّح وخارج سياسي، وبدات تنتشر أسطورة أن الحسم سيكون عسكرياً، وأنه يكفي لحدوثه تزويده بقدر وافر من السلاح والمال، فلا حاجة به إلى إطاعة مركز سياسي موحد، أو قيادي، لا دور ولا لزوم له.
بذلك، تناقص دور السياسي وتأثيره، بدل أن يتزايد مع تصاعد الصراع، واعتبر مجرد عبء ثقيل على كاهل ثورة تتحول أكثر فأكثر إلى أعمال عسكرية ظافرة يغذيها، ويدعمها خارج عربي وإقليمي، تتصارع توجهاته ودوله. وزاد الطين بلة أن العسكري كان يخوض معارك كثيفة، لكنها مجزأة، وتدور في مناطق متفرقة.
"
بدأت تنتشر أسطورة أن الحسم سيكون عسكرياً، وأنه يكفي لحدوثه تزويده بقدر وافر من السلاح والمال
"
خلال هذه العلاقة التي كانت تتطلب معالجة جدية وثورية، وبدل إزالة ما بين السياسي والعسكري من صعوبات وتناقضات، دعي قرابة 600 مقاتل عسكري ومدني إلى مؤتمر في أنطاليه لهيكلة الجيش الحر، تم استبعاد الائتلاف عنه، على الرغم أن العالم كان قد اعترف به مرجعية سياسية له. ذلك كان يعني انتزاع المسألة السورية من السياسي، ووضع يد الخارج على العسكري، وكان يؤسس لفصل أحدهما عن الآخر وبالعكس، ووضعهما في عالمين متباينين ومختلفين أشد الاختلاف، وإخضاع السياسي للتهميش التام والعسكري لإرادات وخطط، لا تنبع قيمتها وأولويتها من أثرها الوطني، أو هويتها السياسية المستقلة، ولا تمت إلى الثورة وحراكها بصلة داخلية ملزمة.
عوض رفض هذا الحدث الخطير، والرد عليه ببرنامج شامل لتوحيد السياسي والعسكري، ولإقامة علاقات لا لبس فيها، بينهما تجعل منهما جسمين، ينتميان عضوياً بعضهما إلى بعض، وإلى ثورة واحدة، تجاهل قادة الائتلاف – السياسي - ما وقع، ولجأ من حل محلهم فيما بعد إلى طريقة "أسدية" في التعامل مع العسكر، أن استغلوا وضعهم على رأس جهة سياسية معترف بها دولياً، لكي يشتروا "قادة" عسكريين، ويستخدموا لأغراض محض انتخابية وشخصية من أرسلتهم أركان الجيش الحر من المقاتلين إلى "الائتلاف"، مندوبين عن المجلس العسكري الأعلى، مع أن هؤلاء انتدبوا إليه لكي يمثلوا مصالح ووجهات نظر المجال العسكري في المجال السياسي، ويقيموا تطابقاً فاعلاً بينهما. بذلك، تم تقريب واستبعاد المكونات العسكرية حسب قابليتها للشراء، أو امتناعها عنه، وقيمة أصواتها الانتخابية، وليس وفق أي معيار وطني. وبذلك، فاقم "السياسي" مشكلات العسكري الذي كان يتعرض لتراجع ميداني متواصل، تحت وطأة هجمات ضارية، تعرض لها على يد النظام و"داعش"، أخرجته من معظم المناطق التي كان قد طرد الأسد منها، وتلازمت مع قطع المدد الخارجي بصورة شبه تامة عنه: مع أنه كان شحيحاً ومتقطعاً على الدوام.
سيكون من الصعب أن تنتصر ثورة يذهب ساستها في اتجاه وعسكرها في آخر، ولن تنجح نضالات يستخدم الساسة العسكر فيها لمقاصد شخصية، لا علاقة لها بمبدأ وطني أو ثوري. في المقابل، لن تنجح ثورة يعزف عسكرها عن تصحيح مسارها، مع أنهم حاملها الذي يرتبط استمرارها، ونجاحها بوحدته وبقدرته على الفعل، علما أن انقساماته وخلافاته لعبت دوراً كبيراً في تقويضها، مثلما لعبت خلافات وانقسامات السياسي دوراً مخيفاً في تمزقه وهزائمه.
 ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
١٥ نوفمبر ٢٠١٤
هكذا وبكل ثقة وإشراق يعلن المبعوث الدولي الجديد إلى سورية عن خطته التي تفتق ذهنه عنها، كما لو أنها حل سحري غير مسبوق، خلاصتها: تجميد القتال في نقاط محددة تكون منطلقاً لاستمرار هذا التجميد وتعميم التجربة على كافة المناطق السورية، حال نجاح النموذج الذي اقترح المبعوث الدولي أن يبدأ من حلب.
يا للهول.. ما تلك العبقرية يا دي مستورا، كيف تضمن الموافقة على خطتك على الأقل من قبل النظام الذي لم يقبل بهدنة ولو لمجرد ساعات قليلة خلال كل الزمن الماضي من عمر الثورة واشتعال الصراع، ثم أين الجديد الذي تحاول تقديمه وعلى من تراهن في نجاح خطتك؟ وهل تلك خطة أصلاً، هل أنت جاد فعلاً لتتــــعاطى مع مشـــكلة بحجم الحدث السوري بهذه البساطة التي تستحق لقب السذاجة، وهل سوف يشد المجتمع الدولي على يديك معجباً بإنجازك غير المسبوق؟
لا يحق لأحد في العالم اليوم، لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أي دولة سواء أكانت عظمى أو صغرى، غربية أو عربية، أن يزعم أن لديه نوايا فعلية أو هاجساً حقيقياً في البحث عن حل للمأساة السورية، سواء كان ذلك الحل سياسياً أو عسكرياً أو إنسانياً، ولاسيما بعد السنوات الأربع التي عانت فيها سورية والسوريون ما عانوا، ولو أن المجتمع الدولي ترك السوريين وشأنهم فلربما لم تصل سورية إلى ما وصلت إليه، ولربما وجدوا حلاً ما سواء بإسقاط النظام أو بقدرة الأخير على قمع الثورة منذ أيامها الأولى- وذلك يراه الكثير من السوريين حلاً بالقياس إلى ما آلت إليه سورية من دم ودمار. لكن تدخل المجتمع الدولي هو ما عقد المشكلة وفاقمها إلى الدرجة التي استعصى فيها الحل، مع استمرار النزيف والدمار بشكل مطرد، لقد بذلت بعض الدول الفاعلة جهوداً جبارة للوصول إلى حالة الاستعصاء، وهي التي بيدها وحدها مفاتيح الحل، فكيف يمكن للسوريين أن يعولوا على حل للمشكلة ممن تسبب في خلقها وتفاقمها، عامداً متعمداً أو متلكئاً متردداً. في الحالة الأولى لا مصلحة للمجتمع الدولي بإنهاء المأساة، وفي الثانية سيبدو وكأن خيوط اللعبة قد أفلتت من بين يديه، أما الصورة الأنقى التي لا يختلف عليها السوريون اليوم فهي رغبة الكثير من الدول في استثمار الحدث السوري والاستثمار فيه باعتباره بات أرضاً خصبة لتحريك الصراعات وإدارة المصالح وتصفية الحسابات الإقليمية والدولية..
المشكلة التي يواجهها السوري اليوم هي أنه يدرك استحالة الحل عبر المبعوثين الدوليين، وعدم جدوى وجودهم حتى إن كانت لدى المجتمع الدولي نوايا صادقة، فلو كانت ثمة مقترحات عميقة وفاعلة لدى أحدهم لارتطمت بحوائط صد متعددة، أهمها انعدام الصلاحيات التنفيذية، ليس عند المبعوث الأممي وحسب، بل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أيضاً، خصوصاً بعد الرخاوة البادية التي واجه بها خرق الكثير من قراراته، أو إحالتها إلى بند وجهات النظر من قبل الطرف المتضرر، مما أدى إلى ميوعتها ومن ثم ذوبانها ونسيانها طالما غاب البند الملزم لتنفيذها، ومن ثم يأتي النظام السوري الذي لا يرى محيصاً عن استمراره على رأس السلطة، طالما لم يتخل عنه داعموه وأياً كانت النتائج، ولا يجد حلاً سوى باسترداد موقعه القديم وإعادة إخضاع سورية والسوريين لسلطته المطلقة، التي ستكون أقسى وأشد بطشاً في ما لو حقق حلم الانتصار، ومن ثم تأتي أطراف الصراع الأخرى، وبشكل خاص المعارضة المسلحة التي لو ارتضت إلقاء السلاح، حرصاً على ما تبقى من سورية – بشرها وحجرها- لما فسر النظام ذلك إلاّ بالنصر المبين، وسوف يلتفت حينها إلى تصفية خصومه الذين ألقوا السلاح طوعاً، فمن أين للمعارضة المقاتلة خيارا آخر وهي تدرك ما ستؤول إليه حالها وحال من ناصرها في ما فعلت ذلك.
الحقيقة التي لم يعد من الوارد نكرانها هي أن التحرك الدبلوماسي بخصوص سورية، الذي شــــهدته السنوات الأربع المنصرمــــة لم يكن ذا هدف محدد، ولم يكن مهموماً بإيجاد حل، قدر اهتمامه باستهلاك الزمــــن والتـــظاهر بملء الخط الدبلوماسي على اعتبار أن المجتـــمع الدولي قرر الحل السياسي خياراً وحيداً في سورية، وليـــس دي مستورا ومن سبقوه سوى من مستلزمات هذا الحل الوهمي وإكسسواراته، الذي رأينا تجلياته على أرض الواقع، فكلما ازداد التمسك بالحل السياسي ازدادت حالة العسكرة على الأرض، وتشعبت الصراعات وتكاثرت الفصائل المقاتلة، وتعقدت سبل الوصول إلى أي نوع من التسوية.
مرحلة كوفي عنان جلبت معها النصرة والفصائل الإسلامية الأخرى، أما مرحلة الأخضر الإبراهيمي فلم تنته إلاّ وتنظيم «داعش» يعلن دولة مترامية الأطراف ممتدة على مساحات واسعة بين العراق وسورية، كل مقترحات المبعوثين الأمميين الهادفة إلى إيجاد الحل السياسي كانت تجلب المزيد من وقود الحرب وأدواتها وتترافق مع توسّع رقعتها. قبل دي مستورا كانت القصة أقل تعقيداً والمقترحات أكثر جدية وملاءمة، ومع ذلك كانت المبادرات السياسية تنعكس سلباً على أرض الواقع، أما مرحلة دي مستورا فهي الأكثر صعوبة وتعقيداً إلى درجة الاستحالة، ومع ذلك يخرج المبعوث الدولي مبتهجاً بخطة شديدة البلاهة والخيالية، ولا يتوانى عن طرحها ولا يتوانى المجتمع الدولي عن التعاطي معها وكأنها خطة رغم انفصالها عن واقع الأحداث انفصال الأسد عن واقع ما يجري في سورية.
لو أن للسوريين رأياً في مأساتهم لاقترحوا على الفور «تجميد» عمل دي مستورا وتجميد كل المبادرات الدبلوماسية بعد أن تعاقب عليهم نجوم الأزمات الدولية، فجعلوا من سورية حقلاً لتجاربهم وحولوا السوريين إلى فئران تجارب لا تزال المخابر السياسية والعسكرية تستعمل أجسادهم ودماءهم وأرواحهم وبيوتهم وأرضهم ووطنهم مواد خام وبالمجان، ومن دون استعجال النتائج.
 ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
١٥ نوفمبر ٢٠١٤
ليس هناك أدنى شك بأن الثورة السورية واحدة من أكثر الثورات المشروعة تاريخياً، فلم يتعرض شعب في القرن العشرين للقهر والفاشية والإذلال المنظم كما تعرض الشعب السوري على أيدي النظام الأسدي الطائفي الغاشم الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً. وبما أن ذلك النظام بات رمزاً لكل ما هو وحشي وهمجي قذر، لم يقبل حتى بتلبية أبسط مطالب السوريين، فاستبدل قوانين الطوارئ سيئة الصيت التي ثار السوريون عليها بقانون الإرهاب الذي راح يحاكم السوريين بموجبه، ويضعهم أمام محكمة الإرهاب لمجرد التلفظ بكلمة بسيطة. كل من يفتح فمه ضد النظام أصبح حسب القانون الجديد إرهابياً وجب اعتقاله إذا كان موجوداً، أو صدر قرار بحرق منزله أو مصادرة أملاكه إذا كان خارج البلاد. لقد أصبح السوريون بعد الثورة يترحمون على قوانين الطوارئ على بشاعتها بعد «الإصلاحات» الإرهابية التي قام بها النظام بعد الثورة. وعندما أراد بشار الأسد أن يضع دستوراً جديداً للبلاد على سبيل الإصلاح المزعوم، وضع مواد جديدة تجعل حتى سلاطين القرون الوسطى يحسدونه على السلطات التي منحها لنفسه بموجب الدستور الجديد، فهو راع لكل شيء في سوريا حتى الزبالة والزبالين والقمامة والنخاسين. لم يترك شيئاً إلا ووضعه تحت رعايته.
وليت بشار الأسد اكتفى بوضع القوانين القراقوشية للانتقام من السوريين لأنهم ثاروا عليه، بل راح يستخدم كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً كي يثأر من الثورة. والأنكى من ذلك أنه عمل على تحويل سوريا إلى بؤرة تجتذب كل شذاذ الآفاق إليها لإفساد الثورة وجعلها تبدو في نظر العالم مجرد فوضى وحركات إرهابية. كلنا يتذكر كيف أخرج كل المتطرفين من سجونه بعد الثورة، وزودهم بالسلاح كي يقاتلوه، ويحولوا الثورة إلى صراع دموي. وقد لاحظنا كيف كان بشار الأسد في خطاب القسم السخيف يتلذذ ويتشفى وهو يتحدث عن إفشال الثورة وتحويل سوريا إلى ساحة صراع يعبث بها القاصي والداني.
وكي يحمي بشار الأسد نفسه ونظامه قدم كل أوراق اعتماده لإيران وروسيا وإسرائيل، وتعهد بأن يكون مجرد بيدق في المخططات الروسية والإيرانية والإسرائيلية بشرط أن لا يسقط نظامه تحت أقدام السوريين، ويكون مصيره كمصير بقية الطغاة الذين قضوا تحت نعال الشعوب. لقد تحول النظام السوري إلى مجرد أداة قذرة ضد سوريا والسوريين، لا بل أصبح حراس قصره من غير السوريين، فالآمر الناهي أمنياً وعسكرياً في سوريا هي إيران وميليشياتها العراقية واللبنانية باعتراف الميليشيات الشيعية نفسها. أما روسيا فقد سلمها بشار الأسد كل ثروات الغاز والنفط من خلال عقود طويلة الأمد مدة بعضها ربع قرن من الزمان.
لقد كان النظام السوري يهدف من خلال الارتماء الكامل في الحضنين الروسي والإيراني دفع خصومه أيضاً إلى الارتماء في أحضان القوى المنافسة لإيران وروسيا في سوريا، بحيث تضيع القضية السورية، وتتحول سوريا إلى سلعة دولية يسمسرون عليها من أجل منافع سلطوية حقيرة. فعندما وجدت جماعات المعارضة السورية أن النظام بات يحتمي بمنظومة عسكرية وأمنية واقتصادية روسية إيرانية مفضوحة، لم يجدوا بداً من الارتماء في أحضان المعسكر الآخر لمواجهة النظام. وقد أصبح بعض شرائح المعارضة السورية بدورها كالعراقية سابقاً مضرباً للمثل في التسول والسير وراء الآخرين. لا شك أن هناك بعض الجهات العربية والأجنبية التي وقفت إلى جانب المعارضة السورية لتمكينها من مواجهة أكثر الأنظمة فاشية في القرن العشرين، وعملت الكثير على مساعدة السوريين. لكن هناك جهات كثيرة أخرى لا يهمها في سوريا سوى تحقيق مصالحها الضيقة التي لا تمت لمصالح السوريين بصلة.
ولو نظرنا إلى الخارطة السورية الآن لوجدنا أن كل طرف خارجي منخرط في الأزمة يغني على ليلاه، ولا يهمه لا سوريا ولا السوريين. هل يعلم السوريون الآن أن كل القوى المتصارعة على سوريا والمتحالفة مع النظام أو بعض فصائل المعارضة لا يهمهما الشعب السوري قيد أنملة. الكل يبحث عن مصلحته في سوريا. إيران تستخدم بشار الاسد كأداة لتوسيع إمبراطوريتها الشيعية الفارسية والوصول عبر الأسد إلى شواطئ المتوسط. وروسيا تريد الحفاظ على قواعدها البحرية في سوريا، بالإضافة الى نهب الثورات الغازية والنفطية السورية التي أعطاها إياها الاسد مقابل الحماية والسلاح والحفاظ على طرق الغاز والنفط الدولية. وتركيا لا تريد لإيران أن تصبح على حدودها السورية، وتعمل على تأمين الشمال السوري لصالحها. وأمريكا طبعاً تريد تأمين الحليف الاستراتيجي إسرائيل من الخطر السوري واستغلال الموقع الاستراتيجي لسوريا. مع ذلك، يستمر بشار الاسد، ويستمر معارضوه في السمسرة للقوى المتكالبة على سوريا كي تنهش في الجسد السوري، وتحقق مطامعها، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير الوطن وتهجير شعبه وتحويله إلى طعام للأسماك في عرض البحار والمحيطات.
 ١٤ نوفمبر ٢٠١٤
١٤ نوفمبر ٢٠١٤
تجارب السورريين في الاعتقال والتغييب كبيرة وممتدة على جيلين، بما يكفي لمحاولة تصنيفها، ولاستخلاص دلالات سياسية منها، ولإصدار حكم أخلاقي في شأنها. يعتمد التصنيف المقدم هنا على موقع ذوي المعتقلين ومعرفتهم بمصير أحبابهم المغيبين.
ولا ريب في أن من شأن تجميع منظّم للمعلومات وتحليلها أن يؤسس لتصنيف أدق من هذا التصنيف الأولي، المعتمد على الخبرة الشخصية.
نمط الاعتقال الأول هو التوقيف من قبل جهة معلومة والحجز في مكان معلوم، أو يُعلم بعد وقت قصير، مع إمكانية مبدئية لزيارة الأهالي للمعتقلين، لكن من دون إجراءات قضائية فورية تتلو الاعتقال. كان هذا حال المعتقلين اليساريين في سنوات حكم حافظ الأسد. اقترن نمط الاعتقال هذا بالتعذيب التحقيقي، وبدرجة أقل بالتعذيب العقابي بعد التحقيق. لكن المجهول الكبير هنا هو موعد الإفراج عن المعتقلين، إذ يمكن أن يطول أمد البقاء في السجن سنوات طويلة، أكثر من أحد عشر عاماً في حالتي الشخصية بين كثيرين آخرين. وهو ما يجعل الاعتقال جريمة بحق الأهالي، وليس بحق المعتقلين وحدهم. جريمة لأن المعنيين من دون استثناء لم يرتكبوا جرماً يُحبسون عليهم عاماً واحداً. من اعتقلوا بعد إحالتنا إلى محكمة أمن الدولة في ربيع 1992، مثلوا بعد وقت قصير أمام تلك المحاكم الاستثنائية. هذا بالطبع يخفف من قلق الأهالي. لكن، كان شائعاً ألا يفرج عن المعتقل عند إنهاء سنوات حكمه.
يتمثل النمــط الثاني في الاعتقال من جهة معلومة، ويكون المعتقلون في مكان معلوم أو غير معلوم، ومن دون إمكانية الزيارة. هذا كان حال المعتقلين الإسلاميين في ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته.
اقترن هذا النمط بالتعذيب التحقيقي الأشد، وبالتعذيب الانتقامي المستمر طوال سنوات الاعتقال التي امتدت أحياناً عشرين عاماً أو أكثر. والعذاب النفسي للأسر ليس أقل.
وقد وقع من بين معتقلي الإسلاميين الألوف قتلى، إن نتيجة المرض والتعذيب، أو لأنهم أعدموا، وهذا من دون إعلام أسرهم في كل حال، ومن دون تسوية ما يترتب على ذلك من مسائل قانونية واجتماعية.
أما النمط الثالث فهو اعتقال تقوم به جهة غير معلومة، لكنها عامة، «الدولة»، ويُحتجز المعتقلون في مكان غير معلوم، ومن دون إمكانية الزيارة. هذا ينطبق على أكثر معتقلي الثورة منذ ربيع 2011. لا يعرف الأهالي الجهاز الأمني أو الميليشيوي الذي اعتقل فرداً أو أفراداً من الأسرة، وقد يطرقون أبواب أجهزة متنوعة، تنكر كلها وجودهم عندها. كان مثل هذا يحصل في الثمانينات والتسعينات حتى بخصوص المعتقلين اليساريين، لكن كان ينجلي الأمر عموماً بعد وقت لا يطول كثيراً.
اليوم، أثناء الثورة لا يُعرف مكان اعتقال أكثر المعتقلين، وليس دائماً تعرف بالضبط الجهة التي اعتقلتهم. منهم مثلاً الطبيب محمد عرب المعتقل منذ ثلاث سنوات، وعبدالعزيز الخير ورفيقاه منذ أكثر من عامين، وفائق المير وجهاد أسعد محمد منذ أكثر من عام، وناصر بندق المعتقل في شباط (فبراير) من هذا العام، وغيرهم كثيرون. وكانت هذه حال وائل حمادة وقت اعتقاله من جانب جهاز الاستخبارات الجوية عام 2011.
المشترك في الأنماط الثلاثة السابقة أن النظام هو فاعل الاعتقال، وإن لم يكن معلوماً دوماً أي وكالات من وكالاته القمعية هي الفاعل المباشر.
بعد الثورة السورية وخروج مواقع من سيطرة النظام، انكسر احتكار النظام للعنف والسلاح، وظهرت أشكال جديدة من الاعتقال ومن فاعليه.
ونميز هنا أيضاً بين ثلاثة أنماط أو أربعة. أولها، اعتقال تقوم به جهة معلومة، تشكيل عسكري أو «قضائي» («هيئات شرعية»)، قلما يحوز استقلالاً فعلياً عن التشكيلات العسكرية، ويكون المعتقلون في مكان معلوم من جانب الأهالي، مع إمكانية الزيارة. ويتعلق الأمر غالباً بموقوفين جنائيين. ولا نعلم مثلاً واحداً عن معتقلين لأسباب سياسية عند أي من السلطات الكثيرة القائمة اليوم في الأرض السورية، تتيح لهم الزيارة والدفاع القانوني المستقل.
ثانيها، هناك حالات تكون الجهة الخاطفة معلومة، ولا يندر أن تقود ضغوط، مسلحة أحياناً، أو وساطات أو مفاوضات، إلى الإفراج عن المخطوفين بعد حين يطول أو يقصر. هناك غير حالة معلومة في هذا الشأن في الغوطة الشرقية.
وكيان «داعش» طليعي في هذا الصنف من الجرائم، لكن لا يُعلم مكان المعتقلين، ولا تتاح الزيارات لأهاليهم، ولا تتوافر عن أوضاعهم ومصيرهم أية معلومات. هذه حال عبدالله الخليل وفراس الحاج صالح وإبرهيم الغازي والأب باولو دالوليو ومحمد نور مطر وإسماعيل الحامض وغيرهم كثر.
على أن أشهر أنماط الاعتقال هنا هو الخطف من جهة غير معلومة (لا تعلن مسؤوليتها عن الفعل)، وتحبس المخطوفين في مكان غير معلوم، من دون إتاحة معلومات عن المختطفين. هذه حال سميرة الخليل ورزان زيتونة ووائل حمادة وناظم حمادي المختطفين منذ أكثر من 11 شهراً في دوما في الغوطة الشرقية.
وهذه جريمة بحق أهالي المخطوفين بمقدار ما هي جريمة بحق المخطوفين أنفسهم. وهي من جهة ثانية جريمة مستمرة ومتجددة كل يوم من حيث إننا، ذوي المخطوفتين والمخطوفين، لا نعلم شيئاً عن مصيرهم. لدينا ترجيحات قوية، بل قطعية، عن الجناة، لكن هؤلاء مستمرون في الإنكار والتعتيم التام.
ونستخلص من هذا العرض الوجيز ثلاث نتائج.
أولاً، بما أننا عشنا مع الاعتقال والتعذيب والتغييب طويلاً، وتشكلت من هذه التجارب حياة وموت جيلين منا، فلعله ليس هناك حقول للمعرفة أولى بالاهتمام لدينا من «علوم» السجن والتعذيب والخطف والقتل (في شأن القتل، أحيل إلى مقالتي: أنماط الموت السورية، مصنفة حسب القاتلين: http://therepublicgs.net/32725)، أعني التفكير في هذه القضايا ببنيتها الخاصة، وبدلالاتها الاجتماعية والسياسية، والفكرية، وليس فقط من زاوية حقوقية.
وفي المقام الثاني نلحظ أن انكسار احتكار «الدولة» العنف يمكن أن يكون ثورياً، وقد كان لبعض الوقت في سورية، وعلامته توجيه السلاح حصراً ضد النظام المعتدي ولمصلحة المجتمع الثائر، ويمكنه أن يكون لا ثورياً أو تدميرياً، ويغلب أن يكون كذلك حالياً، حيث العنف موجه ضد المجتمع أساساً. وما يفتح أبواباً لتفكير أكثر جذرية بأن عنف «الدولة» لم يكن يوماً عنفاً عاماً، مجرداً عن حيثيات المعنّفين ومنضبطاً بقواعد عامة. لقد كان عنفاً ملموساً، انتقامياً، ممتزجاً بالكراهية، وطائفياً في الغالب.
وأخيراً، ليست قضايا الخطف والتعذيب والاعتقال والقتل قضايا سياسية عادية، نتناولها سريعاً ونستخلص منها بعض الدلالات، ثم نمضي لشأن آخر. إنها مؤشرات حاسمة على أننا نوغل في الهمجية، وبتسهيل إقليمي وعالمي، وشراكة إقليمية عالمية. ومن هذا الباب تقول هذه القضايا شيئاً سيئاً عن سورية، وتقول شيئاً بالسوء نفسه عن العالم.