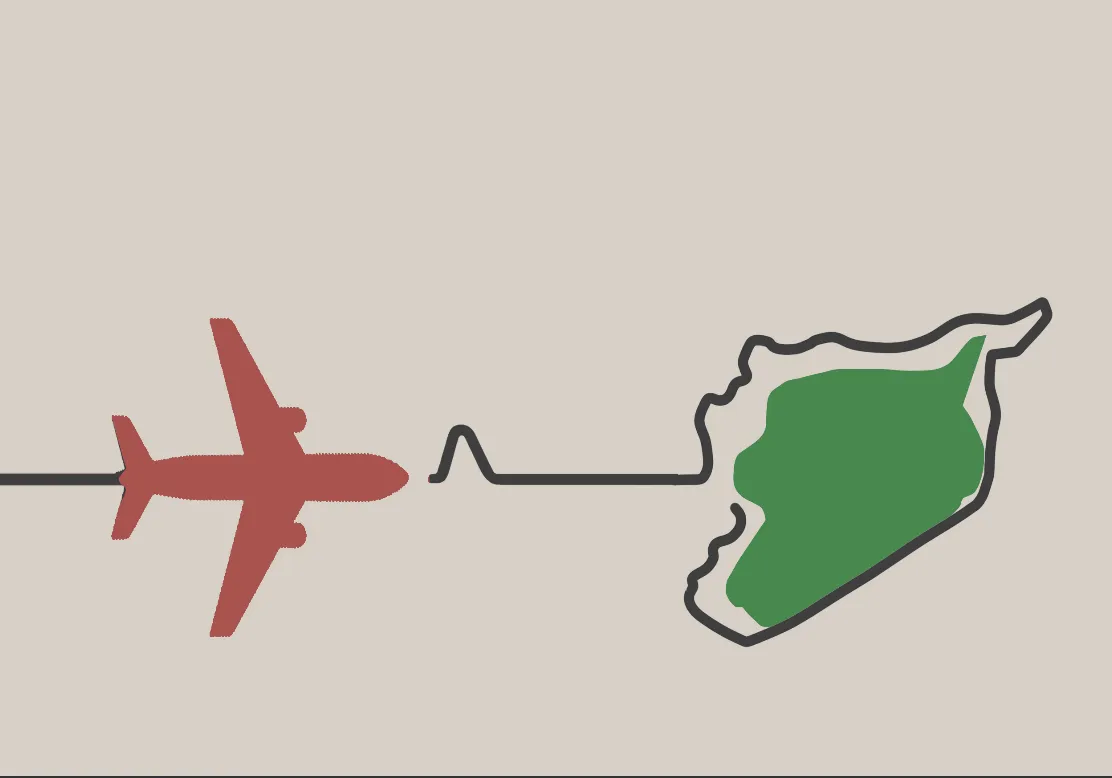٢١ نوفمبر ٢٠١٤
٢١ نوفمبر ٢٠١٤
مما لا شك فيه أن الشعب هو منبع كل ثورة تخرج ضد الظلم و الطغيان ، و أن الشعب هو أساس كل تحرك يهدف الى تغيير نظام حكم اضطهده و سلب حقوقه و حاربه بلقمة عيشه ، و لا ريب أن الشعب هو المحرك و المولِّد لكل إنتفاضة تخرج ضد نظام أو حزب إستبدادي تطالبه بالرحيل و تنشد التغيير ، و من هنا من هذا الشعب تولد الثورات ، تبدأ بحدثٍ صغير يكون تلك “القشة التي قصمت ظهر البعير” و لا يلبث أن يتحول الحدث الى شرارة يشتعل بها أتون الغضب و الحقد على من إستبد و ظلم و تحكم ، و لا تلبث هذه النيران المتقدة بالقلوب و العقول ، المتولدة من جحيم المعاناة و التعب و شظف العيش ، أن تتحول إلى ثورة عارمة .. يحوطها الشعب و يرعاها ..يؤيدها و يكلؤها بعين رعايته ، يأمن لها أسباب العيش و الإستمرار و يوفر لها الحضن الدافئ و الحامي ..
هي الثورة السورية كما كل الثورات على مر التاريخ ، ولدت من رحم الشعب ، و خرجت من خاصرته بما رافق هذا الخروج من الم و مكابدة و صبر ، لتنتفض ضد نظام إستبد بوطن ما يزيد على خمسة عقود ، نظام استبد و قتل و أجرم و سرق و نهب ، هي ثورة فطرية عفوية بدأت بكتابات أطفال على جدران مدارسهم لتستعر كما النار بالهشيم و تنتقل من جدران مدرسة لتغدو على مساحة كل شبر بأرض الوطن ، ثورة بدأت سلمية و استمرت كذلك ما وسعها الأمر ، و بفطرتها السليمة كذلك و عفويتها بدأت بالتحول للعسكرة لتدافع عن نفسها ضد بطش لم يُشْهد له نظير بالتاريخ ، حملت السلاح لتطبق معايير كل الديانات السماوية و الأعراف الإنسانية بحق رد الظلم و حفظ النفس ، و بدأت كتائب الثوار بالتشكل و الظهور ، فظهر الجيش الحر الذي كان إبن ثورة الشعب البكر ، يحمل خصائصه و تفاصيله ، يحوي أطيافه و إثنياته ، و يرفع راية إستقلاله عن المستعمر ، لا يتميز فيه ثائر عن ثائر الا بالخلق و الشجاعة و الاقدام و ما يحمله من فكر و حرية ، ليظهر بعده تشكيلات مختلفة و فصائل متعددة و رايات متباينة ، كل منها له هدف و يقوده منهج و يحركه فكر ، منها المعتدل و الإسلامي و المتطرف و المغالي بالتطرف .
تحولت الثورة للعسكرة ، و باتت تشكيلاتها تتنازع المناطق و الاهداف و الوجود و الموارد ، و لم تنسَ هذه الفصائل بطبيعة الحال أهم سبب من أسباب قوتها و اهم مصدر من مصادر شرعيتها ، و أقوى محرض على استمراريتها و هو الشعب .. تلك الحاضنة الإجتماعية الأساس و المركز ، فسعت التشكيلات و الفصائل إلى كسب ودها و استقطابها كل منهم على حساب الفصائل و التشكيلات الأخرى ، و كما تعددت مشارب و أهداف هذه الفصائل فقد تعددت أساليبهم بجذب هذه الحاضنة الشعبية تجاههم ، فمنهم حاورها و اندمج بها و اعانها قدر استطاعته ، و منهم من تكبر عليها و أهملها و منهم من حاول سوقها بالحديد و النار و القهر و الإرهاب ، و منهم من ظن انه الوصي الشرعي عليها بعد تقهقر النظام من بين ظهرانيها ، و مارس أغلبهم البراغماتية المحضة بداية بالتزلف لنيل رضاها و التقرب منها ، ثم اظهر وجهه القبيح بأهدافه المناطقية أو الشخصية او الأيدولوجية ، فلفظته الحاضنة الشعبية التي عولت عليه و عول عليها .. لينتهي التشكيل او يضمحل او يتقوقع على نفسه برأس جبل او بطن وادي.
الثورة السورية ثورة مُمحِصةٌ كاشفة ، و الحاضنة الشعبية تحوي بوعيها الجمعي حضارة عمرها آلاف السنين ، و الشعب الذي أطلق هذه الثورة “بمشيئة الله” قادر على ان يميز الخبيث من الطيب ، و ان يفرق بين الغث و السمين ، و لكنه شعب كَهلْ صقلته التجارب و السنون ، يعطي الفرصة لمن يطلبها ، و يتمهل بالحكم ليرى النتائج ، و لكنه لا يصبر على ضيم ، و لن يستبدل مستبد بمستبد .. فليعي من يتطلع ليلي أمره بالسلاح او بالسياسة .. ان يحقق طموحات هذا الشعب و ان يلامس ألمه و ان يثبت عزمه على تحقيق أمله .. فبهذا يستمر و بهذا يحوز رضاه و بهذا يمتلك قلوب و عقول “الحاضنة الشعبية”
 ٢١ نوفمبر ٢٠١٤
٢١ نوفمبر ٢٠١٤
في وقت ما من العام الماضي ربما، اكتشف أحد الذين يقفون على رأس قيادة نظام الأسد في دمشق، دليلا استعماريا كتبه الفرنسيون ويدور حول كيفية السيطرة على سوريا. ويعكس ذلك الدليل السياسة العدوانية التي انتهجها الرئيس الفرنسي السابق ألكسندر ميلران، إذ يوصي الدليل بتطبيق سلسلة من الحيل تهدف في مجموعها إلى السيطرة على الدولة المتكونة حديثا ضد رغبات غالبية شعبها.
وقد صممت الأساليب المذكورة لتتناسب مع «بلقنة» سوريا الكبرى واستدعاء سياسة «فرق تسد» بناء على وعود بإقامة عدة دويلات تحكمها الأقليات. ومن واقع الحقيقة القائلة بأن الرئيس ميلران كان اشتراكيا وكان من المفترض أن تكون الدولة الفرنسية ذات طابع علماني، فلا كان هو اشتراكيا محضا ولا هي علمانية صرفة.
من أبرز وصايا الدليل الاستعماري المذكور، هناك اثنتان مهمتان؛ أولاهما تركيز الإدارة الاستعمارية مواردها على السيطرة على ما وصفته بـla Syrie utile أو «سوريا المفيدة». ويقصي ذلك المفهوم أكثر من نصف أراضي سوريا، التي تتألف من صحراء قليلة السكان. وبدلا من ذلك، يسلط الضوء على قيمة الشريط الساحلي ما بين دمشق ومدينة حلب على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مدن البلاد اكتظاظا بالسكان، وطريقين رئيسيين؛ أحدهما يربط سوريا بلبنان في الجنوب، والآخر يربطها بتركيا في الشمال الشرقي. وعبر مراحل النضال الوطني السوري من أجل الاستقلال، تابع الفرنسيون تلك الوصفة بحماس عجيب.
واليوم، فإن ذلك هو ما يحاول نظام الأسد القيام به بالضبط.. فقد انسحبت قوات النظام من غالبية الأراضي لأجل تركيز الموارد المتاحة على «سوريا المفيدة». أما الفراغ الذي خلفه ذلك الانسحاب، فأدى إلى ظهور عشرات الجماعات المسلحة في «أرخبيل الجهاد» الممتد من الجنوب الغربي وحتى الشمال الشرقي. ووفقا لأفضل التقديرات، فإن نظام الأسد يسيطر حاليا على نحو 40 في المائة من التراب الوطني. ولا تزال تقديرات عدد السكان القاطنين في تلك المساحة من البلاد محل شكوك، حيث تتراوح التقديرات بين 35 في المائة و60 في المائة من إجمالي عدد السكان. ويعود ذلك التناقض في جزء منه إلى حقيقة أن كثيرا من سكان سوريا مسجلون بوصفهم لاجئين لدى لبنان، والأردن.. وإلى حد ما، قضى بعض السكان جزءا من أوقاتهم في تركيا على مقربة من منازلهم السابقة، محدثين ما يوصف بـ«حركة المد والجزر البشرية» التي تشكل جزءا من التناقض ذاته.
وتضمنت النصائح الاستعمارية الفرنسية أيضا، وربما بمزيد من الأهمية، حيلة هي: تجنيد أفراد في الشرطة والجيش من بين الأقليات الدينية والعرقية. ولأجل تحقيق تلك الغاية، طُبقت مجموعة أخرى من الحيل.
فمن خلال التباهي بـ«هوية الجمهورية العلمانية»، قولبت فرنسا نفسها في دور «حامي حمى المسيحيين في بلاد الشام».
ومولت الحكومة الفرنسية جهود إرسال عشرات الأقليات المسيحية إلى الداخل السوري، وسددت تكاليف ترميم كنائسهم هناك، وشجعت نشر التعاليم المسيحية في كثير من المدارس، وهو الأمر المحظور في فرنسا ذاتها.
ثم توددت فرنسا إلى «الطائفة النصيرية»، التي تغير اسمها لاحقا ليكون «الطائفة العلوية»، بوعود بإقامة دويلة صغيرة على طول الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط. وابتلعت الطائفة النصيرية تلك الحيلة الفرنسية وصارت من أشد المؤيدين للوجود وللحكم الاستعماري الفرنسي في البلاد.
وتوددت فرنسا كذلك إلى الأكراد، وهي الأقلية العرقية الرئيسية في الشمال الشرقي من البلاد، وذلك عن طريق تأسيس معهد لدراسات ثقافتهم العرقية، والسماح بحرية التحرك عبر الحدود مع الدولة التركية الناشئة حديثا، ومع العراق كذلك. أما بالنسبة لبقية الأقليات، ومن بينهم الدروز والتركمان، فقد استمالتهم فرنسا أيضا بمجموعة متنوعة من الحيل، ومن بينها دعوات وجهت لزعماء تلك الأقليات لزيارة باريس والسماح لأبنائهم بالدراسة في المدارس الفرنسية الراقية.
بُذلت كل تلك الجهود تحت مظلة ثيمة رئيسية واحدة، ألا وهي التحذير الفرنسي من أن عدم التعاون مع الحكم الاستعماري للبلاد سيؤدي إلى إبادة الأقليات السورية على يد الأغلبية السنيّة المسلمة. وللتيقن من وصول الرسالة للقاصي والداني، قام الفرنسيون برشوة عدد من قادة المجتمعات المحلية. وتظاهر الشباب في تلك الأقليات بالتطوع لخدمة فرنسا.. أما من الناحية العملية، رغم ذلك، فقد تعرض كثيرون من أولئك الشبان للاختطاف على يد عصابات التجنيد وأجبروا على الالتحاق بالخدمة في الجيش والشرطة الاستعمارية.
يوثق السيد دانيال نيب في كتابه الرائع «سوريا تحت الانتداب الفرنسي»، الذي نُشر في عام 2012، لحالة العنف التي استخدمها الاستعماريون الفرنسيون للاحتفاظ بسيطرتهم على البلاد بمعاونة المجندين من الأقليات.
واليوم، يستخدم نظام الأسد حيلا مماثلة من خلال محاولة تعزيز «تحالف الأقليات» عن طريق استخدام البعبع السني المسمى «داعش»، أو «ISIS» اختصارا باللغة الإنجليزية. ومن السهولة بمكان تناسي أن «داعش» قتل بالفعل كثيرين من المسلمين السنّة ودمر كثيرا من البلدات والقرى السنية. وبالتالي، فإننا نرى مشهدا غريبا للغاية يتشارك فيه تنظيم «داعش» مع نظام بشار الأسد في رقصة الموت الثنائية.
أخبرتني مصادر من الأقليات المسيحية والدرزية والتركمانية أن عصابات التجنيد، التي تضم فيما بينها أحيانا عناصر من مقاتلي «حزب الله» اللبناني ومعلميهم من إيران، تحاول إجبار أو إغراء بعض الشباب على الالتحاق بآلة القمع الأسدية نصف المتهالكة والمدعومة من موسكو وطهران.
ليس استخدام جنود الأقليات في خدمة الحكم الإمبريالي بالشيء الجديد؛ فلقد كان جيش الملك الفارسي زركسيس الذي اجتاح أثينا قديما يتألف في معظمه من جنود الأقليات من مختلف أصقاع الإمبراطورية الفارسية. وفي روما، استخدم الملك «سكيبيو الأفريقي» جنودا من هيسبانيا وأفريقيا في حملته الناجحة ضد القرطاجيين تحت قيادة هانيبال. ومنذ عصر الإمبراطور أغسطس فصاعدا تكوّنت أكثرية الفيالق الرومانية من جنود الأقليات من القارات الثلاث.
أما في الآونة الأخيرة، فاعتمدت الإمبراطورية البريطانية في الهند بشكل أساسي على المجندين من تلك الأقليات مثل المسلمين والسيخ، ناهيك بأقلية «الغوركا» النيبالية (المعروفة فارسيا باسم: «الباحثون عن المقابر»)!. وقد أسست فرنسا الفيلق الأجنبي لتجنيد الأقليات من جميع أنحاء العالم. وقد بنى الملك البلجيكي ليوبولد لنفسه إمبراطورية في أفريقيا من خلال جيش من المرتزقة جنده من أكثر من 30 جنسية مختلفة.
وأحد الدروس المستفادة من التاريخ أنه حتى أفضل الجيوش تدريبا وتنظيما إذا تألف في معظمه من الأقليات، فلا يمكنه الحيلولة دون زوال نظام مفروض ضد رغبات الأغلبية. ورغم تمتعهم بوفرة في العتاد والسلاح، فإن البريطانيين أُجبروا في نهاية المطاف على التخلي عن إمبراطوريتهم الهندية. وفشل الفرنسيون في ترويض سوريا، ومن ثم الاحتفاظ بقبضتهم على الجزائر، على الرغم من التجنيد واسع النطاق للمقاتلين الجزائريين الموالين لهم.
من غير المتوقع لنظام الأسد ومن يدعمونه في طهران وموسكو، أن يخرج أداؤهم بصورة أفضل. ومع ذلك، ومن خلال تلك اللعبة الخبيثة من وضع مختلف المجتمعات والأقليات في مواجهة بعضهم بعضا، يمكنهم أن يخرجوا بقالب جديد من الشكوك والكراهية المتبادلة التي سوف تجد سوريا المستقبلية، المحررة كما نأمل جميعا، صعوبة شديدة في تجاهلها في المراحل الأولى من النهضة الوطنية الجديدة على أدنى تقدير.
ليست الحرب في سوريا بين الأغلبية والأقلية من سكان البلاد؛ بل إنها حرب بين الشعب السوري بأسره، الذي يرغب في الحياة بحرية وكرامة، ضد نظام الأقلية الحاكمة الذي يزعم أن له توجهات اشتراكية، وعلمانية عربية، ومع ذلك، فهو يلعب لعبة استعمارية مثالية بالنيابة عن سادته في الخارج.
 ٢١ نوفمبر ٢٠١٤
٢١ نوفمبر ٢٠١٤
لطالما كان ينتابني الخوف، حين أعبر الحدود اللبنانية زائراً دمشق. ولطالما كنت أصاب بالقلق، كلما كان عليَّ أن أراجع فرع فلسطين في منطقة "عين الكرش"، لأطلب الموافقة لمغادرة دمشق، عائداً إلى لبنان، بعد أن أكون قد حصلت على موافقة من المخابرات لدخولها. كان هذا في السبعينيات وإلى منتصف التسعينيات، فقد كان على الفلسطيني المقيم في لبنان أن يحصل على موافقة المخابرات السورية، للدخول إلى سورية والخروج منها. لكي تعرف هذه الأجهزة متى دخلت ومتى خرجت، حتى ولو كان هدفك مجرد زيارة ليوم واحد، ترى فيها الأقارب اللاجئين هناك منذ عام 1948.
ومع صعوبة الرحلة، وما تحمله من قلق وخوف، كنت أحبّ سورية، وكنت أحس بأنني سوري، فقد تأثرت في مراهقتي المبكرة بكتابات أنطون سعادة، وإن لم أقترب من حزبه. كانت لغته العربية هي ما جعلتني ألجأ إلى أفكاره، أو ربما اعتزازه باللغة وآفاقها الرحبة في بلاد الشام.
منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية السورية ضد نظام الاستبداد البعثي في مارس/ آذار 2011، وجدتني مندفعاً في تأييدها في ما يشبه زعزعة الروح. لقد عشتها كسوريّ، لا بل عشتها كفلسطيني، أو ربما كسوري، ولكني حتماً عشتها كفلسطيني، فقد كنت، دائماً، أعتقد أن النظام البعثي في سورية استكمل في تعامله مع الفلسطينيين ما بدأته إسرائيل، منذ قطّعت أوصال فلسطين، وقطعت زمنها ومسارها الطبيعي، حين هشمت كينونتها، وأحدثت ذلك القطع القسري في تاريخها وجغرافيتها، وجعلت من هذه الكينونة نتفاً جهد الشعب الفلسطيني، بكل عناصره، في لملمتها، وإعادة تشكيلها جسماً يقاوم الزمن، ويخلق من الألم والتشظي فسحة لإعادة تشكيل الذات التي تعرضت إلى أبشع عملية ذبح.
كفلسطيني مقيم في لبنان، عشت تجربة الصراع الدموي الذي خاضه النظام البعثي السوري ضد الوطنية الفلسطينية، كما ضد الوطنية اللبنانية، وخبرت سعيه الدؤوب إلى إحكام قبضته الخانقة لشعبه على مصير القضية الفلسطينية، وقد وصلت سياسته تلك إلى ذروتها في الحرب الأهلية اللبنانية، وتدخله العسكري في لبنان، لتحجيم الحركة الوطنية الفلسطينية، وحشرها تحت إبطيه ورقة للمساومة، هي وشقيقتها الحركة الوطنية اللبنانية.
كنت في مخيم عين الحلوة حين قصفت راجمات الصواريخ السورية، روسية الصنع، المخيم ومدينة صيدا، وقتلت عشرات المدنيين بلا تمييز، وكنت في بيروت، حين قدّم النظام دعمه الفاعل لميليشيات الكتائب في حصار تل الزعتر، وتدميره لاحقاً. وكنت في صيدا، حين تم حصار المخيمات في شاتيلا وبرج البراجنة والرشيدية، فيما سميّ حرب المخيمات التي دعم فيها النظام حركة أمل. وزرت مخيم البداوي صحافياً، أسابيع قبل قصف النظام وأتباعه المخيم لإجبار ياسر عرفات ورفاقه للخروج من لبنان نهائياً عام 1983، لإضعافه وإضعاف موقفه السياسي أمام الضغوط الدولية، ودفعه لاحقاً إلى اللجوء مطروداً من شمال لبنان، على بواخر فرنسية إلى مصر كامب ديفيد، في طريق عودته إلى تونس.
في السنوات الأربع الأخيرة من النزيف السوري، لم أجد نفسي بعيداً عن آلام الشعب السوري، ولو قيد أنملة، وقد رأى بعض أصدقائي أن ما يدفعني إلى هذا الموقف ليس أكثر من أسباب شخصية، فقد قُتل أخي نزار في صيدا في يونيو/ حزيران، حين اقتحمت الدبابات السورية المدينة. وذهب بعض هؤلاء الأصدقاء بعيداً في تفسير موقفي (الشخصي)، لأن زوجتي سورية، وهي، مثل سوريين كثيرين، لم يعد في وسعها العودة إلى بلادها، بسبب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد معارضيه.
تلك هي الزعزعة التي أصابت روحي، منذ صرخ الشعب السوري منادياً بحريته، فلم يعد ممكناً، لا على المستوى الشخصي، ولا العام، أن أقبل المواقف التي تبرر لهذا النظام وحشيته، ولم أعد آسفاً على اندثار بعض الأصدقاء من حياتي.
 ٢١ نوفمبر ٢٠١٤
٢١ نوفمبر ٢٠١٤
في مناسبة اليوم العالمي للطفل، أو حقوق الطفل، ضمن صيغة أخرى لإحياء المناسبة؛ رصدت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الإحصائيات التالية حول الطفل السوري: مقتل 17.268 بأيدي قوّات النظام المختلفة، بينهم 518 برصاص القناصة؛ واعتقال 9500، قضى منهم تحت التعذيب ما لا يقلّ عن 95 طفلاً؛ وجرح 280 ألفاً، ونزوح 4.7 مليون، وحرمان 2.9 مليون طفل لاجىء، ومليونَيْ طفل داخل سوريا، من التعليم. هنالك، إلى هذا، 18.273 تيتموا لجهة الأب، و4573 لجهة الأمّ، ضحايا قوّات النظام في الحالتين؛ كما ولد في مخيمات اللجوء قرابة 85 ألف طفل. فصائل المعارضة المسلحة المختلفة كانت، من جانبها، مسؤولة عن مقتل 304 أطفال، و»داعش» قتلت ما لا يقلّ عن 137 طفلاً، واعتقلت 455، وجندت المئات…
كلّ هذه الويلات، فضلاً عن أكثر من 130 ألف قتيل، وتخريب الزرع والضرع والحجر والعمران والبنى التحتية واقتصاد البشر وأوابد التاريخ؛ وقعت دفاعاً عن بقاء نظام «الحركة التصحيحية»، ذلك الانقلاب العسكري الذي نفّذه حافظ الأسد ضدّ رفاقه في الحزب والحكم، والذي مرّت، يوم 16 من هذا الشهر، 44 سنة على جثومه فوق صدور السوريين: 30 سنة تحت نير حافظ الأسد، و14 سنة تولاها وريثه بشار. ومنذ العلائم الأولى لابتداء سيرورة إعداد الإبن الثاني لوراثة الأب، بعد مقتل الإبن الأوّل، باسل، سنة 1994؛ كنتُ، وهكذا أظلّ اليوم أيضاً، في صفّ الذين آمنوا بأنّ الوريث ليس سوى وليد الماضي، كما أنه صنيعته ورهينته في آن معاً؛ ولا مفرّ له من أن يحكم في إهاب المشارك الفاعل والأساسي في عمليات إعادة إنتاج الماضي وتكريسه وشرعنته، وإسباغ القدسية عليه أيضاً.
كما آمنت، استطراداً، أنّ نظام الأسد الابن، لأنه استمرار صرف لنظام الأسد الأب، ولأنه معدَّل نحو الأسوأ في بنود كثيرة؛ لن يكون عاجزاً عن التطوير والتحديث والتغيير والإصلاح، وسوى هذه من مفردات جرى التشدّق بها في تدشين التوريث، فحسب؛ بل يظلّ، من حيث طبيعته البنيوية ذاتها، مناهضاً لعناصر التبدّل تلك، عازفاً عنها إرادياً، ومعادياً لها موضوعياً: أية بارقة تحوّل جوهري سوف تهزّ الكثير من أركان عمارة النظام، ولعلها تؤذن بأولى علائم تفسّخه وتداعيه. ولقد احتاج الأمر إلى أسابيع قليلة ـ أعقبت كارنفالات التهريج على مقاعد ما يُسمّى «مجلس الشعب»، وتعديل الدستور (الهزيل، الفردي، الدكتاتوري… الذي فُصّل على قياس الأسد الأب نفسه!) بما يلائم سنّ الإبن الذي لم يكن قد بلغ الأربعين يومذاك ـ حتى أثبت الوريث أنه أبن أبيه، في الاستبداد والفساد والسلطة العائلية والتخريب الوطني والحشد الطائفي… بل زاد على الأب، وبزّه، في التشبث بسلطة متوّجة بالدماء والجماجم والخراب والكوارث.
ففي المناسبة الدستورية الأولى لعهده، أي الاستفتاء الرئاسي، كانت الموافقة بنسبة 97.29٪ بمثابة لطمة عنيفة ذكّرت المواطن السوري بما كان يتكرّر في الماضي من نِسَب مماثلة عند التجديد لانتخاب الأسد الأب؛ الأمر الذي شكّل، في كلّ مرّة، مصادرة صريحة للعقل الطبيعي والمنطق السليم. وكانت تلك النتيجة تؤكد سريان مبدأ انطباق الحافر على الحافر، لجهة علاقة السلطة مع الشعب، ثمّ مع القانون والشرعية والحقّ؛ كما كانت خطوة، مبكرة وفورية، على طريق وضع سوريا في فجر السنة الأولى من عقود «الحركة التصحيحية ـ 2».
وفي المناسبة الدستورية الثانية، أي خطاب القسم الشهير، أعلن الأسد أنه لا يملك «عصا سحرية لتحقيق المعجزات». وفي الواقع لم يكن أحد يطالبه بإشهار عصا سحرية، أو يفترض الحاجة إليها؛ قبل أن يتمكن «الرئيس الشاب» ـ كما كان يُلّقب، حتى في أوساط بعض المعارضين ـ من إلزام نفسه أمام الشعب بإلغاء الأحكام العرفية، أو إعادة تنظيم الحياة السياسية بما يكفل بعض التعددية وبعض الحريات في التعبير والتجمّع والتنظيم، أو إصدار عفو عام، أو سنّ جملة من القوانية الإدارية والتنظيمية «التي بات المجتمع بحاجة ماسة إليها»، على سبيل الأمثلة فقط.
وفي المناسبة الدستورية الثالثة، أي بدء أعمال ما يُسمّى «مجلس الشعب» الجديد، ربيع 2003؛ شنّ الأسد حملة شعواء على المعارضة السورية، بحيث بدا وكأنها السبب الوحيد في بلاء سوريا، والورم الخبيث الذي يتوجب استئصاله على الفور، دون تهاون أو شفقة أو تردد! النظام، الرأكد العاجز عن التبدّل والتطوّر والإصلاح، ليس جوهر المشكلة، أو أمّ المشكلات جميعاً؛ بل هي المعارضة التي تجهل معنى مصطلح الديمقراطية، أو تسيء فهمه، أو تطرحه في غير أوانه. والفاسدون، الذين ينهبون الوطن ويستنزفون طاقاته وثرواته، ليسوا مصدر قلق أو سخط؛ بل هم المعارضون الذين يرون أنّ الديمقراطية «حلّ لعقدهم النفسية على حساب الآخرين»!
في السياسة الخارجية لـ»الحركة التصحيحية»، كانت تسعة أعشار الخطوط العريضة التي صاغها الأسد الأب مسخّرة لخدمة الهدف الأكبر والأساسي، أي الحفاظ على أمن النظام واستمراره في البقاء، وخلق شروط داخلية وإقليمية تُكسبه ما أمكن من أسباب القوّة والمنعة والقدرة على المناورة الواسعة، وتنظيم الهجوم المضادّ في الوقت المناسب. هدف آخر، مكمِّل في الواقع، كان يسعى إلى ضمان سكوت القوى الكبرى عن سياسات الاستبداد والبطش وقهر الحرّيات التي يمارسها النظام ضدّ الشعب في الداخل (وأبرز الأمثلة عليه ذلك السكوت الدولي الفاضح عن حملات الاعتقال المتواصلة، وسلسلة المجازر التي ارتكبها النظام بين 1979 و1982، خصوصاً مجزرة حماة، 1982).
كذلك توجّب أن تخلق السياسة الخارجية ما يشبه الاقتصاد التمويلي، كما في ابتزاز مجلس التعاون الخليجي عن طريق التحالف مع إيران أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية. وتوجّب أن تُستثمر جميع خيارات السياسة الخارجية في تحويل النظام إلى لاعب إقليمي لا يُستغنى عنه، سواء عن طريق تقديم الخدمات (المشاركة عسكرياً في تحالف «حفر الباطن»)، أو التلويح بإفساد هذه اللعبة أو تلك (بسط السيطرة على لبنان، وتوظيف ورقة «حزب الله» بصفة خاصة، واحتضان «جبهة الرفض» الفلسطينية، وتحويل القضايا الكردية إلى ورقة مقايضة وضغط على تركيا والعراق عن طريق رعاية «حزب العمال الكردستاني» أو دعم جلال الطالباني، أو تطويع بعض التنظيمات السياسية الكردية في منطقة الجزيرة…).
وبالطبع، كان من البديهي أن تدخل في هذا المخطط رغبة جامحة، في استرداد ما يمكن من أرض الجولان المحتلّ؛ خصوصاً وأنّ الأسد الأب كان وزير الدفاع حين سقطت الهضبة تحت الاحتلال الإسرائيلي، خلال هزيمة 1967، وكان رئيس الجمهورية حين خسرت سوريا المزيد من الأراضي والهضاب والتلال الستراتيجية في حرب تشرين 1973. وطيلة أربعة عقود ونيف من حكم «الحركة التصحيحية»، عرف خطاب السلطة الكثير من المصطلحات القوموية المتنافرة المتضاربة، والجوفاء الزائفة؛ مثل «فلسطين قبل الجولان»، و»التوازن الستراتيجي»، و»السلام العادل الشامل». ولكنه أيضاً شهد افتضاح المقولات، وانكشاف الشروط، وتحرّر اللغة من المحرّمات؛ وذلك منذ أن نطق الأسد الأب بـ»كلمة السحر»، على حدّ تعبير المعلّق الإسرائيلي زئيف شيف، في لقائيه مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون (جنيف ودمشق)، حين أعلن أنّ «السلام خيار سوريا الستراتيجي، ولا رجعة عنه».
وإذْ ترتبط ويلات الطفل السوري، اليوم، بويلات سوريا كلها، على امتداد 44 سنة؛ فإنّ هذا الماضي لا يستقبل أواخر أيام «الحركة التصحيحية»، ويؤشر على احتضار استبدادها وفسادها وحكمها العائلي، فقط؛ بل يبشّر السوريين بآخر الأحزان، أيضاً، وختام الآلام.
 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014، عرض المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي مستورا على مجلس الأمن الدولي، خطة تحريك للوضع تقوم على إنشاء مناطق "خالية من النزاع"، وصفها "بالمناطق المجمدة"، مشيرا إلى أنها قد تبدأ بمدينة حلب. وبعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال دي مستورا في بيان إنه "أحيط علما بعزم السلطات السورية العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ اقتراحه حول تجميد الصراع بشكل تدريجي".
"مصطلح المناطق المجمدة ليس له رديف في معجم القانون الدولي، فهناك مناطق عازلة، ورديفها محايدة، وثمة مناطق منزوعة السلاح وأخرى عسكرية (أو أمنية)، ورابعة ذات حظر جوي، وخامسة محتلة، وسادسة خاضعة للوصاية"
بداية، يمكن القول إن مصطلح "المناطق المجمدة" ليس له رديف في معجم القانون الدولي، على الرغم من أن بمقدور الباحث العثور عليه في بعض دراسات الجيوسياسة التاريخية، سيما تلك التي صدرت في فرنسا.
في القانون الدولي، هناك مناطق عازلة ورديفتها محايدة، وثمة مناطق منزوعة السلاح وأخرى عسكرية (أو أمنية)، ورابعة ذات حظر جوي، وخامسة محتلة، وسادسة خاضعة للوصاية. وهناك تقسيمات قانونية فرعية لكل نوع من هذه المناطق.
في ما يرتبط بمصطلح "المناطق المجمدة"، يمكن الحديث عن ثلاثة مفاهيم متباينة تتقاطع فيما بينها، دون أن يعبر أحدها عن الآخر. المفهوم الأول عسكري، والثاني مدني، والثالث سياسي.
يدور المفهوم العسكري حول وقف الأعمال الحربية، أو العسكرية عامة. ويشمل ذلك توقف الاشتباكات و/أو/ إخراج الأسلحة الثقيلة، وخروج القوى المسلحة -جزئيا أو كليا- من الأحياء والأماكن المعنية.
هذا المفهوم أشبه بالحاجز الفيزيائي الذي لا يُغيّر شيئا من طبيعة المعطيات السابقة له أو اللاحقة عليه، في حين أن هذه المعطيات (السابقة واللاحقة) قد تتغير في وقت ما استنادا إلى عوامل ذاتية، أو ذات صلة بالمحيط الأوسع.
وبمعنى آخر، إذا افترضنا أن حلب المدينة ستكون "منطقة مجمدة"، فإن هذا التجميد في حال استناده إلى مفهوم عسكري، لن يُغيّر من جوهر المعادلة الأمنية القائمة فيها، حتى بافتراض سحب الأسلحة الثقيلة، وانسحاب قسم من المجموعات المسلحة، فجوهر الأمن لا يتغيّر بمجرد حدوث تحوّل جزئي في موازين القوى، أو في معادلة القوة ذاتها.
من ناحيته، يشير المفهوم المدني للمناطق المجمدة إلى عملية شبيهة بالدفاع السلبي. وهذا المفهوم -أو التجلي- مفيد في بعض نواحيه، لكنه ليس مثاليا.
في جوهره، يشير المفهوم المدني إلى تطبيع الحياة العامة دون المساس بخارطة القوة، والانتشار العسكري لفرقاء الصراع.
وفي ظل هذا المفهوم، يجري وضع الترتيبات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة للمدنيين، والتأكد من قدرتهم على مزاولة أنشطتهم الحياتية والاقتصادية، والاطمئنان إلى انسياب السلع والخدمات الأساسية.
هذا المفهوم -رغم جاذبيته وارتباطه بالضمير الوطني- يُمثل في جوهره أو في خواتيمه نوعا من إدارة الأزمة، ولا يُشير بالمدلول الإجرائي إلى ما هو أبعد من ذلك.
"استنادا إلى أن قاعدة أن السياسة لا تمثل على الدوام امتدادا خطيا للأمن، فإنه -بالنسبة لنظام الأسد- عوضا عن الإمساك عسكريا بحلب، تقرر تسييلها في صورة ربح سياسي مؤكد عنوانُه التجميد"
وفي الأصل، تمثل حياة المدنيين أولوية تتقدم كل الأولويات، بيد أن استقرارهم الفعلي يصعب تحقيقه استنادا إلى منطق إدارة الأزمة. وهذا المنطق قد يفرض نفسه في هذه الحالة بديلا ضمنيا عن الحلول الأكثر شمولا، أو لنقل الأكثر ارتباطا بالسياق الوطني الكلي.
وبالانتقال إلى المفهوم السياسي للمناطق المجمدة، يشير هذا المفهوم إلى عملية مرحلية تنطوي على إعادة تشكيل متدرّج للبيئتين المدنية والأمنية، على نحو دافع باتجاه تحقيق مرتكزات النظام العام الذي يشعر في ظله السكان بالثقة والطمأنينة على نحو محفز لتطبيع حياتهم وعودتهم إلى سالف عيشهم.
إن المفهوم السياسي للمناطق المجمدة في سياقه المعرفي العام يُمثل الاصطلاح الرديف -الأكثر تدرجا ومرحلية- لما بات متحققا في سوريا باسم المصالحات المحلية.
وعند الأخذ به في الحالة السورية، فإن هذا المفهوم سيعني التأكيد على مقاربة سياسية اجتماعية تتجه أفقيا نحو تعميم نماذج المصالحات المحلية، وتنحو رأسيا باتجاه الحل الوطني الشامل.
من جهة أخرى، ثمة إشكالية تفرض نفسها منهجيا على صعيد تحديد المناطق المجمدة، إذ لا تشير المراجع العلمية المتاحة -وهي في الأصل نادرة- إلى أسس موحدة أو ثابتة.
ومن الواضح لنا أن لا أحد لديه معايير محددة بهذا الشأن، فكل منطقة نزاع تُدرس ظروفها العامة أمنيا وإنسانيا، وبالضرورة عسكريا وسياسيا. كما تجري دراسة جملة حيثيات مرتبطة بالمحيط الجغرافي الداخلي والخارجي. وهذه العناصر مجتمعة يُطلق عليها مصطلح البيئة الجيوسياسية للصراع.
وهناك بُعد آخر يرتبط بما يُعرف بالرمزية الوطنية، ويشير إلى دلالات حضارية أو دينية أو سياسية ذات صلة بالمجتمع المحلي أو الشعب عامة.
وماذا عن مدينة حلب في نموذج المنطقة المجمدة؟ في ما يتعلق بحلب، اندمجت خصوصية البيئة الجيوسياسية للنزاع بالرمزية الوطنية للمدينة، ولا سيما لجهة ثقلها الكبير في الاقتصاد الوطني.
في الشق العسكري من البيئة الجيوسياسية، يمكن ملاحظة أن مسارا طويلا من المعارك العنيفة قد دار في مدينة حلب ومحيطها، كما في الطرق والأرياف المؤدية إليها. وقد انتهى هذا المسار أخيرا بوقوف الجيش على أبواب حلب وكشفها عسكريا بالكامل.
وفي الاشتقاق السياسي لهذا التطوّر، ثمة سؤال فرض نفسه على الجميع، وهو: أي ثمن يمكن أن تقبل به الحكومة السورية مقابل اعتبار المدينة "منطقة مجمدة" بعدما أضحت في متناولها عسكريا؟
وكما يعلم الجميع، ففي السياسة ليس هناك شيء من دون ثمن، أما في الأمن فالثمن عادة ما يكون مضاعفا، وهذه معادلة قديمة ثابتة.
ورغم ذلك، فإن السياسة لا تمثل دوما امتدادا خطيا للأمن، والثابت هو أن دخول الجيش إلى حلب -على شاكلة دخوله مناطق أخرى في البلاد- سيمثل حدثا مدويا، وسيتردد صداه في ما هو أبعد من الساحة الوطنية، إلى حيث أروقة العواصم الإقليمية والدولية المعنية.
وهنا، ننتقل إلى بعد آخر في البيئة الجيوسياسية للصراع.. إنه بُعد المحيط، وهذا البعد لا يرتبط بحلب، أو لا ينحصر فيها.
إن الحكومة السورية تدرك دون ريب، أن المجتمع الدولي يراقب جيشها وهو يقف على أبواب حلب ممسكا بزمام المبادرة. كما تدرك أن بعض هذا المجتمع الدولي -كالإقليمي- قد تحرك داعيا إلى وقف التقدم نحو المدينة.
وكما سبقت الإشارة، فإن السياسية لا تمثل على الدوام امتدادا خطيا للأمن. واستنادا إلى هذه القاعدة، فإنه عوضا عن الإمساك عسكريا بحلب، تقرر "تسييلها" في صورة ربح سياسي مؤكد عنوانُه التجميد.
وبهذا المعنى، تكون دمشق قد كسبت معركة حلب المدينة قبل خوضها، أو حتى دون خوضها أصلا. ولكن ماذا عن الواقع الدولي وإسقاطاته على تفاعلات الوضع السوري الراهن؟
يمكن القول إن خصوصية المرحلة أخذت حيزا مهما في حسابات السياسة -واستتباعًا الأمن- في تطورات الموقف، وانتهت الولايات المتحدة إلى القول بعدم استبعاد فرضية العمل مع دمشق لإنجاز هدف مشترك يتمثل في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد ورد مضمون هذا الموقف في كلمة لوزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقال للمرة الأولى إن "الأسد جزء من العملية".
"يمكن القول إن خصوصية المرحلة أخذت حيزا مهما في حسابات السياسة واستتباعًا الأمن في تطورات الموقف، وانتهت واشنطن إلى القول بعدم استبعاد فرضية العمل مع دمشق لإنجاز هدف مشترك يتمثل في محاربة تنظيم الدولة"
وبالطبع، هذا يترجم نوعا من التحوّل في الموقف الأميركي من الأزمة. وخطاب هيغل هذا تزامن مع دعوة الرئيس الأميركي بارك أوباما إلى إعادة تقييم السياسة الأميركية تجاه سوريا.
وقبل ذلك بأيام، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن نظيره الأميركي جون كيري أخبره بأن وجود الرئيس بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا لا يمثل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الأولوية الراهنة لديها هي مواجهة تنظيم الدولة.
هذا التطور تردد صداه سريعا في تركيا التي أعلنت أنها غير معنية بإرسال جيشها إلى سوريا تحت أي عنوان كان، بما في ذلك مقولة المنطقة العازلة التي جرى اليوم التخلي عنها بشكل نهائي.
وبالطبع، هذا موقف صحيح لأن دخول الجيش التركي إلى أي رقعة في سوريا يعني إدخال المنطقة في نفق لا يعلم أحد مداه.
وبالعودة إلى مقولة التحول الأميركي ذاته، فإنها قد تبدو أكثر وضوحا في الأشهر القادمة، وقد تتعزز -على الأرجح- في اللحظة التي تتوصل فيها الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي بشأن ملف طهران النووي، ذلك أن الإيرانيين ما زالوا يرفضون مناقشة أي قضايا إقليمية مع واشنطن قبل الانتهاء من هذا الأمر، ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم.
والولايات المتحدة مهتمة -على وجه الخصوص- بدخول إيران على خط الحرب على تنظيم الدولة. ولهذا الاهتمام أسباب مختلفة، من بينها طبيعة العلاقة التي تربط إيران بكل من سوريا والعراق.
ولأنه لا شيء في السياسة دون مقابل، فقد يكون هذا المقابل مزيدا من التأكيد الأميركي على المقاربة السياسية للأزمة السورية.
 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
العديد يتساءلون عن الأسباب وراء الشعبية المتزايده التي يتمتع بها الآن تنظيم “داعش” خصوصاً في أوساط الشباب والفقراء . وبالرغم من وحشية الأساليب التي تتبعها تلك المنظمة في قتل من تريد دون إكتراث حتى للحيثيات القانونية أو التبريرات العـقائدية لذلك القـتل ، وبالرغم من التمادي في التعبير العلني عن نواياها الدموية ، إلا أن تلك الشعبية ما زالت تنمو بإضطراد . صحيح أن النجاح يولد مزيداً من النجاح ، وأن ما أحرزته داعش من نجاحات في دك حصون الأمر الواقع في العديد من الدول قد دغدغ عواطف الجماهير الغاضبة ، إلا أن غموض الأهداف النهائية لهذا التنظيم يجعل من موضوع ازدياد شعبيته أمراً في غاية الخطورة على مستقبل المنطقة .
يـُعتبر تنظيم داعش أحد أهم قنوات التغيير المفتوحه حالياً أمام العرب . إن الظروف التي رافقت ظهور داعش والغموض الذي إكتنف بداياتها دفع الكثيرين ، وعن حق ، إلى الشك في أصولها وارتباطها بأجهزة مخابرات غربيه وعربيه ساهمت في خلقها وتمويلها وتدريبها . ولكن نجاح داعش السريع على الأرض وقدرتها على الأنتشار والأنتصار جعل منها الآن الخيار الأهم أمام العديد من الراغبين في التغيير . ولكن كيف انتقلت داعش من صفة العمالة والتبعية التي صبغتها منذ تأسيسها لتصبح ملاذاً وخـَيَاراً للعديد من الساخطين والغاضبين والراغبين في التغيير ؟؟
التغيير الأساسي لم يأتِ من داعش ولكنه جاء من موقف الجماهير منها . فنجاح داعش على الأرض ساهم في تحويلها من تنظيم صغير إلى مفهوم وفكرة (concept) تتجاوز حدود العلاقة التنظيمية التقليدية وساهم إلى درجة كبيرة في أسر أفئدة وعقول الكثيرين خصوصاً من جيل الشباب الذي اعتبرها المخرج الوحيد الناجح والمتاح أمامها وأمام الشعوب التي تعاني من أوضاع مأساوية في العديد من الدول العربية . فالألتزام بفكرة أو بشعار أسهل بكثير وأقل تعقيداً من الألتزام بعقيدة أو بتنظيم والدخول في تعقيدات العلاقة التنظيمية .
لا توجد أسس محددة تؤَطـﱢر عداء داعش لهذه الدولة أو تلك . فدولة عربية مثل الأردن مثلاً فيها ميولاً شعبية داعشية واضحة خصوصاً في بعض مدنها مثل معان التي تمتلئ جدران مبانيها بشعارات التأييد لداعش وكذلك مدن الطفيلة والزرقاء ولكنها مع ذلك تبقى بعيدة عن اهتمامات داعش وتهديداتها ، بينما دولة عربية أخرى لها تاريخ معروف في احتضان الحركات الأسلامية خصوصاً السنية مثل السعودية تتعرض لتهديدات داعش ، في حين أن دولة مثل مصر علاقاتها مع الحركات الأسلامية في الحضيض تتعرض هي الأخرى لتهديدات داعش ، بينما إسرائيل ، الدولة الغاصبة لفلسطين وللمسجد الأقصى والقـدس ، لم تتعرض لأي تهديد من داعش أو انتقاد لها حتى وهي تقصف غزة قصفاً قاتلاً ، وهذا ينطبق على أمريكا وسياساتها المعادية للحقوق العربية في فلسطين وغير فلسطين والقائدة للحلف الدولي المناهض لداعش ، لم تتعرض هي الأخرى لأي انتقاد أو تهديد من داعش ! ولكن كيف يمكن تفسير هذه المواقف المتناقضة ؟
من الواضح أن وجود هذا التناقض يعني أن أسس العداء الداعشي للغير ليست عقائدية أو دينية بل سياسية تمليها مصالح وأهداف غامضة تبعث على الشك والريبة . فالأنتقال في مسمـّى تنظيم داعش من تنظيم “دولة الأسلام في العراق وبلاد الشام” إلى “تنظيم داعش” ومن ثم “الدولة الأسلامية” ليستقر الآن تحت مسمى تنظيم “الدولة” لم يأت عبثاً بل له مدلولاته التي تعزز الشكوك بأهدافه الغامضة .
إن التلاعب بمسميات داعش هو جزء من عملية غسيل الدماغ التي يتعرض لها العرب وهو أسلوب متعارف عليه في الصراع السياسي . والهدف من عملية غسيل الدماغ هذه هو غرس القناعة لدى الناس العاديين بأن هذا التنظيم المسمى تنظيم “الدولة” سوف يؤدي إلى إنشاء “دولة” . وإذا ما تم دمج هذا المخطط بمخطط آخر موازي له تؤكد فيه أمريكا على أن عملية القضاء على تنظيم “الدولة” ، أي داعش ، سوف تأخذ مدة زمنية طويلة قد تصل إلى ثلاثين عاماً في حين أن احتلال دولة مثل العراق لم يستغرق سوى أيام ، يتضح لنا أبعاد هذا المخطط وهو إعطاء داعش الوقت الكافي لخلق أمر واقع جديد في المناطق التي تسيطر عليها يؤدي مع مرور الوقت إلى إنشاء “الدولة” أو “الدول الداعشية” على أنقاض بعض الدول العربية المستهدفة مثل العراق وسوريا وليبيا والسعودية الخ .
إن تاريخ داعش القصير ونجاحاتها الباهرة في فترة وجيزة قد عزز الشكوك في أصولها وارتباطاتها . ولكن ذلك لم يشكل عقبة أمام ازدياد شعبيتها في ظل غياب الخيارات الأخرى الفاعلة أمام الأجيال الجديدة من الشباب والشابات اللذين يشعرون بالغضب والأحباط والرغبه الدفينة في تغيير الواقع المرير الذي يعيشونه من جهة ، والأنتقام من الأنظمة الفاسدة والمستبدة التي يعتبروها الخصم الحقيقي وعدو الشعب من جهة أخرى . الوضع هو أقرب إلى نشود الخلاص عن طريق الأنتحار . إن ما نحن بصدده هو محاولة لفهم الأسباب الموضوعية نحو جنوح العديد من الشباب للأنضمام إلى داعش والقيام ، بالتالي ، بسلوك اجرامي لا يقبله عقل كوسيلة لتحقيق الأهداف ، وكذلك انضمام العديد من الفتيات إلى داعش وتقديم أجسداهن قرباناً لمن شاء من أعضاء داعش من الذكور واعتبار ذلك جهاداً حلالاً من أجل القضية “الداعشية” . والتفسير المنطقي الوحيد لهذا السلوك الأنتحاري هو الفراغ القاتل الذي خلقته الأنظمة الأستبدادية داخل مجتمعاتها وَسَعَتْ من خلاله إلى إغلاق منافذ العمل السياسي الديموقراطي أمام أفراد المجتمعات التي تحكمها .
إن الفراغ الشامل الذي صبغ الحياة السياسية في معظم الدول العربية ، وافتقاد الأجيال الجديدة من الشباب إلى إمكانية إحداث التغيير المنشود داخل مجتمعاتها واستمرار بل وتفاقم حالة الفساد والأضطهاد ، قد دفع الأجيال العربية الجديدة إلى البحث عن مخرج تـُعَاقـِبْ بموجبه تلك الأنظمة . والهدف في هذه الحالة هو إلحاق أكبر أذى ممكن بها عقاباً لها على ما فعلته بمجتمعاتها و دُوَلها مما أوصلها إلى الحضيض . وهكذا ، اكتشفت داعش أن لديها مخزون كبير من الحطب البشري الذي تستطيع حرقه للوصول إلى ما تريد ، واكتشفت أجيال الشباب أن هنالك محرقة يمكن أن تستعملها لتغيير الواقع المرير الذي تعيشه بغض النظر إذا ما كان ذلك التغيير هو المنشود وبغض النظر عن تبعات مثل ذلك التغيير على مستقبل المنطقة وشعوبها .
إن هـذا النمط من السلوك الأنتحاري المُدَمـﱢر هو أقـرب ما يـكون إلـى مفـهوم “الفـوضى الخلاقـة ” “creative chaos” الذي طرحته الولايات المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس إبان حكم جورج بوش الأبن . فأمريكا تؤمن بأن تغيير الأمر الواقع (Status quo) يتطلب أولاً حرق الواقع الموجود تمهيداً لتغييره بشكل كامل وليس اصلاحه . وهذا ، على ما يبدو هو الهدف الحقيقي وراء إنشاء تنظيم داعش ودعمه إعلامياً وتسهيل أموره المالية والتدريبية والتسليحية .
إن “الفوضى الخلاقة” قد تؤدي إلى فوضى عارمة تفتح الطريق أمام وضع جديد قد يكون نحو الأسوأ وقد يكون نحو الأفضل كونه لا يستند إلى برنامج عمل محدد بل إلى فعل وردود فعل جامحة تهدف إلى هدم ماهو قائم أولاً . إن الذي جهـﱠـزَ الأرضية أمام هذا المشروع، أي “الفوضى الخلاقة” ، هو استفحال أنظمة القمع والفساد التي سادت العالم العربي ، عِلـْماً أن رسم سياسة أمريكا في المنطقة تستند في جزء منها إلى درجة ضعف أو قوة الأنظمة العربية والموقف العربي من قضايا المنطقة . ولو نجح مشروع الأخوان المسلمين مثلاً في مصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا لكان هو البديل المفـَضـﱠل أمريكيـاً لبرنامج “الفوضى الخلاقة” حيث يتم إدخال العالم العربي في حقبة “سُبَاتٍ سَلَـَفي” يجعل “الماضي” هو “المستقبل” ويـُعيد البشر قروناً إلى الوراء. ولكن فشل مشروع “دولة الخلافة الأسلامية” كمدخل بديل عن برنامج “الفوضى الخلاقة” ، جعل المشروع الأمريكي ينحاز نحو الخيار الداعشي لإحداث التغيير من القاعدة إلى القمة عوضاً عن الخيار الأسلامي الأخواني الذي فشل في إحداث التغيير من القمة إلى القاعدة .
أمريكا ليست بالحصن المنيع أمام ارادة الشعوب الحية اذا ما توفرت تلك الأرادة . ومن هنا كان اعتماد أمريكا الشديد والأساسي على الأنظمة العربية العميلة والمستبدة لسحق إرادة شعوبـها ، وهذا يعني أن الحلف الأقوى هو ذلك الحلف بين أمريكا والقوى المؤيدة لها داخل مجموعة الدول العربية المُستـَهدَفـَةِ من مخطط التغيير من خلال برنامج “الفوضى الخلاّقة” .
ومن عجائب الأمور أن الأندفاع الأنتحاري بين أجيال الشباب نحو تأييد داعش أو الأنضمام لها يهدف جزئياً لمعاقبة هذا الحلف الشيطاني بين أمريكا والأنظمة العربية في حين أن أولئك المندفعين يبدوا غافلين عن أن داعش هي النسخة الجديدة من هذا الحلف الشيطاني ، أو هكذا ابتدأت . ولكن إذا كان هذا هو الواقع ، فماهو البديل أمام أولئك الشباب ؟ في الأوقات الحالية لا يوجد بديل فعال ، مما يعني أن البدائل الفعالة أو المقنعة قد تكون إما معدومة أو متباينة في شيطانيتها . البديل الحقيقي وإن بدا عاطفياً هو في العودة إلى ما يجمعنا كعرب وفي الأبتعاد عن ما يفرقنا . الأداة الأهم التي استعملها أعداؤنا لتفريقنا وتحويلنا إلى شعوب وقبائل متناحرة هي من داخلنا وهي الأنظمة التي حكمت العالم العربي منذ منتصف القرن الماضي ، وعلى العرب العمل على تجاوز الآثار السلبية التي علقت بالعروبة من جراء حـُقـَبْ الأستبداد التي تجاوزت نصف قرن من الحكم الجائر المستبد . والهدف يجب أن يكون في إعادة تمتين الروابط القوميه الثقافيه والعلمية والأكاديمية والفنية والمهنية والنقابية لتعويض الخلل الذي سببته الأنظمة في الحياة السياسية العربية والأقتداء بالتجربة التونسية كنبراساً هادياً لكيفية إعادة بناء اللـُحْمة الوطنية التي تعتبر أساساً هاماً وضرورياً لبناء اللـُحْمة القومية .
ترى لماذا أنشد محمود درويش وهو تحت الأحتلال “سَجـﱢل …. أنا عربي” ولم يقل “سَجـﱢل … أنا فلسطيني” ؟ لقد قال ذلك لأنه يعلم بأن العروبة هي الوعاء الأكبر وهي الوعاء الحافظ .
 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
تنعقد مشاورات كثيرة، تُناقش فيها تحولات الثورة السورية باستمرار، هذا ليس بجديد، إنه الأمر ذاته منذ أربع سنوات. فهل من معطى جديد؛ سوري، أو إقليمي، أو دولي يمكن أن يحدثَ فارقاً وينهي المأساة.
هناك موعد الاتفاق النووي 24 نوفمبر مع إيران، وهناك حرب مستمرة يشنها التحالف الدولي “ضد” داعش، ومقابل ذلك هناك رفض أميركي مستمر لشروط تركيا للتدخل في سوريا. ولكن كل هذه المعطيات قادت أميركا إلى التحالف مع إيران في العراق وفي سوريا، حيث استفاد النظام من التحالف الدولي واستمر بعملياته العسكرية في كافة المدن السورية. وبخصوص النووي، يرجح المحللون التمديد لأشهر إضافية، حيث أن أميركا لا تريد تهميش إيران، ولا غزوها كذلك، بل تحديد شكل علاقاتها الإقليمية بما ينزع عنها وهم الهيمنة في العراق خاصة وفي سوريا وفي لبنان وحتى في اليمن. أميركا لا تريد أكثر من ذلك، ولكن هل كل ما تريده أميركا يتحقق.
نعم، إيران الآن قوة حقيقية في كل هذه الدول، وإن كانت تعاني من الحصار الاقتصادي، ولديها انهيارات حقيقية في الداخل وهناك بوادر تأزم اجتماعي، ولكن هذا لا يعني أبداً أنها على وشك الانهيار، ولديها جيش صلب وهي دولة أمنية بامتياز. يكمل ذلك أن أميركا لا تفكر جدياً في حرب برية، إذن لابد من دور إيراني في المنطقة، وهو ما تقوم به بكل الأحوال، حيث تساند القوات الأميركية في العراق، وحتى في سوريا، فاستثناء النظام من الضربات العسكرية واستثناء المليشيات الطائفية الخارجية التابعة له، وعدم حدوث أي صدام بين الطرفين المسيطرين على الجو، يوضح أن هناك تفاهماً بينهما، وبالتالي لن يكون لموعد 24 نتائج مختلفة عما هو حالياً. ولكن هل ستبادل إيران التوسع المضبوط في سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن، مقابل توقيع اتفاق نهائي يخص النووي وتحجيم قدرتها النووية وفك عزلتها الاقتصادية، والحصول على ملايين الدولارات المحجوزة عنها.
لا أظن أن لدى إيران بوادر هكذا توجه، ولكنها كذلك تعلم حدة الصراعات في المنطقة بينها وبين السعودية وبينها وبين تركيا وبينها وبين إسرائيل، ووجود مشاعر رفض عربي واسع لها، وهذا ربما ما سيعمل عليه في أميركا. وهم بذلك لا ينهون المشكلات، ولكنهم يسكنونها إلى مرحلة لاحقة، يراد فيها استمرار المنطقة ضمن حد منضبط من الصراعات ذات الطبيعة الطائفية والإقليمية. في ظل كل هذا لا حلول جديدة للوضع السوري، والضغط الأميركي سيكون بصورة رئيسة من أجل تسوية الأوضاع في العراق، فهناك النفط وهناك الهيمنة الإيرانية واسعة، وهناك ضرورة أن تشارك إيران ذاتها في الحرب، ولكن بما يخفف من هيمنتها ولا ينهي التدخل فيه.
خطة ستيفان ديميستورا الموفد الدولي الجديد إلى سوريا، رديئة وتنطلق من مقاربة النظام للحل: مصالحات مع المناطق الثائرة، وإيقاف العمليات العسكرية والبدء بها من حلب، وهو ما يتوقعه النظام ويقوم بإبقاء السلاح الخفيف وتخفيف الضغط على تلك المناطق، والانسحاب لسحق منطقة أخرى، وفرض المصالحة عليها، كل المصالحات تشهد اختراقات مستمرة، فالنظام لا يؤمن بها والثوار يعلمون ذلك ولكنهم يريدون فرصة للتنفس.
الحقيقة هي أن النظام يريد تخفيف العلميات العسكرية أولاً، ليعود تالياً ويجهز على كل مصالحة، ويفرض نفسه مجدداً كما كان كنظام أمني. يستند النظام في خطته هذه إلى أن أميركا لا تزال تعطيه دوراً في أي حل سياسي، وديمستورا يعلم ذلك، ويعمل من خلال ذلك، الروس والإيرانيون يؤيدون ذلك أيضاً، وبالتالي هناك توافق دولي على تأجيل سوريا.
قوات التحالف في سوريا تنفذ ما قاله النظام وروسيا بالتحديد، فهما قالا إن في سوريا مجاميع إرهابية ويجب محاربتها، وأن الناس يمكننا التفاهم معهم، أليس هذه خطة التحالف الدولي ضد داعش، وجوهر مفهوم المصالحات أيضاً. نضيف هنا أن تسريبات تقول إن أميركا مع هكذا حل.
ما يغير كل هذا الاتجاه في التحليل للواقع، هو تغير الدور الأميركي، وهناك تسريبات مضادة لما ذكرناه تقول إن داعش لا يمكن تحجميها، دون إسقاط النظام أو المباشرة بحل سياسي فوري، ولكنها ليست جديدة أيضاً. إذن التغيير ممكن بقبول أميركا بالشروط التركية، والاستجابة للضغط السعودي بتغيير النظام أو بالبدء في التفاوض الجديد من أجل نظام جديد ووفق مبادئ جنيف الرئيسة، وهي المتفق عليها دولياً. الكلام عن مؤتمر في روسيا تتمثل فيه قوى المعارضة في الداخل وبعض الشخصيات في الخارج كمعاذ الخطيب، ويكون بمثابة إنهاءً لجنيف وبدء مؤتمر عن سوريا في روسيا هو مجرد أوراق سياسية روسية للضغط أكثر فأكثر على أميركا.
ما لا يساعد في التغيير المذكور، بقاء الخلافات العربية العربية كبيرة، وبقاء المعارضة السورية تابعة وعاجزة وفاشلة ورافضة للعب أي دور وطني يجمع السوريين، ينهي اعتباره يخدم طائفة وضد طائفة ولصالح قومية وضد قومية أخرى.
في غياب أي حل راهن، فإن اتجاه الأحداث مستمر نحو حرب سينمائية وقتل كارثي ودمار مخيف وهيمنة إيرانية مستمرة وتدخل أميركي أوسع وتركي وخليجي في شؤون سوريا ثورة ودولة ومستقبلا.
هناك سيناريو أميركي آخر يقول بالحرب لا بالحل الآن، ولا تعارضه جدياً روسيا ولا إيران، ولكنه يفيد في ترتيب العلاقات الدولية والإقليمية بين هذه الدول كافة وعلى حساب سوريا، وهو السماح بتمدد القوى الجهادية أكثر فأكثر، وحدوث تصادم أكبر مع النظام وبين هذه القوى ربما، رغم أن الميل للتوافق بين داعش والنصرة وأحرار الشام ومن يشبهها، وإن رفض داعش لعقد توافق مؤخراً ليس هو الأساس، فإنه وحتى دون الاتفاق هناك توقف للحرب بين هذه الجهاديات. الصدام بين الجهادية والنظام سيجبر الأخير على التوافق على حل.
الكارثة أن كل ذلك سيعمق البعد الطائفي في أي حل سياسي، وهذا ما سينقل سوريا إلى حل طائفي ومشكلات كبيرة تتعلق بالمستقبل. إيران تعمل مؤخرا على جيش مواز في سوريا لجيش النظام كما أشيع، وهذا ليس بجديد، ولكن تحديد قوامه بمئة ألف شخص هو الجديد. وهذا يعني أن الحرب مستمرة في سوريا، والنفوذ الإيراني باقٍ في سوريا، وربما المشروع ورقة ضغط من أجل توسيع حقوق إيران الإقليمية، وهذا مرجح جداً. إن سوريا مؤجلة الآن وإيران حليف إقليمي لأميركا.
 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
أثير في أثناء انعقاد الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لغَط كثير حول المجلس العسكري الأعلى الذي أرسل خمسة عشر مندوباً جديداً عنه إلى اللقاء، لكي يحلّوا محل خمسة عشر مندوباً، كانوا أعضاء في الائتلاف، منذ جرت توسعته عام 2012. ومع أن عملية الاستبدال طبيعية تماماً، وتعتبر حقاً محفوظاً للكتلة التي يتبع لها الأعضاء، فإن معركة نشبت حول شرعية قبول الأعضاء الجدد، لعبت دوراً كبيراً في انقسامات الهيئة حول قضيتهم والقضايا الاخرى، وخصوصاً منها مسألة الحكومة.
وكان رئيس أركان الجيش الحر الأسبق، اللواء سليم إدريس، والذي أقاله الرئيس السابق للائتلاف، أحمد الجربا، من منصبه، هو الذي أصدر قرار تعيين مندوبي الجيش الحر الخمسة عشر في "الائتلاف". وحين سئل عن الواقعة، قال إنه أصدر قرار التعيين للأشخاص الذين اقترحهم الجربا عليه، وأنه يطلب من المجلس تغطية تصرفه، لعلمه أنه ليس الجهة المكلفة بالتعيين، وهو تابع للمجلس، ولا يجوز أن يقرر شيئاً في منأى عنه، أو من دون استشارته. وقد أصدر المجلس، بناءً على طلب اللواء إدريس، قراراً تضمّن بندين، تفويض اللواء بالتعيين، والتحفظ على أسماء مَن عيّنهم. بهذه الطريقة، حصل الجربا على كتلة انتخابية تمثل الأركان، عملت طوال فترة وجودها في "الائتلاف" ككتلة انتخابية لصالح من كان معظم أعضائها يسمّونه "السيد الرئيس"، وصار استبدال أعضائها يعني تهديد أغلبيته داخل الهيئة العامة التي يفترض أنها ستجدد له بعد قرابة شهرين في رئاسة الائتلاف.
وكان المجلس العسكري الأعلى قد اجتمع، قبل نيف وشهر، في الريحانية، وقرر إقالة ممثلي الأركان الذين تحفظ عليهم منذ جرى تعيينهم، فاقترح ضيفه هادي البحرة إحلال كلمة استبدال محل كلمة "إقالة"، وأصدر، بالتعاون معه، قراراً بتشكيل لجنةٍ، تنتقي ممثلين جدداً للأركان من ذوي المؤهلات العلمية، المعروفين بنظافة الكف، وبدورهم في الثورة، وبسمعتهم النضالية الطيبة، كأنما كان البحرة يتهم من تم إقصاؤهم بالافتقار إلى هذه الصفات. وقد قبل أعضاء المجلس حضور البحرة، مع أنه ليس عضواً في المجلس، أو من الهيئة العامة التي انتخبت أعضاءه، ثم استكملوا عدد أعضائه إلى ثلاثين، بعد أن كانوا سبعة عشر فقط، بينهم من طفش إلى داعش، ومن طلب اللجوء السياسي في بلدان أوروبية، ولم يكن بينهم غير عدد قليل تنطبق عليه مواصفات البحرة. ووافق رئيس أركان الجيش الحر، العميد عبد الإله البشير، على الاستبدال، ومهر قرار إقالة ممثلي الأركان في الائتلاف بتوقيعه.
"
البحرة كان قد أصدر، وهو في نيويورك، قراراً بإقالة المجلس الأعلى، وأرسله بالإيميل إلى الأمانة العامة، لكن اللجنة القانونية أفتت ببطلانه، لأن إصداره ليس من صلاحيات رئيس الائتلاف
"
وتقول قواعد استبدال العضوية في "الائتلاف" بضرورة صدور قرار بقبول الأعضاء الجدد من لجنة العضوية، تصدق عليه اللجنة القانونية، قبل أن يصدره الأمين العام لـ"الائتلاف" بقرار. وقد حدث هذا كله من دون مشكلة. ولكن، وبما أن حضور الأعضاء الجدد إلى اجتماعات الهيئة كان يمكن أن يفجّر الائتلاف، في ظل رغبة جماعة الجربا ببقاء القديمين أعضاء فيه، فقد توافقت، شخصياً، مع الأستاذ البحرة والأمين العام لـ"الائتلاف"، الدكتور نصر الحريري، على مخرج يلزم ممثلي الأركان بقبول المادة 31 من نظام المجلس الداخلي، مع ما تتضمنه من ضرورة تشكيل مجلس أعلى للقيادة، وباعتبار "الائتلاف" مرجعية سياسية لهم. وقد أملى البحرة على الدكتور نصر النص الذي سيوقع عليه الممثلون الجدد، تمهيداً لانضمامهم إلى الهيئة العامة، لكن الطرف الآخر رفض ما توافقنا عليه. فاتني القول إن البحرة كان قد أصدر، وهو في نيويورك، قراراً بإقالة المجلس الأعلى، وأرسله بالإيميل إلى الأمانة العامة، لكن اللجنة القانونية أفتت ببطلانه، لأن إصداره ليس من صلاحيات رئيس الائتلاف الذي يعتبر غير ذي صفة بالنسبة للمجلس، وأكدت حق الممثلين في المشاركة باجتماعات الهيئة كأعضاء كاملي العضوية. فاتني كذلك القول إن الأستاذ البحرة اعترف، في عرض سياسي قدمه إلى الهيئة، بأنه "ربما يكون قد أخطأ في قراره".
ويقول بعض أعضاء "الائتلاف" إن موقفهم يتعلق بمقاومة سيطرة "الإخوان المسلمين" على المجلس وممثلي الأركان. وليس هذا القول صحيحاً على الإطلاق، فالإخوان صاروا بالنسبة لهؤلاء شمّاعةً، يعلّقون عليها أخطاءهم، ولو كانوا مسيطرين على "الائتلاف"، لما كانوا بحاجة إلى استعادة ما فقدوه في اجتماعات سابقة، لأن أحداً ما كان لينجح في انتزاعه منهم.
بقي أن نسمّي الأشياء بأسمائها، كي لا نظل غارقين في خلافات بعيدة كل البعد عن مصالح شعبنا وثورته، ونتجاهل واقعة ساطعة هي أن ممثلي الأركان وأعضاء المجلس الأعلى وافقوا على ورقة الأستاذ البحرة ووقعوها، وقبلوا أن يكونوا جزءاً من مجلس قيادة أعلى يشكله الائتلاف، إنْ صحا من موته السريري، وتخلص من انقساماته القاتلة.
 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
طرح السوريون قضية الحرية كرد على كل منظومة الاستبداد؛ أي هم مع كل حرية، في الاقتصاد والسياسة والتعليم والثقافة والدين وفي كل شيء. طُرح مفهوم الحرية كمطلق يحتمل كل شيء، ولكن كذلك أن يكون بلا أي محتوى. واقعياً، سورية حتى ربيع 2011 لا تعرف أبداً أي شيء عن الحرية. محاولات السياسة والمثقفين كلها باءت بالفشل الذريع منذ بيان الألف وإلى انطلاقة الثورة.
الخلافات المتعاظمة بينهم ولأسباب هامشية كانت توضح رأي هوبس في الإنسان كـ «ذئب لأخيه الإنسان»، وكان روسو مجرد فيلسوف يحب أن يكون الناس خيري الفطرة، أما كانط فليس له أي مكان بين السوريين، وبخاصة معاييره الأخلاقية التي ترفض سعادة البشرية قبالة موت طفل واحد. تجربة السنوات الأربع للثورة السورية، تبيّن أن السوريين مقطوعو الصلة بكل معايير الأخذ بالمواطنة ومنظومة حقوق الإنسان كمعايير أولية في تنظيم أي عمل مجتمعي، سياسي وسواه.
مناسبة الكلام، تصدّع كل القوى السياسية القديمة، وفشلها الذريع في قيادة الثورة. وبالمثل تصدّعت كل الحركات الجديدة، وكيفما دقّقنا بأي تجربة من التنسيقيّات إلى المعارضات إلى الكتائب المقاتلة ومؤسسات الحكومة الموقتة، وجدنا أنفسنا أمام حالة من التفتت والفوضى والشللية والتبعية للدولة الإقليمية والعالمية وفساد واسع يماثل فساد النظام.
كانت قضية حرية المعتقلين من أخطر القضايا، والتي نشرت عنها تقارير كثيرة توضح كارثة ما يحصل. حتى هذه القضية لم تسلم من المفاضلة بين معتقل ومعتقل وفقاً لطائفته أو تياره السياسي ومؤخراً وفقاً لقوميته، وسوى ذلك. يعلم الجميع ما يحصل في المعتقلات، ولكنهم يتعاملون مع كل القضايا بما فيه هذه القضية كمسألة للاستقطاب والصراع السياسي وما هو أدنى من ذلك. إذن المعارضة لم تقدم بديلاً سياسياً أفضل من النظام بما يخص مفهوم الحرية والحقوق التي تتضمنها.
هذه قضية لعبت وتلعب دوراً في انزياحٍ كبير عن الثورة وهناك من يلتحق بالجهادية وهناك من يغرق بالسلبية والتشاؤم، وهناك من يعود ليتصالح مع النظام، وهناك من يعود لأعماله السابقة. هذا الانفضاض، يتحقق شعبياً عبر مصالحات يعقدها النظام مع أهالي المناطق الثائرة والتي أنهكت كلية وتركت من المعارضة لكل أشكال الموت؛ النظام يعتمد هذه القضية كسياسة عامة كي يقوى تدريجياً ويتفرغ لاحقاً لدعسها بالأقدام، والعودة عنها، وإنهاء كل مظاهر التمرد؛ أي هو الآن يُبقي السلاح بيد المقاتلين ويعطيهم الحق بالسيطرة على داخل أحياء المصالحة، وليس لتثبيت حقهم في ممارسة حريتهم بل ليقتلها لاحقاً.
ليس هذا ما خرج إليه السوريون؛ فهم خرجوا للانتقال إلى حياة أفضل، وها هم الآن يعقدون مصالحات معه في كثير من المناطق. ما دفعهم نحو ذلك تركهم «فرادى» في مواجهة عارية معه، وفشل المعارضة في تمثيل قضيتهم وعدم احترامها تضحياتهم، وخضوع الدعم لشروط خارجية.
عكس الأحلام التي رافقت السوريين، أي تحقيق حياة أفضل؛ فإن المناطق «المحررة الآن» تعيش بخوف شديد من المحاكم الشرعية، وفشل السلطات الثورية الجديدة وفساد كثير من ناشطيها، ويقرأ الناس جيداً نتائج المال السياسي الفوضوي، والشخصنة، والذاتيات المتضخمة، وانبثاق العائلية والعشائرية والطائفية والجهادية في شكل واسع. أي أن حلمهم بالحرية والخبز والعمل تقلص كثيراً؛ هذا دفعهم ويدفعهم للهجرة ولإنهاء كل علاقة بالداخل، أو اعتباره مما لا يتغير أو دخلت سورية بالمجهول، ولا آمل يرتجى من أي فعل.
الحرية لا تتحول إلى حقوق للناس، ما لم تقرّ كما هي كحقوق عامة للناس على المعارضة وهدف لثورتهم ضد نظام ينفي أي وجود لها؛ من دون حق الناس بتمثيل أنفسهم في هيئات ومجالس وتجمعات، والأخذ بآرائهم، ستستمر حالة الشعور بالخذلان، وربما التصالح مع النظام أو الانسياق نحو الجهادية. قرأت مؤخراً على «فايسبوك» من كتب: من «الموت ولا المذلة» كتعبير عن صرخة الحرية ضد النظام في 2011، إلى «المـــوت أو تركيا 2014»، كتعبير عن فشل المعارضة والنظام في إبقاء أي روح وطنية لدى الشعب ودفعهم للتمسك بالخارج لحل الكــوارث التي يعيشونها وتتكاثر يومياً.
عرّف ماركس يوماً الحرية بأنها وعي الضرورة، ولاحقاً وحينما تتوافر شروط معنية لا بد من تغيير تلك الضرورة. هذه القضية، أي تشكيل وعي سياسي بأهداف الثورة، وبمعايير معينة ضابطة لممارسة الثوار وفقها، أصحبت أكثر من ضرورة، أي من دونها لن تتحقق أبداً الحرية وبقية أهداف الثورة. يقف حائلاً دونها تبسيط شديد لأهداف الثورة، وانفلات عشوائي في الممارسات المعبرة عنها.
وهذا أدى ويؤدي، إضافة لدور النظام المركزي في كل ما يحصل وحصل، إلى «الكفر» بالثورة والحرية. إذاً التوحش الذي تتعامل فيه المعارضة مع تياراتها، ومع النظام كذلك، وكردّ على النظام وكتعبير عن ممارسات شبيهة فيه، توضح أثره الشديد فيهم؛ وهنا تصح مقولة إن الثقافة السائدة هي ثقافة الطبقة السائدة؛ إن كل ذلك، كان سبباً في انتقال الثورة من الحرية إلى الجهادية، ومن إخفاء كل ما هو سلبي في بداية الثورة إلى ممارسة كل ما هو سلبي وضار بالثورة في السنوات التالية لها.
الشروط الواقعية للحرية لن تتحقق قبل بداية المرحلة الانتقالية لسورية ولن تتحقق كذلك من دون تشكل وعي سياسي ومجتمعي كما أوضحنا من قبل، حيث سيشعر الناس بالأمان، والبدء بممارسة أحلامهم وأفكارهم وحياتهم كما يشاؤون، حينها فقط سيسقطون ليس الخوف من النظام فقط بل ومن المعارضة ومن كل أشكال السلطات التي انبثقت في المناطق «المحررة الآن»، ومارست أفعالاً تماثل أفعال السلطة التي يريدون التحرر منها!.
 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
فيما واصلت مصادر عدة تأكيد أن إدارة باراك أوباما لن تتخلّى عن المقاربة التي اعتمدتها حيال الأزمة السورية، طوال أربعة أعوام، أكثر الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة من إعلان مواقف تُعتبر «جديدة» لهجةً ومضموناً. فبعدما قال في واشنطن إن «تنحية» بشار الأسد «تساعد في هزيمة داعش»، كرر في بريزبين في أستراليا أن «التعاون مع الأسد ضد داعش سيضعف التحالف». وإذ طلب من مستشاريه إجراء مراجعة لسياسة إدارته في شأن سورية، فإنه أبدى اقتناعاً أولياً باستحالة إنزال هزيمة بتنظيم «داعش» من دون إزاحة الأسد. أي أن مصير الاثنين أصبح متلازماً.
ليس مضموناً أن يتوصل المستشارون إلى نتيجة مماثلة، إذ سبق أن أبلغوا كثيرين من المراجعين العرب والأوروبيين أنهم بذلوا أقصى جهدهم لـ «حماية الرئيس» من الأزمة السورية والحؤول دون تورّطه فيها. ثم إنهم متنوعو النيات والغايات، وبينهم الكثيرون ممن يصغون إلى وجهات النظر الإسرائيلية ويأخذون بها، وفي عُرف هؤلاء أن ما تتوخاه واشنطن في سورية قد حصل من دون أن يكلّفها شيئاً، ولا داعي للتورّط الآن في ما تفادته منذ البداية. لكن، يبدو أن العنصر الذي طرأ، متمثلاً بـ «داعش» الذي ذبح ثلاثة أميركيين، وأوجب قيادة أميركا تحالفاً دولياً جديداً ضد الإرهاب، ما لبث أن فرض إعادة نظر لـ «تحقيق الانسجام» بين الاستراتيجية المتّبعة سورياً وضرورة تحقيق الهدف من «الحرب على داعش».
كان الهاجس الذي شغل أوباما وفريقه أن سقوط الأسد يعني سقوط الدولة، بما فيه من تكرار غير مرغوب فيه لما حصل في العراق بعد الغزو الأميركي. وكانت روسيا وأميركا حبّذتا دائماً حلاً سياسياً يحافظ على الدولة والجيش، ما يتيح عملية انتقالية منضبطة وقليلة الأخطار. وقد استخدم الروس في محادثاتهم مع الأميركيين احتمال انهيار الدولة للدفاع عن ضرورة بقاء الأسد وتوليه قيادة أي حل، وكان الجانبان مقتنعين بأن المعارضة لم تستطع تقديم «بديل من الأسد»، بل إن انقساماتها بدّدت قدراتها على القيادة وأثارت المخاوف لدى الأقليات، وإذ اعتبرا أن «البديل» الأفضل ينبغي أن يأتي من داخل النظام فإنهما لم يرسلا إشارات جدية لإبراز أي بديل كما اصطدما بحرص النظام على إقصاء أي شخص قد يشكّل مشروعَ بديل. وفي العامين الأخيرين انتقلت «ورقة البديل» كلياً إلى أيدي الإيرانيين.
كان ينقص هذا الهدف - الحفاظ على الدولة، وهو مشروع مبدئياً، أن يكون الأسد معنياً بهذه الدولة ومؤتمناً عليها، لكنه واظب طوال الأزمة على موقعه كـ «عدو لشعبه». وفي بحثه الدائب عن حل عسكري، واستبعاده أي حل سياسي حقيقي، واستخدامه الإرهاب لضرب المعارضة أو لاختراق مناطقها وتشويه صورتها، غلّب شعار «الأسد أو نخرب البلد» على سيناريوات تعزيز الدولة لاستعادة مواطنيها كافةً. ومع الوقت راحت هذه «الدولة» تتهرّأ وتتآكل، ولم تعد موجودة إلا بالسطوة، ولولا الرعاية اللصيقة من جانب إيران لكان النظام تفسّخ وتلاشى.
ما إن أنجز «داعش» سيطرته في مناطق عراقية وربطها بمناطق سورية عاكفاً على تحقيق مشروعه («الدولة الإسلامية») حتى تغيّرت الظروف والأحوال بالنسبة إلى الأسد ونظامه. فحتى «الحليف» الإيراني، وكذلك الروسي، يبدوان حالياً كأنهما أيضاً في صدد مراجعة حساباتهما تجاهه، وعلى رغم استمرار حاجتهما إليه إلا أنهما لم يعودا مقبلين على الاستثمار فيه. فعلى سبيل المثل، رفضت موسكو أخيراً منحه قرضاً ببليون دولار كان طلبه، وباشرت تحركاً لطرح مبادرة سياسية من دون تنسيقٍ مسبق معه، ولعل هذا ما يفسر معاودة اعتقال المعارض الناشط لؤي حسين. أما طهران التي لمست حاجته إلى الوقود، بعد استيلاء «داعش» على مواقع النفط، فلم تسارع كعادتها الى إمداده، بل إنها على المستوى السياسي تقترب أكثر فأكثر من المساومة عليه إذا حصل اختراق في المفاوضات النووية.
أصبح على النظام أن يحذر من حليفيه اللذين أربكهما تفجّر الخطر «الداعشي» فأدّى عملياً إلى شيء من التهميش لروسيا بوجودها خارج «التحالف» وانغماسها في الأزمة الأوكرانية، كما ضيّق الهامش الذي كانت تلعب فيه إيران. وعلى افتراض أن النظام يرغب في طرح مبادرةٍ ما، وهو ما لم يفعله أبداً، فإنه فقد القدرة والأهلية، ولم يعد متاحاً له تجاوز الإيرانيين. فبمقدار ما يدرك أهل النظام مدى اعتمادهم على إيران صاروا يتحدثون بمرارة عن «مندوبيها السامين»، كما يسمّونهم. ولعل قصة إطاحة حافظ مخلوف ذات دلالة، إذ نشبت خلافات بين مخلوف رئيس «القسم 40» المعني بأمن دمشق وعدد من رؤساء الأجهزة الأخرى، وفي طليعتهم رفيق شحاده رئيس الاستخبارات العسكرية الذين احتجوا لدى الأسد على ممارسات ابن خاله، وفي اجتماع ضم هؤلاء الرؤساء (إلى شحادة، جميل حسن وديب زيتون وعلي المملوك ورستم غزالة) أثار بشار استياءهم برفضه مآخذهم على مخلوف مؤكداً دعمه له، ويبدو أن بعضهم اشتكى لدى الإيرانيين، فقصد «المندوب السامي» الإيراني الاسد ولم يخرج من مكتبه إلا بعد حصوله على إقالة مخلوف.
مع بداية الضربات الجوية على «داعش» والتطمينات التي تبلغها من العراقيين، نقلاً عن الأميركيين، قدّر الأسد أن الحرب تصبّ في مصلحته، فـ «التحالف» يتكفّل بـ «داعش» والنظام يتكفّل بالمعارضة ومناطقها، لذا ضاعف القصف بالبراميل وشدّد الحصار هنا وهناك، خصوصاً على حلب التي تتسابق «جبهة النصرة» و «داعش» على استكمال حصارها من جهة الشرق. وما عزز حسابات النظام أن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا جاءه بخطة هدنة لتخفيف حدّة الصراع، «بدءاً من حلب»، ففهم الأسد أن الأولوية الدولية هي لمحاربة الإرهاب، بالتالي فإن الفرصة سانحة أمامه للإجهاز على المعارضة بدءاً من حلب، لذلك رحّب بالخطة، وكذلك فعلت طهران. في دوائر الأمم المتحدة وأمانتها العامة يكثر الحديث يوماً بعد يوم عن دي ميستورا الذي يبدي تعاطفاً ملحوظاً مع النظام ولا يتواصل إلا مع عواصم تؤيده، كما أن الخطة التي عرضها ليست متوازنة وتفتقر إلى آلية مراقبة، بل تبدو كأنها تدعو النظام إلى حصد ثمار حصاره مناطقَ المعارضة. وفيما خلص تقرير للجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سورية، إلى أن «الفشل السياسي في معالجة الأزمة هو ما أدّى إلى تفاقم التطرّف وظهور داعش»، لم يكن واضحاً أن «هدنة دي ميستورا» تستند إلى خطة سياسية موازية يمكن أن تشكّل دعماً لـ «الحرب على داعش».
هذا ما أتاح لروسيا رؤية ثغرة تعاود من خلالها ممارسة دور كان توقف منذ فشل «مؤتمر جنيف - 2» وتعطّل كلياً مع تشكيل «التحالف ضد الإرهاب». ولم تطرح موسكو جديداً مع الوفد الذي زارها برئاسة معاذ الخطيب، بل حاولت تنقيح اقتراح «حوار واتفاق بين الحكومة السورية الشرعية والمعارضة» سبق أن طرحته حين كانت المعارضة (والنظام) في وضع أفضل مما هما عليه الآن. وكالعادة لم يُفهَم من التصريحات الروسية أن موسكو أجرت مراجعة لمواقفها الأساسية، أو أنها قادرة على التأثير في موقف النظام (وإيران)، لكنها تريد فقط استغلال ضعف المعارضة. أما جديدها فهو أنها تحاول الاستعانة بمصر التي وضعت أفكاراً لمبادرة لم تعلنها وتركّز فيها على حوار بين النظام والمعارضة.
خلال زيارته العراق أخيراً قال رئيس الأركان الأميركي مارتن ديمبسي إن القوة العسكرية لن تقضي على «داعش» ما لم تنجح الحكومة العراقية في «إنهاء الانقسام بين السنّة والشيعة في البلاد»، وإن بناء الثقة يتطلّب وقتاً. طبعاً، هناك أسباب تدعم ولو بحذر هذا الرهان في العراق، فحكومة حيدر العبادي تمثل مختلف الأطراف، وهناك برلمان منتخب، وسعي إلى إعادة هيكلة الجيش. أما بالنسبة إلى سورية فكل المبادرات تصطدم بمشكلة اسمها بشار الأسد، وبنظام لا يملك أية مقومات تؤهله لبلورة أي حل توافقي. والأهم أنه ساهم في تغذية «الإرهاب الداعشي» ويعوّل عليه الآن للبقاء في الحكم. لكن معادلة «إما الأسد أو داعش» آخذة في التحوّل إلى «لا داعش ولا الأسد».
 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
كثر في الآونة الاخيرة عمليات الخطف والاعتقال التعسفي من قبل مجموعات ملثمة تقوم بعمليات دهم واعتقال نشطاء او عسكريين او مدنيين او تجار ليستمر اختطافهم لعدة ايام ثم يعثر على جثامينهم مرمية على احدى المفارق او مكبات القمامة وقد كبلت ايديهم وعصبت اعينهم وتم تصفيتهم رميا بالرصاص دون معرفة الاسباب او من يقف وراء اعتقالهم .
يترافق ذلك مع اختفاء العشرات من الشبان على الطرقات لأيام وقد تطول لأشهر ليعثر عليهم على احدى الطرقات جثث هامدة وقد سرقت ممتلكاتهم من دراجة نارية او سيارة او ما شابه ذلك وتكثر هذه الاحداث في ريف معرة النعمان الشرقي وكفرنبل في ظل عجز كامل لعناصر القوى الثورية على الارض في معرفة وكشف هذه المجموعات ولاسيما بعد ان انتقلت لمرحلة التصفيات المباشرة عن طريق زرع عبوات ناسفة على اطراف الطرقات او المقار الامنية او السيارات الخاصة بشخصيات معينة بغية قتلهم والتخلص منهم لأسباب لا تخدم الا النظام المجرم الذي يسعى لتصفية رموز الثورة ولاسيما الاوائل منهم حيث شهدت مدينة كفرنبل العديد من عمليات الخطف ومحاولة التصفية كان اخرها تصفية الناشط الثوري جهاد زعتور احد ابرز رموز الثورة في كفرنبل
وفي ظل هذا العجر الأمني الذي تعانيه الفصائل الثورية في المناطق المحررة في القاء القبض على اشباح الظلام والحد من عمليات الخطف والقتل والسرقة يطرح المواطن السوري الثائر تساؤلات عديدة منها :
- من هو الكيان او الفصيل المخول بحمايته ومحاسبة المجرمين ؟
- هل عدنا للاعتقالات ذات الطابع الأمني بعد أربع سنوات من العذابات والمعاناة للتخلص منها؟
- أين الجهات التي يتوجب عليها صناعة المؤسسات صاحبة السلطة في التحقيق العادل والمحاكمة العادلة في المناطق المحررة؟
- أين نحن ممن ينصب نفسه مسؤولا عن محاسبة الشعب السوري ويعمل على ذلك ويعتقل ويحقق ويحاكم لا ندري كيف وأين ولماذا؟
ويبقى المواطن الثائر ضحية هذه الاشباح ويبقى الفاعل مجهولا حتى اشعار اخر
 ١٩ نوفمبر ٢٠١٤
١٩ نوفمبر ٢٠١٤
أثار كلام المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا عن خطة طرحها خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق تقضي بوقف إطلاق نار جزئي من خلال البدء في "تجميد المعارك بحلب" العديد من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لمقترحه.
فقد تحدث دي مستورا نفسه عن موقف إيجابي من طرف بشار الأسد يتلخص في استعداده لدراسة الخطة والعمل عليها. بالمقابل، لم يعترض عليها المجلس العسكري في مدينة حلب، بل وضع شروطا للموافقة عليها، فيما تحفظ عليها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورفضها عدد من الفصائل العسكرية المعارضة.
حيثيات المبادرة
تأتي الخطة التي تحدث عنها دي مستورا ضمن مبادرة تهدف إلى وقف القتال المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات في سوريا قدمها إلى مجلس الأمن في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقوم على فكرة إنشاء "منطقة خالية من الصراع" يمكن أن يبدأ تطبيقها من خلال تجميد القتال في مدينة حلب، وبقاء كل طرف في موقعه الحالي بهدف إيجاد شكل من أشكال الاستقرار.
"يبدو أن دي مستورا يستغل انشغال وتركيز المجتمع الدولي على حرب تنظيم الدولة الإسلامية كي يسهم في تحويل كل الجهود نحو هذه الحرب، بمعنى أنه يسعى لتركيز جهود المعارضة والنظام في الحرب ضد داعش"
وفي حال نجاح عملية التجميد فإنها ستشكل حجر الأساس للمزيد من العمليات والخطط المماثلة، على أن يتم خلال فترة التجميد السماح بنقل مساعدات إنسانية وغذائية للمناطق المحاصرة والتمهيد لمفاوضات بين النظام والمعارضة.
ويبدو أن دي مستورا يستغل انشغال وتركيز المجتمع الدولي على حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كي يسهم في تحويل كل الجهود نحو هذه الحرب، بمعنى أنه يسعى لتركيز جهود المعارضة والنظام في الحرب ضد داعش.
لكن ما يسكت ويتعامى عنه المبعوث الدولي هو أن أي حل في سوريا يجب أن ينهي الظلم الذي وقع على السوريين من قبل نظام بشار الأسد، وأن هذا النظام الظالم لم يخض أي معركة حقيقية ضد ظلم داعش، بل إنه حين كانت فصائل من الجيش الحر تخوض معارك ضد هذا التنظيم كانت طائراته تقدم الإسناد والعون له من خلال قصف مواقع المعارضة السورية بالصواريخ والبراميل المتفجرة، بل والأدهى من ذلك هو أن نظام الأسد سهل لتنظيم داعش سيطرته على العديد من المواقع، خاصة في الرقة وريف حلب، في حين أنه كان يدافع عنها بشراسة عندما كانت فصائل الجيش الحر تهاجمها.
وفي هذا السياق، يتساءل سوريون ومراقبون عن عدم اصطدام طيران النظام مع طيران التحالف، ذلك أنه لا يقصف مناطق انتشار داعش فقط، بل أيضا المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر، الأمر الذي لا يجد تفسيره إلا في وجود تنسيق مسبق غير معلن يقتسم فيه الطرفان الأجواء السورية.
ولأجل ذلك يخشون من أن تكون مبادرة دي مستورا تصب في سياق رفع مستوى التنسيق مع نظام الأسد إلى مستوى تعويمه وإعادة تأهيله من خلال إعادة الاعتراف الدولي به، وجعله شريكا في الحرب على داعش على الرغم من حديث المسؤولين الأميركيين المعلن عن عدم شرعيته وعدم التنسيق معه في حرب التحالف الدولي ضد داعش.
غير أن التساؤل عن حيثيات مبادرة دي مستورا يمتد إلى أسباب اختيار مدينة حلب نفسها، والتي أجاب عن بعضها دي مستورا نفسه، وأرجعها إلى كون المدينة واقعة "تحت الضغوط منذ أعوام وفي نزاع مستمر"، خاصة بعد أن أعرب عن صدمته من الدمار الهائل الذي رآه خلال زيارته مدينة حمص، ولا يريد "أن يحصل ذلك في حلب".
لكن السبب الأساس لاختيار حلب يكمن في وجود مخاوف من هجوم قريب لـ"داعش" على هذه المدينة على غرار ما حدث لمدينة الرقة نظرا لموقعها الإستراتيجي، وليس لأنها "مدينة ترمز إلى الحضارة والأديان والثقافات السورية والتاريخ والحضارات المتعددة"، إذ يعلم القاصي والداني أن أحياء عديدة من هذه المدينة العريقة والتاريخية حولها النظام الأسدي إلى مناطق أشباح، حيث أمعن في قصفها بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات والبراميل المتفجرة، وعمل على تدمير أسواقها ومعالمها القديمة على مرأى العالم كله، ولم تشر مبادرة دي مستورا إلى حجم الخراب الذي سببه النظام.
موقف المعارضة
صدرت مواقف متباينة حيال المبادرة من طرف المعارضة السورية -بشقيها السياسي والعسكري- الأمر الذي عكس تشرذمها وانقسامها، حيث اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة المبادرة "غير واضحة"، معتبرا أن "الحل لا بد أن يكون شاملا"، وأنها لن تفيد سوى نظام الأسد إلا إذا ترافقت مع حل سياسي شامل.
"يظهر من تصريحات دي مستورا أن مبادرته حتى وإن نفذت -وهو أمر مستبعد في المدى القريب على الأقل- فإنها لا تشكل إلا خطوة أولية، وليست حلا سياسيا، ولا ترتقي إلى خطة سلام قادرة على إنهاء معاناة السوريين"
أما رئيس "المجلس العسكري في حلب" التابع للجيش السوري الحر العميد زاهر الساكت فقد حدد أربعة شروط للتهدئة في المدينة تتلخص في خروج المليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام، ووقف القصف الجوي وإلقاء البراميل على أحيائها، وإطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين في غوطة دمشق وغيرها.
ويظهر من تصريحات دي مستورا أن مبادرته حتى وإن نفذت -وهو أمر مستبعد في المدى القريب على الأقل- فإنها لا تشكل إلا خطوة أولية، وليست حلا سياسيا، ولا ترتقي إلى خطة سلام قادرة على إنهاء معاناة السوريين.
وتزداد مخاوف السوريين من أن المبادرة لا تتضمن رؤية سياسية لحل الأزمة، إنما تتحدث عن تجميد القتال في مدينة حلب فقط، ولا تمتد على كامل مناطق المحافظة نفسها، والهدف منها هو حرف الصراع، وتحويل وجهته نحو محاربة داعش ودحره على الأرض، في حين أن مقاتلي الجيش السوري الحر وجميع "المعتدلين" يرون في النظام خطرا إلى جانب داعش، ويساوون بين النظام وبينه، بل ويعتبرونه صنيعته ولن يتوقفوا عن محاربته.
وتثير تعقيدات الوضع في سوريا التباسا لدى دي مستورا يخص فهم التطورات الحاصلة فيها، حيث إن مبادرته لا تأخذ معاناة السوريين في الحسبان، ولا تضعها ضمن حساباتها، فالسوريون -معارضة سياسية أو عسكرية- لم يستشاروا في وضع عناصر خطته، وكل ما عليهم هو تنفيذ ما يريده المبعوث الأممي الذي يقول لهم "ليست لدينا خطة للعمل، أوقفوا القتال وقلصوا العنف" دون أي مقابل، عليكم تغيير وجهة بنادقهم من النظام إلى داعش.
محاولات التعويم
تلتقي مبادرة دي مستورا مع محاولات روسيا الوقوف في وجه أي حل يفضي إلى نهاية نظام الأسد، لذلك تسعى جاهدة إلى إعادة تأهيل النظام من خلال مبادرتها إلى لقاء بعض رموز المعارضة السورية، حيث استقبلت مؤخرا وفدا برئاسة أحمد معاذ الخطيب الذي اندفع في تقدير إرهاصات زيارته إلى موسكو، وراح يحلم بأن شمس الخلاص السوري قد تشرق من موسكو، وهذا مستحيل لأن قادة الكرملين شركاء نظام الأسد في حربه الكارثية ضد أغلبية الشعب السوري.
وإذا كان الروس قد أعلنوا لزوارهم في أكثر من مناسبة أن المسار السياسي لحل الأزمة يجب أن يسير بالتوازي مع مسألة محاربة الإرهاب التي تدندن عليه الدول فإن ذلك يلتقي تماما مع ما ترمي إليه مبادرة دي مستورا، ومع جهود مصرية خجولة هدفها أيضا إعادة تأهيل نظام الأسد عبر إدخاله في مفاوضات ترمي إلى إعادة الاعتراف به، وتوحيد الجهود لمحاربة داعش.
"لم يقرأ دي مستورا درس مفاوضات جنيف الذي أظهر للعالم أن النظام السوري لم يرسل وفده للتفاوض، بل لكي يراوغ ويماطل، ويحاول تحويل قطار التفاوض عن سكة الحل السياسي إلى سكة محاربة فصائل المعارضة المسلحة "
كل هذه المحاولات لإعادة تأهيل الأسد وتعويمه تُجرى في وقت استفاق فيه الرئيس أوباما من غفوته، ليطلب من مستشاريه مراجعة الإستراتيجية الأميركية في سوريا بعد أن لامس آفاق الحل في سوريا والذي يقضي بأن "إزاحة الأسد ضرورية لهزيمة داعش"، الأمر الذي يتطلب ضرب أساس التزامه في الشرق الأوسط المتعلق بالحرب ضد الإرهاب، والقائم على الفصل بينها وبين ضرب نظام الأسد، وعلى مقولة تفيد بأن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكريا، وإنما من خلال تسوية سياسية.
وعلى أساس هذا الفهم أخلت إدارته بوعودها والتزاماتها خلال أكثر من ثلاث سنوات مضت من عمر الثورة السورية حيال الشعب السوري، وحيال المعارضة وباتت فاقدة ضميرها الإنساني.
ويبقى أن المبعوث الدولي دي مستورا لم يقرأ درس مفاوضات جنيف الذي أظهر للعالم أن النظام السوري لم يرسل وفده للتفاوض بل لكي يراوغ ويماطل، ويحاول تحويل قطار التفاوض عن سكة الحل السياسي إلى سكة محاربة فصائل المعارضة المسلحة وتدمير الحاضنة الشعبية للثورة.
ويكشف واقع الحال أنه لا يمكن لمبادرة دي مستورا أن تعالج الكارثة التي أصابت السوريين لأنها لا تنظر في مسبباتها، وتتغاضى عن الحرب الشاملة التي بدأها النظام الأسدي ضد أغلبيتهم منذ اندلاع الثورة السورية.
كما لا يمكن لعاقل أن يختصر الكارثة السورية بمسألة إرهاب مدعوم عربيا ودوليا إلا إذا صدقنا أن النظام يمكن أن يتحول من قاتل دمر أحياء معظم المدن والبلدات السورية وهجر ملايين السوريين إلى ضحية وديعة تدافع عن أغلبية السوريين الذين تحولوا -وفق هذا المنطق- من ضحايا نظام ظالم ودكتاتوري إلى مجرمين وإرهابيين يستحقون القتل والإبادة والتشريد.
وبالتالي، فإن العنف هو العلاج الوحيد لسلوكهم الإجرامي بغية استعادة أمن البلاد واستقرارها، وإعادة الجميع إلى مظلة النظام الظالم الجاثم على صدور السوريين منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، وهو أمر لا يمكن أن يحصل مهما كثرت المبادرات، لأن السبيل الوحيد هو إنهاء حكم الأسد.