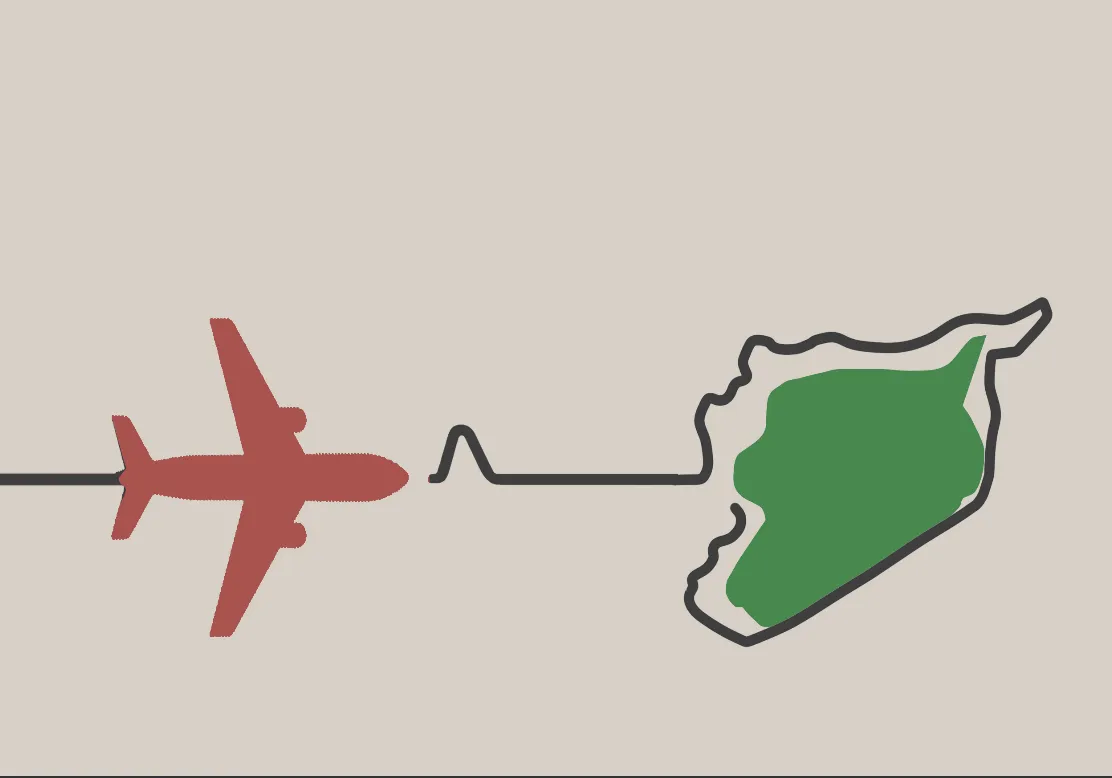٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
"في لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية" هذه المقولة الشهيرة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص يؤكد فيها أن الحرية وحدها لا تكفي للاستمتاع بمخرجاتها وهناك بون شاسع بين الفكرة ونتائجها.
طالب ثوار سورية منذ البداية بالحرية باعتبارها الشرط الكافي لتحقيق المطالب الأخرى في التخلص من حكم آل الأسد، لكنهم لم ينجحوا في تطبيقها وممارستها بالشكل المطلوب لصالحهم عندما أتيحت لهم الفرصة لذلك، سواء في المناطق المحررة أو ضمن مؤسسات وهيئات المعارضة المختلفة في الخارج.
فشل المعارضة في إدارة شؤونها وتقدير مصالح الثورة أوصلها في النهاية لحالة هامشية سواء بالنسبة للداخل أو تجاه الدول الصديقة وابتعادها عن دائرة صنع القرار المتعلق بالثورة ومستقبل البلاد أو حتى مجرد التأثير فيه.
من بين اجتماعين فقط للمعارضة حضرتهما شخصيا بدعوة خاصة كان أحدهما في اسطنبول في حزيران 2012، وهو مخصص لتشكيل لجنة مهمتها التحضير لمؤتمر يجمع أطياف المعارضة في القاهرة، واستمرت الاجتماعات يومين بلا طائل. ولم يبدُ لي وقتها أن حضور ممثلي الدول الصديقة لفرض أسماء معينة في اللجنة بقدر سعيهم لتحديد مهامها وصلاحياتها بعكس المعارضين الذين كان همهم وشغلهم الشاغل طرح أسماء معينة لتمثيلها في اللجنة مع أن عدد الحاضرين كان محدودا وغير كبير.
خصص مجلس الشعب قبل الثورة إحدى جلساته لاتخاذ قرار بخصوص الموقف من المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي المزمع انعقاده في أربيل بكردستان بدلا من بغداد بسبب الظروف الأمنية وقتها، وﻷن دور مجلس الشعب كان شكليا وليس له الحرية في اتخاذ القرار فقد وقع أعضاء المجلس في حيرة شديدة من أمرهم في معرفة اتجاه التصويت الذي تريده القيادة السياسية والذي عليهم العمل عليه، وساهم في ذلك عدم وجود توجيه مسبق من الشعبة الحزبية للأعضاء مما سبب بخلق حالة من الفوضى وقام رئيس المجلس بإعادة التصويت على القرار عدة مرات دون جدوى بغية تحويله من الرفض إلى القبول بالمشاركة.
تشكيل اللجنة التحضيرية لاجتماع المعارضة لم يتم في نهاية المطاف سوى باقتراح ملزم قدم لهم من ممثلي الدول الحاضرة للاجتماع حيث تمت الموافقة عليه فورا دون نقاش وبدا أن يومين من الاجتماعات ضاعا دون جدوى.
في المقابل فإن جلسة مجلس الشعب السابقة الذكر تم تعليقها بعد كل ما حصل وخرج الأعضاء يناقشون بحدة واستغراب مجريات الجلسة وصرح أحدهم بأنه من غير الممكن أن يعمد المجلس لتعديل قراره على العكس من رغبة الأعضاء وأن ذلك يمثل خيانة لمبادئ حزب البعث القومية، ولن يصوت هو على أي قرار لو سارت الأمور بهذا الاتجاه، ولكن الشعبة الحزبية أصدرت تعليماتها وتم في اليوم التالي التصويت خلال دقائق فقط بالموافقة على قرار الحضور وكان ذلك العضو أول الأعضاء الذين يرفعون أيديهم عالبا بالموافقة.
وفق الآليات التي كان يعمل بها النظام قبل الثورة، ربما يمكن فهم وتبرير ما حدث في اجتماع مجلس الشعب السايق الذكر، لكن غير المفهوم أو المبرر هو عجز أعضاء المعارضة عن اتخاذ قرار بتسمية أعضاء اللجنة وإسناد ذلك للغير رغم أنهم ممثلون مفترضون لثورة أولى شعاراتها وأهدافها الحرية.
رغم تخلصها من سيطرة النظام إلا أن حالة من الفوضى سادت المناطق المحررة بسبب عدم القدرة على إدارتها ذاتيا، ما أثار موجة من ردود الأفعال العكسية ضدها كما أثار فشل المعارضة في تقديم مشروع سياسي وطني جامع ومقنع شكوك دول الأصدقاء وعدم اعتمادها المعارضة بديلا عن النظام لفشلها الذريع في تنظيم العمل ضمن مؤسساتها المختلفة. ومن هنا يأتي من يحمل المعارضة مسؤولية تاريخية في إفشال الثورة وعدم تحقيق أهدافها.
لماذا تخلت المعارضة عن حريتها المكتسبة، ولم تحتفظ بقرارها المستقل لصالح الشعب السوري، ووقعت فريسة للتجاذب والاستقطاب الإقليمي والدولي.
لماذا يستمر السوريون في التخلي عن حريتهم في تحديد طريقة حياتهم ومستقيلهم السياسي، وهل يمكن القول إن ذلك صفة ملازمة لهم لا يمكن الخلاص منها
تستند مواقف المسؤولين في مؤسسات النظام حيال قراراته إما إلى مصلحة أو قناعة بها أو بسبب الإدراك باستحالة تغيير أي شيء يقرره النظام عبر دائرة القرار الضيقة والغامضة بعيدا عن المؤسسات الدستورية والقانونية الموجودة والتي ينحصر دورها في تنفيذ قرارات وتوجيهات القيادة الحكيمة والرشيدة للبلاد.
يتذرع المعارضون باستمرار لتبرير فشلهم بحالة التصحر السياسي التي سادت البلاد لعقود وسببت غياب العمل المؤسساتي الحقيقي ومنع منظمات المجتمع المدني الحرة من العمل، ولا يفهم كيف لم يساهم كل هذا الوقت الطويل من عمر الثورة لتجاوز ذلك. ويبدو أن المعارضين يركزون على العوامل الموضوعية ويتهربون من الخوض في العوامل الذاتية المتعلقة بشخصيات المعارضة التي ظهرت فيها حالات واسعة من الأنانية والفردية والنرجسية ولم ترقَ تصرفاتهم لمستوى تضحيات الشعب السوري وتضحياته العظيمة.
ومن اللافت ظهور حالات واسعة من الفساد تم ارتكابها من معارضين خلال فترة قصيرة نسبيا حيث عملت مؤسسات المعارضة بدون مساءلة أو شفافية.
فشل المعارضة في الاستفادة من مناخ الحرية المفتوح أمامها شكل ضربة قاسية للهدف الأساسي للثورة، وبات الحديث يدور حول جدوى الحرية كفكرة مجردة في حال عدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل لصالح الناس. واستغل بعض مؤيدي النظام ذلك للحديث عن عبثية الثورة ومسؤوليتها عن الحالة المأساوية التي وصلت إليها البلاد.
بالمحصلة لا تكفي الحرية وحدها كفكرة أو تطبيق مجرد في تحقيق شيء وبالعكس فقد تساهم في خلق حالة من التشرذم والخلافات والفوضى العارمة، ومؤكد أنه بلا وعي أو ضوايط أو آليات للعمل والمراقبة فإن الحرية تنقلب من نعمة إلى نقمة.
ويبقى المشهد الأكثر قساوة على السوريين منظر جنود الأسد وهم يعذبون أحد المنتفضين المطالبين بالخلاص من النظام ... بدكن حرية ... هكذا يصرخ جنود الأسد بتهكم في وجهه وهم يعذبونه ويدوسونه بأقدامهم ويصرخون في وجهه "هاي منشان الحرية".
 ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
في حين كان الانتباه العام منصرفاً إلى ما يُسمّى "الصراع الشيعي/السني" في المنطقة، واعتبار سوريا حلقة مركزية فيه، غاب إلى حد كبير الاهتمام بالصراع "السني/السني" في المنطقة، إذا شئنا استخدام المفردات نفسها لوصف صراع متعدد الأوجه لا يتوقف عند الملمح الطائفي فحسب. وإذا كان واضحاً تحكم المرجعية الإيرانية في المقلب الآخر، حيث لا يخفي المسؤولون الإيرانيون ضلوعهم المباشر في بؤر النزاع الممتدة من صنعاء إلى لبنان، لا يمكن الزعم بوجود تنسيق من أي نوع على "المحور السني" الذي يغلب عليه التشتت أو التنافس، وحتى الاحتراب الداخلي، الأمر الذي تجلّى تحديداً من خلال الساحة السورية واستخدامها مكاناً ووسيلة لتصفية الحسابات.
منذ الوقت الذي بدا فيه النظام السوري آيلاً إلى السقوط ظهر التنافس على أشده ليسعفه بتشتيت معارضيه، على المستويين العسكري والسياسي. وإذا ظهر إسقاط الأسد آنذاك ممنوعاً بقرار دولي "أميركي تحديداً" فإن سلوك أصدقاء المعارضة الإقليميين لم يساعد مطلقاً في تشجيع الإدارة الأمريكية على توجه مختلف. "الأصدقاء" كان لهم الدور الأبرز في إضعاف وتفتيت أطر المعارضة السورية، بما فيها تلك التي اتفقوا في وقت سابق على دعمها، وكان لهم الدور الأبرز في انقسام الفصائل المسلحة. ولم يتوقف الخلاف عند الانقسام بل تعداه في كثير من الحالات إلى اقتتال داخلي يعكس تصفية حسابات بين الداعمين المختلفين، وكأن النظام سقط وحان وقت النزاع على تركته.
من المغالطات الشائعة على هذا الصعيد تصوير إيران كمنتصر في الحرب السورية، لأن الصراع في سوريا وعليها انتزعها من الاحتكار الإيراني السابق على الثورة السورية، ما اضطرها إلى إنفاق الكثير من الدعم العسكري والاقتصادي لاستعادة النفوذ السابق، مع تلميحات وتسريبات عن موافقتها على تقاسم للنفوذ يُبقي لها حصة "الأسد". لم تتعرض إيران لهزيمة سورية كاملة بسبب الانقسام في الصف الآخر، وأيضاً بسبب عجز هذا الصف عن تظهير بديل سوري قوي ومُتفق عليه. المكسب الإيراني الأكبر هو في أن الصراع معها لم يكن له الأولوية كما يجري تضخيمه في وسائل الإعلام، إذ لا اتفاق في ذلك مثلاً بين تركيا وقطر اللتين يتقارب موقفهما أحياناً من الشأن السوري على وقع الخلافات الخليجية، وبالتأكيد لا اتفاق مطلقاً بين السعودية وتركيا اللتين تخوضان نزاعاً ضروساً على أرضية خلافهما الحاد حول انقلاب السيسي في مصر. وعلى رغم اتفاق دولة الإمارات التام مع توجه السعودية المصري إلا أن مقاربتها للشأن السوري يكتنفها الكثير من الشبهات حول اصطفافها إلى جانب النظام.
وإذا كان انقلاب السيسي في مصر قد أزّم العلاقات الخليجية/الخليجية، وأزم علاقة السعودية بتركيا، إلا أن العلاقة بين المحور السعودي وتركيا لم تكن في أحسن حالاتها قبل ذلك، وهذا في حد ذاته أمر لافت بين بلدين كادت مواقفهما أن تتطابق حينها في شأن عدم المساومة مع نظام الأسد. وأكثر ما يلفت الانتباه هو غياب التنسيق مع تركيا التي تعادي الأسد وتمتلك أكبر حدود مع سوريا، الحدود التي أصبحت شبه مفتوحة مع تحرير معظم مدن الشمال السوري من حيث المساحة والثقل. تظهر أهمية ذلك أكثر فأكثر مع ارتهان السعودية إلى الممر الأردني لدعم الفصائل المسلحة التي تمولها، ومن المعلوم أن المعبر الأردني مُمسك بقوة وتحت الملاحظة الدقيقة للإدارة الأمريكية التي أوقفت عبور المساعدات في العديد من المناسبات الحاسمة. بل إن تقدم "الثوار" في الجبهة الجنوبية يسير غالباً بما لا يقطع الشعرة بين الحكومة الأردنية والنظام السوري؛ هكذا مثلاً لا تقتحم فصائل المعارضة معبر نصيب بصفته المنفذ الأخير للنظام على الأردن، ولا تقطع الأوتوستراد الدولي بين عمان ودمشق.
لقد تسلل الغموض الأمريكي وتناقضاته إزاء الملف السوري بين شقوق المحور السني المزعوم، ومن هذه الجهة على الأقل يتبين تهافت المحور الذي لم يكن له وجود في الواقع، وجرى تسويقه إعلامياً لخدمة المحور الآخر، ولخدمة السياسة الأميركية الحالية في المنطقة. ما أظهرته ساحة الصراع السورية أن التناقضات ضمن "المذهب" الواحد أعمق من التناقض الطائفي المفترض، ولئن دفع السوريون من دمائهم ثمن تلك التناقضات فلأن الساحة السورية صارت مفتوحة لكل اللاعبين الإقليميين الكبار، ومن السذاجة الظن بأن وحدة المذهب كافية لإذابة الخلاف في المصالح السياسية ضمن الإقليم، أو حتى ضمن سوريا نفسها. مع ذلك، ما حصل لم يكن الخيار الوحيد المتاح، إذ كان في وسع الدول المتنافسة على تركة إيران في سوريا أن توازن بين أولوية الانتهاء من النفوذ الإيراني ووراثته تالياً، إلا أن قصر النظر السياسي، وليس التهافت والتقاعس المذهبي، هو ما سيجعل المكاسب أقل من المأمول.
أصلاً، لا مصلحة للسوريين في محور "سني" صلب، كما يتراءى للباحثين عن منازلة إقليمية كبرى، لأنهم مرة أخرى سيدفعون بدمائهم ثمنها. مصلحة السوريين هي في سياسة إقليمية رشيدة حقاً، وفي ألا يُستخدموا لتصفية الخلافات العالقة في ملفات أخرى. فوق ذلك، لا مصلحة للسوريين في أن تتعين الخلافات الإقليمية على أرضهم بين مزاعم الاعتدال والتطرف الإسلاميين.
 ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
فماهي أسباب هذه الإستقالة أو " الإقالة " المتوقعة والغير مفاجئة !
لابد من التعريف بالوزير تشاك هيغل وبخلفياته السياسية , تشاك هيغل هو أحد السيناتورات ( الجمهوريين ) وقد عينه الرئيس الأميركي أوباما في منصب وزير الدفاع لكي بنزع تخوف الجمهوريين من السياسات العسكرية لأوباما ( الديمقراطي ) . ولكن أوباما استخدم هذا التعيين لكي يكون واجهة لأخطاء كثيرة وقع فيها أوباما إن كان على صعيد سياسته العسكرية أو الخارجية .
وبعد انتقادات علنية كثيرة " والإنتقادات الأكثر والأعنف كانت في الغرف المغلقة والإجتماعات المنفردة " من قبل هيغل على هذه السياسات , فقد طلب أوباما من السيناتور الجمهوري أن يقدم طلب استقالته .
إسرائيل , من المعروف عن الوزير هيغل أنه دائما مايغرد خارج السرب بالنسبة لولاء المسئولين الأميركيين الأعمى لإسرائيل والوقوف معها في كل ماتقوم به , مع بعض الإنتقادات التي يقومون بها للحفاظ على بعض ماء الوجه أمام المجتمع الدولي .
وقد تعايش الرئيس الأميركي مع انتقادات هيغل للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل ولم تعد إعتراضات هيغل على سياسات اوباما تجاه إسرائيل تؤرق مضجعه .
بشار , في نهاية الشهر الفائت صرح هيغل بان ضربات التحالف الدولي الجوية ضد تنظيم داعش قد تساعد نظام بشار على البقاء وعلى السيطرة على المناطق التي ستنسحب منها قوات تنظيم الدولة "داعش تحت تأثير الضربات الجوية للتحالف الدولي .
وهذه الإستفادة لنظام بشار ستكون مخالفة لسياسات أميركا " المعلنة " ومخالفة لتصريحات الرئيس الأميركي التي أعادها وكررها عشرات المرات بأن بشار قد فقد شرعيته وعليه التخلي عن السلطة .
تنظيم الدولة " داعش " , لايخفى على أي متابع للأوضاع في سورية والعراق على فشل ضربات التحالف الدولي بوضع حد لتحركات داعش إن كان في سوريا أو في العراق , ففي العراق نرى أن تنظيم " داعش " ينسحب من مناطق ويتقدم في أخرى ومركز مدينة الرمادي ليس عنا ببعيد وقاعدة الحبانية التي تحوي على عدد لابأس به من الأميركيين ,وهؤلاء الأميركيين إن وقعوا في أيدي داعش فسيكون لهم تأثير كبير على الحملة الدولية ضدها وقد تضع نهاية غير سعيدة لهذا التحالف ولهذه الضربات الجوية .
أميركا , جميع الأميركيين من شعب وسياسيين , وجميع المتابعين للسياسة الدولية يعلمون أن السياسة الخارجية في عهد أوباما , بل وأصبحت السياسة الخرجية الأميركية في كثير من الأحداث مجرد سياسة تابعة للسياسات الخارجية الروسية وتنازلت أميركا عن كثير من القضايا لصالح روسيا , ويمكننا القول بأن الملف السوري هو خير دليل على تبعية أميركا للسياسة الروسية إذا ماقارنا سياسة أوباما في ليبيا وتدخله العسكري فيها وسياسته الحازمة في الملفين المصري والتونسي , وكيف رفع الغطاء عن زين العابدين بن علي وعن حسني مبارك , وهنا نعيد التذكير بملف التبعية الأميركية لإسرائيل .
بالنتيجة نرى أن منصب وزير الدفاع الأميركي هو منصب مهم جدا , ولكن أوباما جعله مطية لتنفيذ سياسات خرقاء في أصعب واخطر الملفات الملتهبة عالميا .
ولأن هيغل هو من الحزب الجمهوري وأوباما من الحزب الديمقراطي , ولكي لايتحمل الجمهوريين نتائج هذا الفشل الديمقراطي ولكي لايؤثر عليهم في الإنتخابات الأميركية القادمة .
ولنفس السبب من جهة الديمقراطيين ولكي يحاولوا توريط الجمهوريين معهم في هذا الفشل .
فقد تمت إستقالة وإقالة وزير الدفاع الأميركي .
هي مصلحة حزبية بحتة وسعي لإقناع الناخب الأميركي بالتصويت للحزب الذي يتبع له تشاك هيغل أو أوباما وليس فيها أي نوع من محاولة إحقاق الحق وإبطال الباطل .
 ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
أكثر من نصف مليون فلسطيني كانوا يعيشون في سورية، موزعين على تسعة مخيمات تعترف بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وثلاثة لا تعترف بها الوكالة، بالإضافة إلى مخيمي الحسينية وبرزة، اتسم وضع اللاجئين الفلسطينيين في سورية سابقاً بالنموذجية، خصوصاً إذا ما قورن مع أوضاع أهلهم في دول الجوار، فقد منحت سورية الفلسطينيين اللاجئين فيها جميع حقوق المواطنة، باستثناء حقي الترشح والانتخاب.
66 عاماً مرّت على بدء وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية، اندمجوا فيها بشكل كبير مع المجتمع السوري، حيث لم تكن مخيماتهم معزولة، بل كان معظمها متداخلاً مع المناطق المجاورة، فلا حدود واضحة تعزل مخيماتهم عن محيطها، وكحال الشعب السوري، عانى اللاجئون الفلسطينيون في سورية الكثير في السنوات الأربع الأخيرة، فقد استشهد منهم 2535 لاجئاً، وفقاً لإحصاءات نشرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مطلع الشهر الجاري.
أربع سنوات من الحرب لم يسلم فيها مخيم من المخيمات من قصف أو انفجار سيارة مفخخة، أو اشتباكات أو حصار، ولعل مخيم اليرموك من أكثر المخيمات الفلسطينية تضرراً في سورية، اليرموك الذي سميّ عاصمة الشتات الفلسطيني، لما يتمتع به من مكانة معنوية عند اللاجئين الفلسطينيين، عاش أهاليه منعطفات كبيرة في السنوات الأخيرة، أبرزها القصف الجوي الذي استهدف مسجد عبد القادر الحسيني في ديسمبر/ كانون أول 2012، وما تلاه من انشقاقات في صفوف الجبهة الشعبية – القيادة العامة، الموالية للنظام، وما رافقها من سيطرة الكتائب المحسوبة على المعارضة السورية المسلحة على المخيم، وما لحقه من حصار مشدد، فرضه الجيش النظامي، مدعوماً من فصائل فلسطينية موالية له، حيث نزح نحو مليون فلسطيني وسوري منه، فيما يعاني حوالى 20 ألفاً من المدنيين المتبقين ويلات الحصار، فقد استشهد "155" منهم بسبب الجوع ونقص الدواء، وحتى هذه اللحظة، يرزح المخيم تحت حصار مشدد، فلا خبز ولا ماء للأصحاء، ولا دواء للمرضى، لم يكن الحصار سبباً في تشتت اللاجئين الفلسطينيين من اليرموك إلى البلدات السورية والبلدان المجاورة فقط، بل كان سبباً في هجرة الآلاف منهم إلى الدول الأوروبية، راكبين ما يعرف بقوارب الموت، غير مبالين بمخاطرها، فلم يبق أمامهم من شيء يراهنون عليه سوى حياتهم.
إن كان وجود مجموعات محسوبة على المعارضة السورية المسلحة حجة النظام السوري بحصار مخيم اليرموك، فما حجته بحصار مخيمي السبينة والحسينية اللذين يُمنع سكانهما من العودة إليهما منذ أكثر من عام؟، فالمخيمان يخضعان لسيطرة النظام بشكل كامل، بعد أن تمكن الجيش السوري النظامي، مدعوماً بفصائل فلسطينية، من فرض سيطرته التامة عليهما، إذاً لماذا الحصار؟ ذلك السؤال الذي لا يزال معلقاً منذ ذلك الوقت.
وفي حلب التي يوجد فيها مخيم حندرات والنيرب، تسيطر مجموعات المعارضة المسلحة على الأول كاملاً، ما دفع جميع أهاليه إلى مغادرته، منذ أكثر من عام ونصف، فكانت الاشتباكات العنيفة والمعاملة السيئة التي تلقاها اللاجئون من مجموعات معارضة، من أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم عودتهم إلى المخيم، يضاف إليها استهداف المخيم المستمر بالقذائف والبراميل المتفجرة. أما مخيم النيرب الذي يتمتع بأهمية استراتيجية للطرفين، بسبب مجاورته مطار النيرب العسكري، فيعيش أهاليه تحت سيطرة الجيش النظامي والمجموعات الموالية له، وسط إجراءات أمنية مشددة دفعت شباباً عديدين من المخيم إلى تركه، خشية الاعتقال، أو إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وبالانتقال إلى جنوب سورية، نرى أن مئات من عوائل مخيم درعا نزحوا عنه، بسبب القصف العنيف والمتكرر بالبراميل المتفجرة والقذائف الثقيلة، والتي أدت إلى دمار ثلثي منازل المخيم، إضافة إلى غياب الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة، ما دفع أهاليه لتركه، بحثاً عن الأمن الذي افتقدوه.
وفي ريف دمشق، يعيش مخيم خان الشيح حالة من الحصار الناعم، بسبب إغلاق جميع الطرق التي تربطه مع مركز العاصمة، ما يدفع اللاجئين فيه إلى سلوك أحد الطرق الفرعية، وهو طريق "زاكية – خان الشيح"، مخاطرين بحياتهم وحياة أبنائهم، في محاولة منهم لتأمين بعض الحاجيات لأبنائهم، حيث تعرض لاجئون عديدون للقصف والقنص، عند مرورهم على ذلك الطريق.
أما مخيمات العائدين في حماة، والعائدين في حمص، والرمل في اللاذقية، وجرمانا وخان دنون، وبرزة، والسيدة زينب في ريف دمشق، فتعيش نوعاً من الاستقرار من الناحية الأمنية، حيث تقع جميعها في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، وبعيدة نسبياً عن مناطق الاشتباك، إلا أن معاناة الأهالي، الاقتصادية والمعيشية، حيث تنقطع الكهرباء والمياه ساعات طويلة، إضافة إلى غلاء المعيشة وارتفاع إيجارات المنازل، وانتشار الحواجز الأمنية التي تضيق عليهم حركتهم.
اليرموك، الحسينية، السبينة، حندرات، وخان الشيح ودرعا، مخيمات كانت تستوعب أكثر من ثلثي اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على البحث عن مكان آخر داخل سورية أو خارجها، فقد وصل الأمر إلى أن يهرب آلاف منهم إلى البلدان الأوروبية، سالكين أخطر الطرق البحرية والبرية، للوصول إليها.
تعرضت المخيمات الفلسطينية في سورية للاغتيال المادي والمعنوي، ودفع آلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى ترك مخيماتهم يطرح تساؤلات عديدة، أهمها هل يعلم النظام في سورية أنه ينفذ أجندات ضد اللاجئين الفلسطينيين؟ وهل يدرك أن استهداف المخيمات الفلسطينية في سورية خدمة مجانية للصهاينة؟ هل يذكر أن شارون توعد مخيم اليرموك في يوم من الأيام، وقال له "لك يوم يا مخيم اليرموك"؟
 ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
مع الثورة السورية، كنا أمام نماذج عدّة من المثقفين/السياسيين السوريين: الشعبوي، مثقف البلاط، الحيادي، الانتهازي، الأيديولوجي، الطائفي، الثوري، العقلاني، الثوري العقلاني.. إلخ. واللافت أن مواقف هؤلاء، جميعاً، تحدّدت منذ اليوم الأول للثورة، ولم تطرأ أي تعديلات جوهرية على خطابهم وتصوراتهم ومواقفهم، خلال السنوات الأربع الماضية، على الرغم من زخم الحوادث والمسارات المتعرجة للواقع وتغيراته المتنوعة.
لكن، في الحقيقة، كنا أمام نموذجين فاقعين وطاغيين، عموماً، للشخصيات العاملة في المستويين، الثقافي والسياسي، وهذان النموذجان حدّدا، أيضاً، مسارات المعارضة السورية، واصطفافاتها المختلفة. وعلى الرغم من أن الصفات المدرجة لا تتوفر، بالتأكيد، كاملة في أي من الشخصيتين الفاقعتين، وأن الواقع يحتوي تنوعاً كبيراً بينهما، وكذلك مع إدراكنا استبدادية فعل التصنيف نفسه، بما يتضمنه من تبسيط أحياناً، وما يضمره من خطر وضع البشر في قوالب نمطية غير مطابقة، تماماً للحقيقة، إلا أننا نعرض هذين النموذجين من الشخصيات المثقفة والسياسية، في صورة الحد الأقصى، طمعاً باستفزاز تفكيرنا من جهة، وبهدف تجاوزهما واقعيّاً من جهة ثانية.
الشخصية الأولى: تقيم غالباً خارج سورية، تفتقد، في الغالب الأعم، إلى تاريخ نضالي، لديها انحياز أعمى للثورة، بما يجعلها تتنكر للأخطاء وتتستر عليها. المحرك الأساسي لتوجهاتها وخطابها هو الحقد القديم إزاء نظام الحكم في سورية، مشكلتها الأساسية مع النظام، وليس مع نهج الحكم، مغرمة بالصوت العالي، وتتوفر على حد أقصى من "المزاودة" على الآخرين، شعبوية وغرائزية في أدائها، وشعبويتها ناتجة من الجهل، أو الانتهازية التي تدفعها نحو السعي "الرخيص" للحصول على الحظوة بين الناس، فهاجسها الأساسي محاولة كسب الشارع بأي طريقة كانت، تشيع في خطابها كثيراً مقولات الخذلان والدم، ضحالة في المعرفة السياسية، بما يجعلها أقرب إلى "البلاهة السياسية"، غير عارفة بسورية والسوريين وطبيعة نظام الحكم، معظم وعيها يُبنى استناداً إلى الشائعات والكلام الشفوي أو المنقول.
تعتمد لغة سياسية غوغائية، زوادتها الأساسية المبالغة الخالية من أي معانٍ سياسية حقيقية، مقاربتها السياسية للحوادث مبنية على أساس طفولي، لا يرى إلا الحدود القصوى للظواهر. لذلك، تستند خياراتها إلى قانون "الكل أو لا شيء"، منهج عملها هو "السبحانية" و"الدروشة"، ولا تتقن التخطيط والمراكمة، تسيطر عليها خفة طاغية إزاء الإعلام، جهل مريع في العلاقات السياسية الخارجية وموقع سورية فيها، داعشية الهوى والنهج، حتى لو كانت "علمانية"، وفي حال كانت من الشخصيات التي اعتقلت، سابقاً، فإنها تطمح إلى الحصول على أجرتها وتعويضاتها من الثورة على شاكلة الفوز بمنصب سياسي، أو مال، عاشقة للسلطة، وقد اندفعت نحو اللهاث وراء المواقع، وتصدّر المشهد السياسي، بحكم كونها قصيرة النفس وغير واثقة بنفسها، تتوفر على براغماتية مغالية وفاقعة، إذ لا تتوانى عن اللعب والمساومة بأي شيء، في سبيل المكاسب الشخصية، ساهمت، بخطابها وأدائها، بقدر ما في تغيير طبيعة الحراك الشعبي، وخفض صفته الوطنية، تعطي انطباعاً بأنها غريبة عن سورية، ولا تشبه السوريين، مندرجة في سياسات سعودية قطرية تركية، في أغلب الأحوال. إيران مختزلة بالفرس والمجوس والشيعة، وأخيراً هي لا تعرف الخجل أو التواضع، ولا تعترف بعجزها وقصورها وعدم كفاءتها، على الرغم من فشلها الواضح والمتكرر، ولا تتقن ولا تقبل الرجوع خطوة إلى الوراء، في سبيل مراجعة الذات.
" الشخصيتان معاقتان ومعيقتان، في الوقت نفسه، ولا تنتجان واقعيّاً سوى الهذر والكوارث "
الشخصية الثانية: تقيم غالباً داخل سورية، تفكيرها "الأقلوي" يجعلها "علمانية" في الظاهر، وطائفية في الجوهر، في العمق هي ضد الثورة، ربما لأن الثائرين لم يأخذوا رأيها، أو يعترفوا بقيادتها، تحليلاتها تقوم على أساس أن كل ما يفعله النظام "طبيعي"، ويفترض في الثورة أن تكون مثاليةً في مواجهته، في رأسها أوهام قديمة، ما زالت مستمرة حول حزب الله وإيران. في العمق، لا مشكلة جوهرية لها مع النظام القائم، لأسباب طائفية أو أيديولوجية (ممانعة، مقاومة، قومية عربية...)، والنقطة الرئيسية التي تطرحها، علناً أو ضمناً، هي "كسر احتكار السلطة"، أي المشاركة في النظام، رائحة الأيديولوجية والأوهام النضالية تزكم الأنفاس، مقولات العمالة والاتهام تملأ رأسها، وتتعيش عليها، حالة متفشية من التعالي واحتقار الناس، ليس من النادر أن تتفاخر عليهم باعتقال النظام لها في الزمن الغابر: "أين كنتم أيها الحثالات عندما كنا نناضل".
الهامشية المزمنة تدفعها إلى سلوك تعويضي، يتمثل في نشر كتاباتها السابقة، لتقول للناس بشكل غير مباشر "أنا أفهم منكم"، أو "ألم أقل لكم"، أو إلى ممارسة "تفكير الجكارة"، بالسير عكس البديهي والمعروف أو الواضح، خطابها صادم للمزاج الشعبي، وهذا يعطيها شيئاً من النشوة والانتصار، إضافة إلى كونه خطاباً موتوراً وعصابيّاً، فأي نقد للخطاب يحولها من داعية سلمية إلى داعشية أو تشبيحية الخطاب، حس السخرية والشماتة مسيطران، وتتمنى فعليّاً خسارة الثورة، ويرتفع صوتها في كل لحظةٍ، يظهر فيها أن الثورة تخسر، سريعة في اتهام الثورة، ومترددة، وتحسب كلماتها بدقة تجاه النظام، تتظاهر بالحكمة، وهي، في جوهرها، جبن أو خوف من الخسارة الشخصية، افترضت الهزيمة سلفاً أمام النظام القائم. لغتها السياسية أقرب إلى لغة جمعية حقوق إنسان في سويسرا، أو إلى لغة كائنات تعيش في سنغافورة أو جزر القمر، تشعرك أنك أمام كائنات أيديولوجية، أو ديناصورات قومية أو ستالينية، مغرمة بالشعارات، وتعتقد، في العمق، أنه بمجرد قولها تتحول إلى واقع، منابرها الإعلامية هي منابر النظام ذاتها، نشاطها البسيط والهامشي ينحصر كله في مناطق سيطرة النظام، معظم جهدها ينصب على البيانات السياسية، أخلاقياتها تطهرية في الظاهر، لكن مصدرها وقاعها أيديولوجي محنط. وفي العمق، لا تتوفر على المبدئية والصدقية، مندرجة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في سياسات إيرانية روسية، تركيا بالنسبة لها هي الدولة العثمانية، وتعاني من "عقدة خليجية"، جوهرها أوهامها عن نفسها والآخر، وشعورها المزعوم بالتفوق الحضاري على البدو.
أخيراً، لا شك أن هاتين الشخصيتين معاقتان ومعيقتان، في الوقت نفسه، ولا تنتجان واقعيّاً سوى الهذر والكوارث. في اعتقادي إن سورية تستحق، على الرغم من البيئة القاسية على الصعد كافة، والدم الضاغط على رؤوسنا وأرواحنا، أن يذهب جميعنا، المحسوبون بشكل أو آخر على ساحة الثقافة والسياسة، في طريق التفكّر في أنفسنا، وإعادة النظر في موروثاتنا الفكرية والسياسية والنفسية، ووضع بديهياتنا ومقولاتنا موضع نقاش وتقويم جديين، علّنا ننجح في معركة بناء أرواحنا وعقولنا من جديد، أو إفساح الطريق لكائنات سياسية وثقافية جديدة: مبدئية وواضحة، عارفة وعاقلة، في الآن نفسه.
 ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
فشلت محاولات تقسيم سورية، حين كان للتقسيم دعاة، فكيف حين يرفض السوريون جميعاً التقسيم، وكيف حين يجمعون أن سورية مؤلفة من خمسة أحرف لا تقبل القسمة، ولا يمكن أن تعيش إلا دولة واحدة موحدة.
حين حاولت الحكومة الفرنسية الإبقاء على "دولة العلويين"، وإنشاء إمارة جبل الدروز، كان هناك من يؤيد هكذا كيانين، أما اليوم فلا أحد من الموالين، أو المعارضين، يؤيد ذلك.
يومها، بسهولة بالغة، استطاع محمد علي العابد، بتأييد من غالبية السوريين، ضم لواء اللاذقية وإمارة جبل الدروز إلى الجمهورية السورية. ويومها، اصطدمت المحاولات الفرنسية للبقاء على الكيانين بالحماس السوري العارم لدولة سورية واحدة. جميع محاولات تشجيع العلويين على الانفصال ذهبت أدراج الرياح، وظلت الدويلة المزعومة هيكلاً يقاد، شكلاً، من مجلس تمثيلي، وفعلاً من الحكومة الفرنسية.
كانت النزعة الانفصالية التي شجعها الفرنسيون قوية آنذاك، إذ كان في المجلس التمثيلي المزعوم اتجاهان: الأول طائفي، يريد تكريس الانفصال عن سورية، بدعوى الخوف والاختلاف (كان فيه ثمانية من الطائفة العلوية، وواحد من الطائفة الاسماعيلية، ومسيحي)، والثاني وحدوي، لا يقبل أن تكون اللاذقية إلا محافظة سورية (فيه رجل من الطائفة العلوية، هو جابر العباس، وثلاثة من السنة، واثنان من المسيحيين)، وقد تمكن هذا الاتجاه من تغيير اسم دولة العلويين إلى حكومة اللاذقية عام 1930.
رفضت الكتلة الوطنية، برئاسة هاشم الأتاسي، أي اتفاقية مع الفرنسيين الذين كانوا يراوغون (كما تفعل أميركا وحلفاؤها اليوم) على حساب الدولة الوطنية السورية، ولم تقبل بأي وضع خاص لأي كيان منفصل عن الجسم السوري. وعمت المظاهرات حلب وباقي المحافظات السورية، وتعاطف العالم العربي والعالمي مع مطالب الشعب السوري في الوحدة. رضخ الفرنسيون، في النهاية، إلى مطلبي الوحدة والاستقلال. وتقدم أبناء الطائفة العلوية نفسها الصفوف، يطالبون بالكيان الواحد، ويذكر السوريون حين قال نائب طرطوس، منير العباس، للفرنسيين، بصريح العبارة "إن مصلحة العلويين أن يكونوا جزءاً من سورية".
تكلل هذا النضال بتوقيع هاشم الأتاسي على معاهدة مع الفرنسيين عام 1936، تنص على: (1) محافظة اللاذقية وجبل الدروز جزء من الدولة السورية، و(2) أن تحظى هاتان المحافظتان على نظام إداري ومالي خاص، و(3) أن تخضعان لدستور الجمهورية السورية (والحقيقة أنه من الحكمة والمنطق أن تخضع كل المحافظات السورية لنظم إدارية ومالية خاصة، حتى يمكن تنمية جميع المحافظات بالتكامل مع بعضها).
" لن تؤدي دعوة دي ميستورا سوى إلى مناطق ذات هويات عرقية ومذهبية ودينية متباينة "
تطالعنا الأخبار، اليوم، بهلوسات الانفصاليين وتجار الحروب وتمنياتهم، فالبغدادي يحلم بدولة مسخ في غرب العراق وشمال وشرق سورية، شرط أن تهيمن على بئرين من النفط، والنصرة وأمراء الحرب شمال حلب يهيئون أنفسهم لتقاسم السلطة مع داعش، ويحلم انفصاليون كثر بدولة في الجنوب وفي الساحل.
بالونات اختبار تطلقها مجموعات من المشعوذين والأكاديميين الغربيين، لجس نبض السوريين، في مقدمتهم، هذه الأيام، جوشوا لانديس، اليهودي الأميركي ورئيس قسم الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، حيث يشجع دعاة التقسيم بأطروحة، يدّعي أنها تستند إلى مقاربات تاريخية وإلى تغيرات حدثت في المنطقة في القرون الماضية، وأن الربيع العربي، هو في نهاية المطاف، تنظيم للخلافات بين الطوائف والأعراق والأديان، بعد فشل الدولة القومية. يتناسى لانديس تاريخاً طويلاً من الاندماج الذي عاشته هذه المنطقة بين الطوائف والأعراق والأديان، ويتناسى أن الانقسام لم يكن يوماً إلا من فعل الفرنسيين والإنجليز سابقاً، والأميركان اليوم. وحتى حين يدعم لانديس أطروحته، بدعوى فشل بناء دولة علمانية وطنية في العراق، فهو يتناسى دور أميركا في إقامة دولة محاصصات طائفية وعرقية، وحين يستشهد بدعوات المنظمات الطائفية الإرهابية، يتناسى سبب التفاف الناس حول هكذا دعوات.
لا أحد من السوريين يريد من لانديس، وأمثاله، أن يعلمهم كيف يتقاسمون أرضهم، وكيف ينشئون دولة في الشمال ودولة في الجنوب، لأنهم يعرفون كيف يحافظون على أرضهم موحدة لوطن يسوده العدل والمساواة.
وفي سياق التقسيم، تندرج دعوة دي ميستورا لإقامة مناطق حكم ذاتي مجمدة، وما يسميه تبادل لمناطق النفوذ. ولن تؤدي تلك الدعوة سوى إلى مناطق ذات هويات عرقية ومذهبية ودينية متباينة، ومناطق نزاع للمجموعات المتصارعة وأمراء الحرب، للقضاء على ما تبقى من سورية ونسيجها السوري التاريخي المتعدد، كما يشير اختيار ميستورا حلب إلى هدفه الذي ينسجم مع أفكار التقسيم المشؤومة.
لا يمكن أن تعيش سورية إلا دولة واحدة، لأنه كلما تدخل الاستعمار، أو تدخلت الحرب والمواقع الجغرافية، تعود من جديد موحدةً، فأهلها من دم واحد وعرق سوري واحد.
 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
لا يكلّ تنظيم «داعش» من محاولة إبهار الغرب بصورته، وقد نجح؛ فالتنظيم يبدي هوسا لا محدودا بـ«كيف نراه»، ويجهد لنيل اعتراف الغرب بقوة صورته وبقدرتها على التأثير. فلتكثيف القتل عبر تصويره وإعطائه عمقا ملحميا، دور في هوية الجماعة. صحيح أن «داعش» يجهد لإعادة المناطق التي تحت سيطرت مئات الأعوام إلى الوراء، من حيث الممارسة والمظهر واللباس والقوانين وطريقة القتل ذبحا وصلبا ورجما. لكن مع ذلك فهذا الجهد للعودة إلى ماضي «الخلافة» تشذ عنه علاقة التنظيم بالصورة، فهذه لا يبخل عليها العقل الداعشي، بل يرفدها بأحدث تقنيات العصر.
وشغف هذا التنظيم بصورته ظهر مرارا في الفيديوهات التي أنتجها، بحيث تبدو المساحات التي يسيطر عليها التنظيم أقرب إلى مدن إنتاج سينمائي يوظف فيها قسرا ممثلون ضحايا لا يملكون خيار عدم لعب دور القتلى، فنراهم يؤدون أمام الكاميرات موتهم الحقيقي بكل ما فيه من عذاب وألم ودم على يد جلادين ينظرون إلى العدسة وهم يقتلون؛ فهم يذبحون ويرجمون ويصلبون للصورة وليس لشيء غيرها.
كتب الكثير عن هوليوودية «داعش» وجاذبية الصورة بالنسبة إلى التنظيم، لكونها وسيلته في الحرب النفسية قبل القتال الفعلي. فالقتل في كنف التنظيم هو قتل للقتل وللصورة.
أما «كومبارس» الضحايا فهو يتجدد دائما، فيما «بطولة» الجلادين يجري تكريسها عبر بعض الوجوه، كما يحصل مع أشهر قتلة «داعش»، المعروف بالجهادي «جون»، الذي نفذ عمليات ذبح الرهائن الأميركيين.
هذه الحاجة الملحّة لإبهار الغرب لا تخطئها العين في فيلم التنظيم الأخير، الذي يُظهِر عملية إعدام جماعي لجنود وضباط من سلاح الجو السوري، وبعدها إعدام مماثل لرهينة أميركي، هو بيتر كاسيغ.
في هذا الشريط بذل العقل «السينمائي» الداعشي ذروة قدرته التصويرية والإخراجية، بحيث بدا العنف الممارس بمثابة محتوى لا مفر منه للإبهار البصري. ومن تمكّن من مشاهدة الشريط بالغ الوحشية لن تفوته ملاحظة نقاوة الصورة وتعدد كاميرات التصوير وتوليف المشاهد، بل حتى زوايا التصوير.
نعم، في الفيديو الأخير دشن تنظيم «الدولة الإسلامية» مرحلة جديدة من دعايته، ومن هوسه الجنوني بصورته. بدا أن عملية الإعدام أعد لها مخرج سينمائي، وليس مجرد جلاد فقد روحه. فعملية الإعدام أتت عبر سياق تصويري مشهدي تمت دراسته قبل تنفيذه بحيث بدت عملية الإعدام تلبية لحاجات الصورة، وليس لشيء آخر، فالكاميرات نقلت لنا ببطء تلك العيون الباردة للقتلة ووجوههم المكشوفة التي تشي بتنوع الأصقاع التي أتوا منها. ارتصفوا خلف ضحاياهم، بعد أن التقط كل منهم سكين الإعدام من سلة وُضعت خصيصا لمزيد من الرعب البصري. وحده الجهادي جون ارتدى زيا أسود وقناعا للوجه وقاد عملية الإعدام التي تمت بشكل متزامن ومبالغ في تصويره مقربا صوتا وصورة.
طرح البعض تكرارا دعوة إلى مقاطعة بث أفلام التنظيم والحدّ من تداولها، باعتبار ذلك وسيلة ستضعف من انتشاره حتما. المشكلة هي في ضعف قدرتنا كمشاهدين وكإعلام عن الانجذاب نحو تلك المشاهد التي نقف أمامها عاجزين يتملكنا الرعب، وأيضا الانبهار.. لكن الصورة رغم كل عنفها ستقع حتما في فخ الرتابة، وتلك ستحصل لا محالة إن لم تكن قد بدأت فعلا، وحينها لن يعود لذلك الموت العميم وقعه كما هو اليوم.
الأرجح أن هوس الصورة هو ما سيصيب التنظيم بمقتل.
 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
ترقص المنطقة منذ عقود على اللحن الايراني. كأن الدور الايراني هو الموضوع الجوهري او المشكلة الأساسية. هذا يصدق على علاقات الدول داخل الاقليم. وعلى ادوار الدول الخارجية فيه. تضاعف هذا الواقع بعد انتحار الاتحاد السوفياتي.
هزّت الثورة الايرانية المنطقة. واعتقد قادتها ان رياح الثورة ستتسرب الى الاقليم. شن صدام حسين حربه على ايران. فضّل ان يواجهها على ملعبها كي لا يضطر الى مواجهتها لاحقاً في شوارع بغداد. أرغم جمر الثورة على الانكفاء الى داخل الاراضي الايرانية.
تلقت الثورة الايرانية في العقود الماضية خمس هدايا ثمينة. الاولى ان ولادتها ترافقت عملياً مع خروج مصر من النزاع العربي- الاسرائيلي. ادرك الخميني ومنذ اللحظة الاولى القيمة الاستثنائية لورقة معاداة اسرائيل واحتضان المقاومة ضدها مشفوعة بشعار «الموت لأميركا».
ستأتي الهدية الثانية على يد حزب البعث الحاكم في عاصمة الأمويين حين اختار الوقوف الى جانب ايران الخميني ضد عراق صدام. اما الهدية الثالثة فقد جاءت من العدو الاول. فجأة اجتاحت قوات صدام حسين الكويت وأعلنت شطبها من الخريطة. انشغال العالم بعدوان صدام سيُعطي ايران الفرصة اللازمة لإعادة بناء قوتها وتجديد طموحاتها. وبعد عقد ونصف عقد، ستصل الهدية الرابعة وعلى يد «الشيطان الاكبر» هذه المرة وتتمثل في اقتلاع نظام صدام ثم الانسحاب وترك العراق عملياً في عهدة ايران مباشرة وعبر حلفائها. هذا اضافة عما حصل في الخاصرة الافغانية. وتمثلت الهدية الخامسة في ظهور «داعش» في العراق وسورية وفي زمن رئيس اميركي يعتبر نهجه هدية اضافية لإيران وهو باراك اوباما. وجاءت هدية «داعش» في وقت كانت فيه ايران تقاتل دفاعاً عن الحلقة السورية التي كان من شأن سقوطها ضرب البرنامج الايراني الكبير وتبديد عوائد الهدايا التي تلقاها.
لا يمكن تفسير قوة ايران بالهدايا التي تلقتها. قوتها وليدة عناصر وسياسات مكّنتها من القدرة على توظيف الهدايا واستيعاب التحديات. انشأت الثورة الايرانية نظاماً صارماً حرم القوى الخارجية من امتلاك اوراق ضغط في الداخل الايراني. وأقامت شكلاً من الديموقراطية يعطي الناخب انطباعاً بأنه قادر على تغيير الرؤساء والحكومات، علماً ان القرار الاخير موجود في مكتب المرشد الممسك بكل الخيوط.
نجحت ايران ايضاً في التحول مرجعية دينية وسياسية لمعظم الشيعة في العالم. هذا اعطاها حضوراً داخل الدول الاخرى من افغانستان الى لبنان، خصوصاً مع تقدم فكرة «ولاية الفقيه». تأكدت هذه القوة حين نجحت ايران في تحريك حلفائها في العراق ولبنان للقتال على الارض السورية لمنع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وتحت شعار مقاومة الاحتلال الاميركي للعراق والتصدي لإسرائيل، انشأت ايران على اراضي الغير مجموعة من الجيوش الصغيرة تبين ميدانياً انها شديدة الفعالية من بيروت الى صنعاء. وضعت ايران قدراتها المالية والسياسية والاستخبارية والإعلامية في خدمة «الجيوش» الحليفة التي صارت صاحبة الكلمة الاولى في اماكن وجودها وإن لم تُمسك رسمياً بكل مفاصل السلطة. تكفي هنا الاشارة الى الروايات التي تتعلق بدور الجنرال قاسم سليماني والذي يبدو انه لم يتراجع على رغم وجود المقاتلات الاميركية في الأجواء العراقية والسورية.
لا شك في ان الهجوم الايراني في الاقليم اصطدم بمقاومات محلية وإقليمية وتحفظات دولية. لكن لم تؤد هذه الاعتراضات الى قيام برنامج متكامل مضاد يتسم بالعدوانية والمرونة وحسن اختيار الامكنة والتوقيت. أرفقت ايران ذلك بقرار واضح بعدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الآلة العسكرية الاميركية وعدم قصف اسرائيل بالصواريخ الايرانية المباشرة والاكتفاء بتحريك الصواريخ الحليفة وفقاً للبرنامج الكبير.
بسلاح الصبر والمناورة والمجازفات المحسوبة والتضليل والافادة من الثغرات لدى الآخرين، شغلت ايران دول المنطقة والعالم بملفها النووي فيما كانت تتابع برنامج الدور الاقليمي. ادارت طهران ببراعة ما يسمّيه الغرب التجاذب بين المعتدلين والمتشددين في ايران. وظفت ابتسامة خاتمي وقبضة احمدي نجاد و «اعتدال» روحاني قبل دخول السباق الحالي في فيينا. كما وظفت أخطاء جورج بوش وتردد اوباما وشراهة بوتين.
على مدى عقود، استجمعت ايران عدداً غير قليل من الاوراق لتعزيز موقعها التفاوضي. نظرت الى الاقليم في صورة شاملة. واعتبرت ان اميركا هي الخصم والمنافس والشريك المحتمل. وجد العالم صعوبة في تقبل ايران الفائزة بجائزتين هما القنبلة والدور الكبير.
خطران يحدقان بـ «ايران الكبرى» اذا قامت واعترف بها. الاول ان تفوق تكاليف الدور قدرة الاقتصاد الايراني. انهار الاتحاد السوفياتي تحت وطأة التزاماته ولم ينقذه انه كان ينام على وسادة نووية. الثاني ان يكون النظام الايراني عاجزاً عن الانتقال الى مرحلة الدولة الطبيعية بعد ادمانه الطويل قاموس المواجهة والتوتر وخطوط التماس. لا بد من الانتظار لمعرفة مواصفات اللحن الايراني في الفترة المقبلة.
 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
أعلن تنظيم إسلامي "دولة الخلافة في الشام والعراق"، وأطلق عليها اسم الدولة الإسلامية، ويرمز لها اختصاراً باسم "داعش"، هذا التنظيم يقول الباحثون إنه فرع من فروع تنظيم القاعدة الذي نشأ في تسعينيات القرن الماضي، لمحاربة الوجود الأجنبي في الجزيرة العربية خاصة، والوطن العربي عامة، بعد اجتياح الجيش العراقي الكويت عام 1991، ودخول جيوش الحلفاء 33 دولة إلى جزيرة العرب، تحت ادعاء تحرير الكويت، بموجب قرار من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتشعب إلى تنظيمات متعددة، مختلفة الأسماء والصفات. لكن، بقي الأصل واحداً هو "تنظيم القاعدة".
تنظيم الدولة الإسلامية مسلح، ويتبنى الفكر السلفي الجهادي، ويهدف إلى قيام دولة الخلافة، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتأسست نواته في عام 2004، عقب احتلال الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العراق عام 2003. وفي 29 يونيو/حزيران 2014، أُعلنت دولة الخلافة، وسمي أبو بكر البغدادي أمير المؤمنين أول خليفة في هذه الحقبة من تاريخ الحركات الإسلامية الحديثة. وضعت الولايات المتحدة هذا التنظيم على قائمة الإرهاب، وأعلنت الحرب عليه، ويشارك في هذه الحرب أكثر من 50 دولة، منها دول عربية وأوروبية، إلى جانب أميركا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا.
(2)
يرتكب قادة "داعش" ومنتسبوه جرائم بشعة، تقشعر لها الأبدان، مثل ذبح الإنسان من الرقبة كذبح الأنعام، ومنها القتل الجماعي لكل من لا يسير معهم، والاستيلاء على المال العام والخاص، وهتك المحرمات وتشريد المدنيين من منازلهم وقراهم. هذا ما تتناقله وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي تقول، من دون استثناء، إن تنظيم الدولة الإسلامية فرض على مسيحيي العراق الجزية أو الإسلام أو الرحيل عن البلاد التي تحت سلطتهم. وكما تقول معلومات مضادة إن التنظيم استخدم المصطلح الإسلامي "الجزية"، وهي كما يقول أنصار التنظيم ضريبة مالية في مقابل حماية من ليس على الدين الإسلامي، وعدم مطالبته بالاشتراك في حروب الدولة الإسلامية، ولم يجبروا على اعتناق الدين الإسلامي، ولكن الخوف، وهو طبيعة إنسانية، أجفل المسيحيين عن أراضيهم خوفاً وليس قهراً. لا جدال في أن الأعمال الوحشية التي يقوم بها التنظيم ضد الإنسان في العراق والشام إجرامية، نشجبها وندينها، ولا نقرها تحت أي سبب، لأن الإسلام دين محبة وألفة وتسامح، وليس دين إرهاب وذبح الإنسان كذبح الأنعام.
يقف المجتمع الدولي، برمته، بكل قواته المادية والمعنوية، وما في حكم ذلك من القوة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وجند لها كل إمكاناته القتالية من طائرات حربية وقوات برية، طبعا ميليشيات طائفية، عراقية وإيرانية، وعصابات مرتزقة، وتم تسليح تلك الميليشيات بأحدث الأسلحة وتدريبها تدريباً لحرب المدن والأرياف، بمعونة أميركية، ومن دول غربية، والمعارك تدور على رؤوس أهل السنة في العراق، من دون تمييز، وذلك أمر لا يبعث على الأمل في إنهاء هذه الحرب الملعونة، لأنها تدور في أراض عربية، وعلى رؤوس أهل السنة من المدنيين الأبرياء. ومن المؤسف أن الحكومة العراقية الطائفية استغلت هذه الحرب لتصفية حساباتها مع أهل السنة في العراق.
(3)
تلك، إذن، هي "داعش العربي"، وما تصنع وما يصنع بأهل العراق وسورية، لمحاربة داعش، فماذا، عن داعش الإسرائيلية؟
في الجانب الآخر من الصورة، تقوم إسرائيل بالأعمال نفسها التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من ذبح الإنسان كما تذبح الأنعام على الطريقة الغربية، أي القتل بإطلاق الرصاص على رأس الضحية، ويحرق الإنسان الفلسطيني بعد تعذيبه عذاباً، يشيب له الولدان حياً واقفاً مصلوباً. وفي مكان آخر، تشنق عصابات قطعان المستوطنات من تصل إليه أيديهم من الفلسطينيين، أصحاب الحق في أي مكان، ولا يترددون في شنقة في وسيلة مواصلات، أو أماكن عامة، تحت سمع وبصر الأمن الإسرائيلي. داعش الإسرائيلية تقوم بأعمال أخرى، يحرّمها القانون، مثل هدم منازل المتهمين من الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم، وتجبر آخرين على هدم منازلهم بأيديهم، وهي أكبر جريمة بعد القتل أن يهدم الإنسان ما بناه لأسرته وبنيه من بعده على أرضه. داعش الإسرائيلية تنتهك حرمة الأماكن المقدسة للمسلمين في القدس والضفة الغربية، ناهيك عن حصار غزة.
" العالم كله يتفرج على ما يلحق بالشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقهم وهدم منازلهم وشنق وحرق شبابهم أحياء، انتقاماً منهم على ما لم يفعلون "
في يوم الخميس الماضي، اقتحمت الميليشيات الصهيونية مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، واعتقلت أكثر من 21 مواطناً فلسطينياً، واقتحم الجيش الإسرائيلي الداعشي مدينة نابلس، وعبث بالمدينة وأهلها الآمنين، ولم تحرك السلطة الفلسطينية شعرة في جسد صهيوني.
قررت الحكومة الإسرائيلية تسليح جميع اليهود في مدينة القدس وضواحيها، لمواجهة الفلسطينيين أهل الأرض والحق، والعالم كله يتفرج على ما يلحق بالشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقهم وهدم منازلهم وشنق وحرق شبابهم أحياء، انتقاماً منهم على ما لم يفعلون.
(4)
العالم استنفر كله ضد "داعش"، وجندت الأموال والجيوش لدحر هذا التنظيم، على الرغم من أنه يشكل تهديداً لنظام طائفي دكتاتوري متوحش، في كل من دمشق وبغداد، ولم يقم إلا لإزاحة ذينك النظامين الطاغيين المستبدين، وهذا ما يتوافق ورغبة الدول الغربية وأميركا وحلفائهم من العرب. لكن "داعش الإسرائيلية" التي تريد أن تقيم الدولة اليهودية، وتطبق الشريعة اليهودية على مواطنيها، لم يعترض على جرائمها ضد الفلسطينيين أي إنسان.
في العراق، يجند حزب الدعوة الحاكم في بغداد الميليشيات ويسلحها، وتدربهم أميركا لمحاربة الشعب العراقي الشقيق بذريعة محاربة الإرهاب، أي داعش، بينما يحارب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ويعتقل كل من يقف في وجه الدواعش الإسرائيليين الذين ينكلون بالشعب الفلسطيني. تسلح إسرائيل كل العصابات المستوطنة في القدس وضواحيها والضفة الغربية، وعباس يجرد الفلسطينيين، حتى من حمل الحجارة وقذفها على المستوطنين اليهود، بل ويعتقلهم.
آخر القول: دواعش إسرائيل محميون، ودواعش سورية والعراق مستهدفون. إسرائيل تسلح دواعيشها، ومحمود عباس يجرد الفلسطينيين حتى من امتلاك الحجر لمقاومة الاحتلال. حزب الدعوة في العراق يسلح ميليشيات ويجندها، ومحمود عباس يعتقل كل من يقاوم إسرائيل، وشتان بين القيادات الفلسطينية والإسرائيلية وحكومة المحاصصة في بغداد.
 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
لم يلق اعتقال رئيس تيار بناء الدولة السوري، لؤي حسين، الاهتمام الكافي من المؤيدين والمعارضين السوريين على السواء، ليس لأن الرجل وتياره لا يملكون وزناً كبيراً في الساحة السياسية والاجتماعية السورية، كالائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية فحسب، بل لأن الرجل اختط لنفسه تياراً وسطياً من الأزمة السورية (منزلة بين المنزلتين). ومثل هذه المواقف الوسطية في وقت الأزمات الكبرى (اتفقنا معها أو لم نتفق) تبدو رماديةً غير واضحة المعالم، ويزيد من رماديتها تعقد الأزمة وتشعبها. لذلك، سرعان ما تتعرض مثل هذه المواقف للاتهام والعمالة من معظم الأطراف، لا سيما التي تمثل حدي الأزمة، وتعتمد منطق الغلبة.
لم يمنع وصفه النظام السوري بالديكتاتوري، ومن ثم تحميله النظام سبب الأزمة، ورفضه مفاوضة النظام قبل وقفه العمليات العسكرية والأمنية، لم يمنع ذلك كله من اتهام المعارضة الخارجية له، ولأمثاله، بالعمالة للنظام أو أداة بيد النظام.
في المقابل، لم يمنع رفضه التدخل العسكري الخارجي، ومطالبته بالحفاظ على الدولة، وقبوله بحل سياسي للأزمة، عبر تشكيل سلطة ائتلافية تضم أشخاصاً من النظام والمعارضة، لم يشفع ذلك كله له عند النظام.
وصف بعضهم اعتقال لؤي حسين بالمسرحية الأمنية للنظام، من أجل تعويمه سياسياً في المرحلة المقبلة، مع ظهور إرهاصات أولية بدأت من موسكو عن حل سياسي للأزمة، كما فعل النظام تماماً مع رئيس جبهة التغيير والتحرير، قدري جميل، حين ترك منصبه وزيراً للتجارة بشكل مفاجئ، أو أقيل منه، ليستقر به المطاف في موسكو، ويكون جزءاً أساسياً من المشروع الروسي للحل السياسي. واعتبر آخرون لؤي حسين عميلاً للخارج، وإن كان بلباس معارضة داخلية، وتضاعف وصف العمالة له كونه علوياً، بعد خروجه عن معقول الطائفة وأدبياتها، ثم تضاعف هذا الوصف، في المرحلة الأخيرة، من كتاباته التي عكست خوفه من سقوط الدولة.
بغض النظر عن الاتفاق، أو الاختلاف، مع وجهة نظر لؤي حسين، فإن جوهر الموضوع هو اعتقاله، والتهمة التي نسبت إليه "إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة"، وهي التهم الموجودة في أدراج الأنظمة الشمولية والجاهزة مسبقاً. كيف يمكن للمثقف والسياسي، وحتى المواطن السوري العادي، التصديق أن لؤي حسين أضعف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة، هل المواطن السوري خالٍ من المصائب والكوارث، ولم يعد يعكر صفو حياته سوى لؤي حسين؟ مئات آلاف القتلى والجرحى، عشرات آلاف المعتقلين، دمار مدن وقرى بكاملها، ملايين النازحين والمهجرين، اقتصاد شبه متوقف، تحالف دولي يشن هجوماً في شمالي سورية، وتنظيم يمارس أبشع أنواع الإرهاب.
كيف يمكن لهؤلاء الذين يأملون بدولة تسودها الديمقراطية ودولة القانون وحرية الرأي الاقتناع أن النظام مستعد لقبول عملية سياسية، تنهي الأزمة، وتؤسس لمرحلة جديدة في سورية؟ كيف يمكن تصديق ذلك؟ والنظام ما زال غير قادر على تحمل المعارضة التي وصفها هو نفسه، يوماً، بأنها واعية ووطنية، في مقابل للمعارضة الخارجية غير الواعية وغير الوطنية؟
" كيف يمكن للمثقف والسياسي، وحتى المواطن السوري العادي، التصديق أنّ لؤي حسين أضعف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة؟ "
لماذا يعتقل لؤي حسين؟ هل فقط لأنه تجرأ، وقال إن الدولة أضحت، بنظر السوريين، كياناً مفارقاً لهم، وأن النظام عمل على تحطيم البنى الاجتماعية، كالقبيلة والطائفة، من دون بناء بنية وطنية، تقوم على المواطنة، ومن ثم تحذيره من انهيار الدولة السورية؟ (راجع مقاله في صحيفة الحياة في 24 يونيو/حزيران الماضي، السوريون لا يشعرون بحاجتهم إلى الدولة)، أم لقوله إن النظام عاجز عن حماية السيادة الوطنية؟ داعياً السوريين إلى القول الصريح والعمل العلني لإنقاذ دولتهم عبر تسوية سياسية، تستبدل النظام بسلطة ائتلافية من السلطة والمعارضة والشخصيات العامة، يكون لديها الأهلية لحماية البلاد (بيان تيار بناء الدولة في 2 / 11 / 2014).
هل تخطى رئيس تيار بناء الدولة الخطوط الحمر في مقالاته وبياناته، أم أن للمسألة وجه آخر، لأنه حاول التواصل مع الشباب السوري، وتشكيل موقف سياسي من الأحداث الجارية في بلده؟
اعتقال ﻟﺆﻱ ﺣﺴﻴﻦ، وقبله رجاء الناصر وعبد العزيز الخير، يسلط الضوء على الخيبات التي يتعرض لها أنصار الحل السلمي، ويبعث رسائل سياسية تؤكد رفض النظام هذا الطريق، كما رفض عند بدء الأزمة العمل السلمي الشعبي لصالح الحل الأمني.
 ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
لا يمكن تشبيه زيارة المبعوث الدولي دي مستورا إلى حمص المدمّرة، سوى بقيام مبعوث للأمم المتحدة، برفقة وزراء هتلر بزيارة معسكرات «أوشفيتز» ليرى نجاح عمليات الإبادة فيها. ليس من معنى للزيارة، يالإخراج الذي حصلت فيه والدلالات الرمزية المحيطة بها، سوى موافقة الأمم المتحدة على هذا النموذج، الذي كان ثمنه حوالى مليون نازح وعشرات آلاف المفقودين والمقتولين تحت أنقاض البراميل أو بسبب الجوع، وتغيير جذري للتركيبة السكانية للمدينة، وكل هذا موثّق لدى منظمات الأمم المتحدة، ولا أحد يعرف إذا كان الرجل سأل مرافقيه عن الناس الذين سكنوا تلك الأحياء، أين هم، وما إذا كانت المصالحة قد جرت مع الحيطان المدمرة!
ربما من الطبيعي ألا يشعر دي مستورا بشيء من عدم الانسجام بين دوره ومكانته، وبين مثل هذا الواقعة، ذلك أنها خطوة متناسقة مع السياق الذي تسير عليه الأمم المتحدة، كممثلة للمجتمع الدولي في سورية، والذي يعيد إحياء التجربة التي استخدمت في البوسنة والهرسك عبر إقامة ما سمّي بالمناطق أو الملاذات الآمنة، على أن تؤمن الحماية لعددٍ من المدن البوسنية من اجتياحات الصرب، وكانت مدينة سربرينيتسا ضمن هذه الملاذات، وبمقتضى ذلك قامت قوات الأمم المتحدة بتجريد تلك المناطق من أي وسيلة للدفاع، ومن ثم وقفت عاجزةً عن التصدي للصرب الذين اعتقلوا المراقبين الأمميين، ومن ثم أغاروا على مواقع البوسنيين مرتكبين مجازر عدة أفظعها مجزرة سربرينيتسا التي راح ضحيتها نحو 8 آلاف شخص، فهل ثمة مساع لاستعادة مثل هذه التجربة في سورية؟
ثمة من يرى بأن فكرة « تجميد الصراع» التي يقترحها دي مستورا ليست جديدة في السياق السوري، وهي امتداد لتجربة «الهدنات» التي طبقها نظام الأسد في كثير من المناطق السورية، بتخطيط روسي وإشراف إيراني مباشر، كما حصل في حمص نفسها، وخطورة مثل هذا الإقرار تتأتى من كون المجتمع الدولي سلّم أخيراً بالرؤية الروسية الإيرانية لحل الأزمة، عبر تحويلها إلى حالة تمرد في بعض المناطق وإيجاد حلول موضعية لها من خلال تأمين بعض الحاجات الأساسية للمناطق المنهكة وتسوية أوضاع بعض المطلوبين في تلك المناطق، وبالتالي طي صفحة الثورة السورية بصفتها تحولاً جذرياً في قلب المجتمع، وإعادة النظام إلى سكة الحياة وتوفير كل الظروف المناسبة له لإعادة إنتاج ذاته.
اكثر من ذلك، فإن توسيع زوايا النظر إلى الموضوع وتركيبه ضمن المشهد العام للتحولات الجارية في الإقليم، يشير الى وجود رابط واضح بين عدة تفاصيل محيطة، منها مفاوضات الملف النووي بين واشنطن وطهران ونيّة مسقط إعادة فتح سفارتها في دمشق وزيارة بعض أعضاء المعارضة الى موسكو، إذ إن جمع كل هذه الخيوط من شأنه إعطاء القدرة على قراءة دقيقة للمشهد برمته، ولعل النتيجة الأولى لهذه القراءة أن الملفات الإقليمية التي ادعت واشنطن عدم خوضها مع طهران في مفاوضاتها النووية، بدأت تتصدر التفاهمات بين الطرفين، وأن الوسيط العماني صار جاهزاً، بعد إتمام اللمسات الأخيرة على النووي، لتولي ملف جديد في المنطقة، وهو الملف السوري، كما أن جزءاً من أطراف التفاوض صار جاهزاً لإعلان الصفقة في موسكو1.
في التصريف النظري لهذه السياسات، فإن معنى ذلك هو التوجه إلى الإقرار بإعادة تأهيل بشار الأسد، كمقدمة لإشراكه في جهود محاربة الإرهاب، على اعتبار أن القوة المحلية في اغلبها ستنضوي ضمن إطار التفاهم الذي يقترحه دي ميستورا، ويمكن النظام الادعاء بأن غالبية القوى المحلية قد عقدت الهدنات وما تبقى خارج هذا الإطار هي إما جهات متطرفة مثل «جبهة النصرة» أو مرتبطة بـ «داعش» التي هي طرف خارجي، وربما هذا ما يفسر المفاوضات التي يجريها النظام مع الكتائب المتواجدة في جنوب دمشق ويقترح عليها الذهاب إلى القنيطرة ودرعا، وذلك بناء على خطة مسبقة تقضي بضم مناطق شرق سورية وجنوبها ضمن خريطة القوى الإرهابية وإدماجها ضمن ضربات التحالف الدولي.
في التصريف العملي، يمكن إدراج هذه السياسة على طيف واسع من الأهداف والإستراتيجيات، فهذا الطرح يشرعن وضعية «أمراء الحرب»، وذلك انطلاقا من التفسير الدولي لطبيعة الأزمة في سورية والمائل الى اعتبارها حرباً أهلية وبالتالي تساوي المسؤوليات بين أطرافها، وليس مصادفة هنا أن تتوقف وزارة الخارجية الأميركية عن دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق بجرائم الحرب في سورية، كما أنه يشكّل بداية تقسيم «ناعم» لسورية، إذ ينطوي هذا الوضع على ترسيم المناطق التي تحت سيطرة الأطراف وتحويلها الى عنصر تفاوضي أساسي ودائم، وهو الأمر الذي يناقض التكتيك الذي تنبني عليه المبادرة من تحويل الحالة إلى دينامية تصالحية شاملة.
 ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
بخلاف التنظيمات الإرهابية التي سبقت ظهور تنظيم داعش ومهَّدت له، لم يتوفر بين أيدي الجمهور أو المحللين بحث أو وثائقي لدارسي التنظيمات الإرهابية وخبرائها، أو الصحافيين المتخصصين، يشرح الاستراتيجية القتالية والأداء الفردي والجماعي لتنظيم داعش، في واحدة من المعارك المتلاحقة التي يخوضها التنظيم في سورية، أو العراق، سوى الأفلام التي صدرت عن المؤسسات الإعلامية التابعة للتنظيم نفسه، والتي تصدَّرها، أخيراً، فيلم "لهيب الحرب"، ويلاحظ المتابع العادي، عوضاً عن المتخصص، كثافة التقنيات الهوليودية العالية التي استخدمت في تصويرها وإنتاجها، ومهارة التنظيم في تسويق الرسالة العقيدية والسياسية الخاصة به، لمؤيديه المحلييّن، أو للشبان التائهين وراء حواسيبهم الشخصية في الدول الغربية على الأقل، ويشكلون عماد مقاتلي التنظيم وذخيرته التي لا تنضب.
وبالطبع، يعود ذلك الغموض المقصود، أولاً، إلى الوحشية المفرطة التي يظهرها داعش تجاه الصحافيين الأجانب، وحتى تجاه هؤلاء المحليين، في حال رفضوا موالاته، ونقل الخبر والصورة كما يريد أمراؤه، وأحياناً كثيرة: في حال رفضوا "مبايعة الخليفة"، كما تتواتر الروايات، مثلاً، عن حيثيات الاعتقالات المتتالية التي تعرّض لها صاحفيو شبكة الجزيرة في شمال سورية. ويُرد الغموض، أيضاً، إلى سياسة التقليل من الصوت والصورة التي ينتهجها داعش، بهدف تشكيل أسطورة الرعب وإرهاب النفوس وتحطيم معنويات أعدائه وحواضنهم الشعبية، فداعش، وعلى الرغم من امتلاكه جهازاً إعلامياً محترفاً، وكبيراً على ما يبدو، من إنتاجه، ليس غزيراً إعلامياً، بل يعتمد تقوية أسلوب التواتر القصصي لما حدث ويحدث في المعارك والاقتحامات. والراوي، هنا، غالباً ما يكون ناجياً أو هارباً منهم، أي الأكثر تزعزعاً وميلاً لتضخيم الأحداث وتهويلها. وبهذا استطاع التنظيم عبر أعدائه الرواة فعل ما لا يمكن فعله بقناة تلفزيونية وإذاعة. وربما كان هذا مبالغةً لو لم تُثبت المشاهدات في سورية على الأقل أن عناصر غالبية الفصائل المسلحة كانوا قد أدمنوا مشاهدة مقاطع الفيديو التي تصور أساليب قتال خصومهم على موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك"، ربما من دافع أن معرفة العدو أول النصر، أو تطمين النفس الخائفة بمشاهدة قتال عدوها وتمهيدها بفكرة أن العدو هو هذا القريب على الشاشة يصيبُ ويُصاب.
لا شك أن داعش يمتلك، فعلاً، أساليب متفوقة في وحشيتها، قتالاً واقتحاماً وإعداماً لأسراه وأعدائه والتنكيل بهم، وخصوصاً عندما يتعمَّد هذا لقصدِ إرهابٍ ما يلي من عدو، وظهر هذا جلياً في عدة معارك باستخدام أسلوب غزارة النيران الثقيلة في أثناء الالتحام، بحيث قُتل عدد من عناصر التنظيم بنيران مدفعيته، ثم أسلوب القنص المكشوف المكثّف في قلب المعركة، وصولاً إلى أسلوبه الأكثر تأثيراً في أعدائه والذي ورثه عن أبيه، تنظيم القاعدة، المفخخات والانتحاريون أو الإنغماسيون كما يسميهم التنظيم. هذا عدا الصلب وقطع الرؤوس والأيدي والأرجل الذي لقي منه مدنيو الرقة ودير الزور وقراهما النصيب الأكبر.
ولكن، الأهم من هذا كله ما يقوله أعداؤه، نقلاً عن نقل، وتضخيماً عن تضخيم، وما يشيعه التنظيم من قصص مروعة خيالية، سهلة التصديق والنقل في مجتمع الحرب المنهك الخائف الذي لا يرى إلا انتصارات متلاحقة لـ"أصحاب الرايات السوداء"، فيدبُّ الهلع في نفوس من يهاجمهم التنظيم قبل أن يهاجمهم، ويموتون ألف مرّة، قبل أن يموتوا خائري العزيمة، ويكفي أن يقارن جندي من قوات نظام الأسد بذهنه لحظات مصير أسرى مدرسة المشاة في حلب مع مصير أسرى مطار الطبقة وأسرى قاعدة سبايكر، أو أن يقارن جندي من الجيش الحر مصير أسراه في قتال مع فصيل يشابهه مع مصير أسرى قريتي الشعيطات والشحيل في دير الزور، ويكفي أن يتخيل مدني في قرية يحاصرها داعش "مهاجريه" الأوزباكستانيين، ذائعي الصيت، بعمليات ذبحهم الوحشية، لنعلم سر سرعة داعش وضرباتها الخاطفة لقوات كبيرة العدة والعتاد، وسر خضوع ملايين المدنيين لها، على الرغم من كل ممارساتها المرفوضة بأقل وصف لها.
" غالبية الفصائل المسلحة كانوا قد أدمنوا مشاهدة مقاطع الفيديو التي تصور أساليب قتال خصومهم "
يروى أحد عناصر الجيش الحر الفارّين إلى الحدود التركية أن التنظيم استطاع احتلال قرية بعشرة مقاتلين في مقابل 90 عنصراً للفصيل المسيطر أصلاً. ويروي رفيقه أن "معركة الشدادي استمرت 15 دقيقة فقط، وأدّت إلى مقتل 60 عنصراً من حركة أحرار الشام الإسلامية"، وهنا ربما يكون عدد القتلى صحيحاً، بيد أن ما ورد من الفصائل الأخرى عن المعركة يفيد بأنها استمرت ثلاث ساعات على الأقل. والأكثر إيلاماً في المشهد أن رواية العنصر الفار الخاطئة نُشرت في صحيفة غربية، كقصة مثيرة عبر صحافي قابله في مدينة أورفا التركية.
وليس داعش سبّاقاً إلى هذا الأسلوب، في بث الرعب تكتيكاً قتالياً أساساً، بل سبقه في هذا نظام الأسد عبر ميليشياته الطائفية التي اقتحمت قرية الحولة ثم كرم الزيتون والخالدية ودير الزور وغيرها من المدن والقرى، لترتكب مجازر تضاهي في بشاعتها مجازر داعش، مرسلة الرعب في قلوب السوريين الثائرين جميعاً، ولكَ أن تتخيل الروايات المروعة الكثيرة عن كل مجزرة وكل معتقل. والجدير بالذكر، هنا، ما أفاد به قائد عمليات النظام سابقاً على محور جوبر – زملكا (القوات الخاصّة 154) بأن النظام كان يجابه الثوار بتكتيكات الرعب وروايات الترويع، ويعتمد عليها في صلب خططه العسكرية، ويأمر ضباطه بالتركيز على من يروي فظائع اقتحام قرية ما إلى جاراتها بالتفاصيل، معتمداً في ذلك على مدنيين، يعملون لصالحه بشكل مباشر، وبغض النظر عن صحة كلام الضابط "المنشق" هذا، فإن هذا التكتيك أصبح معروفاً ومكشوفاً، حين استخدمه نظام الأسد في حماه 1982، وأثمر له استسلام دير الزور وحلب آنذاك، كما أثمر 30 عاماً من خضوع الشعب فقط باستخدام ما يرويه الآباء الخائفون لأبنائهم عن فظائع تلك المجزرة.
وإذا كان نظام الأسد، بضعف عقيدته القتالية مقارنة مع تنظيم كداعش، قد اعتمد في بقائه أربعين عاماً بالترهيب كتكتيك أول وأساس، ولم يسقط بعد بالرغم من تعريته وإضعافه ودحض أسطورة الرعب والخوف من الذاكرة وعقيدة المواجهة التي تبناها الشعب السوري منذ بداية الثورة، كم سيبقى تنظيم داعش الذي قام أساساً على هذا الأسلوب ويعدُّه نهجاً وجزءاً من رسالته بل ورسالة الدين الإسلامي كما يعتقد، بل ويتقن تنفيذه أكثر كما ظهر ويظهر من نتائج، هذا إذا لم نسأل عن من هم القادرون على دحض أسطورته وخرافة الرعب في مجتمع خائف ومقهور أساساً في سورية والعراق، ومن القادر على إيقاف "تمدده" وتمدد الخوف في الصدور؟
ليست طائرات التحالف بالتأكيد كما ثبتَ منذ حين، بل إن انتقائية دول التحالف في توجيه ضرباتها الخجولة لداعش دون النظام بالرغم من تنافسهما على انتهاج الإرهاب فعلاً وقولاً، سيزيد الخائف خوفاً والمخوِّف: داعش كان أم النظام، قدرةً على التخويف، فليبق السؤال مفتوحاً إذاً كما هو هذا الخوف.