 ٣ مارس ٢٠١٧
٣ مارس ٢٠١٧
الملفت في مفاوضات جنيف 4 السورية هو الخلاف حول المعارضة، التي سوف تحاور النظام، حيث ظهر أن هناك ثلاث معارضات، تتنافس على الجلوس لحوار النظام الذي لا يزال يرسل الشخص ذاته، والتي تعني مشاركته أنْ لا نتائج ممكنة، لأنه آتٍ ليكرّر الخطاب ذاته، الخطاب الذي يريد تكريس النظام، ولملمة بعض أطراف المعارضة للمشاركة في "حكومة وحدة وطنية"، كون أن منصب الرئيس غير مطروح للنقاش أو التفاوض، وحيث أن الأولوية للحرب على الإرهاب، الإرهاب الذي يصنعه النظام أصلاً.
هناك في جنيف وفد الهيئة العليا للمفاوضات، وهي التي تشكلت في الرياض انطلاقاً من مشاركة أطراف المعارضة كافة، وبالتالي، باتت تعبّر عنها، فهي تضم أكبر كتلتين معارضتين: هيئة التنسيق والائتلاف الوطني، وكذلك شخصيات عديدة. وهناك وفد مؤتمر القاهرة الذي من المفترض أن المؤتمر جرى تمثيله في الرياض، ومن ثم مؤتمر موسكو. وإذا كان وفد التفاوض الذي شكلته الهيئة العليا يعتبر "الممثل الشرعي"، بالضبط لأنه يضم أطياف المعارضة، فإن منصتي موسكو والقاهرة تعتبر كل منهما أنها تمثل المعارضة، وتريد وفداً موحداً مقسماً بالتساوي بينهما.
حين أخذت المؤتمرات تتوالى، وبات كل مؤتمر يعتبر أنه منصة للمعارضة، أشرت إلى الهدف من هذا التشتيت، حيث كان واضحاً أن روسيا تريد تشتيت المنصات، لكي تتحكم هي في تحديد من هي المعارضة، وبالتالي تهمّش المعارضات التي لا تريدها. كان هذا واضحاً حينها، لكن مع الأسف انساقت المعارضة وراء مؤتمراتٍ لم تعرف الهدف منها، وبات حينها عقد المؤتمر بعد الآخر موضة. وها هي تصطدم الآن بما "فعلت يداها"، حيث باتت في تنافس مع منصّات صنعتها هي. وعلى الرغم من أنها ممثلة في وفد التفاوض، إلا أن "خيالات مآته" التي اخترعتها باتت تنافسها، وتطالب بأن تكون لها حصة مساوية لها، فمؤتمر القاهرة الذي يطالب بحصته في وفد التفاوض شاركت فيه هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي، وجزء مهم من شخصيات الائتلاف الوطني، مع عدد محدود من الشخصيات المعارضة. وأصدر بيانات لا تختلف عن البيان الذي صدر عن اجتماع المعارضة في الرياض. لكن نلمس الآن أنه بات ورقةً لتقزيم وفد التفاوض، وبالتالي، باتت الشخصيات المعارضة المستقلة هي التي تستحوذ على منصة القاهرة، وتنافس الكتلة الأساسية التي قام عليها مؤتمر القاهرة. أخذت التسمية، واستحوذت على التمثيل، وباتت تريد المساواة مع كل المعارضة.
أما مؤتمر موسكو فيختلف قليلاً، على الرغم من أنه ضم هيئة التنسيق، لأنه يضم طرفا شارك في السلطة بعد الثورة، وسُحب لكي يوضع في وفد المعارضة، بناء على رغبة موسكو المباشرة، لكنه فشل. ولهذا، أخذ يدعو إلى مؤتمراتٍ في موسكو لكي يقول إنه المعارضة، أو إنه طرفٌ أساسي في المعارضة. هذا هو وضع الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير، وهي الجبهة التي عارضت بخفةٍ، بعد أن كان بعض أطرافها يشير الى خطل السياسة الاقتصادية وآثارها المدمرة. وقد باتت تنشط ضمن محور موسكو، وبالتالي، ليس بعيداً عن النظام، ولا عن المنظور الروسي للحل الذي يكرّس الاحتلال الروسي لسورية.
هناك اختلاف بين هذه "المنصات" في فهم طبيعة الصراع وفي طبيعة الحل، والجوهري هنا قبول استمرار بشار الأسد أو رفضه، وكذلك دور بشار الأسد في الحل. لكن ما يهدف إليه الروس هو نشوء معارضةٍ "على مقاسها"، تقبل بما تريد هي، بعد أن ظلت مصرّةً على بقاء الأسد. وقد سمح "تخبيص" المعارضة بأن تلعب روسيا كما تريد، وأن تظل تناور إلى أن تصل إلى الحل الذي تريده بالشخصيات والهيئات التي تريدها. ولسوف تظل تقضم المعارضة على الأرض إلى أن تصل إلى ذلك. ما أظنه ضرورياً هو أن يُفسح المجال لمن يقبل "حكومة الوحدة الوطنية"، ليعود إلى "سقف الوطن"، فلا داعي للتنافس على "فطيسة".
لا حل لا في جنيف 4 ولا 5 ولا 6، ولا حل باستمرار وجود بشار الأسد ومجموعته.
 ٣ مارس ٢٠١٧
٣ مارس ٢٠١٧
بالتأكيد، لن يستسيغ «حزب الله» الذي يديره «الحرس الثوري» دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الضحك بدلاً من البكاء، فيما هو يرفع شعار «كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء»، في تعميم لحال «الإبكاء» التي يفرضها في مناطق نفوذه، لتسري على اللبنانيين أجمعين، وتوسيع نطاقها لتشمل ما تيسر له من أرض سورية.
روحاني تساءل في معرض انتقاده المحافظين الذين ينوون استبداله برئيس جديد في أيار (مايو) المقبل، لماذا يرفض منافسوه أن «يتمتع الإيرانيون بمباهج الحياة، وكيف أن البكاء مهما بلغت مستوياته حلال، فيما الضحك والنشاط حرام؟».
لكن للحزب رأياً آخر. فهو يعتقد، على غرار المتشددين كافة، أن الفرح والسرور لا يتناسبان مع فكرة «المقاومة والجهاد» التي لا يمكن أن تستقيم سوى في أجواء من الحزن والعبوس والحداد والموت والانتحار، لذا يحظر أي احتفال في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية بغير «أعياده» التي تقتصر على التذكير بالحروب والتهجير وسائر المآسي، مثل «يوم الشهيد» و «يوم المقاومة» و «عيد التحرير»، فيمنع الحفلات الغنائية، وينكر حتى على السكان المسيحيين في القرى الجنوبية الاحتفال بمناسباتهم خوف انتقال «عدوى السعادة» إلى جمهوره.
وقبل نحو ثلاثة أشهر، منعت هيئة «التعبئة التربوية» التابعة له طلاباً جامعيين في العاصمة بيروت كانوا يحتفلون بذكرى صديق لهم، من الاستماع إلى أغاني فيروز لما قد تسببه من «انشراح» قد يلهي مناصريه عن مهمتهم الجليلة: الندب الدائم تمهيداً لتحرير مزارع شبعا.
لكن «قيَم المقاومة» التي يقول الحزب إنه يدافع عنها ويحافظ عليها، لم تعد موجودة سوى في خطابات أمينه العام وتصريحات قادته ووزرائه ونوابه. فالحزب تحول عملياً في الجنوب اللبناني إلى حارس لحدود إسرائيل بموجب اتفاقات أبرمها وشكلت أساس قرار مجلس الأمن 1701، قبل أن تُسدى إليه وظيفة جديدة هي «تحرير» سورية من شعبها، لتظل ملائمة لحكم آل الأسد.
ولا تقنع أحداً التهديداتُ الأخيرة التي أطلقها نصرالله بقصف مفاعل ديمونا وخزانات كيماوية في حيفا، لأنها تندرج فقط في إطار التفاوض الإيراني مع الإدارة الأميركية الجديدة: التلويح بحرب مع إسرائيل للإبقاء على الوضع القائم، بما يتيح استمرار التنعّم بمكاسب الاتفاق النووي والتحايل على العقوبات المتبقية.
وإسرائيل نفسها تدرك مدى التزام «حزب الله» بالتفاهم الحدودي، ومدى مثالية الوضع في جنوب لبنان بالنسبة إليها، حتى أن رئيس وزرائها نتانياهو دعا قبل أيام إلى نقل هذه التجربة إلى قطاع غزة، مطالباً بنشر قوات دولية هناك لإرساء هدوء مماثل وإغلاق الجبهة مع حركة «حماس».
ذلك أن عداء إيران الصُوري لإسرائيل لا غرض له سوى المزايدة على العرب، بمن فيهم أصحاب القضية أنفسهم، وإقامة مهرجانات عن فلسطين معظم خطبائها ممن تلوثت أيديهم بالدم الفلسطيني.
ويذهب الحزب إلى أبعد مما ذهب إليه نتانياهو، فيدعو إلى إحياء نموذج «الشريط الحدودي» الذي كانت تقيمه إسرائيل إبان احتلال جنوب لبنان، وإنشاء شريط مماثل في سورية عند الحدود مع لبنان.
لكن ربما يكون روحاني مخطئاً. فلا شيء يُفرح في إيران التي يحكمها «الحرس» و «الباسيج» بالمعتقلات والترهيب، ولا في لبنان الذي صار رئيسه ناطقاً باسم «حزب الله»، يدافع عن سلاحه وشططه.
غير أنه في حال قرر المرشد تمديد فترة رضاه عن روحاني وإعادة «انتخابه» رئيساً، ربما يضطر «حزب الله» إلى مراعاة رغبته والنظر في دعوة الرئيس، وقد يجرب توزيع بعض «الحبوب» التي يتهم بتصنيعها وتهريبها إلى دول الخليج، على أعضائه وأنصاره ومريديه، لعلها تخفف عبوسهم قليلاً وتخفف عمّن يُبكونهم في طريقهم.
 ٣ مارس ٢٠١٧
٣ مارس ٢٠١٧
آفاق التفاهمات الأميركية – الروسية ما زالت مفتوحة على رغم تراجع الاندفاع لها في الآونة الأخيرة بسبب انحسار الثقة. جولة على الأجواء الروسية أثناء انعقاد مؤتمر «نادي فالدي» Valdai club هذا الأسبوع في موسكو أفادت بأن المقايضات واردة والرغبة في الصفقة الكبرى موجودة وإن سيناريوات الأخذ والعطاء تمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط. إنما لا أحد يهرول إلى التنازلات في موسكو. إنها مرحلة الإعداد للاستعداد والتلميح إلى مواقع الأخذ ومحطات العطاء مع رسم الخطوط الحمر وتحديد سقف التوقعات. وهنا جردة عن جغرافيا التفاهمات والتنازلات والصفقات، بناءً على أحاديث عدة مع مختلف المطلعين والمقربين من صنع القرار.
الصين فائقة الأهمية في التجاذبات الأميركية – الروسية. فلا موسكو جاهزة لفتح صفحة المساومات مع واشنطن، إذا كان في ذهن الولايات المتحدة خلق شرخ في العلاقات الروسية – الصينية الإستراتيجية في أكثر من مكان. ولا واشنطن مستعدة للعداء مع موسكو لدرجة دفعها كلياً وحصراً نحو بكين، تعزيزاً للتحالف الصيني – الروسي في محور ضد المصالح الأميركية. الرسالة التي يحرص الروس على إيصالها إلى الأميركيين هي أن الصين غير قابلة للأخذ والعطاء. وما يقوله الروس هو أنهم غير مستعدين للكشف عن مواقع المساومات مسبقاً، أو للإعراب عن جاهزية التنازلات خوفاً من «أن يطالبونا اليوم بإيران وغداً بالصين» في إشارة إلى نماذج المفاوضات الأميركية على التفاهمات. فالصين فوق الاعتبارات العادية في العلاقات الأميركية – الروسية.
أوروبا هي موقع المساومات حول أوكرانيا وحول حلف شمال الأطلسي (ناتو). القيادة الروسية رسمت خطاً أحمر اسمه القرم، وهي أوعزت إلى كل من يتحدّث عن شبه جزيرة القرم بأن لا عودة ولا تراجع عن ضمها إلى روسيا – أو استعادتها من أوكرانيا، كما يصر الروس – تحت أي ظرف كان، ومهما كان الثمن أو المكافأة. موسكو تصر في الوقت ذاته، على أن أي صفقة مع الولايات المتحدة يجب أن تنطوي على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا منذ أن قامت بضم القرم.
ما يلمح إليه الروس هو أن فسحة المساومة هي دانباس Donbass شرق أوكرانيا. هناك يمكن لموسكو أن تستغني عن نفوذها العميق جداً، والذي سبّب لها مضاعفة العقوبات ضدها، بتهمة توغلها عسكرياً في الأراضي الأوكرانية، في أعقاب غزوها وضمها القرم – كما تؤكد الدول الغربية وبالذات تلك التي أرادت لأوكرانيا أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي.
الرأي الروسي هو أن أكثرية العقوبات فُرضت بسبب دانباس وأن الاستغناء الروسي عن دانباس يجب أن يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية عن روسيا. الروس يريدون أيضاً ضمانات بألا تُستخدم الدول التي التحقت حديثاً بحلف «الناتو» من أجل نشر الأسلحة الغربية على الحدود مع روسيا في البلقان أو غيره. يريدون تحييد كييف عن «الناتو»، كي لا تكون هذه العاصمة الأوكرانية وكراً لحلف شمال الأطلسي.
لماذا يقتنع الروس بأن هذه الصفقة التي تبدو مختلّة ستكون مقبولة لدى الولايات المتحدة؟ «لأن أوكرانيا مكلفة جداً «مادياً»، يقول أحد المراقبين، ولأن مردود الكلفة الباهظة لا يستحق مثل ذلك الاستثمار، وفق التفكير الروسي. إنما هناك عوامل أخرى يريد الروس الترغيب فيها، بحيث يكون الأخذ أوروبياً والعطاء شرق أوسطياً. والكلام هو عن إيران.
تفهم القيادة الروسية حاجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن يكون حازماً وقاسياً مع إيران. لذلك تركت لنفسها أكثر من هامش للتأثير في طهران بالذات في سورية، إنما مع الإسراع إلى القول إنّ النفوذ الروسي مع إيران محدود.
مشهد العلاقات الروسية – الإيرانية معقّد وله تراكمات ميدانية وعسكرية وتطلعات إستراتيجية واقتصادية. أولاً، يرى الروس أنه لولا الطائرات الروسية في الأجواء السورية لتقديم الغطاء الجوي للمقاتلين التابعين لإيران، لكانت إيران وميليشياتها خسرت الحرب في سورية ودفعت ثمناً كبيراً. إذاً، يشعر الروس بالتفوق العسكري الذي حصد الانتصارات الميدانية وضمن محطات مصيرية في الحرب السورية مثل معركة حلب. وهم يشعرون أيضاً بأن سحب الغطاء الروسي الجوي للميليشيات الإيرانية في سورية سيعرّيها ويجعلهاعرضة للسحق في حال تم اتخاذ قرار سحقها أميركياً. وعليه إن لروسيا أدوات نفوذ حادة في إيران، إذا ارتأت استخدامها في إطار المساومات مع الولايات المتحدة.
إنما، مهلاً. هذا لا يعني أن روسيا جاهزة للاستغناء عن علاقتها التحالفية مع إيران أو لاستخدام ذلك النفوذ الكبير فيها، لإحداث تغيير جذري في مشروع إيران الإقليمي الممتد من العراق إلى سورية إلى لبنان وكذلك في اليمن. لذلك الكلام أن «للنفوذ حدوداً».
ففي سورية هناك شبه تنافس روسي – إيراني على اقتسامها إما ككل، أو كسورية مجزّأة عبر التقسيم. موسكو لن تتخلى عن إنجازاتها الشرق أوسطية عبر الحرب السورية وهي عازمة على توسيع قاعدة طرطوس وإنشاء قاعدة حميميم. موسكو تريد ضمانات لتواجد روسي دائم في سورية بلا قيود أو شروط، وهي بالتأكيد تريد أن تكون لها حصة كبرى في الاستثمارات وإعادة البناء في سورية. إنما موسكو تدرك أيضاً أن إيران التي حاربت في سورية وخسرت قادة عسكريين كباراً وليس فقط رجال الميليشيات غير الإيرانية، لن ترضى بالخروج من سورية بلا مقابل. بالعكس، إنها باقية، وروسيا راضية.
ما ذكرته التقارير عن اتفاقات أبرمتها الحكومة الإيرانية مع حكومة بشار الأسد مطلع هذه السنة لم تنحصر في الاستفادة الاقتصادية، إنما شملت ما سمي «استعمالات زراعية» في ضواحي دمشق. بكلام آخر، إنها لغة التغيير الديموغرافي والتقسيم عبر لغة «زراعية» على 50 مليون متر مربع في ضواحي العاصمة السورية. هذا بالطبع إلى جانب نحو 50 مليون متر مربع لإقامة ميناء نفطي في الساحل السوري الغربي، إضافةً إلى اتفاقات حول امتلاك إيران شركات الاتصالات والفوسفات في تدمر.
ظاهرياً، تبدو مسألة سحب الميليشيات التابعة لطهران من سورية في أعقاب الاتفاق على سحب جميع القوات الأجنبية موضع خلاف بين موسكو وطهران. عملياً، إن الفرز الديموغرافي والتواجد «الزراعي» يجعلان مسألة سحب القوى العسكرية التابعة لطهران واردة وسهلة، بعد ضمان الحصة الإيرانية في سورية الواحدة، أو سورية المتعددة والمجزّأة. أين التنازلات إذاً؟ إنها في ترتيب الدار بعد الدمار وفي ترتيبات الاستقرار القائم على اقتسام الكعكة السورية بين روسيا وإيران وتركيا. وماذا للولايات المتحدة، في الرأي الروسي؟ الجواب هو: القضاء على «داعش» والراديكالية الإسلامية (السنّية) أولاً، تحجيم إيران داخل سورية، بما لا يسمح لها بالامتداد إلى الحدود مع إسرائيل، ثانياً، نصب روسيا الضامن الأقوى والشريك للولايات المتحدة في سورية، بدلاً من ترك سورية بين المخالب الإيرانية وميليشياتها. وأخيراً، إذا رغبت الولايات المتحدة وأوروبا في الاستفادة من مشاريع إعادة بناء سورية، فهناك ما يكفي للجميع، وروسيا جاهزة لفتح الأبواب أمامها.
عنصر الكرد في الساحة السورية ما زال رهن المساومات والمقايضات بالذات مع تركيا وليس فقط مع الولايات المتحدة. واضح أن الأولوية التركية هي تنظيف حدودها من الكرد ومنع قيام دولة كردية مستقلة في سورية، لا سيما أن الدولة الكردية المستقلة في العراق باتت حتمية. هنا تتوافق المواقف التركية الرافضة تقسيم سورية – خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى دولة كردية – مع مزاعم روسيا بأنها هي أيضاً ضد التقسيم. إنما للواقع على الأرض قصة أخرى، ذلك أن إيران قد تكون الضامن وراء منع تواجد دولة كردية في سورية، بغض النظر عن التقاسم والاقتسام والتقسيم. فمن بين ما تقايض عليه الدول، منع دولة كردية مستقلة في غير العراق – لا في سورية ولا في تركيا ولا في إيران.
الكرد يقولون إنهم كانوا دائماً في الخط الأمامي للحرب على «داعش» والانتصار على التنظيم. إنهم «الأقدام على الأرض» التي دفعت الثمن واستحقت المكافأة. الدول العربية، لا سيما الخليجية، لم ترسل الجيوش لتكون «الأقدام على الأرض»، في العراق أو سورية، وبالتالي، خسرت المبادرة والزخم ووجدت نفسها خلف موازين المقايضات والصفقات واقتسام النفوذ والثروات.
إنها تأتي الآن إلى العراق كعنصر نفوذ مع السُنّة هناك، دعماً للمسعى الأميركي بألاّ تسقط المناطق المحررة من «داعش» في قبضة النفوذ الإيراني، أو في أيدي «الحشد الشعبي» العراقي وقيادة «فيلق القدس» وقائده قاسم سليماني في الموصل في العراق أو الرقة في سورية.
ماذا عن الرئيس السوري بشار الأسد في موازين المقايضات؟ البعض يقول إنه باقٍ لفترة ليست طويلة. آخرون يتحدثون عن ترتيبات بدأت لما بعد «تقاعده». وهناك كلام عن أسماء ومناصب وتفاهمات رهن إتمام الصفقات. وهناك من يقول إن كل الكلام عن مصير بشار الأسد من صنع المخيلات، لأن الصفقة الكبرى بعيدة، ولأن لا داعي لروسيا للاستغناء عن الأسد قبل أن تقتضي الصفقات ذلك – والمؤشرات في الولايات المتحدة لا تفيد بأن هناك استعجالاً إلى التخلص من الأسد، بل إن هناك استعداداً للقبول به كأمر واقع، مع اتخاذ إجراءات عزله عملياً.
الغائب عن صنع الصفقات بمعنى أن لا حديث عن ضغوط عليه في المعادلات الأميركية – الروسية هو إسرائيل إذ إن كلتيهما تريد إبعادها عن المساومات. فلسطين باتت في مرتبة ثانية وثالثة لكثير من العرب، لا سيما بعدما تربّعت إيران على صدارة قائمة الأولويات لدى الدول الخليجية، وبعدما بات اليمن أهم الأولويات.
أما في اليمن فروسيا ليست جاهزة لاستخدام أية أدوات ضغط ضد إيران، لتفرض عليها الكف عن التدخل هناك على الحدود مع السعودية، فهذه ليست أولوية روسية. هذه مسألة ربما تكون لاحقاً ضمن موازين الصفقة الكبرى التي لم يحن وقتها بعد. فهناك احتمال لتوتر في العلاقات الأميركية – الروسية وصعود محاور مضادة. فإذا كانت روسيا في محور مع إيران مقابل محور يضم الولايات المتحدة والسعودية، لن تتحمس موسكو مسبقاً وقبل الأوان إلى سحب الورقة الإيرانية المهمة من اليمن. فلا استعجال في الأمر بل إن الدول الخليجية تقدّر لروسيا مجرد عدم تعطيل مهماتها في اليمن.
«نادي فالداي» نظّم مؤتمراً مهماً تحت عنوان: أي غدٍ آتٍ إلى الشرق الأوسط؟ كان واضحاً أن روسيا تتموضع في ذلك الغد، وهي تضع الإستراتيجيات العملية لأي من السيناريوات إن كانت في ظل التفاهمات الأميركية – الروسية، أو في حال بروز تصادم المحاور. ما لم تكشف عنه جولة استنباض الأجواء هو تلك الأوراق الخفية الجاهزة للمقايضات السرية عشية الصفقة الكبرى. فهذا مبكر، ولم يحن الأوان.
 ٢ مارس ٢٠١٧
٢ مارس ٢٠١٧
في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 نشرت في هذه الصفحة من جريدة «الحياة» مقالاً بعنوان «لماذا على المعارضة السورية حضور مؤتمر جنيف؟». أثار المقال حينها الكثير من ردود الفعل المرحبة وربما لعب دوراً في إقناع المعارضة التي كانت مترددة وقتها في حضور أول مفاوضات غير مباشرة عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وكان المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي يشرف وقتها على المفاوضات ويضع أجندتها.
في ذلك المقال حاججت بأنه «يجب أن تظهر المعارضة السياسية والعسكرية سواء ممثلة في الجيش الحر أو الائتلاف حساً بالمسؤولية تجاه الشعب السوري المهجر والمشرد، إذ لا يعقل أننا لا نستطيع أن نقدم أجوبة لملايين السوريين حول انتهاء الأزمة وأمل عودتهم إلى بيوتهم، حول مصير أبنائهم وبناتهم المعتقلين في سجون نظام الأسد، والخوف يزداد يوماً بعد يوم حول وفاتهم تحت التعذيب في ممارسة اعتادت سجون الاحتلال الأسدي على ممارستها بحق كل المعتقلين من دون تمييز بين سنهم أو جنسهم» .
وبالتالي قلت إنه يجب أن تظهر المعارضة نوعاً من الإحساس بالمسؤولية تجاه كل ذلك، وأن النصر العسكري عبر «الجيش الحر» لا يمكن تحقيقه من دون تدخل عسكري خارجي بدا بعيداً وقتها على رغم استخدام الأسد السلاح الكيماوي في الغوطة في ٢١ أب (اغسطس) 2013، حيث تجنب الأسد حينها الضربة العسكرية الأميركية عبر صفقة روسية قضت بتسليم أسلحته الكيماوية مقابل تجنب الضربة.
ولذلك أضفت بأنه يجب أن تكون أولويات المعارضة السورية في التحضير لمؤتمر جنيف كالتالي:
- تجنب أي معارك جانبية تزيد من خسارة المعارضة قيمتها وسمعتها في الشارع السوري حول من سيحضر اللقاء؟ ومن هو الوفد الذي سيمثل السوريين؟ وتركيز النقاش والحوار حول لماذا سنحضر إلى جنيف؟ وماذا يمكن أن نحققه من حضور المؤتمر؟
- ينص اتفاق جنيف الأول على ما يسمى «جسم انتقالي كامل الصلاحيات»، وبالتالي لا بد للمعارضة من الإصرار على تشكيل مجلس انتقالي لا دور للأسد فيه، يمتلك الصلاحيات الكاملة بما فيها الجيش والاستخبارات ويشرف على المرحلة الانتقالية، إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة، تسبقها إجراءات شاملة تشمل عودة المهجرين والنازحين.
- يجب أن تصر المعارضة على تشكيل إجراءات ثقة ومسارات متابعة تشرف عليها الأمم المتحدة، وهي: مسار المعتقلين السياسيين بحيث يجري تسليم كل اللوائح إلى الأمم المتحدة لإجبار نظام الأسد على إطلاقهم من دون أي شروط، ومتابعة شؤونهم بحيث تستطيع المعارضة أن تكسب ثقة آلاف العائلات السورية التي لديها معتقلون في سجون الأسد، والمسار الثاني يتعلق بفك الحصار عن المناطق المحاصرة وعلى رأسها الغوطة الشرقية وحمص ومخيم اليرموك، وتكون مسؤولية الأمم المتحدة هي مراقبة وصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل إلى هذه المناطق، أما المسار الثالث فهو التزام دولي ومن كل الدول الداعمة لمؤتمر جنيف بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمنكوبة وإعطائها وأهلها تعويضات خاصة وسخية، فكل مناطق المعارضة أصابها الأسد بالدمار، وعلى المعارضة السياسية أن تعي ضرورة فتح كل الفرص لإعادة ملايين اللاجئين إلى بيوتهم بأمان وكرامة، فلم يذلّ السوري في عمره كما يخضع للإذلال اليوم في مخيمات اللجوء.
تلك إذن هي النقاط التي يجب أن يدور النقاش حولها بين المعارضة اليوم، ويجب عدم تحويل النقاش إلى نقاش حول الوطنية والخيانة. يجب أن تتصرف المعارضة بمسؤولية تجاه ملايين السوريين وبحنكة بحيث تتخلص من الأسد عبر مسار دولي يلتزم به المجتمع الدولي حول المرحلة الانتقالية.
للأسف لم يتحقق شيء من ذلك خلال السنوات الأربع الماضية وعقدت جولات تفاوضية عدة في جنيف أيضاً بلا معنى أو حتى مبرر لعقدها من دون تحضير من القائمين عليها في الأمم المتحدة.
وبالتالي وكما يقال المكتوب ظاهر من عنوانه: لن تقود المفاوضات المستأنفة مجدداً إلى أي حل، بل بالعكس تماماً ازداد الوضع على الأرض في سورية سوءاً وتدهوراً، فارتفع عدد الشهداء إلى ما يقارب النصف مليون، وزاد عدد اللاجئين إلى ما يعادل الستة ملايين أما النازحون في وطنهم ففاق عددهم 9 ملايين، وبالتالي تعرض أكثر من نصف السكان للقتل والتهجير والتشريد مع سياسات الأسد التي ازدادت شراسة وهمجية، والأسوأ من ذلك أن المعارضة السورية العسكرية تعرضت لهزيمة قاسية جداً بالخروج من مدينة داريا رمز الصمود والمقاومة في دمشق، وحلب التي كانت لوقت طويل رمز امتلاك المعارضة زمام المبادرة في الشمال السوري، وتتالت عمليات التهجير القسري بإشراف روسي – إيراني.
وحتى في الملف الذي يبدو لوهلة أولى أنه في غاية البساطة ولا يكلف النظام أي تكلفة سياسية أو عسكرية وهو الملف الإنساني، لم يفرج النظام عن المعتقلين وزاد عدد التقارير المروعة عن عمليات القتل والتصفية الجماعية داخل السجون وآخرها كان تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا، أما المناطق المحاصرة فبدل أن تنتهي ازداد عددها وبات التجويع سياسة يومية لكسر المدنيين والمعارضة، وبات المجتمع الدولي يستمع إلى هذه الأخبار من دون اكتراث أو مسؤولية بأنه يجب القيام بشيء لوقف عمليات الإبادة هذه.
وفوق ذلك كله أتى فوز إدارة أميركية جديدة ترى الحل السوري في روسيا فجعل السوريين يترحمون ربما على أيام باراك أوباما وسلبيته الكارثية التي أوصلت سورية إلى دمار معمم على يد الأسد وحلفائه.
بالتالي ما هي نقاط القوة التي يمكن المعارضة أن ترتكز عليها في مفاوضاتها السياسية في جنيف؟ عصفت ذهني كثيراً فلم أجد ما يستحق عناء الذهاب إلى جنيف.
والأسوأ من ذلك كله أن المعارضة السياسة تشظت إلى معنى ضياع الهوية السورية تماماً، فتحالفاتها باتت هي التي تفرض عليها قرارها ولم يعد القرار الوطني موجهاً لها أو بوصلة لتحركاتها.
إذاً، ما الحل؟
الحل يكمن في عملية تعبئة جماعية للمعارضة بما أسميه عملية «التحشيد المدني» من أجل التغيير، وهذه تشمل المهجرين واللاجئين والسوريين في المناطق المحررة وحتى في مناطق النظام، إنهاء عهد ما يسمى الفصائل المسلحة والتوحد تحت راية وطنية واحدة، وفي الوقت نفسه خلق مناخ سياسي ضاغط دولي وإقليمي وداخلي باتجاه مطالب محددة وواضحة مثل الإفراج عن المعتقلين كلهم وإنهاء وصمة العار و «المسالخ» البشرية التي تستمر تحت أعيننا، والتركيز على المطالب الإنسانية في كسر الحصار عن المناطق المحاصرة.
يجب على المعارضة السياسية العمل على تشكيل قطب مواز مؤثر وفعال عبر تكثيف الاجتماعات الدورية والاتفاق على عدد من الخطوات السياسية ذات الأثر الجماهيري مثل الدعوة إلى عدد من الاعتصامات السلمية والعلنية في شكل مشترك داخل سورية وخارجها.
علينا أن نعتمد على الشباب كشريحة محورية في بناء التراكمات السياسية على أرض الواقع، ففعاليتهم في المشاركة تؤشر إلى الديمومة والاستمرارية والقدرة على الوصول إلى أكبر الشرائح تأثيراً في المجتمع السوري بحكم كونه مجتمعاً شاباً كما يدل على ذلك متوسط العمر في هذا المجتمع.
والجزء الأخير من عملية التحشيد يتعلق ببناء إستراتيجية واضحة ومحددة الخطوات والأهداف لعملية الانتهاء من الألم وإشاعة الأمل بأن التغيير في سورية ليس ممكناً فحسب بل مقبل بكل تأكيد
 ٢ مارس ٢٠١٧
٢ مارس ٢٠١٧
استبدل النظام السوري خلال السنوات الست الماضية المصطلحات الدولية في التعامل مع ثورة الشعب السوري، محولاً الأنظار عنها من صراع سياسي إلى قضايا متشابكة من إنسانية وإغاثية وحرب دامية على الإرهاب، ولاحقاً المشاركة في الإدارة وآليات الوصول إلى ذلك، وإعداد دستور جديد وقانون انتخابات، وكل ما من شأنه أن يغير معادلة أن الثورة تعني التغيير الكامل، لتصبح الثورة ومسألة التغيير السياسي في مكان، وطاولة المفاوضات في مكان آخر.
وفي مقاربة واضحة المعالم مع تعامل إسرائيل في المفاوضات الفلسطينية، بدءاً من طرق حصار المدن والمناطق وعزل بعضها عن بعض ومروراً بتهجير السكان وترهيبهم، ووصولاً إلى طاولة مفاوضات عقيمة أبدت إسرائيل رغبتها في استمرار العملية التفاوضية إلى ما لا نهاية، وفي تعبير آخر طاولة تفاوض لا تمنع بقاء الحال على ما هو عليه، ولا تفيد في إعادة الحقوق الأساسية لتكون فوق تفاوضية، كحق الإنسان في الحياة الآمنة في بيته وعلى أرضه مع حقوق مواطنة كاملة.
ورغم الفروقات الكبيرة بين ثورة شعب من أجل الحرية ونضال شعب ضد احتلال إسرائيلي لأرضه، وهذا الفرق الكبير بين القضيتين، لكن المدهش أيضاً وجود تشابه كبير بينهما، على الأقل في العمليتين التفاوضيتين السورية- السورية، والفلسطينية- الإسرائيلية، ففي الحالين مثلاً لا يوجد اعتراف بالشعب أو بحقوق هذا الشعب، فلا إسرائيل تعترف بوجود الشعب الفلسطيني بوصفه شعباً له حقوق، ولا النظام السوري يعترف بوجود شعب له حقوق، فالشعب الذي يعترف به النظام هو من يحمل السلاح معه ويدافع عن سورية الأسد، فهو يعتبر سورية ملكاً خاصاً له، وإرثا عائلياً، ما يفصح عنه شعار: سورية الأسد أو نحرق البلد، وما تبقى من السوريين هم مجموعة من الإرهابيين أو مرتبطين بمؤامرة خارجية أو لا لزوم لهم في «سورية المفيدة» أي «سورية الأسد» لا أكثر.
كل شيء مسموح به تحت سقف النظام الحاكم: تغيير وزارة، أو تغيير مجلس الشعب، وحريات اقتصادية وإعلامية، بشرط ألا تهدد سقف النظام، ولا تقترب من مناطق سيادته (السيطرة على الموارد والقرار والجيش والأمن)، والأمر نفسه في إسرائيل أيضاً، التي تسمح للفلسطينيين بحكم ذاتي، أو حتى بإقامة دولة منقوصة السيادة، لكن السيادة الفعلية على الأمن والسلطة والموارد تبقى لإسرائيل.
أيضاً، في المفاوضات عملت إسرائيل على تجزئة القضية الفلسطينية، بمعنى أن القضية لم تعد تتعلق بدولة تحتل أرض شعب آخر وتصادر حقوق مواطنيه، وإنما قضايا متعددة ومختلفة وكل قضية يفترض حلها بمعزل عن غيرها، إذ هناك قضية اللاجئين، والقدس، والحدود، والمستوطنات، والأمن، والمياه، والعلاقات الاقتصادية، والمعتقلين، وقضية مواجهة الإرهاب... إلخ، وهذا ما اشتغل عليه النظام بدعم كبير من روسيا وإيران، ولاحقاً مجموعة الدول التي وجدت مصالحها متقاطعة مع هذه الرؤية، فتشعبت القضية السورية وتجزأت لتصل إلى مسارات عديدة، كل مسار يحتاج إلى «جنيفات»، وكل جولة في جنيف تحتاج إلى قاموس لتفسير مضامينها، إذ يرفض النظام ومن يوافقونه بشكل مطلق اعتبار الثورة قضية سياسية، أو قضية شعب يريد التغيير السياسي من أجل الحرية والكرامة والديموقراطية والمواطنة، لأن كل ذلك يمس وجوده كنظام، ولذلك فهو عمل بكل جهوده على تحويلها قضية اعتداء خارجي، أو قضية إرهاب، أو قضية صراع بين الأقليات، أو قضية طائفية، أو قضية إنسانية أو إغاثية للاجئين والنازحين.
المتابع اليوم لتفاصيل ما يقدمه الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا لحل الصراع السوري- السوري، من اقتراحات للدخول في العملية التفاوضية التي لا تزال مستعصية على النظام والمعارضة، يستذكر ما حدث في اتفاق أوسلو عام 1993 وكيف عملت إسرائيل على مرحلة حل القضية الفلسطينية، ومن يراجع اتفاق أوسلو، يلاحظ وجود مرحلتين، انتقالية مدتها خمس سنوات تتعلق بإيجاد حلول موقتة وجزئية، ومرحلة نهائية تناقش القضايا الأساسية، لكن من دون تحديد أي جدول زمني، ومن دون أي ضمانات. في المفاوضات السورية توجد أيضاً مرحلة انتقالية، لكنها لا تهدد النظام، الذي يعمل، مع حلفائه، على اعتبارها مرحلة لإعادة تعويمه، بل يسعى خلالها النظام لتجنيد إمكانات خصمه المعارض في الحرب المزعومة على الإرهاب، وهي الحرب التي يمكن أن تمتد وتتمدد وفق المصلحة الدولية التي تتضمن أيضاً مصلحة النظام في «عدم الانتقال السياسي».
وعلى هدى إسرائيل بما فعلته من تقسيم للأراضي في الضفة الغربية التي لا يتنازع على ملكيتها الفلسطينية أحد، وتحويل المفاوضات إلى لعبة علاقات عامة، أو إلى مسار عبثي لا جدوى منه، يفعل النظام السوري الشيء ذاته كما لاحظنا من جنيف1 إلى جنيف4 إضافة إلى مسار آستانة، وما كان للنظام أن يفعل ذلك لولا أنه وجد إسرائيل مثله الأعلى في الضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية التي صدرت، وستصدر، لتبقى المفاوضات حفلات سمر يراق خلالها مزيد من الدم السوري.
 ٢ مارس ٢٠١٧
٢ مارس ٢٠١٧
هل هناك فعلا جدية روسية في الضغط على النظام السوري للبحث في الانتقال السياسي في نظام الحكم في سورية؟ وهل أخذت موسكو تعطي إشارات إلى استعدادها للافتراق عن الخطة الإيرانية في بلاد الشام والتي أساسها بقاء بشار الأسد في الرئاسة إلى ما شاء الله؟ وهل بلغ التمايز الروسي- الإيراني الذي برزت مظاهره الميدانية على الأرض السورية حد تحوله سياسة مناقضة لما تنويه طهران في تنافسها مع الدب الروسي على الإمساك بالقرار السياسي السوري في إطار مشروعها في الشرق الأوسط كلاً؟
تُطرح هذه الأسئلة، وغيرها كثير، لمناسبة التركيز الإعلامي على اعتبار الضغط الروسي على وفد نظام الأسد المفاوض في جنيف4 كي يقبل بند الانتقال السياسي على جدول التفاوض بينه وبين وفد المعارضة، «بدايةً طيبة» و «تقدماً»، كما قال رئيس وفد الأخيرة نصر الحريري أول من أمس.
قيل الكثير عن الخلاف بين الروس والإيرانيين، وبين هؤلاء والأتراك... بعد دخول قوات النظام والميليشيات المدعومة من طهران إلى حلب قبل شهرين، والذي مهد له القصف الروسي العنيف لأسابيع. إلا أن بعض الاستنتاجات في هذا المجال انطلق من بعض المؤشرات الواقعية، لتضخيم التوقعات حول هذا الخلاف. واستند التضخيم إلى افتراض أن العدائية «الترامبية» لدور إيران في سورية والمنطقة مقابل المراهنة الروسية على التفاهم مع الإدارة الجديدة في واشنطن، قد تقود إلى صفقة بين الجبارين على حساب إيران. لكن واشنطن تتمهل في توضيح توجهاتها. والميدان السوري يخضع للتقلبات المتناقضة، وكل أسبوع، بل كل يوم لا يشبه الذي سبقه في رسم خريطة الوقائع العسكرية في لعبة الأمم على الرقعة السورية، والدليل ما يحصل في منبج وغرب حلب، وهكذا على المستوى السياسي.
كان من الطبيعي أن تلجأ الديبلوماسية الروسية إلى الظهور بمظهر ممارسة الضغط على النظام لقبول بحث الانتقال السياسي بنداً أساسياً في جدول أعمال جنيف، بعد إحباطها بالفيتو مع الصين، مشروع قرار مجلس الأمن إدانة النظام لاستخدامه الأسلحة الكيماوية مجدداً، وبعد أن أفقدها خرق النظام وإيران وقف النار في كل أنحاء سورية، والذي ادعت موسكو النجاح في تثبيته في آستانة1 و2، صدقيتَها كراع للاتفاق. والأرجح أن القنبلة الدخانية التي اسمها «الضغط على النظام» حول الانتقال السياسي، جاءت للتغطية على التقريرين الدوليين اللذين أذيعا فور فشل تمرير قرار مجلس الأمن، عن استخدام قوات الأسد غاز الكلور في غاراته على حلب، وعن قصفه المتعمد لقوافل الإغاثة الإنسانية التي كانت مخصصة للمحاصرين شرق حلب قبل إسقاطها منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي... في وقت تأخذ المعارضة على الروس عدم ضغطهم على النظام و «حزب الله» لتنفيذ ما تقرر في آستانة من تمرير للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وللإفراج عن معتقلات في السجون... إلخ.
لم يكد وفد المعارضة ينتهي من الحديث عن التقدم بفعل الضغط الروسي، حتى قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، الذي تولى المهمة، إن «الجديد هو أن أطراف جنيف وافقوا على البحث في كل المواضيع في شكل متواز»، ثم اتهمت الخارجية الروسية المعارضة بتقويض المحادثات لرفضها التعاون مع معارضتي القاهرة وموسكو المؤيدتين بقاء الأسد، فيما قال مسؤول في وفد النظام إن جدول الأعمال يتضمن 4 سلات هي الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات، مستبعداً ضم الانتقال السياسي إلى النقاط الثلاث التي طرحها ستيفان دي ميستورا، ومصراً على تقديم بند الإرهاب الذي رفضت المعارضة مواصلة إلهاء الأسد العالم به.
ومع صحة القول إن المعارضة انتزعت للمرة الأولى بند «الانتقال السياسي» نظرياً، فإن الإصرار الروسي على «بحث متواز» لكل المواضيع يعني ربط أي تقدم في أحدها بالتقدم في غيره، لإطالة التفاوض في شأن الحكم الانتقالي الذي نص عليه القرار الدولي 2254 ، فما تضمنه الأخير من جدولة زمنية لآلية الانتقال (عملية سياسية لـ 6 أشهر تحدد جدولاً لصوغ دستور، ثم انتخابات في غضون 18 شهراً بإشراف دولي) تأخر زهاء 15 شهراً منذ صدور القرار في 18 كانون الأول (يناير) 2015.
قنبلة موسكو الدخانية إحدى المناورات المنفصلة المفاجئة، التي سرعان ما يظهر نقيضها كما عودتنا ديبلوماسيتها، والمتبقي يتكفل به وفد النظام بالاستناد إلى لغم في القرار الدولي هو أن قيام هيئة حكم انتقالية جامعة تخول سلطات تنفيذية كاملة تعتمد في تشكيلها على «الموافقة المتبادلة». وهذا باب للمماحكة غير المتناهية، في انتظار التوافق مع إدارة ترامب.
 ٢ مارس ٢٠١٧
٢ مارس ٢٠١٧
لن يتقدّم السوريون خطوة واحدة إلى الأمام في محادثات جنيف الرابعة، والتي سوف تنتهي كما انتهت مفاوضات جنيف 1 و2 و3، أي قبل أن تبدأ، وقبل أن تنهي مناقشة جدول الأعمال التي تحطمت على "صخرتها" جميع المؤتمرات التفاوضية السابقة. ربما، هذه المرة، بمنسوبٍ أقل من التهم والشتائم التي يتقنها وفد النظام، احتراما للحليف الروسي الذي وقعت عليه، للمرة الأولى، رعاية "تمثيلية" المفاوضات السورية. والسبب بسيط جدا، وأقل تعقيدا بكثير مما تدّعي الدبلوماسية الدولية، وما يريد كبارها أن يقنعوا الرأي العام السوري به، وهو لا يختلف عن السبب الذي أفشل مفاوضات الحل السياسي في فلسطين، منذ مؤتمر مدريد الشهير في 1991. نظام الأسد وحلفاؤه الأساسيون في طهران يرفضون التخلي عن السيطرة على كامل السلطة والبلاد، مهما كانت الظروف، ولأي طرفٍ كان، لأنهم يريدون، بكل بساطة، الاحتفاظ بها، تماما كما رفض نظام الاحتلال الإسرائيلي "التنازل" عن أي شبرٍ من فلسطين، وأراد ولا يزال السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية، وضمها بالتدريج وحرمان الفلسطينيين من أي أمل بإقامة دولة على حدود "إسرائيل".
كما كان عليه الحال في المسألة الفلسطينية، لم يكن لدى القيادة الفلسطينية بكل أجنحتها، ولا لدى الرأي العام الفلسطيني، على تعدّد اتجاهاته، أي شك في أن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي لإسرائيل، والضامن لمصالحها وأمنها، وتفوّقها على عموم المنطقة العربية وغير العربية في الشرق الأوسط كله، وأن واشنطن لا يمكن أن تفعل، في أي ظرف، ما يمكن أن يسيء إلى مصالح الاحتلال الإسرائيلي. لكن، لهذا السبب بالذات، وفي ظرفٍ تضاءلت فيه الخيارات إلى حدود العدم، راهن الفلسطينيون على العلاقة الوجودية بين واشنطن وتل أبيب، من أجل تحقيق تسويةٍ تحفظ ماء الوجه، وتقبل بجزءٍ لا يكاد يذكر من فلسطين، يرضي طموح النخبة الفلسطينية، ويبرّر استمرارها ووجودها على رأس شعبٍ لا يزال أغلبه يعيش في المخيمات. ما يعني أن من مصلحة إسرائيل إيجاد حل للقضية الفلسطينية بأرخص الأثمان، ومن مصلحة الولايات المتحدة الضغط على حكومات إسرائيل، من أجل تسهيل التوصل إلى هذا الحل الذي لا يعدو أن يكون مبادرةً لحفظ ماء الوجه للسلطة الفلسطينية التي يعترفون بفائدتها في منع بروز حركات متطرّفة فلسطينية.
ويكاد الوهم ذاته الذي ربط مصير الحركة الفلسطينية بالتفاهم مع الولايات المتحدة والرهان على تماهيها مع إسرائيل، من أجل إقناعها باتباع سياسة أكثر عقلانيةً حتى بالنسبة لحفظ مصالحها ذاتها، يعود بالصورة نفسها في ما يتعلق بمراهنة سوريين كثيرين وقادة المعارضة أيضا على موسكو، وعلاقتها القوية مع نظام الأسد، والتي تريد، في نظري، أن تحولها إلى علاقاتٍ وثيقة ونهائية، لا تنافسها أي علاقات أخرى، بما يناظر الترابط الوثيق في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، للضغط على نظام الأسد وطهران، وحثهما على قبول تسويةٍ تحفظ ماء وجه معارضةٍ فقدت، كما حصل للفلسطينيين، كثيراً من حماس حلفائها السابقين ودعمهم، وغيّب أصدقاءها اليأس والخوف من التورّط معها.
في الحالتين، كانت الحصيلة صفرا. وبدل أن تكون المفاوضات وسيلةً للتوصل إلى حل للنزاع أو الصراع القائم، صارت هي المشكلة، وصار الهدف الذي يسعى إليه الأطراف، حلفاء المعارضة وأصدقاء الشعب السوري، أو من يتّسمون باسمهم، هو الجري وراء اجتماعاتٍ لا معنى ولا قيمة لها، والتأكيد على أهمية محادثاتٍ تبعد الأطراف عن القضية المطروحة للنقاش أكثر مما تقربها من إيجاد حل لها. والحال أن ما يحصل هو بالضبط تقويض أسس أي مفاوضاتٍ جدية، ووضع السوريين ومعارضتهم، كما وضع الفلسطينيون وقادتهم منذ ربع قرن، أمام خيار واحد: قبول الأمر الواقع. كل ما هنالك أن استمرار الحديث عن مفاوضاتٍ قادمة، ومؤتمرات محتملة، يفتح إمكانية تمرير فرض الأمر الواقع بالتدريج، ومن دون أن يشعر الطرف المعني، أو بالأحرى تهريب الحل العسكري الذي يتقدم وحده على الأرض، وتحويل المفاوضات إلى مخدّر من أرخص الأثمان.
لم يكن السوريون بحاجة إلى وساطة موسكو، إذا كان الهدف من المفاوضات التي تدفع إليها وتتوسط لإنجاحها، هو إعادة هيكلة النظام السوري، وإعادة الشرعية والاستقرار إليه، كما صرح مبعوث روسيا للقضية السورية ميخائيل بوغدانوف، الاثنين الماضي، في مداخلته في منتدى فالداي للحوار الاستراتيجي في موسكو، عندما انتقد "الثورات التي تسعى إلى إطاحة أنظمةٍ بدعم خارجي"، وقال إن الاحتجاجات تسمح بتقويم مشاعر المواطنين، وتتيح الفرصة لتحسين الدستور، إلا أن ذلك لا يعني ضرورة إلغاء الدستور والمطالبة برحيل السلطات الشرعية عن طريق القوة أو الثورات أو الانتفاضات، من دون انتظار إجراء انتخابات جديدة، وهذا يعني تكليف النظام الشرعي بالإصلاحات، وتنظيمه الانتخابات، أي ببساطة إلغاء جوهر المفاوضات في جنيف.
وليس هناك أي سببٍ لكي تعطي المعارضة السورية، مهما وصلت من الضعف، ولا الشعب الذي قاتل ست سنوات وحيدا، بركتهما لتعيين ممثلي منصة موسكو أو غيرها أعضاء في حكومة مشتركة مع النظام، فهؤلاء أحرار، وبإمكانهم في أي وقت أن ينضموا إلى حكومةٍ واحدة، يسمونها كما يشاؤون، حكومة وحدة وطنية أو حكومة روسية سورية، أم أي شيء آخر. ولن يقف أحد ضد خياراتهم، لكن هذه ليست الحكومة التي تمثل موقف الشعب الذي تريد أن تعبر عنه المعارضة، ولا موقع معارضةٍ قدمت آلاف الضحايا، من أجل تغيير النظام القائم، وتحرير الشعب من القهر والذل والاضطهاد. ومن الأفضل، في هذه الحالة، أن تبقى المعارضة معارضة، وتترك الروس والإيرانيين يشكلون حكومتهم الخاصة، ويضعوا على رأسها أيا من الدمى التي يثقون بها، ويستطيعون التلاعب بقراراتها، كما يشاؤون. قد يمثل هذا حلا لبقاء الأسد، وبقاء طهران ومصالحهما الفائقة، ولتوسيع نفوذ الروس وتكريس انتدابهم على سورية، لكنه لن يكون اتفاقا، ولا حلا للمسألة، ولا إنهاءً لأي نزاع.
لا ينبغي أن يخدع الروس أنفسهم، ولا أن تخدع الحكومات العربية وغير العربية التي تراهن على الروس، في مثل هذا الحل، باسم الحفاظ على إمكانية الحرب على الإرهاب، نفسها أيضا. لن يكون هناك حل، مهما حصل، وحتى لو وقّعت المعارضة على صك الاستسلام، ولن توقع، مع نظامٍ شنّ الحرب على شعبه، وقام بتدمير وطنه، وتشريد أبنائه في مختلف بقاع الأرض، ولن تكون هناك تسويةٌ ممكنةٌ مع نظامٍ قبل بأن يكون غطاء للاحتلال.
في نظري، ستستمر المفاوضات مع النظام السوري، وأولياء أمره من الإيرانيين، عقيمة، مهما تعدّدت المؤتمرات، وأعيد صياغة المبادرات لتمريرها على الرأي العام السوري. والمستفيد الوحيد من هذا العقم والفشل والتأجيل الدائم للحل قوى التطرّف التي يمقتها الجميع، لكنه يعمل على تغذيتها في كل خطوةٍ يسعى فيها إلى الإبقاء على أصل المأساة ومصدرها، وهو نظام القهر والإذلال والتعذيب والمعتقلات.
وسيخطئ أيضا الذين يسوقون من بين الحكومات العربية حلا رخيصا على طريقة المحاصصة الطائفية، يغطي على الإبقاء على نظام العبودية، أو تقاسما للسلطة مع مجرمي الحرب وأبطال الإبادة الجماعية، لأن الأغلبية الساحقة من السوريين لن تقبل، وسوف ترفض تحويلها إلى طائفةٍ وطوائف متنازعة على سلطاتٍ ومناصب وهمية. ما يريده السوريون هو الحرية.
والتسوية السياسية الوحيدة التي تقود إليها، وتفتح الطريق أمام مفاوضاتٍ حقيقية ومثمرة، ترضي تطلع السوريين إلى الحرية، هي وقف الحديث عن جميع المواضع الثانوية، وتركيز الأطراف كافة، وفي مقدمتها الدول الكبرى التي تريد الخلاص، أو على الأقل تخفيف عواقب الكارثة السورية التي لم تنته بعد، على نقطةٍ وحيدة واحدة: توفير الشروط الأمنية والسياسية التي تسمح للشعب السوري، من دون تمييز بين الطوائف والقوميات والطبقات، بتقرير مصيره من خلال انتخاباتٍ عامةٍ نزيهة وحرة وتحت إشراف دولي. وإذا كان التوصل إلى هيئةٍ انتقاليةٍ تقوم بالإعداد لهذه الانتخابات، وتضمن استمرار الدولة، وإدارة الشؤون العامة خلال سنة أو أكثر، مستحيلا بين الحكم والمعارضة، أي إذا أصر الحكم القائم على عرقلة التوصل إلى حلٍّ يفضي إلى عملية تقرير مصير، فعلى الأمم المتحدة والدول الكبرى الخمس في مجلس الأمن أن تتحمل مسؤولياتها إزاء السوريين المنكوبين، وتأخذ على عاتقها تحقيق هذه المهمة، قبل تسليم السلطة لحكومة سوريةٍ ديمقراطيةٍ، منبثقةٍ من الشعب ومعبرة عن إرادته. أمام رفض النظام وشركائه التراجع، وتردّد الدول الكبرى في مواجهة حلفاء النظام، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتنامي مخاطر التطرف الجديد النابع من الإحباط والبؤس والهوان، لا أعتقد أن هناك، ما لم تتغير المعطيات الدولية، أي حلّ آخر قابل للحياة.
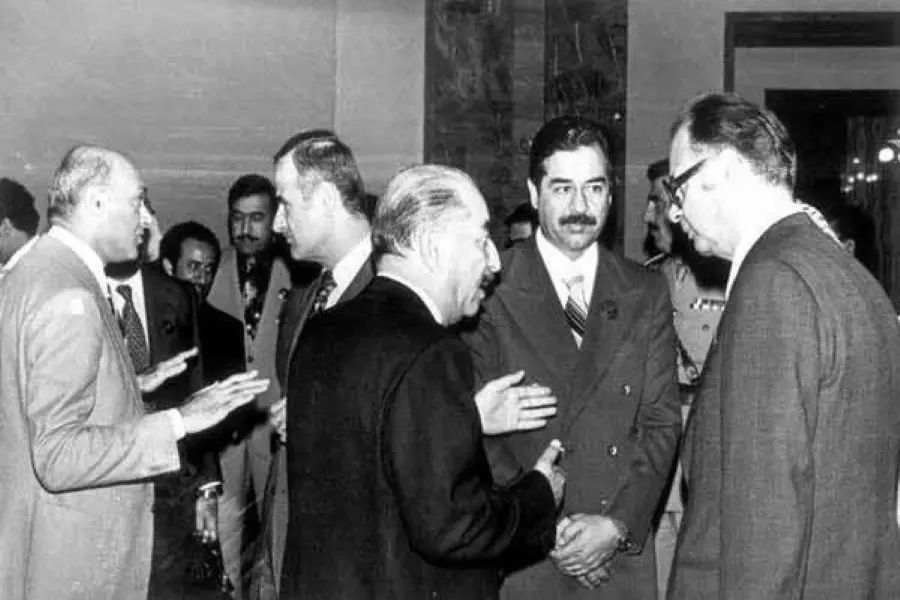 ٢ مارس ٢٠١٧
٢ مارس ٢٠١٧
تتصف الديناميكيات الأمنية والسياسية لمنطقة الخليج العربي بالمعقدة، ويستوجب فهم دوافع التعاون والمواجهة وضعها ضمن إطار نظري شامل قادر على الإلمام بجميع خصائصها المحلية والإقليمية ومدى تفاعلها مع العوامل الخارجية وتكاملها مع بعض البعض. يتبنى هذا الملف نظرية "بوزان" في تحليل تفاعلات منطقة الخليج للفترة الممتدة من تاريخ انسحاب الأسطول البريطاني عام 1971 حتى الغزو العراقي للكويت، وتزودنا نظريته المسماة بالمجمَّع الأمني الإقليمي The Regional Security Complex Theory (RSCT) بإطار نظري رصين من أهم ميزاته اعتبار المستوى الإقليمي كوحدة أساسية في التحليل دون إغفال نفاعلها مع المستويين المحلي والدولي. ونتناول في المقدمة أبرز المقاربات التي اعتمدها "بوزان" في نظريته، وأولها تعريف الشرق الأوسط، حيث اعتبره مجمعاً أمنياً إقليمياً مقسّماً إلى ثلاثة مناطق أمنية داخلية هي: منطقة الخليج، ومنطقة بلاد الشام، ومنطقة المغرب العربي. ويخلص "بوزان" في نظريته إلى تشابه الديناميكيات الأمنية للمناطق الفرعية مع الإقليم ككل من حيث الخصائص والميّزات. أمّا المقاربة الثانية فتكمن في تميز النظرية بين التفاعلات الدولية الناتجة عن قدرة الدول الكبرى على ممارسة القوة من مسافات بعيدة والتفاعلات الإقليمية الفرعية الناتجة عن ممارسات الدول الأقل تأثيراً ضمن بيئتها الأمنية الرئيسية في حيز نفوذها المباشر. وتكمن أهمية نظرية المجمع الأمني الإقليمي في فهمها الأعمق للهيكل الإقليمي، وفي قدرتها على تقييم التوازن النسبي للقوة والعلاقات المتبادلة والمتداخلة على المستويين الإقليمي والدولي.
مبدأ نيكسون
وبناء على ذلك، فإن التفاعلات السياسية والأمنية في منطقة الخليج كـ (مجمع أمني فرعي sub-complex) كانت وما زالت تتشكل من خلال التفاعل والتداخل بن ثلاثة قوى إقليمية رئيسية هي: المملكة العربية السعودية، والعراق، وإيران. كما أن المصالح المتداخلة بين هذه الدول من جهة، والدول العظمى (بريطانيا، والولايات المتحدة، وروسيا) من جهة أخرى، قد لعبت دوراً بارزاً في عملية تشكيل وإعادة تشكيل الهيكل الإقليمي لمنطقة الخليج العربي. وربما يكون المثال الأوضح على ذلك محاولة الولايات المتحدة ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه انسحاب الاسطول البريطاني من منطقة الخليج عام 1971، بعد ما يقرب من قرنين من الزمان على الهيمنة الأحادية لبريطانيا على المنطقة. حيث تبنّت الولايات المتحدة بدايةً استراتيجية (توازن القوى عن بعد offshore balance of power)، وذلك من خلال الاتكّاء بشكل أساسي على كل من السعودية وإيران، ضمن ما عرف حينها بسياسية (الدعامة المزدوجة (Twin Pillar. وكان إدارة الرئيس نيكسون تخشى أن يثير الانسحاب البريطاني من المنطقة شهية الاتحاد السوفيتي للتمدد جنوباً والوصول إلى المياه الدافئة في الخليج الأمر الذي من شأنه أن يهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة في مصادر الطاقة، وحرية الملاحة عبر المضائق الحيوية في منطقة الخليج. لاحقاً وبعد سقوط الشاه وانتصار الثورة الاسلامية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبني سياسة الحضور المباشر، وهي عملية بطبيعتها متدرجة؛ بدأت أبّان حرب الخليج الأولى من خلال ما عرف باسم قوات التدخل السريع وحرب "الأعلام" وصولاً إلى احتلال العراق وإسقاط صدام حسين عام 2003.
تكامل التحليل
تتميز نظرية "بوزان" بتكامل مستويات التحليل الثلاثة، الداخلي والاقليمي والدولي في تفسير التفاعلات السياسية والأمنية لمنطقة إقليمية ما بعينها. فعلى الصعيد الداخلي على سبيل المثال، تتأثر الديناميكيات الأمنية بشكل كبير بطبيعة النظام السياسي للدولة، وبالنظر إلى منطقة الخليج في السبعينيات من القرن العشرين نرى أن طبيعة الأنظمة السياسية قد ساهمت بشكل كبير في بلورة التفاعلات الأمنية بين الدول المكونة له. فقد كانت غالبية دول منطقة الخليج تتكون من أنظمة مَلَكية تقع معظمها ضمن منظومة التحالفات الغربية، ولذلك كان من السهل الوصول إلى تفاهمات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة، وتحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. فسياسة "الخيار العربي" الذي اعتمدها شاه إيران في العام 1973، على سبيل المثال لا الحصر، تُجلي بشكلٍ واضح مدى تأثير الطبيعة المتشابهة للأنظمة السياسية في التقراب ما بينها. وبالفعل ساهمت سياسية "الخيار العربي" في إشاعة جوٍ من الانفراج في جميع انحاء المنقطة، لكنه تحولّ مع سقوط الشاه وانتصار الثورة الإسلامية إلى حالةٍ من التوتر والتصعيد نتيجةً لتبني إيران سياسة تصدير الثورة وما ترتّب عليها من إثارة الأقليات الشيعية في دول المنطقة للقيام بثورات هدفها تغير الأنظمة القائمة بالقوة، فانبثق عنها حرباً باردة بين إيران والسعودية، وحرباً تقليدية بين إيران والعراق، وأصبحت المنطقة بالتالي مكشوفة للتدخلات الخارجية من قبل الدول الكبرى.
يستق حجم التداخل والترابط الكبيرين بين الديناميكيات السياسية والأمنية في منطقة الخليج مع رؤية "بوزان" التقليدي للمجمع الأمني والذي عرّفه بمجموعة الدول التي تترابط مخاوفهم الأمنية بشكل وثيق بحيث يصبح من الصعب الحديث عن الأمن القومي لدولة بمعزل عن مخاوف باقي الدول الأخرى[i]. والانتقاد الأهم الذي يمكن توجيهه لهذا التعريف أنه ركّز بشكل كبير على الدول كلاعبٍ مركزي ووحيد في تشكيل البيئة السياسية والأمنية للإقليم، في حين تجاهل الفاعلين الآخرين الذين أصبحوا يلعبون أدواراً محورية جنباً إلى جنب مع الدول في تشكيل هذه البيئة الأمنية والتفاعلات التي تقع بداخليها.
اللاعبون خارج إطار الدولة
تدارك "بوزان" هذا القصور في تعريفه الجديد حيث اعتبر المجمع الأمني عبارة عن مجموعة من الوحدات تتداخل عملياتهم الأمنية بحيث يصبح من العسير تحليل أو حلّ المشكلات الأمنية بمعزلٍ عن بعضهم البعض[i]. وقد أضفى هذا التعميم في التعريف مزيداً من السعة ليتضمن طيفاً أوسعاً من اللاعبين المساهمين في تشكيل الديناميكيات الأمنية والسياسية كمنظمة التعاون الخليجي مثالاً عن المنظمات العابرة للدول، والمليشيات الأجنبية والمذهبية مثالاً عن (اللاعبين خارج إطار الدولة non-state actors). على أي حال، لم تفقد المقاربة التي اقتصرت على مركزية الدول في فهم الواقع الأمني أهميتها، فالدول تبقي هي اللاعب المركزي والأهم في رسم وتنفيذ السياسات، وإذا كان هناك من دور للفاعلين غير الحكوميين فغالباً ما يكون بدعم وتسهيل وتوجيه من الدول ذاتها.
تخطّى مفهومي الأمن والتهديد المقاربة المركزية للدولة بشكل ملفت بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث فسح دخول العامل الأيديولوجي المجال أمام اللاعبين خارج الدولة للمساهمة في تشكيل الواقع السياسي والأمني لمنطقة الخليج. في هذا السياق أصبحت بعض الدول تسعى لاستخدام مثل هؤلاء اللاعبين في تحقيق أهداف سياساتها الخارجية. فقد سعت إيران – على سبيل المثال – إلى تحقيق هدفها في تصدير الثورة من خلال العمل على استنهاض الأقليات الشيعية للتمرّد على حكوماتهم من أجل زعزعة استقرار الأنظمة "الفاسدة وغير الاسلامية" على حد تعبير الامام الخميني، واستبدالها بأنظمة مشابهة لنظام الجمهورية الإسلامية.
وكمثال حيّ على ذلك يمكن النظر إلى (حزب الدعوة العراقي) والذي تمّ تأسيسه على يد آية الله محمد باقر الصدر القريب من الخميني والذي رأى فيه قائداً لنظام إسلامي في العراق. شرع حزب الدعوة بعد تأسيسه مباشرة في تكوين جناحه العسكري ليبدأ في شن هجمات على أهداف حكومية في كل من العراق والكويت بشكل أساس. وقد كان لمثل هذه الهجمات تأثير سلبي كبير على النسيج الاجتماعي لهذه الدول حيث بدأ يُنظر إلى الشيعة كعملاء لقوة خارجية عوضاً عن اعتبارهم مواطنين، وأصبح ولاؤهم لأوطانهم محلّ شك من قبل الحكومات. وقد ساهم هذا التحوّل في إضافة بُعد جديد على مصدر التهديد، حيث لم يعد ينظر إلى التهديد ببعده الخارجي، بل أصبح التهديد الذي ينبع من الداخل محل اعتبار لخطورته الفعلية على أمن الأنظمة السياسية القائمة.
التفاهم والمناوأة
وبالعودة إلى نظرية "بوزان"، ينبع تشكّل المجمع الأمني بالأساس من الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي والإقليمي على حد سواء، والفوضى بمعناها الاصطلاحي تعني عدم وجود حكومة مركزية تتحكم بالنظام العالمي، وقادرة على فرض القانون والمحافظة على السلم والأمن العالميين. وتفرض طبيعة النظام الفوضوية على الدول أن نتخرط في ديناميكية توازن القوى بحيث تحدد حالات (التفاهم والمناوأة amity and enmity) شكل التحالفات والعداوات التي تنشأ بين الدول المتجاورة، فالهدف الأخير للدول هو المحافظة على بقائها وفي ظل نظام عالمي يتسم بالفوضوية فإن هذا الهدف لا يتأتى إلا من خلال الاعتماد على الذات والسعي إلى تعظيم القوة.
كما ويلعب القرب الجغرافي بدوره أهمية كبيرة في تحديد طبيعة العلاقة بين الدول، فالتهديدات تنتقل بشكل أسهل وأسرع بين الدول المتجاورة جغرافياً، وبناءً عليه يعتبر "بوزان" كلاً من الفوضى وتأثير المسافة بالإضافة للتنوع الجغرافي عوامل أساسية في انتاج أنماط التجمعات الإقليمية حيث ترتفع درجة الترابط الأمني بين دول المجمع الأمني الواحد مقارنةً بالترابط الأمني بينها وبين تلك الدول التي تقع خارجه[i]. ويؤكد "بوزان" أن التجاور الجغرافي يظهر بشكل أبرز في القطّاعات العسكرية والسياسية والاجتماعية والبيئية من القطّاع الاقتصادي. ويظهر هذا التفاوت بشكل واضح في منطقة الخليج، فبالرغم من الفرص الاقتصادية الهائلة لتشكيل مجمع اقتصادي على شاكلة الاتحاد الأوروبي ينعم بالاستقرار والازدهار، إلا أن الهواجس الأمنية المترتبة عن التهديد العسكري والخلافات الأيديولوجية والطائفية ما زالت تضغط بثقلها لتثبيط مثل هذه التوجهات والتي من شأنها حلّ الكثير من النزاعات والتهديدات الأمنية التي تجتاح منطقة الخليج خصوصاً والشرق الأوسط بشكل عام فيما لو تحققت.
تجيب مقاربة (التفاهم والمناوأة) من جهة، و(التقارب الجغرافي) من جهة أخرى عن بعض التساؤلات المهمة المتعلقة بمنطقة الخليج من قبيل: لماذا شنّت العراق وليس السعودية الحرب على إيران عام 1980؟ وكيف استطاعت السعودية تشكيل مجلس التعاون الخليجي بالرغم من المخاوف التاريخية لدى مشايخ الخليج من الهيمنة السعودية؟ فبالنظر إلى مقاربة "بوزان" تصبح الاجابة عن مثل هذه التساؤلات أكثر وضوحاً. وهكذا نرى أن العراق بالاعتبارات الجغرافية أقرب إلى إيران من السعودية حيث يحتدم بينهما خلاف حدودي تاريخي يتعلّق بشطّ العرب، هذا بالإضافة إلى التداخل الاجتماعي العميق بينهما على المستوى الطائفي، ولذلك كان الخطر المتأتي من سياسة تصدير الثورة للنظام الإيراني أشدّ على العراق منه على السعودية وعليه فتبرير اتخاذ قرار الحرب من بغداد وليس من الرياض أكثر منطقية.
في ذات السياق تشترك السعودية وباقي دول الجزيرة العربية بالكثير من السمات التاريخية واللغوية والثقافية والدينية، ولقد تمتعت هذه الدول بالحماية الخارجية من قبل الامبراطورية البريطانية على مدى سنوات طويلة من تاريخها، حيث تعهّدت بريطانيا بحماية أمنها ومنع أي صراعات عابرة للحدود فيما بينها. وعليه لم يكن القادة المحليّون قلقون بخصوص استقلالهم بالرغم من استمرار الخلافات القبلية بينهم. غير أن الانسحاب البريطاني من المنطقة، والثورة الإيرانية وسقوط الشاه، وضعف الالتزام الخارجي بالحماية، والحرب العراقية–الإيرانية دفعت قادة الخليج في نهاية المطاف لتنحية مخاوفهم جانباً وتشكيل مظلة أمنية جامعة تمثلت بمجلس التعاون الخليجي.
على صعيد آخر، خضعت منطقة الخليج على مدى عقود لتنافس ثلاثي الأقطاب بين العراق والسعودية وإيران، وكانت هذه الدول تتنافس من أجل تعظيم نفوذها ومحاول إعادة تشكيل النظام الإقليمي بما يخدم مصالحها. وقد جرت التحالفات وإعادة التحالفات على قاعدة منع أي من هذه الدول من الهيمنة المنفردة. وقد أدّت المستويات المرتفعة من التنافس فيما بينها إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن في المنطقة بدأت ارهاصاتها بالتشكّل منذ أربعة عقود وما زالت تزداد تجلّياتها حتى وقتنا الراهن رغم تحول التنافس الإقليمي من ثلاثي الأقطاب إلى ثنائي القطبية بعد سقوط العراق في دائرة النفوذ الإيراني على إثر الغزو الأمريكي في العام 2003.
أمريكا تملأ الفراغ
تنبع أهمية اعتبار حدث الانسحاب البريطاني من الخليج في العام 1971 نقطة انطلاقة في تحليلينا للديناميكيات الأمنية والسياسية للمنطقة كونه – أي الانسحاب – قد مهدَّ لظهور نظام إقليمي جديد في منطقة الخليج، التي بقيت تحت النفوذ البريطاني لمدة تزيد عن القرنين.وقد بدأت ارهاصات هذا الانسحاب تظهر عندما كشفت الحكومة البريطانية في العام 1969 عن نيتها الانسحاب من منطقة الخليج. وقد أحدث هذا الإعلان صدمة في أوساط القيادة الأمريكية وأمراء الخليج على حدّ سواء، فالانسحاب البريطاني بهذه الطريقة المفاجئة يعني أن المنطقة ستكون وبشكل غير مسبوق في تاريخها الحديث بلا حماية مباشرة من دولة عظمى.
وقد جاء الانسحاب في وقت حرج، فالولايات المتحدة كانت منشغلة في حربها المدمرة في فيتنام، وهذا يعني أنها كانت غير قادرة علىملء الفراغ الناتج عن انسحاب الأسطول البريطاني من مياه الخليج، وهو ما يجعل المنطقة مفتوحة أمام التمدد السوفيتي. كما أن دول الخليج لم تكن في وضع يسمح لها بصيانة أمنها بمفردها سواء على مستوى الجهوزية العسكرية أو على مستوى الإرادة السياسية، فقد كانت الخلافات بين أمراء الخليج بحد ذاتها خطرا مهدداً لاستقرار المنطقة ككل، حيث عملت بريطانيا على منع تطوره طوال وجودها، وكان من أهم التزامات لندن في ذلك الوقت هي منع نشوء أي صراعات عابرة للحدود بين دول الخليج. لذلك وعندما قررت الانسحاب سادت حالة من الخوف لدى القادة السياسيين المحليين للمآلات التي سوف يُخلفها هذا الفراغ الاستراتيجي.
وبالفعل ترجمت هذه المخاوف بشكل سريع إلى واقع عندما استغلت إيران هذا الفراغ وبادرت باتخاذ خطوات استفزازية أحادية الجانب تمثلت باحتلالها للجزر الاماراتية – طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى- في مياه الخليج.في المقابل سَعَتْ بعض الدويلات حديثة التكوين والنشأة كالكويت والبحرين والتي كانت تعيش نزاعات حدودية مع الدول الأخرى المجاورة لها، إلى دعم فكرة ترسيخ وتقوية حضور الأسطول البحري الأمريكي في مياه الخليج كضامن للأمن الإقليمي، كما دخلت هذه الدول في سباق تسليح من أجل تقوية قدراتها العسكرية، وفي غضون سنوات قليلة غدت منطقة الخليج من أكثر مناطق العالم طلباً للسلاح.
أدرك قادة الخليج أن ثمّة نظاماً إقليمياً جديداً آخذاً بالتشكّل والتطور، وأن دورهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة سيتوسع لا محالة مستقبلاً. وبالفعل فإن القيمة الاستراتيجية لدول المنطقة قد تعززت في ظل غياب السيطرة الفعلية لواحدة من القوى العظمة على المنطقة منذ عصر القوى الامبراطورية. وقد ساهم صراع النفوذ بين المعسكرين الغربي والشرقي في ظل أجواء الحرب الباردة في تغذية هذه القيمة التي تمت ترجمتها فعلياً على الأرض على شكل تحالفات عسكرية وأمنية بين الولايات المتحدة والكثير من الملكيات في الخليج.
إيران و"الخيار العربي"
وبناءً على ذلك، صاغت الولايات المتحدة تحركاتها في المنطقة ضمن سياسة الدعامة المزدوجة التي تألفت من السعودية وإيران بغرض إبقاء الاتحاد السوفيتي بعيداً عن المياه الدافئة التي شكلّت للروس على مدى قرون حلماً عصياً على التحقيق. وفي زيارة الرئيس نيكسون الشهيرة مع مستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر إلى الصين، توقف لبعض الوقت في طهران والتقى خلالها الشاه محمد رضا، وأثناء المحادثات نظر نيكسون إلى الشاه وقال بصريح العبارة: "احمني". وقد عكس ذلك الثقل الذي تمتعت به إيران في الحسابات الأمريكية، وقد أصدر الرئيس نيكسون بعيد ذلك أمراً تنفيذياً – أثار جدلاً كبيراً حينها - يسمح لإيران بشراء جميع أنواع الأسلحة الأمريكية ما عدا النووية[i]. ويجدر بالذكر أنه لم يحظَ بهذه الميزة في ذلك الوقت إلا عدد محدود من حلفاء الولايات المتحدة المقربين. وقد غدت إيران بغضون سنوات قليلة بفضل تقاربها مع الولايات المتحدة، والطفرة التي أحدثتها أسعار النفط بعد حرب 1973 من أقوى الدول الإقليمية على المستوى العسكري، وأصبحت البحرية الإيرانية ترسل دوريات لها في مهمات أمنية خارج مياه الخليج وصلت حتى أعالي المحيط الهندي. لتضطلع طهران بلعب دور شرطي منطقة الخليج، والضامن لأمنها واستقرارها ضد أي تمدد للاتحاد السوفيتي أو حلفائه الاقليميين.
سارت الدول العربية على ذات الطريق، فقامت باعتماد سياسة مشابهة لتعزيز قيمتها الاستراتيجية. وما إن خبا صراع التقدميين العرب والمحافظين باستلام السادات مقاليد السلطة في مصر وحزب البعث في العراق حتى تبلورت مرحلة جديدة من التضامن العربي. فكان وقوف الملكيات العربية في الخليج إلى جانب كلٍ من مصر وسوريا في حربهما ضد إسرائيل واستخدام النفط لأول مرة كسلاح استراتيجي في المعركة إحدى تجلّيات هذا التعاون. أثبتت الدول العربية أن لديها من القوة ما يخوّلها للامساك بزمام المبادرة من أجل ترجيح كفة الحرب لصالحها، وبذلك أجبروا القوى الدولية والإقليمية على إعادة تقييم علاقتهم معها، وأسست بالتالي قاعدةً جديدةً في إدارة المنطقة أمنياً من خلال التفاهم مع العرب ودون الالتفاف حولهم. فتبنى شاه إيران مبدأ (الخيار العربي Arab Option) وأحدث ذلك تحوّلاً في منظومة علاقته مع العرب، وقد تمحور الخيار العربي على فكرة مؤداها أن النفوذ الإيراني لا يمكن أن يتحقق في المنطقة من غير التفاهم مع العرب والتقارب منهم، وبخطوة فجأت الجميع قام الشاه بالتوقيع على اتفاقية الجزائر مع العراق في العام 1975 لحل خلافاتهما الحدودية وإعادة ترسيم "شط العرب"، بالإضافة إلى دعمه للقرار العربي في الأمم المتحدة الذي يدين الصهيونية بوصفها شكلاً من أشكال التمييز العنصري. فقد أصبح العرب في نظر الشاه قوة قادرة على الانتصار، وأن إسرائيل قابلة للهزيمة، وفي ظل تغير موازين القوى الإقليمية لصالح العرب بشكل نسبي، كانت سياسة "الخيار العربي" التعبير العقلاني للبراغماتية الإيرانية في ذلك الوقت.
بدا الأمر وكأن دول الخليج قد نجحت في الوصول إلى تفاهمات فيما بينها، فسادت في الإقليم حالةٌ من الأمن والاستقرار في النصف الثاني من عقد السبعينيات من القرن العشرين (قبيل الثورة الإسلامية في إيران)، فكان التدخل الخارجي من قبل الدول الكبرى بالتالي في أقل مستوياته. وكما يرى "بوزان"، كلّما تعاظمت قدرة اللاعبين الأساسيين في المنطقة على التسوية، كلّما ضاق هامش تدخل القوى الكبرى شيئاً فشيئاً، وبالعكس يحدث تدخل القوى العظمى عندما تقوم إحدى القوى الخارجية بعقد تحالف أمني مع إحدى القوى المحلية داخل المجمع الأمني[i] بهدف إخلال ميزان القوى على حساب لاعب آخر أو عدة لاعبين داخل الإقليم الواحد. ولقد شجع تراجع حدّة الصراع الأمريكي السوفيتي في السبعينيات أيضاً على تخفيض مستوى التوتر في منطقة الخليج غيرها من مناطق العالم التي كانت تشهد تنافساً محموماً بين القطبين.
ولكن في ظل نظام دولي فوضوي لا تكفّ فيه الدول العظمى عن السعي لتعظيم قوتها ونفوذها – كما يرى جون ميرشايمر – فإن التنبؤ بطول فترة حالات الوئام يصبح أمراً مثيراً للسخرية. ففي نهاية عقد السبعينيات غزت القوات السوفيتية أفغانستان، وأسقطت ثورةٌ إسلامية الشاه في إيران، وهو ما أدى في المحصلة إلى تسارع التوتر وارتفاعه إلى مستويات مخيفة على الصعيدين الإقليمي والدولي الأمر الذي انعكس دراماتيكياً على التفاعلات الأمنية والسياسية الإقليمية في منطقة الخليج خصوصاً والشرق الأوسط عموماً.
مبدأ كارتر ومنطقة الخليج
شكّلت أحداث عام 1979 على الصعيد الأمن الدولي والإقليمي علامة فارقة في تاريخ منطقة الخليج، فبعد فترة هدوء نسبي سادت العلاقات بين واشنطن وموسكو، عاد التوتر من جديد على الساحة الدولية عندما قام الجيش الأحمر بغزو أفغانستان، الأمر الذي وصفه جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة بـ "التهديد الواضح للسلام وللعلاقات الأمريكية السوفيتية على مستوى العالم".[i]
وبناءً عليه قام كارتر بترسيخ قاعدة جديدة في السياسية الخارجية الأمريكية، سميت بمبدأ كارتر، وأعلن عنه في تصريح اعتبر فيه أن: " أي مساعي خارجية للسيطرة والتحكم في منطقة الخليج العربي تشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة الحيوية، سيقابله ردٌ رادعٌ من قبل واشنطن بما فيه الخيار العسكري."[ii] عكس هذا المبدأ مخاوف الأمريكان من توسع حيز التدخل الروسي في أفغانستان ليشمل منطقة الخليج العربي، فقامت بتعزيز وجودها العسكري البسيط في الخليج من خلال نشر قوات التدخل السريع Rapid Deployment Joint Task Forces RDJTF استعداداً لمواجهة تحديّات أمنية جديدة فيه، وما فتأ الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ينمو تدريجياً وحسب ما تقضيه التطورات الدولية والإقليمية حتى وصل إلى ذروته عشية إعلان حرب الخليج الثالثة وغزو العراق عام 2003.
كما أدّى سقوط الشاه وانتصار الثورة الإيرانية إلى إعادة ترتيب الأولويات الأمنية في منطقة الخليج، فلقد استبدل النظام الإيراني الجديد سياسة "الخيار العربي" التي تبناها الشاه في مطلع العقد لتخفيف التوتر التاريخي بين القوميين العرب والإيرانيين بسياسية عدائية وتوسعية في المشرق، كما أضفت على هذه العلاقات بُعداً طائفياً أحيت من خلاله التنافس الشيعي السني في الإقليم. يصف ديفيد كومينز الثورة الإيرانية بـ "التهديد السياسي لدول الخليج، وأنه لا بد لكل من السعودية والبحرين والكويت من مواجهة الدعاية العدوانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحاولتها في توظيف مواطنيها الشيعة".[iii]
اعتبرت دول الخليج نظام الثورة الإسلامية الذي أقامه الخميني حديثاً تهديداً وجودياً لها على الصعيد السياسي والأيديولوجي والديني. فعلى الصعيد الديني قدّم النظام الإيراني مرجعيةً دينيةً للأقليات الشيعية في دول الخليج مكّنتها من المطالبة بلعب دور سياسي متقدم في بلادها، ولقد شكّلت الحركات الشيعية في البحرين والعراق ضغوطاتٍ حقيقية على أنظمة بلادها، مهددةً بإسقاط حكوماتها وبإقامة أنظمة سياسية ثورية إسلامية شبيهة بإيران. وسياسياً اعتبر الخميني الأنظمة الملكية والنظام البعثي في جوار إيران أنظمة غير إسلامية، ووصفها بالفاسدة والظالمة، وأنه "لا مهرب من تدمير هذه الحكومات الفاسدة المفسدة، ومن إسقاط جميع الأنظمة الظالمة، والخائنة، والمجرمة".[i] أمّا أيديولوجياً، فلقد لفظ الخميني المرجعية الثقافية الغربية التي قام عليها النظام الدولي الحديث، وتبنّى مرجعية ثقافية محلية تاريخية متأصلة، عوضاً عن استيراد الأفكار الرأسمالية من الغرب أو الأفكار الشيوعية من الشرق.[ii] يصف "فارهنغ رجائي" هذا الجانب لدى الخميني قائلاً : "رفض الخميني هيمنة القوى العظمى، معتبراً إيّاها مصدر الشرور والمشاكل في العالم"[iii]، فقال "تعتبر شعوبنا أمريكا عدوتها الأولى"[iv]. ويعد رجائي أحد أسباب عداوة الخميني للشاه في اعتبار الأخير: "ألعوبة بيد الأمريكان"[v]، فيما ينطبق ذات المنطق على الأنظمة العربية التقليدية، التي اتهمها بالعمالة وحضّ "المظلومين" (الشيعة على وجه الخصوص) على الانتفاضة في وجهها وباستبدالها بأنظمة حكم إسلامية.
عكس تحوّل السياسية الخارجية الإيرانية من سياسة "الخيار العربي" إلى سياسة "تصدير الثورة" انزياحاً دراماتيكياً في علاقة طهران بجيرانها الإقليميين، وفي الواقع لم يخبُ التنافس العربي الإيراني نهائياً أبان حكم الشاه، ولكن كان خاضعاً لمنطق التوازن الحيوي للقوة لاستتباب السلام في المنطقة، والذي ما لبث أن اختل بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران. ولقد قدّمت نظرية "بوزان" إطاراً نظرياً هاماً لتبيان مدى تأثير التغيرات السياسية المحلية في هيكلية المجمَّع الأمني الإقليمي، حيث يتعاظم تأثير التقارب الجغرافي في توازنات المجمع، وهذا ما شهدناه من الأثر المباشر للثورة الإسلامية في إيران ضمن المجمع الأمني في الخليج دون بقية الأقاليم المجاورة.
"الثلاثة الكبار" في الإقليم
خضعت ديناميكيات ميزان القوى في منطقة الخليج تقليدياً للعلاقات العراقية الإيرانية السعودية، المتشابكة والمتداخلة بطبيعتها، ولقد سعت دول الجزيرة العربية (المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة) لخلق عامل إضافي في معادلة التوزان العراق الإيراني، انطلاقاً من وعيها بتضارب مصالحها مع انفراد بغداد أو طهران في قيادة المنطقة، الأمر الذي يستدعي تدخلها في حال رجحت كفّة إحدى القوى الإقليمية على الأخرى. وفي خضم الصراع الأيديولوجي العربي بين القوميين والاشتراكيين من جهة والأنظمة التقليدية والرأسمالية من جهة أخرى،[i] استدعت ممالك الخليج تدخل شاه إيران في عدّة مناسبات لأجل إحداث توازن أمام الأنظمة القومية العربية في القاهرة وبغداد. ولقد نشطت الدول الأخيرة في تقويض حكم الأنظمة الملكية العربية، فتدخلت في "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن مرة، ودعمت انقلاباً في إمارة الشارقة عام 1973 مرةً أخرى، واستضافت قيادات خلايا الجبهة الشعبية لتحرير عُمان حتى عام 1975[ii]. ولقد اتسمت هذه المرحلة في اتساق المصالح الإيرانية مع الأنظمة العربية التقليدية في الحفاظ على شرعية الأنظمة الملكية في المنطقة وفي صيانة وتعزيز التقارب الاستراتيجي مع دول المعسكر الغربي.
دفع نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية في تحقيق أهدافها المحلية في البلاد لتحول مصدر التنافس الإقليمي من صراع عربي أيديولوجي إلى صراع مذهبي طائفي، فاستدعت دول الجزيرة هذه المرة تدخل العراق لاحتواء إيران الشيعية الثورية، الفرصة التي لم توفرها بغداد بعد تطبيع العلاقات مع جيرانها عام 1975. وتباعاً عملت بغداد بشكل براغماتي ودؤوب على تعزيز قيادتها للمنطقة، فقامت باستغلال الفراغ الناتج عن مقاطعة مصر العربية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد لصالحها من خلال محاولتها تعزيز قيادتها للمحور العربي، وقامت بتوقيع ميثاق "العمل الوطني المشترك" مع نظيرها ومنافسها البعثي في دمشق عام 1978 مما عدّ كخطوة أولية نحو توحيد البلدين، وتوسطت بنجاح في إنهاء الحرب اليمنية في آذار 1979، ووقعت في ذات العام اتفاق تعاون أمني مع السعودية توّجت بأول زيارة رسمية لرئيس عراقي للرياض قام بها الرئيس أحمد حسن البكر.[i]
وبالفعل نجحت العراق من خلال موقعها الجغرافي المميز وممارساتها السياسية الموفقة في ربط المجمع الأمني الخليجي مع المجمع الأمني الشامي، إلا أن استقالة البكر أو عزله بانقلاب أبيض على الأصح، ووصول صدّام حسين إلى سدة الحكم في البلاد بتاريخ السادس عشر من تموز 1979، واتهامه للنظام السوري بالعمل على اسقاطه أدّى إلى وأد جهود الوحدة العراقية السورية. [ii]ولقد لعب الخلاف العراق السوري كما سنرى لاحقاً دوراً حيوياً في ميزان القوى أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
وفي حين كانت طموحات عراق صدام حسين تنمو وتربو، كان حس المغامرة لدى إيران الخميني يتعاظم ويتجاسر، الأمر الذي دفع المنطقة ككل إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر، وبالفعل اندلعت حرب طاحنة بين البلدين في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر سنة 1980، محدثةً واقعاً مأسوياً جديداً في المنطقة. ولا يزال تحديد مسؤولية اندلاع الحرب مسألة شائكة حتى اليوم، وفي حين تتخطى الإجابة على هذا السؤال حدود هذا الملف، نكتفي بقول إن العراق كان أول من شرع في اقتحام أرض إيران، أما إيران فقد كانت أول من شنّت هجوماً نارياً على العراق.
التمكّن الشيعي
أعطت الثورة الإيرانية دفعة معنوية للشيعة العرب وأضفت لهم إحساساً بالتمكين بعد أن نصّب الخميني نفسه قائداً وحامياً للشيعة في العالم، وحفزهم انتصار الثورة في التمرد على الأنظمة السياسية في بلادهم، فلم يقتصر التهديد الذي شكلته إيران على أنظمة الخليج العربي على الجانب الأخلاقي والفكري فحسب، بل عمدت كذلك إلى تعبئة السياسية والعسكرية للشيعة ضد النخبة الحاكمة.
أدّى الأثر المزعزع للثورة الإيرانية وردّة فعل الأنظمة المتأثرة به إلى تصعيد درجات التوتر الطائفي بين السنة والشيعة على مستوى الداخلي[i] ، وإلى توتير العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربية، ولقد شوهدت أهم تجليّاتها في العراق والبحرين والكويت والسعودية، الأمر الذي تطور إلى حرب دامية مع طهران كما هو الحال في العراق الذي يضم أكبر تجمعاً للشيعة العرب، والأقرب جغرافياً من إيران. فلقد كان الإمام محمد باقر الصدر العراقي الجنسية أحد المقربين من الخميني، وأحد أهم داعميه الإقليمين، فضلاً عن مساهماته المباشرة في الثورة الإيرانية كالمشاركة على سبيل المثال في صياغة الدستور الإيراني الجديد.
رأى الخميني في باقر الصدر قائداً محتملاً لثورة إسلامية في العراق[ii]، وبإلهامٍ وتشجيع الخميني قام حزب الدعوة الذي أسس جناحاً عسكرياً له عام [iii]1979، بتنظيم والدعوة إلى مظاهرات شعبية في المدن الشيعية في العراق، ما لبث أن تطورت إلى أعمال عسكرية وصلت إلى محاولة اغتيال طارق عزيز في الأول من نيسان 1980. ولّد نشاط حزب الدعوة المتعاظم ردّة فعل عنيفة من قبل النظام العراقي الذي شنّ عملية أمنية واسعة النطاق ضد أعضاء الحزب، اعتقل خلالها آية الله باقر الصدر وأخته آمنة بنت الهدى وأعدمهما في الثامن من نيسان 1980، وأصدر قانوناً يجرم عضوية حزب الدعوة تحت طائلة عقوبة الإعدام.
اعتبرت بغداد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية تهديداً مباشراً لسيادة النظام ووحدة الأراضي العراقية، يقول "جيمس دفرينزو" أن نظام البعث في العراق: "كان قلقاً من انتقال عدوى المظاهرات والتمرد الشيعي إلى الكرد الانفصاليين، وأن يشجعهم على حمل السلاح مما قد يدفع البلاد إلى حرب أهلية طاحنة"[iv] وفي حين: " لم يقم صدام حسين سابقاً بمهاجمة طهران شخصياً، أو بالتهديد بشكل مباشر بالحرب"[v] إلا أنه بدأ بتغيير لهجته التصعيدية اتجاه إيران مع تصاعد وتيرة العنف الشيعي حتى نيسان 1980. هذا مع العلم أن العراق وعلى الصعيد الرسمي قد رحب بانتصار الثورة الإيرانية عام 1979، وقد أرسل الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر رسالة للخميني هنأه بها بإنشاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما دعم العراق انسحاب إيران من منظمة حلف الأوسط (حلف بغداد سابقاً) وعرضت تسهيل عضوية إيران في حركة دول عدم الانحياز، كما وجهت دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإيراني مهدي بازركان لزيارة بغداد في تموز 1979".[vi]
تركت أحداث نيسان 1980 أثراً عميقاً على شخصية صدام حسين كما نوّه إليه غوزيه، حيث اقتبس في كتابه ما نوه إليه المدون الرسمي لسيرة صدام حسين من أن أحداث نيسان شكلت "نقطة تحول في سلوك صدام اتجاه إيران، حيث اتّخذ قرار الحرب بعدها بقليل". ومن المهم عدم إغفال حقيقة أن صدام قد اتخذ قرار الحرب بمفرده، فلقد لعبت شخصيته دوراً محورياً في الأحداث اللاحقة، وكان هدفه الرئيس تحقيق انتصار سريع لتعزيز قيادته للعراق وللعالم العربي. وقد بدت إيران الضحية المناسبة من حيث المبرر والضعف الذي خلفته الثورة في صفوف الجيش الإيران كما يلحظ دفريزو، حيث "انخفض تعداد جنود الجيش الإيراني من 400،000 جندي إلى 200،000، وأوقفت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، الموردين الأساسيين للسلاح في زمن نظام الشاه ، بيع العتاد وقطع الغيار للنظام الثوري الجديد في طهران".[vii]
باختصار اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، وبات يعرف إليها بحرب الخليج الأولى لثلاثة أسباب رئيسية:
تهديد واستفزاز الثورة الإيرانية لدول الجوار.
ضعف إيران الخارجة بسبب الصراع الداخلي.
الطموحات التوسعية.
وفي حين صدر قرار الحرب في أروقة القرار العراقي، إلا إن بغداد استشارت دول الخليج العربية الأخرى قبيل إعلان الحرب، ولقد كان من المنطقي تضافر جهود الدول العربية في مواجهة التهديد الإيراني المشترك. يقول غوزيه: "كشفت مقابلات كوردسمان وواغنر مع الشخصيات المعنية، أن المسؤولين العراقيين بدأوا بتداول فكرة العمل العسكري ضد إيران عربياً في أيار 1980، وأبلغ صدام حسين قادة الخليج الحرب بعزمه إعلان الحرب في تموز وآب من العام نفسه".[viii]
الحرب والتوازن القلق
أُعلنت الحرب بين العراق وإيران في 22 ايلول 1980 عندما شنّت القوات العراقية هجوماً واسع النطاق على إيران واستولت على مدينة خرمشهر في محافظة خوزستان. وعلى الرغم من فشل القوات العراقية في التوغل أكثر والسيطرة على المناطق ذات الغالبية العربية في الأهواز، اعتقد صدام حسين أن ضعف إيران سيدفعها للمساومة وللتنازل عن شط العرب مقابل انسحاب القوات العراقية من الأراضي الإيرانية، إلا أن إيران رفضت الرضوخ لهذا الخيار، وفاجأت الجميع بتعبئة مئات الآلاف من الشباب الإيرانيين لصد هجوم القوات العراقية. وبدلاً من إضعاف الحكومة الإيرانية، كما كان المتوقع، يلحظ دفرينزو أن الهجوم حفّز العديد من الإيرانيين لتجاوز خلافاتهم الداخلية وللاتحاد في مواجهة خطر خارجي أكبر.
تعرضت القوات العراقية لضربة موجعة في الهجمات المضادة التي قادتها القوات الإيرانية عليها، وعرضت بغداد وقف إطلاق النار بعد تكبّدها خسائر أولية فادحة، قابلها رفض الخميني الذي أصدر أمراً بمواصلة القتال حتى النهاية. وأوضح الأخير نيته بشكل جلي أن هدفه من استمرار الحرب اسقاط نظام صدام حسين، واستبداله بنظام إسلامي. وزعم الخميني أن "توحيد إيران والعراق وربطهما مع بعضهما البعض، ستدفع الشعوب الأصغر للانضمام إليهما"[i]. وفي الثالث عشر من تموز عام 1982، شنّت القوات الإيرانية هجوماً على مدينة البصرة العراقية لتدور رحى الحرب حتى انتهائها على الأراضي العراقية فقط.
وجدت دول الخليج العربية في بداية الحرب نفسها عالقة في معضلة معقدة، فدعم العراق يعزز من مخاطر هيمنته على المنطقة، في حين يشكّل دعم إيران تهديداً إيديولوجياً على أنظمتها الحاكمة[ii]. وعلى الرغم من اشتراك دول الخليج في الخشية من تعاظم قوة العراق وإيران في المنطقة، إلا أن تقييمها لهذه المخاطر تفاوت بشكل كبير. ففي حين أخذت المملكة العربية السعودية والكويت موقفاً حاداً في دعم العراق ضد إيران، اتخذت كل من عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة موقفاً محايداً. يصف كل من نايجل أشتون وبريان جيبسون هذه المرحلة: "بتعدد سياسات الدول الخليجية تجاه الحرب، وأنها عملت ضد بعضها البعض في بعض الأوقات".[iii]
قام جيرد نونمان في تحليل آخر، بتصنيف الدول العربية الست إلى مجموعتين:
الدول العليا: بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت التي كانت ترضخ لتهديد أمني إيراني مباشر، ولذلك اتخذت موقفاً واضحاً وصريحاً في دعم العراق.
الدول الدنيا: بما في ذلك سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تستشعر نفس درجة التهديد الإيراني لأمنها، ولذلك اتخذت موقفاً محايداً في الحرب.
وخلص نونمان أن "البحرين وإلى حد كبير قَطَر كانت عالقة بين الموقفين ولكن انتهى بها الأمر للاقتراب بشكل أكبر من الموقف السعودي - الكويتي".[iv]
وفي حين يمكننا أن نتفق إلى حد ما مع هذا التبسيط في قراءة الواقع الأمني لهذه المرحلة، إلا إننا نعتقد أن أمن واستقرار منطقة الخليج يعتمد أساساً على الديناميكيات المترابطة والمتداخلة للثلاثة الكبار في المجمع الأمني الإقليمي للخليج: المملكة العربية السعودية والعراق وإيران، ولقد وجدت السعودية نفسها في موقع متقدم لتعزيز نفوذها في المجمع بينما تورط اللاعبون الآخرون في حرب تقليدية. فكانت الأولوية السعودية منع تغلب أحد الطرفين على الآخر أو على الأقل منع إيران من الانتصار.
المملكة العربية السعودية: الأخ الكبير
قادت المملكة العربية السعودية والكويت حملة ضخمة لدعم العراق، لا سيما عندما اضطرت القوات العراقية للانسحاب من الأراضي الإيرانية. ولقد أوصل الهجوم المضاد الإيراني الناجح ‑ووعد الخميني بإطاحة بصدام حسين‑ رسالةً واضحة للسعوديين وبقية دول الخليج العربي مفادها أن إيران لن تقف عند حدود العراق إذا ما كتب لها الانتصار، الأمر الذي ولّد ردّة فعلٍ سريعة من قبلهم. ويصف أشتون وجيبسون المساعدات الخليجية للعراق على النحو التالي:
"تألفت المساعدات الخليجية من قروض سخية، ومعونات مالية ضخمة، ومنح نفطية للعراق. قدرت المساعدات السعودية بـ 25 مليار دولار أمريكي، كما تعهدت بتسهيل شحن الإمدادات المدنية والعسكرية إلى العراق. وكذلك ساهمت كل من أبو ظبي ودولة قطر في دعم العراق مادياً. أمّا الكويت فلقد قدّمت 13.2 مليار دولار على شكل إغاثة عاجلة كما منحت للعراق حق استخدام مرافقها المائية في الشويخ والشعيبة، مما سمح باستمرار تدفق الأسلحة والنفط داخل وخارج العراق، ومتجاوزين بذلك التفوق البحري الإيراني في شمال الخليج [...]. ومع بداية عام 1982، زوّدت الكويت والمملكة العربية السعودية العراق بـ 330،000 برميل نفط يومياً للتعويض عن إغلاق سورية لخطوط الأنابيب عبر أراضيها إلى العراق. في بداية العام التالي، نقل البلدين أرباح انتاج حقول الخفجي المشتركة للحكومة العراقية ".[i]
بيد أن الإنجاز الأكبر الذي حققته السعودية في سعيها نحو تعزيز مكانتها في الإقليم، كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981. حيث نجحت السعودية في احتواء مخاوف بعض إمارات الخليج العربي من نواياها التوسعية، لا سيما قطر ودبي، واستطاعت جمع مشايخ الخليج تحت مظلة واحدة وبقيادتها. شكّل غياب كل من إيران والعراق من المجموعة دلالة واضحة على إرادة المملكة العربية السعودية في التفرد بقيادة هذه المجموعة. ولقد ساعد على ذلك "تورط العراق في الحرب مع إيران، وازدياد اعتمادها على مساعدات الخليج، مما أضعف قدرتها على الاعتراض"[i]. وعلى الرغم من افتقار مجلس التعاون الخليجي إلى وجود "مؤسسة صنع القرار فوق وطنية متكاملة تشارك دول الأعضاء على سيادتها كالمفوضية الأوروبية على سبيل المثال"[ii]، إلا إنها لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وعلاوة على ذلك، وفر المجلس درجة حماية إضافية للدول المنضوية في عضويته.
لم يقتصر دور مجلس التعاون الخليجي على القضايا الأمنية فقط بل لعب أيضا دوراً سياسياً هاماً خلال الحرب. أولاً، حافظ المجلس على موقفه المحايد[iii] ، على الرغم من ميل معظم دوله لدعم العراق. ثانياً، أصّر المجلس على ضرورة إطلاق مفاوضات سلام ثنائية بين البلدين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعرض مبادرة سلام في عام 1982 لإنهاء الحرب، ولكن رفضتها إيران. ثالثاً، أمّن المجلس غطاءً سياسياً دولياً للمملكة العربية السعودية، وأضطلع بمهمة الدفاع عنها كلما تلّقت هجوماً مباشراً من إيران. فعندما هاجمت إيران إحدى المنشآت النفطية السعودية في عام 1984، أصدر المجلس بياناً أدان به الاعتداء، ودعم تبنى مسودة قرار الأمم المتحدة الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على الشحن الدولي. [iv]
أثبت مجلس التعاون الخليجي قدرته على الحفاظ على الاستقرار والأمن داخل الدول الأعضاء ونجح إلى حد كبير في منع امتداد الصراع الإيراني - العراقي إليه داخل حدوده. ولكن لم تكن
 ١ مارس ٢٠١٧
١ مارس ٢٠١٧
كلما تعرفَ الرأي العام في العالم (إن صحت التسمية) على فظاعات جديدة للنظام السوري، كالتقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية عن ضحايا سجن صيدنايا، زادت قناعتي بأننا نعيش عصراً مختلاً تماماً، لا سيما لجهة حالة الشلل والتفرج التام على مأساة الشعب السوري المستمرة من قبل المجتمع الدولي.
ضمن السياق نفسه ولتعرية كل أوراق التوت عن أعنف نظام عرفه التاريخ المعاصر، عرضت قناة «العربية» أخيراً فيلماً وثائقياً عن سجن تدمر، فيلماً رهيباً، قام بتأدية الأدوار فيه سجناء لبنانيون سابقون قضوا فيه سنوات عدة.
تدمر السجن، أو سجن تدمر، لا فرق، حيث المعتقلون أرقام فقط، والسجّان هو الجلاد والحاكم والقاضي.
من فتحة صغيرة في باب المهجع يتلصص أحد المعتقلين على سلوك أحد الحراس. كان التاريخ يشير إلى 8 آذار (مارس) أي إلى «عيد» وصول البعث إلى السلطة. فقط في هذا النهار رأى المعتقل أن الطعام هو رزّ وفروج وصنوبر، بينما في بقية الأيام يحصل سجناء كثيرون على حبة بطاطا. من تلك الفتحة رأى السجين المتلصص كيف أن الحارس وقد التهم بعض لحم الفروج، تبوّل على بقية طعام السجناء.
توثيق هذه الجرائم بالمعنى الحقوقي أمر في غاية الأهمية، ولكن متى تُترجم تلك الوثائق الحقوقية إلى فعل سياسي قانوني، كي تأخذ العدالة مجراها؟ فبمقدار الرعب الذي عاشه المعتقلون يكون السؤال الموجع، الذي أراه بلا جواب بسبب الصمت عن تلك الجرائم، فكأن هذا العالم يمشي مقلوباً مع السوريين، بلا رأس قانوني أو أخلاقي.
نظامٌ مروع تاريخه مسلسل من المجازر، وبمقدار الضياع الذي يراه السوريون في سياسة أنظمة العالم المؤثرة، هناك أيضاً وجه آخر قبيح ما زال السوريون بعيدين عن فضحه وتعريته، هو أن كل هذا القمع العاري والمديد الذي مارسه النظام كان بأيدي سوريين: فالحارس الذي تبول على طعام سجناء لبنانيين في سجن تدمر سوري.
سوريون مع النظام وجدوا في بوط بشار الأسد قبلتهم، سوريون يعتقلون سوريين، يعذبون سوريين، يقتلون سوريين.
هي حقيقة عارية نتجاهلها من شدة فظاعتها. الجلادون والقناصون ورماة المدفعية والطيارون درسنا معهم في المدارس نفسها، لكنهم هم أنفسهم بعد حين رأيناهم يعملون على تثبيت ركائز استبداد النظام، فصاروا ضباطاً وعساكر ومخبرين يخدمون نظامهم المروع ويهتفون بحياة قائده.
مروعٌ حال العالم إذاً، ولكن حالنا السوري الاجتماعي والنفسي أيضاً مروع أكثر. فالانقسام الاجتماعي، الطائفي والأخلاقي يأخذ شكل التشظي.
لذلك فإن من يعّول على أي تغيير سياسي عبر المفاوضات مع هذا النظام واهم، حتى لو رغبت موسكو بوتين بذلك. فليس النظام الإيراني وحده من يعيق أي اقتراب جدي من حل سياسي، إنما أيضاً النظام وبنيته الأمنية الصارمة. فهو لا يمكن تغييره إلا عبر الكسر والإزاحة.
صدى صوت السجان في سجن تدمر ما زال يروع حياة سجناء خرجوا أحياء من هناك، وما زال صراخ سجاني صيدنايا مروعاً أيضاً.
الثورة السورية وصفت باليتيمة، ولكن من وصفها بذلك لم يشاهد هذا الخراب والإجرام الهائل الباقي في نفوس السوريين الواقفين مع النظام. ثورة يتيمة، نعم، لأن بوط النظام العسكري والأمني بوط سوري قبل أن يتدخل البوط الإيراني والروسي.
في الأدبيات السياسية عادة ما يستخدم الكتاب والصحافيون عبارات كثيرة التلخيص والدقة حين يدرسون الظواهر السياسية لأي نظام سياسي، لكن في حالة النظام السوري لا بدَ من استعارة الكثير من مصطلحات الطب النفسي. وفي العمق الجارح هذا لا بدّ أن يدرك السوريون مأساتهم الذاتية مع جلاديهم السوريين، قبل أن يبدأوا بتفقد خرائط السياسة ونقدها في محيطهم العالمي.
 ١ مارس ٢٠١٧
١ مارس ٢٠١٧
«لا نرغب في استمرار هذا الخطاب بين البلدين، سوف نصبر على تركيا، إلا أن للصبر حدوداً أيضاً». بهذا التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني يمكن أن نستشف مدى التجاذب والتصريحات النارية المتبادلة بين كل من تركيا وإيران.
نسير مع القارئ في السطور القادمة لمحاولة الكشف عن مآلات تلك التجاذبات وإسقاطاتها على علاقات البلدين مستقبلاً.
بدايةً لاشك أن هناك قوالب حاكمة لطبيعة العلاقة بين أي بلدين، تؤثر بدورها على طبيعة تلك العلاقة وهامش حركتها. وإسقاط ما تقدم على الحالة التركية الإيرانية يفضي إلى الوصول للقوالب الحاكمة التالية:
1- قوتان إقليميتان في منطقة الشرق الأوسط تمتد مصالحهما وتأثيرهما إلى خارج حدودهما الجغرافية.
2- تشابك مناطق النفوذ والمصالح، ما يؤدي إما إلى تقارب، أو نشوب خلاف (سوريا -شمال العراق).
3- علاقات ومصالح اقتصادية ترى للمستوى الاستراتيجي، وتمتد لفضاء مستقبلي رحب.
4- خلفية تاريخية ما تلبث أن تستدعي نفسها بين فينة وأخرى، لترخي بظلالها على طبيعة العلاقة بين البلدين.
القوالب الحاكمة سابقة الذكر ظلت على الدوام تؤطر لطبيعة تلك العلاقة وتجاذباتها. وبعيداً عن السير طويلاً في تاريخ العلاقة بين البلدين، يمكن الإشارة هنا إلى الفترة الأخيرة، وتحديداً السنوات العشر المنصرمة، فقد لعب الجانب الاقتصادي دوراً كبيراً في تحسين العلاقة بين البلدين يعززه هدوء ملموس في فترة من الفترات في مناطق المصالح المتشابكة مثل سوريا وشمال العراق.
وفي مقابل العقوبات الاقتصادية التي تعرض لها النظام الإيراني، بسبب البرنامج النووي، جاءت تركيا بوصفها متنفساً مهماً للنظام الإيراني لتخفيف وطأة تلك العقوبات، فزاد عدد الشركات الإيرانية العاملة في تركيا، وأصبحت البنوك التركية مساراً مهماً للتحويلات المالية الإيرانية.
انعكس ذلك على التحركات التركية سياسياً لصالح النظام الإيراني ولتحقيق تقارب بين إيران والولايات المتحدة، حيث توصلت فيما يطلق عليه بالاتفاق الثلاثي (تركيا، إيران، البرازيل) في 2010، رغبة في تعزيز المسار الاقتصادي الذي ما انفك البلدان يتطلعان لوصول التبادل التجاري فيه إلى 30 مليار دولار، والتطلع إلى أن تكون تركيا المسار الرئيس للغاز الإيراني إلى أوروبا.
ذات القالب الاقتصادي الحاكم بين البلدين ساهم ولا يزال في إدارته لتخفيف وطأة قالب التنافس الإقليمي. فبالرغم من التباين الجلي فيما يتعلق بالأزمة السورية، ظل النظام الإيراني وحاجته للمتنفس الاقتصادي التركي تدفع للتخفيف من وطأة ذلك التباين.
يتساءل القارئ، وإذا كان الأمر كذلك فما الذي طرأ في الفترة الحالية لتتصاعد نبرة التصريحات بين البلدين، وهل القالب الاقتصادي سيعود من جديد لاحتواء سباق التنافس الإقليمي؟
أستذكر مع القارئ موقفاً مشابهاً لما يحدث الآن بين كل من تركيا وإيران، كان ذلك مع بداية عمليات عاصفة الحزم للتحالف العربي في اليمن، حيث أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح قال فيه: «على إيران والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تدعم الحوثيين أن تنسحب». قابله تصريح من قبل وزير الخارجية الإيراني ومطالبات من أعضاء البرلمان الإيراني بإلغاء الزيارة المرتقبة في ذلك الوقت للرئيس التركي إلى طهران. فجاءت النتيجة أن تحققت تلك الزيارة وتبعتها زيارات أخرى اهتمت كثيراً بالشأن الاقتصادي وتجاوز للخلاف السياسي.
التصريحات النارية الأخيرة بين البلدين وتصاعدها لا يمكن فصلها عن السياق الزمني والظروف المصاحبة له. فبعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، لُوحظ سياق مختلف في السياسة التركية التي عادت بعلاقاتها مع روسيا إلى المسار الصحيح وانفراجه مع الجانب الإسرائيلي وتخفيف لحدة الموقف بشأن مصير بشار الأسد وتنسيق أكبر مع روسيا وإيران بشأن سوريا. شجع على ذلك موقف الإدارة الأميركية السابقة، ورسائل الرئيس الأميركي الحالي حول رؤيته للشأن السوري، باعتبار أن هناك حرباً على الإرهابيين دون تمييز بينهم وبين المعارضة السورية.
ما الذي تغير إذن؟
لعل الموقف الأميركي الحالي من النظام الإيراني، وقراءته للأزمة السورية الجديدة، قد عاد بالقالب التنافسي الحاكم بين البلدين من جديد إلى السطح. فتصريح نائب الرئيس الأميركي بأن أميركا لن تتعاون مع روسيا طالما أن هذه الأخيرة تصنف جميع المعارضة السورية على أنهم إرهابيون، والحديث عن المناطق الآمنة في سوريا، مضاف إليه الزيارة الأخيرة للرئيس التركي لعدد من دول الخليج، كل ذلك دفع بالنظام الإيراني إلى تصعيد حدة التصريحات، مقارنة بالتصريحات السابقة لأردوغان.
وبغض النظر عن مآلات مع ما ستفرزه التصريحات المتبادلة بين كل من إيران وتركيا، فإن ما جاء به وزير الخارجية التركي في توصيفه للسلوك الإيراني في المنطقة، وما قاله أردوغان عند زيارته للبحرين بأن إيران تسعى إلى تقسيم العراق وسوريا وتتصرف من منطلقات قومية، هي حقائق واقعية تدفع باتجاه مزيد من التوتر في المنطقة، وبالرغم من القالب الاقتصادي الحاكم في كثير من المسائل فإنه لابد أن تكون لدول المنطقة قراءة واضحة حيال سياسة النظام الإيراني وسلوكه في المنطقة.
فمن دون أمن واستقرار لا يمكن أن تكون للاقتصاد والتنمية بيئة جاذبة.
 ١ مارس ٢٠١٧
١ مارس ٢٠١٧
مع الإدارة الأميركية الجديدة بدأت فكرة جديدة تتبلور في الحرب على «داعش»، لا تقتصر على نشر المروحيات والمدفعية في الرقة والموصل وتعزيز وجود القوات الخاصة، بل تشكل جبهة أميركية خليجية تساهم في الحرب على «داعش»، شريطة أن المناطق التي تتحرر من «داعش» يجب ألا تحتلها إيران أو ميليشيات تابعة لها، هذا هو العنوان الرئيسي الذي خرجت به وثيقة موسكو وزيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس للخليج والعراق.
أي أن هناك اتفاقاً أميركياً روسياً تركياً خليجياً على إنهاء التمدد الإيراني في العواصم العربية، ويجب أن نكون واضحين جداً في هذه الرسالة إن أراد العالم تعاوننا للقضاء على تنظيم داعش.
مقابل أي مساهمة خليجية أو عربية في الحرب على «داعش»، سواء في العراق أو في سوريا، يجب أن تكون إيران خارج تلك المناطق، وأن تكون هذه الرسالة واضحة أكثر للحكومة العراقية، التي قال ماتيس إن أميركا ستبقى داعمة للعراق حتى بعد تحريره من «داعش»، فإذا ربطت هذا الموقف مع موقف ماتيس من إيران كالدولة الأولى الراعية للإرهاب، فأنت أمام جبهة موحدة مصرة على خروج، لا القوات الإيرانية فحسب من العراق وسوريا، بل «النفوذ» الإيراني كذلك منها، هذه رسالة ليست من دول الخليج، بل من الولايات المتحدة كذلك.
تشكيل جبهة أميركية خليجية، هو عنوان المرحلة المقبلة، تحمل شعار عروبة الأراضي المحررة من «داعش»، أصبح وشيكاً حتى يتبين للعالم حقيقة الجهة الداعمة للإرهاب ولبقاء «داعش» ومن يريد فعلاً التخلص منها، أو من يريدها ذريعة لتمدده.
خروج القوات الأجنبية والميليشيات المدعومة إيرانياً من سوريا ومن العراق هدف أساسي للمساعدة، ومرحلة ما بعد «داعش» أصبحت تناقش قبل التخلص من «داعش».
هذا ما ذكره عادل الجبير وزير الخارجية السعودي حين أعلن عن استعداد بلاده لإرسال قوات إلى سوريا لمكافحة تنظيم داعش بالتعاون مع أميركا؛ إذ نقلت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية عن الجبير قوله إن «السعودية ودولاً أخرى بالخليج أعلنوا عن الاستعداد للمشاركة بقوات خاصة بجانب الولايات المتحدة، وهناك بعض الدول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضًا لإرسال قوات».
وأضاف: «سننسق مع الولايات المتحدة من أجل معرفة ما الخطة وما الضروري لتنفيذها».
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمر وزير الدفاع جيمس ماتيس، بعرض خطة جديدة في غضون 30 يوماً، لمكافحة تنظيم داعش.
وقال الجبير للصحيفة الألمانية إنه «يتوقع عرض هذه الخطط قريباً، موضحاً بشكل غير مباشر أنه يمكن تسليم مناطق محررة في سوريا إلى المعارضة».
وأكد أن «الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم داعش، ولكن أيضاً ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة (حزب الله) أو إيران أو النظام».
وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي: «على النظام (السوري) أن يعود إلى طاولة الحوار لإجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة، وذلك لتحقيق الانتقال السياسي السلمي في سوريا». وأضاف: «أيها المجتمعون يجب أن نرسل رسالة قوية نطالب فيها بأن تغادر جميع الميليشيات الأجنبية الأراضي السورية فوراً»، وكان وزير الخارجية التركي، قد شدّد على ضرورة انسحاب جميع الميليشيات من سوريا، في تصريح له نهاية العام الماضي، عقب الإعلان عما عرف بوثيقة موسكو الروسية والإيرانية والتركية، التي نتجت عنها دعوة مؤتمر «آستانة» في كازاخستان، أي أن الموقف الروسي غير معارض أبداً خروج إيران من سوريا والعراق، بل العكس، فإن ذلك يصب في مصلحته إذا أخذنا في الاعتبار أن الوجود الإيراني سيبقي على الجبهة السورية مشتعلة حتى وإن أجبرت المقاومة على تسليم سلاحها.
أما في العراق فإن الحديث عن مرحلة «ما بعد (داعش)» قد بدأ فعلاً، وحول الوضع الإيراني بالتحديد كما هو الحال في سوريا؛ لهذا سارع رئيس الوزراء العراقي السابق المالكي، لزيارة إيران في بداية شهر يناير حين استشعر بالغيوم تتجمع فوق السماء الإيرانية، سارع بالالتقاء بعلي أكبر ولايتي المستشار الدولي لخامنئي ليطمئن على مستقبله، وقال إنه جاء إلى إيران للقاء خامنئي ولبحث ما سمّاه «الأخطار المحتملة بعد (داعش)»، حسب ما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية، في تعبير سياسي جديد على السياسة الدولية والإقليمية، وبخاصة أن الحرب على «داعش» لم تنته بعد، في العراق أو في سوريا. ولم يعرف مغزى قوله بأنه ذهب إلى إيران للبحث في الأخطار المحتملة بعد «داعش»، مع المسؤولين الإيرانيين الذين لا ينتشر التنظيم المتطرف بين ظهرانيهم، وليست لديه أي عمليات عسكرية معلنة على أرضهم، («العربية» 4 يناير).
فإن أراد العراق أن تدعم دول الخليج أمنه واستقراره بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن عليه أن يتصرف حيال الانفلات الأمني الذي تتسبب فيه الميليشيات الإيرانية داخله.
 ١ مارس ٢٠١٧
١ مارس ٢٠١٧
حاولت الحكومة الأميركية حل أزمة سوريا، واخترعت مفاوضات ثلاث مرات في جنيف تقوم على طرح سياسي متوازن، لكن محور «نظام دمشق - إيران - روسيا» أفسد المؤتمرات الثلاثة. الآن الروس مع حليفيهم ابتدعوا مؤتمرين؛ واحداً في آستانة، والثاني، ينعقد الآن، في جنيف، والبدايات تؤكد النهايات؛ فشل مكرر.
ومع أن الجميع، تقريباً، تعاون مع المشروع الروسي، بمن في ذلك تركيا ودول الخليج، وحكومة ترمب الجديدة في واشنطن، إلا أن ذلك لم يكن كافياً. إرضاءً للروس وتعاوناً مع الأمم المتحدة، تم إيقاف تمويل المعارضة بالسلاح، ومورست الضغوط على الفصائل المعتدلة منها لتقبل بحلول أقل من توقعاتها، ومنع بعض الفصائل من المشاركة، وأيدته واشنطن، وصار المبعوث الأممي دي ميستورا محامياً عن الموقف الروسي. لم ينته «جنيف 4» بعد، لكن الفشل أبرز ملامحه حتى الآن.
هذا الوضع يبين، أولاً، أنه لا يوجد على الأرض فريق منتصر، أو قوي، حتى يمكن فرضه على الجميع بدعم دولي، وهو ما حاولت إيران وروسيا فعله بفرض النظام السوري المتهالك. وثانياً، الفشل؛ لأن الحل المقترح لا يلبي الحد الأدنى من توقعات ملايين السوريين المشردين والخائفين. المشروع ركيزته الإبقاء على النظام حاكماً، يعني ذلك فرض معادلته على الأرض من تهجير وإلغاء للغالبية الباقية من السكان في داخل سوريا. الفكرة في حد ذاتها غير قابلة للصمود حتى لو وقّعت كل الفصائل عليها. إنها معادلة تريد تمكين النظام من حكم معظم سوريا بالقوة، مثل الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء أن إسرائيل تملك نظاماً وقوة ضخمة مكنتها من المحافظة على هذا الوضع الشاذ. ومع أن الروس حاولوا إقناع عدد من فصائل المعارضة بالالتحاق بالنظام، ومكافأتهم بمقاعد في الحكومة، إلا أن الأمر يبدو لهم، وللجميع، مثل تشريع عملية اغتصاب، ولن يلتحق بالحل أحد ذو قيمة.
وما سبق طرحه من حل سياسي، وكان مرفوضاً من الطرفين آنذاك؛ النظام والمعارضة، لا يزال هو الحل العملي والبديل المعقول... نظام مشترك وليس مجرد تبعية له. ويمكن تطويره الآن، فتبقي على الرئيس، لكن تذهب سلطات الأمن والمال للمعارضة، أو يذهب الرئيس وتبقى الكراسي السيادية في يد النظام، ضمن إطار مشاركة تحميه القوى الإقليمية والدولية. المقاسمة تبنى على معادلة توازن معقولة لكلا الطرفين مصلحة في المحافظة عليها؛ إما الرئاسة، وإما صلاحيات الرئاسة، وليس كلتيهما. لدينا نموذج صامد هو «اتفاق الطائف» الذي أنهى النزاع اللبناني، وهو أكثر تعقيداً من السوري، والذي قام على خلق حلٍ تنازل فيه كل طرف. فدعوات الحرب طالبت بإلغاء حق المسيحيين في الرئاسة وسلطاتها، وتوزيعها بشكل متساو، لكنها انتهت بإعادة توزيع الصلاحيات، بقي الرئيس وراح جزء من صلاحياته للفرقاء الآخرين. من دون «الطائف» ربما استمرت الحرب، وخسر المسيحيون حصصهم هذه. ولو رفض السنة والشيعة أيضاً لجلبت الحرب مزيداً من تدخلات خارجية تديم الحرب، وكانت الساحة اللبنانية قد بدأت تشهد مزيداً من الانقسامات داخل كل طائفة. الوضع السياسي في لبنان اليوم ليس كاملاً أو رائعاً، لكن البلاد على الأقل استقرت. نزاع سوريا أقل تعقيداً، والمعارضة المدنية تقبل بالتشارك وبدستور يحمي كل الأقليات، ولديها في منظومتها تجربة جيدة، سمحت بمشاركة وترؤس السوريين من دون فوارق دينية أو عرقية. أما المعارضة الإسلامية المسلحة، فإن معظمها مرفوض من الجميع، لأنها تحمل مشروعاً دينياً وأممياً ليس في صلب مطالب الشعب السوري.
فشل مؤتمرات آستانة وجنيف سيعيد الوضع إلى الاقتتال، حتى بعد حرمان المعارضة المعتدلة من السلاح، التي اضطر بعضها للتحالف مع التنظيمات الإرهابية حماية لها بعد نفاد ذخيرتها. الفشل المكرر قد يعيد الأطراف المتصلبة للتفكير بطريقة عقلانية وواقعية، مثل إيران التي عليها أن تدرك أنه لن يسمح لها بالاستيلاء على العراق وسوريا ولبنان. لقد حدث توغلها مستفيدة من ضعف إدارة الرئيس الأميركي السابق. وهيمنتها على هذا الهلال الكبير تهدد بقية دول المنطقة وكذلك العالم، إما نتيجة لاستخدام إيران وكلاءها سلاحاً ضد خصومها في كل مكان، بمن في ذلك الأوروبيون والأميركيون، أو لأن الوضع سيستمر مضطرباً فيجذب المتطرفين إليه، وهو ما يهدد الجميع.






