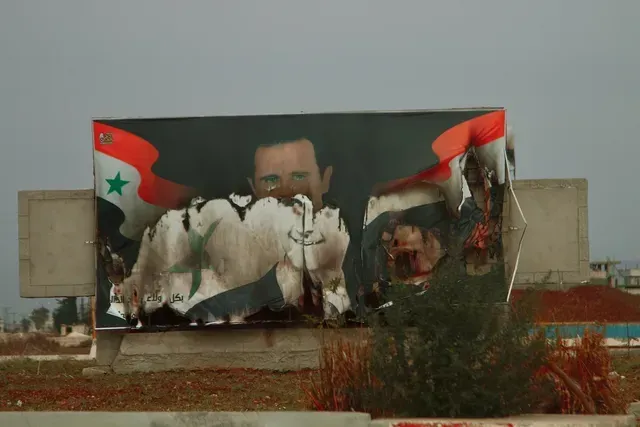١٣ يونيو ٢٠١٧
١٣ يونيو ٢٠١٧
شكلت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” في درعا نقطة تحول في مسيرة مواجهة الأسد و حلفاءه عسكريا ، بعد أن تمكنت هذه الغرفة من الخروج عن ما ألفناه من غرف العمليات التي شكلت على عجل و ذابت بنفس السرعة دون أن تترك بصمة واضحة أو محافظة على مكتسبات تشكيلها.
و تجاوزت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” ، مطبات عدة طوال ما يزيد عن عامين (وهو عمرها) ، حيث أسست لأول مرة تشكيلاً منظماً و متجانساً و قادر على التعامل مع التطورات بشكل متوازن (حتى الآن على الأقل) ، و اتخذت من عملية التوازن بين المكاسب و الخسائر ، و ترجيح الكفة لما هو أسلم و أشد حماية للمدنيين ، بعيداً عن المغامرات الغير محسوبة أو التحركات التي لا طائل منها إلا زيادة الخسائر البشرية.
وولدت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” بعد الفشل الذريع الذي خلفته معركة عاصفة الجنوب ، حيث اجتمعت عددا من الكتائب والألوية في مدينة درعا وعددها قرابة ال20 كتيبة اتفقوا جميعا على تشكيل غرفة أطلقوا عليها غرفة عمليات البنيان المرصوص في كانون الأول عام 2015 شهر ، مهمتها التخطيط والاستعداد للمعركة القادمة وهي تحرير حي المنشية.
قال أحد القادة العسكريين في درعا في الفترة التي هجرت فيها داريا، قال لن نفتح أي معركة عبثية يكون مصيرها الفشل ووقودها أرواح عناصرنا والمدنيين، المعارك تحتاج لتخطيط وصبر وليس فورة دم، ولن ننجر ولن نرضخ للضغوط الشعبية المغيبة عن واقع المعارك، كانت هذه الكلمات في تلك الفترة كافية لتخوينه ونعته بأبشع الأوصاف، ولكن صدق الرجل، فما رأيناه من معارك في حلب وسقوطها ومعارك في ريف حماة الشمالي وسقوط أغلب بلداتها مع مئات الشهداء وآلاف الجرحى، كان أغلبها بسبب ضعف التخطيط وسرعته والتحرك عاطفيا، وتحت الضغط الشعبي الذي لن يفهم تعقيد الواقع العسكري أبدا.
عامان وشهر هي المدة التي فصلت إعلان بدء معركة الموت ولا المذلة عن إعلان تشكيل غرفة عمليات البنيان المرصوص، والتي انطلقت في 12 شباط من العام الحالي، و قد تكون المدة طويلة ولكنها كانت تستحق كل هذا الإنتظار، فالغرقة استطاعت أن تمسك جميع الخيوط بكل قوة، من حفر للأنفاق وتدريب للمقاتيلن وتصنيع السلاح وزرع أجهزة اتصالات متطورة، وأجهزة تصوير ومراقبة، وتحكمت بأهم ما فيها وهي الآلة الإعلامية للفصائل المشاركة ومنعت خروج أي صورة أو فيديو إلا عن طريقها وبشعار الغرفة فقط، وهو ما نجح كثيرا بتشتيت قوات الأسد التي كانت تعتمد في كثير من الأحيان على الصور والفيديوهات التي تنشرها الفصائل لتحديد مواقعها بدقة وقصفها.
استطاعت الغرفة أيضا تحرير حي المنشية بدرعا بعد 115 يوما من المعارك الحادة و المتواصلة ، هي مدة متناسبة مع حجم الترسانة وعدد الحواجز وكيفية التدشيم في هذا الحي والذي كان بحق يعتبر ثكنة عسكرية كبيرة، وإذا أخذنا عدد الشهداء القليل الذين ارتقوا في المعركة نعلم لماذا كانت هذه المدة، فقد غرفة العمليات حريصة كل الحرص على أرواح المقاتلين وكان التقدم والهجوم مدروس بشكل كبير جدا، وكل تقدم كان يسبقه تمهيد بصواريخ قوية التدمير أو تفجير نفق أو عربة مفخخة او خرطوم متفجر.
اليوم ومع الحشود العسكرية الكبيرة من المليشيات الشيعية متعددة الجنسيات إلى مدينة درعا في محاولة منها للسيطرة على كامل المدينة، استنفرت غرفة عمليات البنيان المرصوص وأظهرت انضباط وقوة في الصد ورد العدوان، حيث لم تتمكن الميليشيات الشيعية من التقدم شبرا واحدا على الرغم من حجم القصف الجوي والمدفعي والصاروخي العنيف، بل سقط في صفوف المهاجمين عشرات القتلى والجرحى.
لغاية الآن "على الأقل" ما تزال غرفة عمليات البنيان المرصوص مثالا بارزا لما يجب عليه أن تكون أي غرفة عمليات حالية ومستقبلية، غرفة عمليات تراعي فيها البعد العسكري أولا قبل البعد العاطفي، حيث ومنذ تهجير مدينة داريا وتلاها الزبداني وخان الشيح ومحيط دمشق، كانت كل الاتهامات تنصب على درعا بالخيانة والخذلان، ولكنها في الحقيقة كانت تجهز رد الدين.
ثمة من يخطط في الخفاء والعلن لإفشال هذا المشروع المثالي ويزرع الفتن والاتهامات في طريقها، فهل ستنتهي غرفة عمليات البينان المرصوص مثل سابقاتها، لا نعلم ولكن ما نعلمه أنها تحتاج للدعم المستمر معنويا وماديا حتى تواصل مسيرتها في كتابة النصر.
 ١٣ يونيو ٢٠١٧
١٣ يونيو ٢٠١٧
ما تُسوقه الدراما العربية والسورية في شهر رمضان عبثٌ خطيرٌ بفكر المواطن، وتخفيف واستهزاء بعقل المشاهد، ففي وقت ننتظر جميعاً تسلّل الدراما إلى أعماق المجتمع، كطبيب يُشخص ويداوي أمراض المجتمع، نراها تنزلق إلى سطحية العمل في بثها أفكاراً مسمومة، وتزوير للحقائق، والابتعاد عن معالجة المشكلة، وتجنب البحث في أسبابها.
فلم نعد ندري الرسالة التي تريد الدراما إيصالها، في مسألة محاربة الإرهاب والتطرّف، فإذا ما أردنا أن نبتعد عن المظلومية، ونحكم العقل، نجد أنّه من خلال تطرّقها إلى محاربة الإرهاب في مسلسل غرابيب سود، تزيد من وتيرة التطرّف من خلال تشويها المقصود للإسلام، وإنّ فضحها أعمال التنظيم من دون التطرّق إلى بداية نشوئه، والدول التي رعته ومدّته بكلّ ما يريد من عوامل السيطرة والتسلط، فهي بهذا تكون في صدد مهمة أُوكلت لها من دولٍ اتخذوا موقف العداء من الدين الإسلامي منذ 1400 عام.
يركز مسلسل "غرابيب سود" على أعمال تنظيم الدولةالإسلامية بصورةٍ تجعل المتلقي يعتقد أنّ كلّ ما يراه مصدره الدين الإسلامي، فتم الحديث عن جهاد النكاح بطريقة تحقير للمرأة العربية، وتصويرها حاجة إشباع لشهوات الرجال، متناسين أنّ الإسلام أول من أنصف المرأة، وحرّم وأدها وأعطاها حقوقها، فيما من المعروف أنّ جهاد النكاح ظهر في الثورة السورية بفعل شيطنة وتجييش وكذب قناة الميادين السورية المموّلة من إيران، فلا يُخفى على أحد حقيقة استنباط هذا المصطلح وتغذيته ونسبه للفصائل الإسلامية، بغرض تشويه الثورة السورية وتفريغها من مضمونها.
جميعنا يعلم من هو التنظيم، وكيف تغذّى على الدول التي ساهمت، مباشرة، في إنعاشه على حساب دماء الشعوب، والدول نفسها استثمرت بالتنظيم وجعلته شماعة تُعلّق عليها كلّ تبريراتها لتحقيق أجندتها في سورية والعراق، فاستحكم التنظيم بأبنائنا وتفنّن بقتل شبابنا، فنحن نعلم أنّ التنظيم فاجر ومخالف كلّ الشرائع ويرتكب أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لكن هذا لا يعني أنّه مصدر التشريع الإسلامي، كما أراد مخرجو المسلسل أن يظهروه هكذا، فالدين بريء من هذه الأعمال التي لا تنقص منه شيء .
الأمر الخطير يقع في بث السموم لتخدير كلّ أبنائنا ممن لم يعرفوا بعد مفهوم الدين، ولا حتى من هو تنظيم داعش، لأجل ذلك من أول يوم لعرض هذا المسلسل، هبّت الأقلام عند كل من له ضمير حي، ويعي خطورة الواقعة، فطالبت بوقف هذه المهزلة من الأعمال الهابطة المسيّسة .
منذ أن انطلقت الثورة السورية، قبل نحو ست سنوات ونيف، والأعمال الدرامية تتهاوى نحو الهاوية، فأذكر جيداً كيف تم استغلال المأساة السورية، في صناعة البسمة من قنوات النظام المجرم، وترويجها على أنّها فبركاتٌ لا صحة لها في الواقع.
ناهيكم عن تزويره الحقائق، وقد نجح بذلك من وراء رجال الفن المنزلقين والساقطين أخلاقياً ممن يرضون لأنفسهم دور المهانة والإذلال من أجل المال والجاه والسلطة، كأمثال زعيم الدراما، زهير رمضان، الذي بات رجل الشاشة السورية، بعدما ارتدى البذلة العسكرية، واتخذ من نفسه مالكاً للفنانين، ويحق له أن يفصل ويقاضي من يشاء، ولكلّ من أساء لسيده بشار الأسد.
غابت الدراما السورية، والعربية عموما، بشكل مباشرعن أحداث الربيع العربي، وفي ظنها أنّها تبتعد عن السياسة، لأنها شأن بعيد عن مجال الفن، لكن الحقيقة تقضي القول إنّ مالكي الشاشات من دول أنظمة الاستبداد يبسطون يدهم على كلّ مؤسسات الدولة، فليس غريباً أن يجندوا الدراما لصالحهم، حتى تكون نافذة لهم لتحقير البشر وتخدير العقول.
سبع سنوات من زلازل الربيع العربي والدراما العربية تعيش في واقع مغاير عن واقع الحقيقة، وهنا منطقي أن نفهم، ما دام أنّ شعوبا تموت على أيدي حكامها، فمن الطبيعي أن تكون الدراما سلاحاً بيد الجلاد، وكلّ التعويل اليوم على الدراما الحرّة التي لا تكون جندياُ للحكام، وتجعل من نفسها سنداً لإنسان، وعوناً له في تشخيص الواقع، ودراسة مشكلات المجتمع وتقدم حلولاً تزيد من خيرية الإنسان، وتقلل من شره.
 ١٣ يونيو ٢٠١٧
١٣ يونيو ٢٠١٧
وصف المسؤولون البريطانيون على شاشات التلفزة، وكذلك متابعو الصحف البريطانية على صفحات التواصل الاجتماعية، الهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن أخيرا، وتحديداً في منطقة برج لندن، بأنّها تضرّ بالإسلام وصورته. وأفردت قناة بي بي سي ساعات مطوّلة جداً عن الحادث، ونشرت الصحف البريطانية تقارير متتابعة.
ولا يخفى أن عدة صحف بريطانية تعمل على تشويه صورة الإسلام والمسلمين، ولا تألو جهداً للنيْل من ثقافتنا الإسلامية، سواء في ظلّ وقوع هجمات إرهابية أم بدونها، بشكل صريح أو مبطّن، ومن الصحف المنحازة تماماً ضد الإسلام، الديلي ميل.
لن أناقش هنا ضرر التطرف وآثاره على الإسلام، وأقوم بتفسير الواضح، ولكنّني أود أن أدعو الشباب العربي المتنور الغيور على إسلامه وصورته المشرقة أن يجتمع لمواجهة التحيّز والكراهية ضد المسلمين، وهما تتغذيان على فتيل التطرف المشتعل. نجتمع لنواجه بالحجة والبرهان والمنطق، لأن الغرب لا يميل إلى لغة المشاعر والاستعطاف. نريد أن نجتمع لمخاطبة العقول الغربية، والرد عليهم بشكل راقٍ على مواقع تواصلهم، كلما رأينا هجوماً كلامياً ضد الإسلام والمسلمين. واجبنا أن نطوي الصمت وننتقل من المشاهدة إلى الحوار.
لا نستطيع، نحن الأفراد، أن نعالج هذه المشكلة بمواجهة التطرف المسلح نفسه، فهي مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، لكن باستطاعتنا أن نرمم ما يتم تخريبه من صورتنا الإسلامية، ونستطيع أن نصحح بعض ما هو مرسوم في أذهان معظم العالم الغربي.
كل ما نحتاجه إطلاق مبادرة تحمل اسم "إسلام جميل"، يضم مقالات وحوارات مع مجموعة من المتنورين في الدّين وأخرى من متقني اللغة الإنجليزية، لنبدأ جولات الحوار والمحاورة في معركة إبراز وجه الإسلام الجميل، فهل نفعل؟
 ١٣ يونيو ٢٠١٧
١٣ يونيو ٢٠١٧
مع انتهاء "قوات سورية الديمقراطية" من معركتها الفاصلة مع "داعش" في مدينة الرّقة، تكون خريطة النفوذ في سورية قد تم إعادة ترتيبها من جديد، أميركياً هذه المرّة، في ظل القبول الروسي، والصمت التركي، وانحسار الدور الإيراني الذي يتوافق مع انحسار وضعية النظام في المنطقة الشرقية تماماً. كما تفيد هذه المعركة بأن حسابات الدول الضامنة لجولات أستانة التفاوضية لم تكن تأخذ في الحسبان أن أطرافاً أخرى لم تنضو في توافقاتها، ستكون حاضرة، وستقضم من حصصها، سواء ما تعلق بمهمة "الحرب على الإرهاب"، أو المسعى إلى تقاسم النفوذ على المناطق التي يتم تحريرها من قوى التطرّف والإرهاب، مثل "داعش" وغيرها، ما يعني أن هذه القوى، أو الأطراف، سيكون لها دورها المقرّر في تشكيل مستقبل سورية.
وبهذه المعركة، تكون "قوات سورية الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، قد سيطرت على مساحة واسعة من الأراضي السورية، ربما تتجاوز التي يسيطر فيها النظام مع داعميْه إيران وروسيا، ما يضع هذه القوات أمام مسؤولية الإعلان عن نفسها وخطتها في التعاطي مع المناطق المحرّرة من "داعش". السؤال الآن: هل يعتبر أهالي هذه المناطق أنفسهم محرّرين من حكمي "داعش" والنظام؟ أو هل تدخل هذه الأراضي المناطق ضمن نطاق الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية؟ وهل سنشهد، هذه المرة، نموذجا جديدا لحكم محلي، بعيدا عن الإقصاء والاستبداد، وعن التجارب السلبية السابقة، لكي تصبح هذه المناطق ورقة قوة إضافية للثورة السورية؟
أيضاً، سيطرح هذا الوضع الجديد مجدّدا، وبإلحاح، ملف العلاقة بين المكوّنات الكردية، وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أو قوات سورية الديمقراطية، وبين المعارضة السورية، بمكوناتها السياسية والعسكرية، وهو الملف الذي جرى تأجيله أو تجاهله، لأسباب مختلفة، الأمر الذي أثار الشكوك بين الطرفين، ما تسبّب بأضرار بالغةٍ بالثورة السورية، وبوحدة السوريين. دليل ذلك، مثلا، التخبّط في تصريحات قياداتٍ في المعارضة، إذ صرّح رئيس وفد التفاوض في جنيف، نصر الحريري، قبل أيام، إن "قوات سورية الديمقراطية إرهابية من وجهة نظرنا، لا تختلف أبداً عن داعش"، فعلى الرغم من الملاحظات على سلوك هذه القوات خلال مسيرة معاركها، وإدارتها مناطق نفوذها واعتقالاتها شخصيات كردية، إلا أن تشبيهها بـ"داعش" ليس موفقاً، فكلامٌ كهذا يعطل إمكان إيجاد توافقاتٍ، حتى وإن لم تكن موجودة أصلاً، مع المكونات الكردية الفاعلة، ويؤزّم العلاقة بين السوريين، كرداً وعرباً. وتاليا، فإن وضعاً على هذا النحو يفيد النظام، الأمر الذي ينبغي على المعارضة تداركه، خصوصا أنها معنيةٌ بإعادة صياغة علاقاتها مع القوى الفاعلة ضد النظام، وتقوية ارتباطها بأهداف الثورة في إقامة دولة المواطنين الديمقراطية، التي تستوعب كل المكونات السورية على أسس عادلة، أفراداً وقوميات.
على الجهة المقابلة، يخوض النظام السوري مع حليفه الإيراني معركة شرسة في درعا، لتوسيع رقعة سيطرته في المنطقة الجنوبية، على حساب "الجيش الحر"، ليتمكّن من جديد من الجلوس إلى طاولة مفاوضات أستانة، كقوة فاعلة ولو شكلياً على الأراضي السورية، جنباً إلى جنب مع المليشيات الإيرانية التي تتزعمها مليشيا حزب الله. علماً أن هذه المعركة بالذات تؤكد أن اتفاق المناطق منخفضة التصعيد الذي وقعته إيران وروسيا وتركيا مجرد لعبة جديدة، أو مجرد تورية، يُراد منها إعادة تعويم النظام، وقضم المناطق الخارجة عن سيطرته، وهذا ما حدث، أيضاً، في غوطة دمشق الشرقية، وفي ريف حلب.
وستبين النتائج التي ستتمخض عنها معركة درعا خريطة تموضع الأطراف المتصارعة في الجنوب، أو بمعنى آخر ستوضح ما إذا كان من المسموح للنظام وحلفائه أخذ المنطقة الجنوبية، أو تمسّك الولايات المتحدة بموقفها بخصوص تحجيم إيران في الصراع السوري، وتقليص نفوذها في سورية، ولا سيما على الحدود السورية مع الأردن ومع العراق، أي من الجنوب إلى الشرق.
على ذلك، ستحسم الأيام المقبلة في مصيري منطقتين استراتيجيتين في سورية، أي المنطقتين الشرقية في الحدود مع العراق التي ستحجم نفوذ إيران ومليشياتها في سورية، وتردع قوات الحشد الشعبي العراقية، وقوات النظام، والجنوبية، حيث تحاول المليشيات الإيرانية فرض وجودها لخلط الأوراق، وفرض وجودها لاعباً رئيساً، من خلال وجودها على مقربةٍ من الحدود مع إسرائيل. وفي الغضون، ستوضح هاتان المعركتان مكانة قوات سوريا الديمقراطية، وخريطة القوى العسكرية في الشمال والشمال الشرقي، كما ستوضح حجم الوجود أو الدعم الأميركي المباشر، لقوات المعارضة (وقوات قسد) ما يكشف عن توجهات الإدارة الأميركية الجديدة في خصوص الصراع السوري. وإن غدا لناظره قريب.
 ١٢ يونيو ٢٠١٧
١٢ يونيو ٢٠١٧
بعد أن مر الموعد المقرّر من قبل لعرض حلقة أخرى من مسلسل أستانة الممل، وزاد تثاؤب المتفرّجين، جراء خلو هذا الإنتاج التلفزيوني من كل عناصر التشويق والإثارة اللازمة لاستقطاب المتلقين، أعلن وزير خارجية كازاخستان تأجيل عقد الاجتماع الدوري المنتظم لما بات يُعرف باسم مسار أستانة، إلى أجل غير معلوم، فكان وزير الدولة المضيفة كمن يعلن عن انتهاء فعاليات معسكرٍ كشفي، قبل أن يتم توزيع الجوائز الرمزية على المشاركين، في ختام هذا النشاط الترويجي.
لم يمر وقت طويل، حتى تبيّن أن إعلان كازاخستان عن فض هذه اللعبة الملفقة من ألفها إلى يائها، كان قراراً غير منسّق مع موسكو، ان لم نقل إنه كان مفاجئاً للدولة التي أعدت هذه الدراما السياسية الباهتة، في أوائل العام الجاري، وأخرجتها كيفما اتفق، الأمر الذي حدا بنائب وزير الخارجية الروسية إلى الإعلان أن مؤتمر أستانة تأجل بضعة أيام فقط، وأنه سيعقد في العشرين من شهر يونيو/ حزيران الحالي، وكأن شيئاً لم يصدر عن الجمهورية الآسيوية السوفياتية السابقة.
ولعل هذا التضارب في الدعوة إلى عقد اجتماع النسخة الخامسة من مؤتمر أستانة، بين الدولتين، المضيفة والراعية، أي كازاخستان وروسيا، هو بمثابة أول ورقة نعي لهذا المسار الذي سبق لموسكو أن اختارت مكانه وزمانه على نحو مريب، وحدّدت هويات أعضائه المشاركين بشكل تعسفي، في لحظةٍ بدت مواتيةً للدولة التي أملت نفسها على جميع الأطراف، في أعقاب معركة حلب الفاصلة بين مرحلتين من زمن الثورة السورية، حيث بدت روسيا آنذاك صاحبة اليد العليا في مسار الأزمة الدامية الطويلة.
ويصحّ هذا الاستنتاج المتعلق بدنو أجل مسار أستانة، حتى وإن انعقدت جلسة أخرى في الموعد الجديد الذي حددته موسكو من دون استئذان مسبق من شريكيها الإقليميين؛ إيران وتركيا، بل وربما من دون التشاور مع الدولة المضيفة التي درجت، في العادة، على أخذ زمام المبادرة بتوجيه الدعوات إلى المشاركين، وتحديد يوم انعقاد المؤتمر، بالتفاهم مع الدولة الراعية هذا المسار الذي ظل يراوح مكانه، في ظل حالة تكاذبٍ يقوم بها أغلب المشاركين، بادعاء النجاح في ختام كل جولةٍ حافلة بالصور التذكارية.
تستند هذه المقاربة لمآلات مؤتمر أستانة إلى حقيقةٍ مستمدة من منطق عقد هذا المؤتمر الذي تم توقيت أول جولة له في الثاني والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أي في لحظة الانتقال السياسي في البيت الأبيض، إن لم نقل لحظة فراغ أميركي كان قائماً من قبل، بلغت ذروته في تلك الفترة التي كانت فيها روسيا تلتقط أول صورة لها مع ما تدّعيه أول "نصر" على قوى الثورة والمعارضة في أحياء حلب الشرقية، الأمر الذي شجعها على تحويل ذلك المكسب العسكري إلى إنجاز سياسي، كانت تمنّي نفسها به، وتتحرّق لتحقيقه في أسرع وقت ممكن.
وليس أدل على استعجال روسيا توظيف نتائج معركة حلب، قبل أن يفلت الوضع من بين أيديها، والاستثمار السياسي في تلك النتيجة بصورةٍ مكثفة، سعيها إلى تحويل منصة أستانة المقامة على قاعدة التهدئة، وتثبيت خطوط وقف إطلاق النار القائمة، إلى مسار سياسي بديل لمؤتمر جنيف المتعثر، تفرض فيه موسكو رؤيتها للحل المستمد من لحظةٍ حربيةٍ فارقة، ومن تفرّدٍ شبه كامل بمسارات الأزمة الكارثية السورية، بدليل طرح روسيا مسودة دستور سوري جديد، ومحاولة فرضه على الأطراف المعنية، وهو ما شكل صدمةً للجميع، بما في ذلك وفد النظام السوري نفسه.
مع مرور مزيد من الوقت، خبا "النصر" الروسي شيئاً فشيئاً، وفاتت لحظة القطاف السياسي في الوقت الملائم، وتكريس حقيقةٍ دبلوماسية منتهية. كما بدت يد روسيا الطويلة أقصر من أن تطاول سائر مكونات المشهد السوري المتغير باضطراد، وأضيق من أن تحتوي كل المتغيرات المتلاحقة التي ظلت الأزمة السورية المعقدة تنتجها، ثم تعيد إنتاجها، في النطاقين؛ الإقليمي والدولي، لا سيما مع زيادة الحضور الأميركي على مسرح الأزمة، حتى وإن كان البعد العسكري لهذا الحضور أشد رجحاناً من البعد السياسي للدولة العظمى، المفتقرة بعد لاستراتيجيةٍ خاصةٍ بها في إطار التعاطي مع تطورات الحالة السورية.
وأكثر من ذلك، تعقد المشهد الإقليمي المعقد أصلاً، وطرأت عليه تحولاتٌ جديدةٌ وعميقة الغور، منذ انعقاد القمة الأميركية- الإسلامية في الرياض، تلك القمة التي وعدت بقيام تحالف استراتيجي شرق أوسطي بقيادة الولايات المتحدة التي قلبت صفحة باراك أوباما إلى صفحة مغايرة، تشي بانخراطٍ أوسع وأعمق في شؤون هذه المنطقة وشجونها الكثيرة، وهو ما من شأنه أن يقلص حدود المناورة المتاحة أمام روسيا، إن لم نقل إنه سينهي تفردها الطويل، أو على الأقل الحد من قدرتها على اللعب وحدها في متاهات هذه المنطقة.
إزاء ذلك كله، بدا الإعلان عن تأجيل مؤتمر أستانة إلى أجل غير مسمى، بمثابة تحصيل حاصل لكل هذه المتغيرات التي تزاحمت على المسرح الإقليمي في غضون الفترة القصيرة الماضية، حتى لا نقل إن ذلك الإعلان، المفاجئ على ما يبدو لروسيا في المقام الأول، كان بمثابة ورقة نعي لهذه اللعبة الروسية التي سبق أن وصفناها، في وقت مبكر، بأنها قد تتحول نقطة ضعف وإخفاق في سجل الدبلوماسية الروسية، كونها لعبة قائمة على الاستعجال والتفرّد والمراوغة، ولا تتمتع بقوة دفع ذاتية كافية، ناهيك عمّا تواجهه من جدران صد، تزداد، مع الوقت، صلابة، ليس آخرها الحضور الأميركي على الميدان السوري، هذا الحضور الذي يؤسّس لمعادل سياسي بالضرورة الموضوعية.
وعليه، يمكن الحديث، من الآن وبصوت أعلى من قبل، عن نهاية هذا المسلسل الروسي الرديء، المسمى مؤتمر أستانة، بثقةٍ أعمق من السابق، حتى وإن انعقد مرة أخرى في الأيام المقبلة، طالما أن هذا المسار المراوغ فشل في تكريس أي حقائق سياسية كانت منتظرة بعد معركة حلب، وأخفق على رؤوس الأشهاد في إنتاج ما هو أكثر مما تسمى مناطق منخفضة التوتر، وهي خدعةٌ روسيةٌ أخرى مكشوفة، وفضلاً عن ذلك كله، عجزت روسيا عن جعل مسار أستانة بديلاً لمسار جنيف، وهذا هو العجز الروسي الأبلغ وضوحاً في خواتيم هذه اللعبة الماجنة.
 ١٢ يونيو ٢٠١٧
١٢ يونيو ٢٠١٧
يصوّر الصراع الجاري في سورية "حربا ضد الإرهاب"، وكذلك "حرباً أهلية"، أو حتى صراع النظام "العلماني" ضد قوى أصولية وسلفية. ويوصّف بأنه "مؤامرة" إمبريالية ضد "النظام الوطني"، وعديد من التوصيفات الأخرى. بالأساس، يجري الهروب من القول بحدوث ثورة في سورية، وأن الشعب تظاهر أشهراً طويلة من أجل "إسقاط النظام".
هذه الثورة هي التي كانت التعبير عن تفجّر الصراع بين الشعب والنظام، نتيجة الوضعية التي بات يعيشها الشعب على إثر اللبرلة التي اجتاحت سورية، بعد تسعينيات القرن العشرين، وخصوصاً بعد استلام بشار الأسد السلطة. وإذا كان النظام يعتمد على قوة أجهزته الأمنية المتعددة، وعلى "البنية الصلبة" في الجيش (الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري ووحدات خاصة)، وكان يعتقد نفسه قادراً على هزم الثورة بها، وبمجمل السياسات التي اتبعها، ظهر (على الرغم من كل مساعدات إيران التقنية واللوجستية، وكذلك مساعدات روسيا) أنه، مع نهاية سنة 2012، لم يعد قادراً على الصمود في وجه الثورة التي بدأت سلميةً، وتسلحت بعد أكثر من ستة أشهر، لكن القوى المسلحة كانت قليلة وبسلاح بسيط. توسعت الثورة خلال سنة، لكي تشمل معظم أرجاء سورية، وبقيت فئات جرى تخويفها من "السلفية والإرهاب" ومن "الطائفية"، وحيث ساعد خطاب أطرافٍ في المعارضة بذلك. كذلك ظلت الرأسمالية السورية، وبعض الفئات الوسطى، ملتصقةً بالنظام. ووصل التوتر إلى الجيش الذي بات النظام عاجزاً عن استخدامه ضد الشعب، وأخذ يعاني من حالات انشقاق وفرار من الجندية. لهذا، أفضى توسّع الثورة وتسلحها، و"تحييد" الجيش، إلى أن تُنهك "البنية الصلبة"، وتخسر جزءاً مهماً من عدادها.
هذه اللحظة هي التي فرضت استجلاب "قوى العالم" إلى سورية. لم يكن الشعب السوري يحتاج "دعماً خارجياً"، حيث أظهر أنه قادر على إسقاط النظام، لكن النظام بالتحديد هو الذي احتاج دعماً خارجياً. ولهذا، فإن كل من دخل سورية، بعدئذ، دخل لكي يساعد النظام، بغض النظر عمّا طرح، أو أين جرى تصنيفه، أو الأوهام التي ألقيت عليه.
هنا لا أودّ التحليل، بل أودّ التوصيف أكثر، لكي أوضّح طبيعة الصراع الذي يقوم من أجل خنق الثورة وتدميرها. ولأوضّح أنه فوق الثورة تراكب صراع قوىً وهمي، كان غرضه سحق الثورة بالأساس. وبالتالي، لم يكن صراعاً حقيقياً كما يظهر في الخطاب الرائج. وهو ما حاولت التأشير عليه منذ البدء، حيث بدأ الخطاب بالإشارة إلى "الحرب الأهلية"، ومال إلى التلميح إلى "حربٍ طائفية"، وصولاً إلى التركيز على "الحرب ضد الإرهاب"، حيث إن كل الحشد الذي تجمّع في سورية هو من أجل الحرب ضد الإرهاب! هذا الإرهاب الذي تجمّع كذلك في سورية. لماذا في سورية التي تشهد ثورة تجمّع الإرهاب؟ وبالتالي، أي إرهابٍ يحارب كل هؤلاء الذين تجمعوا في سورية كذلك؟ ربما المصادفة وحدها هي التي جمعتهم.
إذا كانت جبهة النصرة قد أُعلنت بداية صيف سنة 2012، فقد ظلت بلا فاعليةٍ إلى نهاية ذلك العام. ولم ينشأ تنظيم داعش، إلا في إبريل/ نيسان سنة 2013. ثم ضعف النظام نهاية سنة 2012، وأخذت تتوافد قوى جديدة، لكي تقاتل الثورة. تدخّل أولاً حزب الله (بعد أن كانت إيران تخطط، وترسل أدوات القمع، والقنّاصة، والطيارين فيما بعد)، لكن توسّع التدخل لكي يشمل قوى طائفية عراقية (لواء أبو الفضل العباس، وحزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق، وفيلق بدر). وتحت هذا المسار، شارك الحوثيون قبل أن يعملوا على الاستيلاء على السلطة. لكن، يمكن اليوم أن نحدِّد مشاركةً كبيرة من لبنان (حزب الله، وبعض القوميين)، والعراق (كل تلك المليشيات، وأيضاً النجباء، وغيرها)، ومن أفغانستان وباكستان (الزينبيون). وكل ما يجمعها هو الانتماء للطائفة الشيعية، وحيث الارتباط بإيران، الدولة التي أرسلت كذلك الآلاف من الحرس الثوري، ومن الباسيج، وحتى من جيشها. بالتالي، بات في سورية عشرات الآلاف، وربما فاقوا المائة ألف، مرسلين ومسلحين وممولين من إيران، وباتوا هم "حُماة" النظام منذ تدخلهم. وأصبح قادة إيرانيون هم الذين يقودون المعارك، ويعيّنون الضباط القادة.
نحن هنا أمام مئات الآلاف ممن ينتمون إلى الطائفة الشيعية، يجري توظيفهم لحماية النظام ومنع سقوطه (مع بضعة مئات من القومجيين العرب من لبنان وتونس خصوصاً). وهؤلاء هم مَنْ منع إسقاط الشعب السوري النظامَ في المرحلة الأولى من الثورة، على الرغم من أنهم لم يستطيعوا ذلك بعد عامين من تدخلهم.
في الفترة ذاتها، أي بعد نهاية سنة 2012، جرى تشكيل جبهة النصرة ثم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبدأت عملية ضخّ "جهاديين" من كل أصقاع الأرض، من السعودية والكويت ودول الخليج، إلى مصر وتونس وليبيا ولبنان إلى الشيشان والأغور، والتركمان والأتراك، والأوزبك، ومن مسلمي أوروبا. وحتى من أميركا وإنكلترا. وهؤلاء يمثلون مجموعاتٍ أصوليةٍ سلفيةٍ مغرقةٍ في تعصبها. وهي التي تُعتبر الممثل "الحصري" للإرهاب في سورية. والتي تتدخل كل الأطراف الدولية من أجل مواجهتها. هذه القوى أتت، كما تُعلن، من أجل إقامة "دولة الخلافة"، ولقد تمركزت في المناطق التي كان النظام قد انسحب منها، بعد إبريل/ نيسان سنة 2012، والتي باتت تُعتبر مناطق "محرّرة"، أو مناطق خارجة عن سيطرة النظام. وعملت على تصفية كل الناشطين والكتائب المسلحة التي تقاتل النظام، والإعلاميين والذين نشطوا لمساعدة المهجّرين. وكذلك فرض "الشرع"، وتحويل الناس إلى قطيع. لقد فرضوا سلطة استبداديةً مغرقة في الجهل والوحشية.
كانت المعارك الأوسع لكل هؤلاء مع الكتائب المسلحة التي تقاتل النظام، ومع الناشطين السياسيين والإعلاميين والإغاثيين، وكل المجموعات التي تظاهرت ضد النظام وقاتلته. وظهر واضحاً أن "داعش" خصوصاً، ولكن كذلك جبهة النصرة، كانا يعملان بجهدٍ حثيثٍ لقضم قوى الثورة، وإنهائها. بمعنى أنها عملت على تكملة ما كان يقوم به النظام، ليظهر أن هدف الطرفين إنهاك الثورة وتصفيتها. لهذا كان تركيزهما على قوى الثورة. وبهذا سيطر "داعش" على جزء كبير من شمال سورية وشرقها، وامتد جنوباً، وكذلك نحو القلمون. وعملت جبهة النصرة على السيطرة في المناطق التي انحصرت فيها الكتائب التي تقاتل النظام، وقامت بتصفية كثير من تلك الكتائب، ومن قتل أو اعتقال كادراتٍ كثيرة.
"الإرهاب" الذي بات يعني وجود آلاف الأجانب المنخرطين في "تنظيم جهادي"، وجرى تسهيل وصولهم من دول عديدة إقليمية ودولية، ومن النظام ذاته، أي الذي جرى حشده، هذا الإرهاب هو الذي بات يبرّر كل الحشود الأخرى، على الرغم من أنه حشد من الدول نفسها التي حشدت وتحشد لمواجهته. فالمعركة يجب أن تكون في البلد الذي يشهد ثورةً، لكي يفضي الصراع إلى تدمير "الأخضر واليابس". بالتالي، في مقابل حشد إيران "الشيعي"، جرى حشد "سني"، لكي يتقاتلا على جثة الثورة. هذا من حيث الشكل، أو من حيث الخطاب الإعلامي، لكنهما أتيا لكي يقتلا الثورة.
ثم تحت مسمى قوات سورية الديمقراطية، نجد أن أكراداً أتراكاً وعراقيين يشاركون فيها، هم من حزب العمال الكردستاني، وأتى "يساريون" من بلدانٍ عديدة لمشاركة "الحزب الماركسي اللينيني" نضاله الثوري. ولقد مثّل ذلك دخول قوى جديدة في الصراع، بعد أن اتخذ حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) طريقاً "مستقلاً" في مسارٍ يهدف إلى تحقيق "كيان كردي" (فيدرالية روجافا). ولقد تعاون مع النظام، ومع أميركا وروسيا في سبيل الوصول إلى ذلك، وهو يقاتل تحت إشراف وتدريب وسلاح أميركي.
وهنا ننتقل إلى مستوى آخر من التدخل العسكري، حيث تتدخل أميركا بقواتها الجوية (ثم الآن البرية) بالتحالف مع حزب الاتحاد الديمقراطي (بي يي دي) (تحت مسمى قوات سورية الديمقراطية) لمحاربة "داعش". والطائرات الأميركية تقصف كذلك جبهة النصرة (باتت جبهة فتح الشام، ثم هيئة تحرير الشام). ولا شك في أن تركيزها ينصبّ على هذه الجبهة. وروسيا أرسلت طيرانها وقواتها التي تدعم النظام. وظهر كذلك أن هناك شركات أمنية خاصة روسية ترسل المقاتلين والخبراء الروس إلى سورية لدعم النظام. وكذلك بات هناك قوات برية روسية وشرطة عسكرية روسية على الأرض. وكل دولة منهما تدعم طرفاً، لكن ليسا الطرفين المتصارعين، فإذا كانت روسيا تدعم النظام، وقد منعت سقوطه بعد هزيمة قوات إيران، وتعمل بجدية كاملة لسحق الثورة، حيث تركّز حربها ضد الكتائب التي تقاتل النظام (الإسلامية وغير الإسلامية)، وتعمل على قضم المناطق واحدة بعد أخرى، وتمارس الوحشية ضد الشعب، نجد أن أميركا تمركز دعمها لقوات سورية الديمقراطية في الشمال، وبعض الكتائب التي جرى تدريبها في الأردن في الجنوب، وتركّز قصفها في مناطق "داعش"، وعلى مقار جبهة النصرة. وترفض تسليح الكتائب التي تقاتل النظام، بل تريد أن تحوّلها "حرباً ضد داعش"، وهذا شرطها لدعم "المعارضة المسلحة".
إذن، هناك "مقاتلون" من "كل العالم" في سورية، ويركّز الإعلام (الغربي، والعربي)، وتركز أطراف الصراع على أنه صراع بين النظام وحلفائه من طرف، والمجموعات الأصولية التي تمثّل الإرهاب من طرف آخر. حيث إن كل تلك القوى التي أتت لكي تدعم النظام أتت لمحاربة الإرهاب. ولهذا، على العالم أن يقف مع النظام لهزيمة الإرهاب. لكن، هل يتقاتل هؤلاء الذين يدعمون النظام وأولئك الإرهابيون كما توضّح الصورة في الإعلام والخطاب؟
الخطاب الرائج، والمقصود ترويجه، ينطلق من هذه الثنائية، حيث يقاتل النظام و"حلفاؤه" المجموعات الإرهابية تلك. هذه هي الصورة المتداولة. لكن، أين موقع الثورة من ذلك كله؟ ليس هناك ثورة كما يُراد أن يقال، وكما جرى الاشتغال عليه منذ البدء. بالتالي، هي حرب عالمية ضد الإرهاب على الأرض السورية (والعراقية) وليس غير ذلك. حيث يظهر أن النظام وإيران، بقواتها متعددة الأشكال، وأميركا والحشد الشعبي في العراق، كلها تقاتل "داعش" وجبهة النصرة. لهذا، يصبح السؤال: هل تتقاتل هذه القوى فعلياً؟ هل تقاتل أميركا الإرهاب؟ يبدو ذلك، لكن الإرهاب صناعتها، ولهذا يصبح السؤال عن قتالها هذا الإرهاب الذي صنعته. هنا نلمس سعيها إلى العودة إلى السيطرة على العراق، وإبعاد إيران عنها، وإعادة تموضع قوات لها في العراق، كما قرّرت منذ بدء احتلال البلد. وفي سورية تمكين أكراد متعاونين معها، أي "قوات سورية الديمقراطية"، في إطار التفاهم مع روسيا، حيث كان واضحاً "اعتراف" أميركا بأحقية روسيا في سورية منذ سنة 2012.
لكن، ماذا تفعل كل تلك القوى التي "تتقاتل" في سورية؟ هناك جبهة النظام ضد الثورة، وتشمل قوات حزب الله والمليشيا الطائفية العراقية والحرس الثوري الإيراني، والأفغان وغيرهم، وكذلك القوات الجوية الروسية، وقوات برية أيضاً. وقد تركزت معاركها ضد الكتائب المسلحة التي نتجت عن التظاهرات، وبعض المجموعات الأصولية (أحرار الشام وجيش الإسلام ومجموعات أخرى). وهناك جبهة داعش و"النصرة" التي قاتلت كتائب الثورة ونشطاءها، ولعبت دور المعتقل والقاتل لكثير من كادراتها، وأيضاً فرضت سلطةً أصولية قروسطية على مناطق سيطرتها. وبينما ظهر أن جبهة النصرة تقاتل النظام كان "داعش" بعيداً عن ذلك. حيث يظهر أن معظم معاركه هي مع قوى الثورة، وخاض "معارك" مع قوات النظام، كان يبدو أنها مرتبةٌ سلفاً لأسباب متعددة. في كل الأحوال، فإن أغلب عملياته تركزت على مواجهة الكتائب المسلحة التي تقاتل النظام. ولعبت جبهة النصرة دور "المخرِّب" من داخل مناطق الثورة، سواء بقتل النشطاء أو بتوريط الكتائب الأخرى في معارك خاسرة، أو قضم تلك الكتائب. وكان واضحاً أنها قوى "مزروعة" لخدمة تدمير الثورة. أما حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) فقد عمل على السيطرة على مناطق الجزيرة السورية، وكان يريد التمدّد إلى شمال غرب سورية (عفرين)، لكي يكون كل شمال سورية وشمال شرقها فيدرالية روجافا. وهو لذلك كان يتعاون مع من يخدم هذه الفكرة، على الرغم من أن اعتماده الأساسي كان وما زال على أميركا، لكنه تعاون مع الروس ومع النظام في مناطق عديدة. بينما تركزت عمليات حلفاء النظام على مواجهة الكتائب المسلحة، وكان الهدف تصفيتها، واسترجاع المناطق التي تسيطر عليها.
يظهر واضحا في كل هذه الصورة أن كل المعارك كانت تهدف إلى تدمير قوى الثورة، والفصائل الأصولية (أحرار الشام وجيش الإسلام ومجموعات أخرى) التي تقاتل النظام بالتحديد. ولم يكن من قتال بينها، لا بين أميركا و"داعش"، ولا النظام وحلفائه مع "داعش" وجبهة النصرة. وظهرت هذه الفصائل الأصولية أنها خاضعة لسياسات دول إقليمية، وتلتزم بالسياسات التي تقرّرها. وأن قتالها النظام أو فيما بينها هو نتيجة حسابات تلك الدول.
إذن، أين الثورة، وأين الشعب؟ هو الذي ينسحق بصراعات كل هؤلاء، لكنه مصمم على استمرار الثورة.
 ١٢ يونيو ٢٠١٧
١٢ يونيو ٢٠١٧
مع دخول الثورة السورية عامها السابع ومرور المناطق المحررة بعدة مراحل وصراعات داخلية حاولت فيها الفصائل العسكرية إثبات وجودها وفرض هيمنتها على معظم القطاعات عسكريةً كانت ام مدنية دون مراعاة أية أنظمة أو قوانين او أعراف لتثبت أنها قادرة على القيام بكل الأعباء المدنية في الوقت الذي كانت فيه تقع بالمحظور وتتهاوى في مستنقع الحياة المدنية وتقوده الى جملة من الاستقطابات الداخلية المعقدة و التي نقلت صراع إثبات الوجود العسكري المحموم الى صراع مدني يختبئ خلف بطانة عسكرية .
ومع دخول منطقة الشمال السوري في مرحلة التهدئة الأخيرة قبل حولي شهرين وتوقف المعارك والأعمال العسكرية ، تحولت الجهات العسكرية الى الالتفات الى الشؤون المدنية لإثبات وجودها وهيمنتها عبر مؤسساتها، لينتقل صراع النفوذ الجغرافي ويتحول الى شبح يلاحق المدنيين بعد أن باتت تظهر الى السطح عورات الولاءات العسكرية من قبل تلك المؤسسات المدنية ، وبدأت تظهر ملامح الصراعات بالتشكيلات المدنية والتي تغذيها مرجعيات عسكرية بغية بسط نفوذها التام على ما تبقى للمدني من حقوق يمارسها دون استقطابات العسكر .
وفي الشهور الأخيرة لوحظ توجه محموم الى تشكيل المجالس المحلية و العشائرية والأهلية ومجالس الشورى، ففي كل قرية او بلدة او مدينة تجد فيها مجلسين محليين متناحرين بالتوازي مع مجلس للشورى وآخر أهلي وعشائري جميعها بنيت على أساس تقديم الولاء لأحد قطبي الصراع في الشمال السوري ( هيئة تحرير الشام و حركة أحرار الشام ) ليحظى كل فريق بدعم من أحد الأقطاب ويروح التشكيل الموازي للتسبيح في فلك القطب الآخر ، وينتقل الصراع العسكري لينعكس سلباً على الحياة المدنية في ظل الأحلام المراهقة للفصائل العسكرية على ما تبقى من جغرافيا المناطق المدمرة .
ولم يقتصر الأمر على مجالس الإدارة المحلية فحسب ، بل قام كل فصيل عسكري بتشكيل محاكم ودور قضاء وسجون بالإضافة الى هيئات خدمية تنموية تقوم على استثمار بعض من المكتسبات والفتات التي بقيت في المناطق المحررة، كالكهرباء والمياه والمطاحن والحبوب والافران وحتى وصل تنازعهم للتدخل بقطاعات حساسة كالتربية والتعليم وحتى الإغاثة، الأمر الذي وصل الى مرحلة التضارب بالتعطيل على الآخر عن طريق العبث بالممتلكات العامة التي تديرها مؤسسات موازية للقطب الآخر، ليبقى المواطن هو المتضرر الأكبر والأكثر تعرضاً للحرمان والخسارة في ظل عدم مبالاة الجهات العسكرية التي تدعم كل مؤسسة .
وباتت الساحة المدنية خلال الأشهر الماضية ساحة صراعات باردة واستقطابات شعواء على ممالك كرتونية تعتمد اللامركزية و تفتقد الى الدعم والخطط والموازنة وتتحكم في قرارها شخصيات عسكرية لا تملك الكفاءة والخبرة وتصدر بيانات وقرارات تشير الى سذاجة وحماقة وجهل القائم على صياغتها، وسادت عليها أجواء النكايات والمناحرات والإكتساب المادي من خلال استغلال حاجة المدنيين لما وضعت يدها عليه الفصائل العسكرية واعتبرته من موروثها الجهادي الحصري .
وليصبح الطابع العام المتحكم في الحياة المدنية هي مؤسسات شكلية محمية ومدعومة من قبل الفرقاء العسكريين، في ظل بقاء القرار الأول والأخير للجهة العسكرية دونما الاستئناس برأي الخبرات المدنية المتاحة في المناطق المحررة، وضاربةً بعرض الحائط التجارب المريرة للشعب السوري من قانون الطوارئ الذي انتهجه الأسدين الأب والإبن خلال نصف قرن من الزمن على الشعب السوري وإعطاء الجهات العسكرية والأمنية مطلق الصلاحيات في التسلط على رقاب المدنيين ومؤسساتهم التي تحولت الى مؤسسات صورية تنفذ ما تمليها عليه الأفرع الأمنية دونما اعتراض .
وفي إضاءة على بعض المؤسسات الثورية التي لم يكن للجهات العسكرية يدٌ فيها فهي - على قلتها - إلا أنها الوجه النير للحياة المدنية فعلى سبيل المثال لا الحصر كسبت الثورة رصيداً قيماً من خلال مؤسسة الدفاع المدني " القبعات البيضاء " و ووزارة الصحة من حيث إظهار الصورة النيرة للوعي في الإدارة المدنية ، وكان ذلك نتاجاً لعدم سماحها للمراهنات والمراهقات العسكرية بالعبث في تشكيلها وادارتها والتدخل في شؤونها ، فأظهرت نموذجاً يحتذى به من العمل المؤسساتي المحايد والقادر على القيام بأعماله على أكمل وجه دونما التحييز الى طرف ما في المنطقة المحررة وجعلت مؤسساتها من المواطن المدني وتلبية حاجاته البوصلة الأساسية لمسيرها محققةً ما عجزت عنه كل مؤسسات العسكر الواهية والغوغائية ، وكانت واحةً خضراء وسط ساحة من الممالك الهلامية التي تبنى على الرمال والتي لم تنتج لرعاتها حتى اليوم إلا الوهم و السراب .
ومن خلال التجارب الأخيرة ونجاعتها ونجاحها كان لزاماً على الشعب السوري أن يصل الى مرحلة من الوعي، يزدري فيها ولوغ العسكر في مستنقع الحياة المدنية، والتوعية من عدم تحويل المدنيين الى قطبين متناحرين أسوة بصراعات العسكر ، وعدم ترك المجال لتعزيز القطبية والصراع وتحويله من الساحة العسكرية الى التناطح في الساحة المدنية ، حيث لا نتيجة لها إلا أن يزهق فيها ما تبقى من الحياة المدنية تحت اقدام بساطير العسكر المتصارعة.
 ١١ يونيو ٢٠١٧
١١ يونيو ٢٠١٧
الغريب أن ثمة بقايا روح عند حزب البعث كي يعقد مؤتمره القومي في دمشق بعد عقود من التأخير، وبحضور من سمّوا قيادات بعثية قطرية من عدة دول عربية. والأغرب هو المشاحنات العنيفة التي شهدها المؤتمر وخروجه بقرار حل القيادة القومية للحزب بشكل نهائي، والاستعاضة عنها بمكتب قومي استشاري. والأكثر غرابة ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية عن سبب الحل، وهو غياب دور القيادة القومية وعدم قدرتها على ضبط الأمور الأمنية في البلاد!
منطقياً، كان الأجدى اتخاذ قرار بحل الحزب، ليس فقط لأنه خان الشعارات التي رفعها، وتحول إلى أداة قهر وإفساد بيد النظام الحاكم، أو لأنه فقد مشروعيته القومية بعد هزيمة حزيران (يونيو) 1967، والتي تمر ذكراها الخمسون، هذه الأيام، وإنما الأهم لأن رياح الربيع العربي، أكملت الإجهاز عليه، معلنة نهاية مرحلة طويلة تصدرت فيها الشعارات القومية المشهد، أو معلنة، ربما، بداية تبلور إرهاصات لفكر قومي جديد غني بعمقه الحضاري وبقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان.
لم تكن صدفة أن تتصدر قضايا الحرية والكرامة والعدالة، شعارات الثورة وخطاباتها، كنتيجة طبيعية لانحسار الفكر القومي لدى السوريين، وتراجع إيمانهم بدوره كحافز نضالي وتغييري، وهم الذين كابدوا كثيراً من ما آلت إليه أوضاعهم ومن النتائج المريرة التي حصدتها سنوات طويلة من تغليب النضال القومي على كل شي، ما يفسر ليس فقط شدة رفضهم لسلطة الاستبداد القائمة وإنما أيضاً للمسوغات الأيديولوجية التي تسوغ استمرارها في الحكم.
وتالياً لم تكن مصادفة أن تتقدم مشهد الثورة، التيارات الليبرالية بداية، ثم الإسلامية فيما بعد، وأن تكون قوى المعارضة، التي لا تزال تتعاطى وفق المنظور القومي وشعاراته، هي الطرف الأضعف حضوراً وتأثيراً في الحراك الثوري، وأن تتكشف صورة لمجتمع لا تعضده آمال قومية وهوية وطنية دأبت السلطة على التغني بهما، بل تنهشه اصطفافات عصبية مريضة ومتخلفة، جراء توسل النظام الشمولي الشعارات القومية والوطنية، لتسويغ القمع والتنكيل وحماية مراتع الفساد والامتيازات الفئوية.
هو حزب البعث الذي احتلت الألوف المؤلفة من قواعده، خصوصاً من أبناء الفلاحين والعمال وصغار الكسبة، الصفوف الأولى في الاحتجاجات والتظاهرات ضد فساد السلطة وعنفها المفرط وقدموا أثمن التضحيات، ليصح القول إن الحركات الإسلامية ما كان لها أن تحوز موقعاً وازناً لولا أنها كسبت فئات شعبية واسعة فقدت ثقتها بحزب البعث والفكر القومي وانسلخت بصورة جماعية عنهما، معتقدة أن الخيار الديني يشكل بديلاً سياسياً وملاذاً روحياً يعينها على مواجهة واقع القهر والاستبداد وأوضاع تنموية ومعيشية مذرية.
هو حزب البعث الذي استسهل أهله التخلي دستورياً عن دوره كحزب قائد للدولة والمجتمع، ولم يعد يسمع لهيئاته وكوادره أي صوت مؤثر في الصراع الدائر، وهو الحزب القومي الذي بادرت سلطته لفتح النار على المبادرات العربية الساعية لمحاصرة تفاقم المحنة السورية واحتوائها، واستجرت لمواجهة شعبها ما حلا لها من الأطراف الإقليمية والدولية، لتمكن الأجنبي المعادي للعرب وطموحاتهم، كإيران وتركيا وروسيا، من تقرير مصير البلاد والمنطقة، وأيضاً هو الحزب الذي دأبت قيادته على تأجيج العصبيات القومية والمذهبية عبر ممارسات مغرقة بالشوفينية واضطهاد الآخر المختلف، ثم توظيف عنفها المفرط واستفزازاتها الطائفية لتنفير البشر من وطنهم ودفعهم للهروب بحثاً عن حياة آمنة وكريمة.
واستدراكاً، هو الحزب الذي قادت سلطته أعنف ثورة مضادة لتحطيم آمال الشعب السوري في التغيير والحرية، واستباحت أشنع وسائل الفتك وأشدها عنفاً وتدميراً للدفاع عن سطوتها وامتيازاتها حتى لو كان الخراب والطوفان، ليغدو أحد وجوه الوفاء لما قدم من تضحيات، هو المسارعة لإطلاق رصاصة الرحمة على حزب البعث وفكره القومي الشوفيني في لحظات احتضارهما، رفضاً لإدمانهما اللاعقلانية وتغليب الغرائز والانفعالات على الواقع الملموس والتحليل الموضوعي، ورفضاً للأوهام والمنفخات الفارغة والجذور المريضة الفكرية والبنيوية التي حاولا أن يستمدا منها حضورهما، والأهم رفضاً لاستمرار دوريهما كأداة قهر وإذلال لمصلحة نظام ازدرى الشرعية الديموقراطية، وكرس سلطانه بشرعية ديماغوجية لا تهتم بالتأسيس لدولة المواطنة والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان، بل تتوسل شعارات تدعي الممانعة وتحرير فلسطين وردع المطامع الإمبريالية والصهيونية كي توطد دعائم الاستبداد وتلغي الحريات العامة والتعددية السياسية وتداول السلطة.
وفي المقابل، ربما يكمن أحد وجوه التفاؤل بالرهان على تقدم مصلحة غالبية السوريين، مع تفاقم معاناتهم وضيق خياراتهم، في لجوئهم للتمسك بهويتهم ووحدتهم وتعدديتهم على طريق خلاصهم من الاستبداد والاستباحة الخارجية وخيار الإسلاموية السياسية، وربما يكمن أحد وجوه الأمل، في أن تتبلور في سورية التي اعتبرت، في ما مضى، أهم قلاع القومية العربية، وأنجبت أبرز منظري الفكر القومي وأكثرهم شهرة، ولم تتأخر في التخلي عن هويتها وخصوصيتها لتلبية نداء أول وحدة عربية عرفها التاريخ الحديث، أن تتبلور أفكار واجتهادات نقدية للفكر القومي تحرره من جملة التباسات أحاطت به، ومن اندفاعات شوفينية بالغة الخطورة ارتكبت باسمه، وأساساً لتؤكد حقيقة الدور الرئيس للاستبداد في تشويه الفكر القومي وتحويله إلى إيديولوجية مغلقة ومفرغة من أي بعد إنساني أو حضاري.
هو أمر لافت ومثير، انتماء غالبية أنظمة البلدان التي ناهضتها الشعوب وشهدت ثورات، كمصر وسورية واليمن وليبيا، إلى الفكر القومي، وهي حقيقة ساطعة، وجود أبعاد وروابط قومية كامنة لمستقبل التغيير العربي، اتضحت ليس فقط في قوة وعمق المشتركات وتشابه أوجه المعاناة، وإنما في التواتر الزمني لنهوض الثورات العربية والتأثيرات المتبادلة بينها، والأهم في تماثل الشعارات والمطالب وتشابه الأعداء والمآلات، ما يوفر شرطاً موضوعياً لتعاضد من طراز جديد بين الشعوب العربية، عنوانه نصرة الديموقراطية واحترام التعددية وحقوق الإنسان كطريق لا غنى عنها لحماية الخيار القومي وتمكينه في الأرض.
 ١١ يونيو ٢٠١٧
١١ يونيو ٢٠١٧
دخل الصراع العسكري السوري مرحلة مختلفة كليا عن المراحل السابقة، لجهة المساحات الجغرافية الجديدة، ولجهة القوى المتصارعة بشكل مباشر هذه المرة (الولايات المتحدة، المعارضة السورية / النظام، الفصائل الدائرة في الفلك الإيراني، روسيا، تنظيم الدولة الإسلامية).
ملامح المعركة بدأت منذ فترة وبلغة أميركية واضحة لتحقيق هدفين معلنين: أولهما يتمثل في منع تنظيم الدولة الإسلامية من الانتشار في الصحراء السورية مع اقتراب معركة دير الزور، والثاني منع إيران من اختراق طرفي الحدود السورية/العراقية.
أخذت المعركة بعدا آخر بعد القصف الأميركي لرتل عسكري تابع لإيران -عند منطقة الحشمي قرب مفرق الزرقا- كان متوجها نحو التنف، الأمر الذي أحدث استنفارا كبيرا من دمشق وطهران، وأطلق معركة الحدود والمحاور الصحراوية بشكل واضح وصريح.
صراع الحدود
بدأت واشنطن أول إجراءاتها على الأرض منذ نحو شهرين عندما أغلقت بالتعاون مع البشمركة معبر ربيعة الحدودي في محافظة نينوى، وتحولت مدينة ربيعة إلى تجمع عسكري للقوات الأميركية والبشمركة لمنع قوات الحشد الشعبي من الاقتراب من هذه المنطقة من الناحية العراقية.
كما تم قطع الطريق أمام أية محاولة لعبور الأراضي السورية من جهة الحسكة، بعدما لاحت في الأفق تفاهمات بين الحشد وحزب العمال الكردستانيفي شنغال، ومحاولة الطرفين الحصول على حصة جغرافية من الحدود.
وإلى الجنوب؛ أحكمت الولايات المتحدة مع فصائل المعارضة السيطرة على منطقة التنف عند المثلث السوري/العراقي/الأردني، قاطعة المعبر الإستراتيجي بين سوريا والعراق أمام الطموحات الإيرانية.
لكن بين معبر ربيعة العراقي ومقابله السوري اليعربية في الشمال، وبين التنف في الجنوب؛ تمتد الحدود السورية مع العراق عبر محافظات الحسكة ودير الزور ثم حمص.
وباستثناء معبر القائم/البوكمال الخاضع لسيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية"؛ لا توجد معابر رئيسية في هذا الشريط الحدودي، ولذلك عمدت طهران ودمشق -في لعبة تبادل الأدوار- إلى محاولة فتح ثغرات في الجدار الحدودي:
هناك ثلاث نقاط حدودية يسعى الحشد الشعبي إلى اختراقها ضمن الشريط الممتد من غرب محافظة نينوى إلى القائم في محافظة الأنبار.
المشكلة في هذا الشريط لا تكمن في الجانب العراقي وإنما في سوريا، حيث ينقسم الشريط الحدودي بين محافظتيْ الحسكة ودير الزور، وفي الأولى تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفي الثانية يسيطر "تنظيم الدولة الإسلامية".
وليس معلوما إلى الآن كيف يمكن لقوات الحشد اختراق الحدود، فمن ناحية الحسكة سيتطلب الأمر تفاهما مع "قسد" بعيدا عن الولايات المتحدة، وهذا أمر بالغ الخطورة لكون "قسد" لا يمكنها تحمل العداء الأميركي، لذلك هددت بمواجهة أية محاولة من الحشد لعبور الأراضي السورية، وهي رسالة تلقفها الحشد فأعلن قبل أيام أنه لا ينوي دخول هذه الأراضي.
أما من ناحية محافظة دير الزور فإن طريق القائم/البوكمال مغلق بسبب الفيتو الأميركي، وقد حاول الحشد قبل أسبوعين اختراق هذا المعبر فتلقى ضربة عسكرية من الولايات المتحدة التي تضع نصب أعينها مدينة البوكمال كهدف مقبل.
ولن يبقى أمام الحشد سوى النقطة الثالثة والأخيرة في المنطقة المقابلة لمدينة الميادين السورية، لكن مثل هذه المحاولة لن تحدث إلا بعد إطلاق معركة دير الزور فعليا، فالحشد لن يخاطر بتحمل خسائر كبيرة في هذه المعركة حيث الثقل الحقيقي لتنظيم الدولة في سوريا.
من الجهة السورية؛ يسعى النظام إلى البحث عن خيار آخر غير التنف بعدما أصبح حاجزا لا يمكن اختراقه، وفي ظل صعوبة الوصول إلى دير الزور في هذه المرحلة، يعمل النظام على اختراق الحدود شمال غرب التنف بنحو 60 كلم (منطقة صحراوية قاحلة)، لكن هذا الأمر يتطلب بداية تثبيت صراع المحاور داخل سوريا، ويتطلب ثانيا موافقة أميركية لا تزال مجهولة التحقق إلى الآن.
ويبدو أن محاولات النظام السوري للوصول إلى الحدود من هذه المنطقة ستكون صعبة، بعد إعلان "جيش مغاوير الثورة" إقامة قاعدة عسكرية بدعم أميركي في منطقة الزكف الواقعة شمال التنف على الطريق نحو البوكمال.
لعبة المحاور
الصراع على الشرق معقد ومتشابك، فالأمر لا يقتصر على المناطق الحدودية فقط وإنما يتعداها إلى العمق الجغرافي السوري، فالمعارك في جنوبي الرقة وريف حلب الشرقي وجنوب وشرق حمص والقلمون الشرقي وصحراء السويداء، هي جزء لا يتجزأ من الصراع على الحدود.
اكتشف الأميركيون ومعه فصائل المعارضة أن تثبيت السيطرة على الحدود مع العراق يتطلب الوصول إلى محافظة دير الزور وتحديدا البوكمال أولا، ويتطلب ثانيا الدخول في عمق البادية غربا لتشكيل محمية جغرافية عسكرية، في حين وجد محور دمشق/طهران/موسكو أن مواجهة الولايات المتحدة والفصائل يتطلب تأمين العمق الجغرافي الداخلي قبيل الانتقال إلى الحدود.
وهكذا نشأت لعبة المحاور العسكرية لكلا الطرفين، لكن هذه اللعبة تبدو أكثر وضوحا وتماسكا لدى المحور السوري/الإيراني مما هي عليه الأمر لدى الولايات المتحدة وفصائل المعارضة.
نجح النظام في تحقيق إنجازات ميدانية نتيجة هدنة المناطق الأربع التي تبين أن الروس استعجلوا فيها للحاق بالأميركيين في الشرق، وليس من أجل تهيئة المناخ لتحقيق السلام السوري.
وعليه فقد تمكن النظام من تشكيل سد عسكري يمتد من ريف حمص الجنوبي والشرقي إلى بادية السويداء، على امتداد القلمون الشرقي. وقد سمح هذا السد الجغرافي لقوات النظام بالانتقال إلى مرحلة ثانية تشمل ثلاث مناطق جغرافية:
ـ المنطقة المحيطة ببلدة القريتين في القلمون الشرقي جنوبي محافظة حمص.
ـ المنطقة المحيطة بتدمر، حيث تمت السيطرة على قصر الحلابات والمناطق الممتدة نحو القريتين، وهذه المنطقة مهمة لأنها تؤمن الطريق نحو السخنة البلدة التي تشكل أهمية إستراتيجية كبيرة لكونها بوابة النظام للدخول إلى محافظة دير الزور.
ـ المنطقة الصحراوية في السويداء، إذ سيطرت قوات النظام على منطقة الزلف ورحبة ومنقار رحبة.
ويسعى النظام إلى وصل هذه المناطق الثلاث ببعضها البعض قبل الانتقال إلى معركة دير الزور، وذلك من أجل تحقيق هدفين: الأول تقطيع أوصال فصائل المعارضة وتشتيتها بحيث لا تستطيع الاتجاه نحو الغرب، والثاني محاصرة فصائل المعارضة في منطقة التنف لقطع الطريق على أية محاولة أميركية بتوسيع رقعة سيطرتها الجغرافية.
وإذا كانت مخططات النظام واضحة في ريف حمص الشرقي، فإنها غير معروفة عند المثلث الجغرافي السوري/العراقي/الأردني، فهل ستذهب دمشق وطهران نحو مواجهة مباشرة مع واشنطن لجرها إلى الانخراط في المستنقع السوري؟ أم ستكتفيان بحصار الأميركيين وفصائل المعارضة في هذه المنطقة؟ وإلى أين سينتهي المخطط الأميركي الذي لا يزال غمضا إلى الآن؟
من المبكر الإجابة على هذه الأسئلة، لكن الواضح حاليا هو عدم وجود نية أميركية لمواجهة النظام عسكريا على الأرض بشكل مباشر، والانتصارات العسكرية التي حققها النظام مؤخرا على حساب المعارضة في جنوب حمص وبادية السويداء والقلمون الشرقي توحي بذلك.
ففي حين تسعى الفصائل إلى ممارسة ضغط عسكري على النظام غرب البادية باتجاه القلمون الشرقي، تركز الولايات المتحدة على معركة الحدود فقط.
لكن واشنطن قد تسمح للفصائل بإقامة نقاط جغرافية آمنة تكون بمثابة حواجز تقف في وجه النظام وإيران إذا ما قررا التوجه نحو التنف، وهذا ما حدث في منطقة السبع بيار، وما حدث مع إسقاط الفصائل لمقاتلة سورية في منطقة تل دكوة بريف دمشق الشرقي.
صحيح أن التحالف الأميركي مع فصائل المعارضة في هذه المنطقة سيكون نسخة مكررة عن التحالف الأميركي مع "قوات سوريا الديمقراطية" في الشمال، من ناحية التركيز على محاربة تنظيم الدولة، لكن الفصائل هنا تتحرك في بيئة معادية لها، في حين كانت "قسد" تتحرك في بيئة مسالمة، ولم يكن أمامها سوى عدو واحد هو تنظيم الدولة.
ولذلك زودت واشنطن فصائل المعارضة بأسلحة متطورة منها مضادات طيران، لحماية نفسها من هجمات النظام والقوات التابعة لإيران، ولمنحها القدرة على التحرك ضمن مساحات واسعة في شمال البادية وشرقها وجنوبها.
وكذلك للقيام بعمليات عسكرية دفاعية ضد قوات النظام وحلفائه ضمن محورين رئيسيين: شمالي يمتد من التنف نحو البوكمال، ويمكن أن يتطور ويتجه نحو الغرب عند السخنة، وجنوبي يصل التنف ببادية السويداء ثم درعا عند الحدود الأردنية.
حافة الهاوية
التطورات العسكرية في الشرق السوري تشير إلى وجود تفاهم أميركي/روسي مضمر حول تقاسم النفوذ بين محوريْ البلدين، وهذا الأمر بدا جليا مع توقف قوات النظام عن التقدم نحو قاعدة التنف أولا، ومع التزام واشنطن الصمت تجاه القصف الروسي الذي استهدف "جيش أسود الشرقية" أثناء تقدمه نحو حاجز ظاظا ومنطقة سبع بيار في البادية ثانيا.
ويبدو من مسار العمليات العسكرية أن الحدود السورية/العراقية داخل محافظة حمص ستكون من نصيب الولايات المتحدة وفصائل المعارضة، ويمنع عليها التوغل نحو الغرب حيث مناطق النظام، على أن يبقى الجنوب في درعا والجنوب الشرقي في السويداء متروكا إلى حين.
وليس معروفا ما هو مصير القوات التابعة لإيران هناك؟ وهل الحضور الروسي المتزايد في الجنوب مقدمة لإطلاق معركة كبرى للضغط على الأميركيين لتحصيل مكاسب في الشرق؟ أم أنها خطوة للحلول محل الطرف الإيراني؟
أما محافظة دير الزور فتبدو أصعب من أن يسيطر عليها طرف بمفرده، وأغلب الظن أن المحورين سيتقاسمان عبء قتال "تنظيم الدولة" ويتقاسمان تركته الجغرافية، وأيضا من دون الحضور الإيراني. وقد كشفت الأيام السابقة الحضور الروسي في محيط تدمر على حساب القوات التابعة لإيران.
حتى الآن، لا يزال التحرك العسكري الأميركي والروسي مدروسا وخاضعا للضوابط الميدانية، لكن موسكو وواشنطن تسيران على حافة الهاوية في ظل رفض إيران معلن لأية محاولة تبعدها عن الحدود، وإذا ما قامت إيران بكسر الخطوط الحمر الأميركية، فإن مرحلة جديدة من الصراع ستبدأ، وقد تضع القوات الأميركية والروسية وجها لوجه.
 ١١ يونيو ٢٠١٧
١١ يونيو ٢٠١٧
كتبتُ قبل أيام عن ملامح معركة إيرانية – أميركية على الصحراء بين سورية والعراق. تساءلتُ هل يمكن أن يسمح الأميركيون للإيرانيين، الممثلين بجماعات شيعية تعمل تحت إشرافهم وتقاتل إلى جانب القوات النظامية السورية، بالوصول إلى الحدود مع العراق عند معبر التنف (المقابل لمعبر الوليد في الجانب العراقي). جاء جواب الأميركيين سريعاً. ضربوا رتلاً لحلفاء دمشق وقتلوا عدداً منهم ودمّروا آلياتهم بمجرد اقترابهم من التنف. لكن هؤلاء لم يرتدعوا. حاولوا التقدم مجدداً بعد أيام، فاستهدفتهم ضربة ثانية. وزيادة في التوضيح، ألقى الأميركيون منشورات من الجو فوق القوات النظامية وحلفائها تحدد لهم خطاً أحمر حول التنف لا يمكن الاقتراب منه. ليس واضحاً إذا كان هؤلاء قد فهموا الرسالة فعلاً، أم أنهم يريدون اختبار صبر الأميركيين وحدود ردهم. لم يعاودوا هذه المرة الاقتراب من التنف، بل شقوا طريقاً آخر شمالها ووصلوا إلى الحدود العراقية، قاطعين بذلك الطريق أمام جماعات سورية يسلحها الأميركيون للتقدم نحو البوكمال في دير الزور.
الناطق العسكري السوري الذي ظهر في التلفزيون الحكومي معلناً وصول قوات النظام إلى حدود العراق، كان صريحاً بحديثه عن «حلفاء» شاركوا في المعركة. وحتى في المشاهد المصوّرة التي عرضتها وزارة الدفاع السورية كان واضحاً أن القوات التي تقدمت شمال التنف تألفت على وجه الخصوص من هؤلاء «الحلفاء»، أي الجماعات التي تعمل بإشراف إيران. مروحياتهم وآلياتهم وعتادهم ولباسهم كله أوحى بذلك، على رغم رفعهم العلم السوري.
إعادة فتح طريق برية بين دمشق وبغداد بدت بمثابة هدف إيراني ثانٍ في مرمى الأميركيين. بالطبع، الهدف الأول سجّله «الحشد الشعبي» بوصوله إلى حدود العراق مع سورية (بين نينوى والحسكة). وكي لا يكون هناك لبس في حقيقة أن إيران هي من سجّل هذا الهدف، سارع قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني إلى تفقّد «الحشد» عند الحدود السورية.
ولكن لماذا يسمح الأميركيون للإيرانيين بتسجيل هذه الأهداف في مرماهم؟ هل هم عاجزون عن الرد؟ بالطبع لا. الأميركيون بلا شك قادرون على الرد، وهم يستعدون لذلك، على رغم انشغالهم بالمعركة ضد «داعش» التي يعطونها الأولوية. ويعرف الإيرانيون على الأرجح هذه الحقيقة، ولذلك فإنهم يسعون إلى تثبيت مواقعهم والاستفادة من عدم رغبة الأميركيين في مواجهة معهم خشية أن تؤثر سلباً في المعركة ضد «داعش». لكن عدم حصول المواجهة الأميركية– الإيرانية حتى الآن لا يعني أنها لن تحصل. فالمؤشرات كلها توحي بأنها آتية لا محالة، وقد تحصل في أكثر من ساحة.
إيران نفسها قد تكون إحدى هذه الساحات. وفي لجوء إدارة ترامب إلى مايكل داندريا المعروف بـ «آية الله مايك» وتسليمه ملف إيران في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آيه)، أكثر من رسالة لطهران. ومايك هذا اسم معروف في عالم الاستخبارات منذ إشرافه على حملة طائرات «الدرون» التي قصمت ظهر «القاعدة» وقضت على قياداتها على الحدود الباكستانية– الأفغانية.
العراق أيضاً سيكون على الأرجح ساحة أخرى من ساحات المواجهة الأميركية– العراقية. لكن مهمة الأميركيين هنا لن تكون سهلة. فقد ثبّت الإيرانيون أقدامهم في العراق منذ أن «أهدتهم» إياه واشنطن عقب إطاحة صدام حسين عام 2003. وعلى رغم أن هناك شرائح عراقية واسعة تعارض النفوذ الإيراني، إلا أن طهران تملك الورقة الأقوى عسكرياً من خلال فصائل «الحشد الشعبي». ولا يريد الأميركيون، كما يبدو، مواجهة مع «الحشد» حالياً خشية عرقلة الحرب ضد «داعش».
وسورية بدورها ستكون ساحة أخرى من ساحات المواجهة. لكن الحرب ضد «داعش» ليست فقط ما يؤخر اندلاعها. فالدور الروسي في دعم حكومة دمشق لا يجب إغفاله بالطبع، وإن كان الأميركيون يتمنون على الأرجح أن يؤدي النفوذ الروسي في نهاية المطاف إلى تقليص نفوذ إيران، وإن كان ذلك لا يبدو واقعياً في ظل الوضع الراهن.
أما لبنان فسيكون بدوره ساحة مواجهة تلوح منذ شهور، وستستهدف تحديداً «حزب الله». لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عقدت بالأمس جلسة ناقشت فيها «خيارات» المعركة ضد هذا الحزب واستمعت إلى خبراء ومسؤولين سابقين اتهموا إدارة باراك أوباما بأنها - نتيجة توقها إلى اتفاق نووي مع الإيرانيين - «حلّت» أو «غيّرت مسار» أو «جمّدت» تحقيقات ومحاكمات مرتبطة بـ «إرهاب حزب الله».
إذاً، ملامح المعركة الأميركية – الإيرانية توحي بأنها حاصلة لا محالة.
 ١١ يونيو ٢٠١٧
١١ يونيو ٢٠١٧
التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان اليوم يتصل معظمها بانعكاسات الحرب السورية، وإن كان لبنان يعاني من تشققات بنيوية سابقة للحرب السورية.
رغم التقدم المحرز المتصل بانتخاب رئيس للجمهورية بعد 30 شهراً من الفراغ، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة، وملء عدد من المناصب الأمنية والإدارية، فإن تعثر ولادة قانون جديد للانتخاب وتفاوت الرأي والتقدير حول موعد الانتخابات المقبلة يبرزان هشاشة الائتلاف الحاكم اليوم وعدم امتلاك أطرافه رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الانتخابات. والسؤال المهم الذي يطرح اليوم في لبنان: هل فقد حزب الله قدرته على الترجيح أو الحسم بين هؤلاء الأطراف، على غرار ما يضطلع به منذ مايو (أيار) 2008، وعلى غرار ما قام به أخيراً عند ترجيح اختيار العماد ميشال عون للرئاسة، أو عند وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة الرئيس سعد الحريري؟ أم أن الحزب ينتظر التوقيت الملائم؟ أم هو غير متحمس لإجراء الانتخابات قبل اتضاح الوضع الإقليمي الحرج والمتحرك؟ هذا ما سنتبينه، على الأقل جزئياً، خلال الأسابيع القليلة الفاصلة عن 20 يونيو (حزيران)، موعد انتهاء الولاية الممددة للمجلس الحالي المنتخب عام 2009. وتبعاً للسيناريو الذي سترسو عليه عملية تأجيل الانتخابات، سيتضح حجم الضرر اللاحق بمصداقية المؤسسات والسلطات.
القلق من المجهول وعدم اليقين في لبنان لم يعد يقتصر على المستوى المؤسسي والسياسي، بل بات يطاول أخيراً المستوى الأمني الذي كان مسلماً به ضمن الستاتيكو القائم منذ اندلاع الأزمة السورية أنه خط أحمر. فالمتغيرات المتسارعة في المنطقة منذ انتخاب دونالد ترمب تشي بتوجه أميركي جدي نحو تحجيم طموحات إيران الإقليمية، وهي تطرح بالتالي من جديد مسألة حزب الله ودوره الخارجي. وإن كانت احتمالات التصعيد تنحصر حتى الآن في المسرح السوري، فإن دخول العامل الإسرائيلي على الخط، سواء من بوابة منع الحزب من الحصول على أسلحة كاسرة للتوازن، أو منع إيران من إقامة منطقة نفوذ جديدة محاذية للجولان، أو منع قيام خط إمداد بري متواصل بين إيران وحزب الله في لبنان، يدعو إلى القلق من انفلات أي مواجهة بين إسرائيل وحزب الله في سوريا وتمددها إلى لبنان، وذلك رغم توازن الرعب القائم حالياً بين الطرفين. إن أي حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله على غرار 2006 ستكون لها نتائج كارثية على لبنان.
الترجمة الميدانية للتوجه الأميركي الجديد حيال إيران وحزب الله لم تتضح بعد، لكن ثمة توجه جدي لفرض رزمة جديدة من العقوبات على إيران وحزب الله، من بوابة مكافحة الإرهاب بعدما تم استبعاد خيار تمزيق الاتفاق النووي. وما تسرب من معلومات حول مشروع العقوبات الجديد يشير إلى احتمال توسيعها إلى كل من يتعامل مع الحزب ولتطال ربما مسؤولين في الدولة اللبنانية. وبمعزل عمّن ستطاله العقوبات الأميركية المنتظرة، فإن مجرد إقرارها أو حتى الاستمرار بالتلويح بها يشكلان عبئاً إضافياً على الوضع الاقتصادي الهش أصلاً الذي تعرض في السنوات الماضية لسلسلة ضربات لم يتعافَ منها بعد. فاندلاع الحرب في سوريا، ثم انخراط حزب الله فيها، كانا كفيلين بنقل نحو 8 في المائة من سكان سوريا إلى لبنان، حيث باتوا يشكلون 25 في المائة من إجمالي السكان.
تزامناً مع عبء النزوح السوري، بدأ لبنان يعاني تدريجياً نوعاً من العزلة الاقتصادية ذات أوجه عدة؛ أهمها انقطاع خطوط التصدير البرية، وامتناع السياح الخليجيين عن زيارة لبنان، وانخفاض التدفقات المالية التي تشكل تقليدياً رئة التمويل الخارجية للبنان. وقد انخفضت لسببين: تراجع عائدات النفط، ورداً على تزايد استخدام إيران وحزب الله للبنان منصة إعلامية وسياسية ضد السعودية ودول الخليج.
ؤؤ
قبل أعباء الحرب السورية، لم يكن لبنان «جنة» اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. وفي طليعة التشققات التي كان يعانيها وما زال، الانقسام الحاد حول المنظومة العسكرية التي يحتفظ بها «حزب الله» خارج الدولة التي باتت أهم ذراع خارجية للاستراتيجية الإيرانية، والتي يعود الاعتراض عليها داخلياً إلى ما قبل اندلاع الحرب السورية.
كذلك، هناك الفساد الذي يحتمي بنظام «المحاصصة» بين زعماء الطوائف بذريعة حماية المصالح الاستراتيجية لطوائفهم، في حين أنها حقيقةً التجسيد المحلي لنظام الدولة الغنائمية القائم على السطو على المال العام والحيز العام واستغلاله وتوزيعه على قاعدة الزبائنية السياسية أو المحسوبية. ويعتبر الفساد العائق الرئيسي أمام التنافسية والاستفادة من الحيوية الكبيرة للقطاع الخاص اللبناني المتميّز بروح المبادرة وثقافة ريادة الأعمال. وثمة من يقدر حجم «الاقتصاد الأسود»، الذي يشتمل على التهريب والتهرب الضريبي والرشوة والإثراء غير المشروع، بخمسة مليارات دولار، أي ما يعادل ثلث الموازنة العامة للدولة أو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ضمن هذا المناخ، اندلعت الحرب السورية ومعها أزمة اللجوء. ارتفع عدد إجمالي المقيمين في غضون سنتين 30 في المائة، وهي نسبة غير مسبوقة في التاريخ الديموغرافي الحديث لأي دولة. ولتبين فداحة الوضع، يكفي النظر إلى انخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي دراماتيكياً من 9400 إلى 7900 دولار، أي بنسبة 14 في المائة. فضلاً عن ذلك، فإن الضغط على المجتمعات المضيفة للاجئين وعلى البنى التحتية بات غير محمول، خصوصاً الطرقات والصرف الصحي والكهرباء. صحيح أن أزمة الكهرباء هي في الأساس أزمة فساد وسوء إدارة، لكن الطلب تزايد بقوة بسبب النزوح. كذلك، فإن البطالة بين اللبنانيين ارتفعت من 9 في المائة إلى 20 في المائة، والعمالة غير النظامية بينهم باتت تناهز 30 في المائة، فيما هي تفوق الـ50 في المائة بين السوريين. نسبة الفقر بين اللبنانيين ارتفعت من 27 في المائة إلى 35 في المائة، وهي تصل بين اللاجئين السوريين إلى 75 في المائة. باختصار، الخسائر المتراكمة للبنان على مدى 6 سنوات من جراء الأزمة بلغت 25 مليار دولار.
الجميع، دولاً ومنظمات، «معجب» بصمود لبنان وسخاء اللبنانيين، لكن قدرة لبنان على الصمود تتآكل كل يوم. والوصفة التقليدية المطروحة أمامه، أي الاكتفاء باستيعاب اللاجئين ودمجهم في سوق العمل، تنم إما عن جهل فادح أو عن تقصير. لا يمكن لأي اقتصاد من 4 ملايين نسمة أن يهضم 1.5 مليون نسمة إضافية، وأن يُطلب منه خلق نصف مليون فرصة عمل إضافية، لا في خلال 5 سنوات ولا في خلال 20 سنة. إن أي خبير اقتصادي عاقل يدرك هذا الأمر، هذا إذا وضعنا جانباً التوترات والمزايدات العنصرية الخطيرة التي تثيرها قضية النازحين. إن الاستيعاب عبر سوق العمل فحسب، وهو ما يُطلب من لبنان، ليس حلاً لأزمة النازحين. الحل المتكامل، الواقعي والعادل والمستدام، يجب أن يقوم على رؤية تعطي أولوية متكافئة لثلاث ركائز:
1 - العودة الآمنة للاجئين، أي المحصنة أمنياً واقتصادياً، إلى مناطق تحظى بالحماية الدولية داخل سوريا.
2 - الاستيعاب المؤقت لجزء من العمالة السورية التي لا تشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية. وهذا أمر مفيد للجانبين ويتطلب تنظيماً أكثر فاعلية لسوق العمل، ولا طائل من التحريض والهذيان الشعبوي في هذا المجال.
3 - مشاركة المجتمع الدولي بشكل فعلي في تحمل الأعباء، ليس مالياً فحسب، إنما أيضاً باستيعاب عدد أكبر من السوريين الذين يرغبون في الانتقال إلى بلد ثالث. صحيح أن هناك تقصيراً فادحاً من المجتمع الدولي حيال لبنان والدول المضيفة، لكن المسؤولية الأولى تقع على السلطات اللبنانية التي لم تستقر حتى الآن على سياسة متكاملة وفاعلة لإدارة أزمة النازحين.
الخلاصة العامة:
1 - إن عودة لبنان إلى شيء من الاستقرار يمر بحتمية الحل السياسي في سوريا، الذي يتضمن فيما يعني لبنان ثلاث أولويات: محاصرة الإرهاب، وانسحاب حزب الله من سوريا، وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
2 - إن عودة الأمور إلى نصابها في لبنان تتطلب، فضلاً عن تثبيت القرار 1701، تخلي حزب الله عن دوره الإقليمي وعن دوره الأمني داخل لبنان وتحوله إلى حزب سياسي. هذا معبر إلزامي لتحييد لبنان ولتطبيع الأوضاع فيه.
3 - في لبنان أزمة سلطة وليست أزمة نظام أو دستور أو ميثاق. الصيغة اللبنانية التي تجمع بين المساواة في المواطنة وحماية التعددية الدينية قابلة للتطبيق والتطوير إذا تم تحييد لبنان ونزع عناصر التأزيم الإقليمي، وتم الالتزام باتفاق الطائف، واعتماد قانون انتخاب ديمقراطي واحترام دورية الانتخاب وتداول السلطة.
4 - لبنان ليس بلداً فقيراً، والاقتصاد اللبناني قابل للحياة وهو يملك ميزات تفاضلية قوية وثروة بشرية استثنائية. المعبر الإلزامي إلى ذلك حياة سياسية نظيفة ومصالح اقتصادية مشروعة وفك الارتباط غير المشروع بين السياسة والأعمال والكف عن اعتبار المال العام غنيمة والدولة بقرة حلوب.
 ١٠ يونيو ٢٠١٧
١٠ يونيو ٢٠١٧
نشرت "مجموعة العمل الوطني الديمقراطي" نص رسالتها إلى رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لمطالبتها بإجراء إصلاح طال انتظاره، ولعب غيابه دورا خطيرا في تراجع الثورة، وإصابة السوريين باليأس من انتصار من ضحوا بمليون شهيدة وشهيد من أجله. وقابل عديديون الرسالة التي أثارت اهتماما واسعا بتعليقٍ ينم عن فقدان الأمل بإصلاح "الائتلاف" الذي يعتبرونه جسما ميتا، تحكمه داخليا بنيته الذاتية الغريبة عن الثورة، وخارجيا تبعيته لدول إقليمية وعربية، تحول بينه وبين ممارسة وظائفه كياناً سورياً مستقل الإرادة، ومن دون تزويده بالوسائل وبآليات الاشتغال الضرورية لتحريره من وضعه المتهالك، ولمنحه الاستقلالية الضرورية عن "رعاته" التي تمكّنه من التفرغ لخدمة ثورة السوريين الوطنية، ولمراعاة خصوصيتها، باعتبارها قضيةً يتولى إدارتها باسم الشعب السوري ونيابة عنه، لا بد أن تذهب دون ذلك، من فشل إلى آخر، وتحتجز، وتعجزعن تحقيق ما طالبت به الثورة: الحرية والعدالة والمساواة، والنظام الديمقراطي البديل للطغيان الأسدي.
أما القول إن "الائتلاف" جسم ميت، فهو مبالغ فيه ويطرح مسألة البديل، وهل يمكن تأسيسه في ظل ما وصل إليه المجتمع السوري من تدمير المجتمع وتمزيقه، وتعانيه تنظيماته السياسية والعسكرية من تشتت وتناقض، وتعيشه نخبه من ضمور وتدنٍّ في وعيها، وتهافتٍ في واقعها، وتخضع له المناطق المتبقية خارج سيطرة النظام من تعسّف تمارسه مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) وتنظيم داعش وجبهة النصرة وبعض حملة السلاح الآخرين، وتواجهه من كوارث تحت وطأة حل النظام وروسيا وإيران العسكري، فضلا عن خضوع "الفصائل المعتدلة" لإرادات غير سورية... إلخ.
تطرح هذه الأوضاع السؤال التالي: ماذا يكسب السوريون إن مات "الائتلاف" حقا، وفقدوا بموته اعتراف أغلبية دول العالم بحقهم في تمثيل سياسي بديل للأسدية؟. وهل موت "الائتلاف" رد يخرجه من ضعفه وعجزه، علما بأن أحدا لا يضمن قيام بديل له أفضل منه، ناهيك عن اعتراف العالم به؟. أليس من الأفضل العمل لإصلاح "الائتلاف"، ليؤدي وظائفه ممثلاً وقائداً ثورياً للسوريين؟. بصراحة: على الرغم من الوضع السيىء الراهن، يبقى "الائتلاف" ملكا لشعب سورية: صاحب المصلحة الحيوية جدا في إصلاحه وتفعيله، والاشتراك في خياراته وقراراته، والتفاعل الإيجابي الشامل مع ممثليه الذين يجب أن ينالوا اعترافه، ويجدّده عبر رفده بدماء تنتمي، قولا وفعلا، إلى ثورته، يمكّنه حضورها فيه من لعب دوره القيادي الثوري، وتوحيد جناحي الثورة السياسي والعسكري على أسس برامجية وخطط تنفيذية، تضمن انتصار حق السوريين على باطل النظام ورعاته.
هل هذا ممكن؟ أعتقد أن تحقيقه احتمال ضعيف، لكنه لن يكون مستحيلا في حال نظمت قوى الحراك والثورة المجتمعية الحية حملة وطنية جدية ومستمرة، للمطالبة بإصلاح "الائتلاف"، يبادر السوريون إلى إطلاقها منذ الغد، على أن تدعم تياره الإصلاحي، وتمكنه من الاستناد إلى إرادة شعبية، وجودها والتعبير عنها أحد حواضن نجاحه الذي يجب أن يركز على إعادة هيكلة بنيته، بحيث تخدم الثورة من دون أي طرف داخلي أو جهة خارجية، وتعيد إحياء الوطنية السورية الجامعة، غير الحزبية أو الفئوية، وتجدّد ثورة الحرية، وتتعامل بندية مع "الآخرين"، ركيزتها شراكة المصالح، والتزامهم بأهداف الثورة وضرورة بلوغها، وتبنيهم استراتيجية تنفذ أعمالا مشتركة، وتبلور أدوات تحقيقها، وتوسع باضطراد هوامش فاعليتها.
لا شيء يضمن أن يحسن التخلي عن "الائتلاف" أو موته العمل الوطني. وفي المقابل، سيبقى عاجزا عن تأدية وظائفه، إن حافظ على بنيته وسياساته وممارساته الراهنة. كما لن تستقيم أمور الثورة، إن اقتصر دور السوريين فيها على شتم "الائتلاف" ومن فيه، وأحجموا عن لعب الدور الحيوي الذي يلزمهم بإخراجه من عجزه الحالي، وتحويله إلى مؤسسةٍ تحظى بدعم شعبها وولائه. لضمان النجاح، لا بد من تشكيل "هيئة إصلاح وطني"، تكون شبابية بصورة أساسية، تتابع بصورة منظمة ويومية شؤونه، وتتواصل مع قياداته حول كل أمر وشأن، لتتكامل نشاطاتها الموازية مع أنشطته، ويصير مؤسسة تخدم الشعب وثورته، تمكنها صفوفها الموحدة من إسقاط الأسد ونظامه، وتأسيس بديله الوطني الديمقراطي، وحقن دماء السوريين، فإن فشل مسعاها وبقي "الائتلاف" على حاله، غدت بديله الإنقاذي الذي ينتظره الشعب، وتمس حاجته إليه.
أخيرا، لا بد أن يبادر إصلاحيو "الائتلاف" إلى بذل جهود يومية حثيثة لإخراجه من حالٍ يجعل وظيفته اليوم التخلي عن الثورة، ومنع غيره من خدمتها.