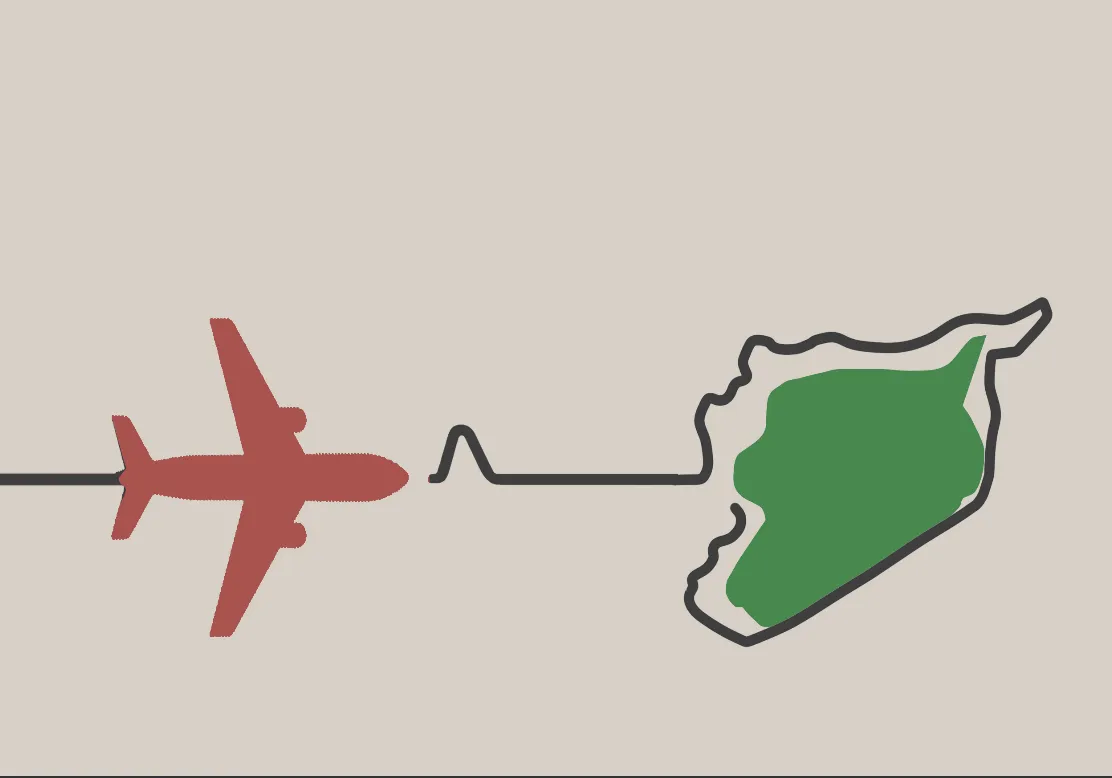٢٣ ديسمبر ٢٠١٤
٢٣ ديسمبر ٢٠١٤
لا أعرف لماذا تهوى ذاكرتي العودة إلى البدايات. بداية الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، واستحضار أحداث لم أعطها أهميتها وقتها، وإذ بي أجدها تداهمني، وتفرض نفسها علي، وتأمرني أن أكشف النقاب عنها، ولأني أؤمن أن النهايات تحددها البدايات، فقد طاوعت ضميري، لأكتب عن تلك الحوادث التي تبدو مُضحكة وأشبه بالنكتة، لكنها ذات دلالات خطيرة.
منذ بداية الثورة السورية، وكنت لا أزال موظفة (طبيبة عيون) في المشفى الوطني في اللاذقية، وكنا كالعادة، أطباء وممرضات، نخربش توقيعنا الصباحي على دفتر الدوام، ومعظمنا كان يفرّ من المشفى، بعد التوقيع، ويذهب إلى عيادته الخاصة. في تلك الفترة، أي في شهر مارس/آذار من عام 2011، تم توزيع عدة أوراق إلى كل العاملين في المشفى الوطني، أوراق أعطوها لكل موظف، بعد أن خربش توقيعه على دفتر الدوام تشرح لنا خطة الأمير بندر بن سلطان لتدمير سورية! وتحكي بالتفصيل الدقيق مراحل تلك الخطة، وتصاعد العنف والإجرام فيها، واكتشفتُ لاحقاً أن كل مؤسسات الدولة وزعت تلك الأوراق (عن مؤامرة بندر بن سلطان) على العاملين لديها! يومها، قرأت تلك الأوراق بذهول، وتساءلت طالما أن الخطة، أو المؤامرة، مكشوفة إلى هذه الدرجة، فلماذا لا تُتخذ إجراءات لإحباطها؟ والعجيب أن كثيرين من الموظفين صدقوا تلك الخطة، كما لو أن بندر بن سلطان لاعب شطرنج، يحرك الأوضاع في سورية كما يشاء.
في تلك الفترة، غصّت الشوارع في اللاذقية بلافتات من نوع (الجزيرة، والعربية، والفرانس 24) قنوات سفك الدم السوري، ولافتات أخرى، أعترف، بكل خجل، بأنني لا أملك الشجاعة لذكرها. وبعد أيام، فوجئت بمسرحية من الطراز الرفيع، إذ أحضر مسؤولون في المشفى الوطني في اللاذقية كُوَماً من حبوب دوائية، كوّموها مثل هضبة في ساحة المشفى، وقالوا إنها حبوب هلوسة، أرسلتها قناة الجزيرة إلى اللاذقية. ووسط مشهد لا يمكن أن أنساه، تحلق معظم العاملين، من أطباء وممرضات في المشفى الوطني في ساحته، وتفرجوا مذهولين على هضبة حبوب الهلوسة، كيف صبّ عليها المسؤولون البنزين وأحرقوها. كنت أتمنى لو أحصل على حفنة من تلك الحبوب، لأعرف إن كانت سكاكر أم طباشير. وانطلت المحرقة على كثيرين صدقوا أن هضبة الحبوب البيضاء الصغيرة هي حبوب هلوسة، أرسلتها قناة الجزيرة للشعب السوري، تماماً، كحبوب الهلوسة التي تحدّث عنها القذافي. ولمّا سألت زملاء، كيف تأكدوا أن قناة الجزيرة هي من أرسلت حبوب الهلوسة، قالوا إن العنوان كان مكتوباً على الأكياس العملاقة التي تضم حبوب الهلوسة!!
لا أعرف سيناريو أتعس وأفشل من هكذا سيناريو، فلو أرادت جهة ما إرسال سمومٍ، أو حبوب هلوسة، إلى جهة عدوٍّ، هل تكتب عنوانها صراحة؟ المحرقة التي تمت في ساحة المشفى الوطني في اللاذقية تمثيلية مفضوحة إلى حد كبير، لكن أناساً بسطاء مُروعين، طوال عقود من الذل والخوف والذعر، يجدون مبرراً ليصدقوا، ليُخرسوا صوت العقل والمنطق، ويصدقوا أن قناة الجزيرة أرسلت حبوب هلوسة للشعب السوري. لست بصدد الدفاع عن قناة الجزيرة، هنا. لكن، ما يعنيني هو ذلك الاستخفاف والاحتقار للشعب السوري، تلك التمثيليات المفضوحة والمُقززة التي تُقدم له حقائق لا يجرؤ أحد أن يشك بها.
" أعظم مخرجي العالم الموهوبين عاجزون عن ابتكار مسرحية إحراق حبوب الهلوسة التي أرسلتها قناة الجزيرة إلى المشفى الوطني، وقد كتبت عنوانها صريحاً على الأكياس؟ "
جدران المشفى الوطني منذ بداية الثورة عليها لافتة أبدية: خلصت، خلصت، خلصت، مكتوبة بخط كبير ثم متوسط وصغير، والمقصود خلصت المؤامرة على سورية، ولا يجرؤ أحد من العاملين في المشفى أن يقول لهم إن المؤامرة ما خلصت. الخوف يلصق الشفاه بصمغ الخوف والذعر، وحتى حين أصبح المشفى الوطني في اللاذقية يغصّ بالنازحين، من حلب وريف إدلب، لم يجرؤ أحد أن يسأل المنكوبين عن ظروف نزوحهم؟ وكيف تدمرت بيوتهم؟ ومن دمرها؟ الخوف سيد الموقف. الخوف الذي تخمّر في النفوس طوال عقود وعقود. لا أنسى منظر جندي سوري أسعفوه إلى المشفى الوطني، بحالة خطيرة، وكسورٌ عديدة في كل أنحاء جسمه. كان في الثالثة والثلاثين من عمره، ودخلت أمّه في حالة ذهول وهذيان، وهي تردد: في سبيل من عُطب إبني؟
يا لروعة الفعل المبني للمجهول. يومها تمنيت الموت الرحيم لرجل ستكون إعاقته، إن بقي على قيد الحياة، جحيماً لأسرته. يمكنني ذكر مئات القصص المُشابهة من خلال عملي في المشفى الوطني في اللاذقية، ومن خلال إطلاعي الدقيق على قصص وحالات مُروعة، كم من شاب مات في المُعتقل بالسكتة القلبية، كما يقولون للأهل، ولم تُسلم جثثهم لأهلهم، بل بالكاد يعطونهم تقريراً بالوفاة. شباب سورية يتحولون أوراقاً، إما ورقة نعي: الشهيد البطل، أو ورقة بشهادة وفاة إن مات الشاب في المعتقل.
إلى متى سيُعامل الشعب السوري باحتقار واستخفاف وعدم احترام؟ إلى متى سوف تستمر المسرحيات الهزلية تُقدم له حقائق؟ أعظم مخرجي العالم الموهوبين عاجزون عن ابتكار مسرحية إحراق حبوب الهلوسة التي أرسلتها قناة الجزيرة إلى المشفى الوطني، وقد كتبت عنوانها صريحاً على الأكياس؟ وبعد أربع سنوات من الجحيم السوري، حيث نزح أكثر من ثلث الشعب، ويعاني أكثر من 80% من السوريين من الفقر، وبعد الانهيار الاقتصادي وموت مئات الألوف، بعد كل تلك المعطيات، أين هي خطة الأمير بندر بن سلطان التي وزعها المسؤولون في سورية على عامة الشعب؟ لماذا لم تتخذ الإجراءات لمقاومتها؟ من يصدقها الآن؟ ألم يحن الأوان ليحترم النظام والمعارضة ودول العالم كلها الكبرى في الإجرام، ومنظمات حقوق الإنسان الشكلية الوهمية، والفضائيات ببرامجها الندابة النواحة على سورية والشعب السوري، ألم يحن لكل تلك الجهات أن تحترم الشعب السوري، وحقه في حياة حرة كريمة بلا نفاق وتمثيليات وحبوب هلوسة، وعبارات خلصت، خلصت، خلصت، وتوزيع أوراق المؤامرة للأمير بندر بن سلطان. إلى متى سيُعامل السوريون كبهاليل؟
قد تكون ذاكرتي مشوشة من هول ما أشهد وأتألم، كأحبائي السوريين. لكن تلك الأحداث أعتقد أنها بالغة الأهمية، لتعطي صورة كيف يُعامل الشعب السوري، وبأي ضلال واحتقار يتعامل معه المسؤولون والعالم بأسره. إنها ثورة كرامة حقاً، وثورة حرية بلا أدنى شك.
 ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
تدفع الكارثة السورية العميقة مزيدا من السوريين للبحث على حلول فردية لخلاصهم من موت، يكاد يكون محققا في الداخل سواء كان ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام أو تلك الخارجة عن سيطرته، لأن النظام لا يقتل علنا أو بالصدفة فقط في المناطق التي يسيطر عليها، إنما يقتل تحت التعذيب في المعتقلات والسجون، وكل من تحت سيطرته معرض للموت في أي لحظة، والأمر في هذا ممتد حتى في المناطق الخارجة عن سيطرته، والتي تتعرض يوميا، لهجمات قوات النظام البرية والجوية بما في ذلك القصف بالمدفعية والدبابات أو بالبراميل المتفجرة وصولا إلى الضرب بالغازات السامة وغيرها على نحو ما حدث في الغوطة وعشرات الأماكن السورية الأخرى.
غير أن قتل السوريين، لم يعد يقتصر على قوات النظام وأدواته المحلية، والتي تم جلبها للحرب المدمرة إلى جانبه مثل حزب الله والميليشيات العراقية، بل يمتد إلى تشكيلات مسلحة، تسيطر وتوجد في المناطق خارج سيطرة النظام. وإن كان تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» هما الأبرز والأخطر بين هذه التشكيلات، فإن أغلب التشكيلات الأخرى، ليست خارج القائمة، لأن شيوع السلاح وعدم انضباطه، والتناقضات الآيديولوجية والسياسية والتنظيمية بين التشكيلات، تفتح كلها الباب على استخدام السلاح بين الجميع، لا سيما في ظل عمليات إغلاق باب العمل السياسي، والنشاط الشعبي الحر، وعمل منظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة، التي ترصد وتراقب وتنتقد تردي الأوضاع في جوانبها المختلفة، وثمة جانب آخر، لا بد من التوقف عنده في موضوع قتل السوريين، وهو نشاط جماعات وعصابات إجرامية، تقوم بعمليات الخطف والقتل لتحقيق أهداف محدودة.
وسط هذه اللوحة المأساوية لما يحيط بالسوريين، يبدو أن من الطبيعي، سعي الكثيرين للبحث عن مصير آمن، عبر الخروج من البلاد سعيا وراء أمن شخصي وبحثا عن خلاص فردي، وهذا التوجه لا يقتصر على المعارضين، إنما موجود في صفوف المؤيدين والصامتين، وهذا ما يفسر عمليات الخروج الواسعة من سوريا إلى بلدان الجوار والأبعد منها، وفي مستقراتهم يسعى كثير منهم للحصول على فيز بقصد اللجوء أو الإقامة في بلدان، تمتد من أستراليا إلى الولايات المتحدة مرورا بأوروبا الغربية وغيرها.
ورغم أن قابلية الدول لإعطاء اللجوء للسوريين، تبدو محدودة جدا مقارنة بما هو عليه عدد السوريين الراغبين في الهجرة أو حتى الإقامة في تلك البلدان، فإن مسار اللجوء الطبيعي إلى هذه البلدان شديد الصعوبة بفعل الضوابط والشروط، التي تضعها تلك البلدان والمدد الزمنية اللازمة لإتمام هذه العمليات، سواء كانت مباشرة عبر سفارات تلك البلدان أو من خلال الأمم المتحدة، التي تنظم عمليات لجوء لمن يطلبها وتوافق عليه.
وبخلاف الطريق الآمن لعمليات اللجوء، التي يسعى إليها السوريون، فإن مسارات أخرى للجوء، تجري في الواقع تحت مسمى الهجرة غير المشروعة، التي تتم من خلال عصابات منظمة ومافيات الاتجار بالأشخاص، وفيها يتم تهريب الأشخاص والعائلات عبر البحار أو الحدود البرية وعبر المطارات، وكلها طرق محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الموت غرقا، وحسب الأرقام فإن عشرات آلاف السوريين ماتوا في رحلات بحرية في الطريق من بلدان شمال أفريقيا وتركيا إلى البلدان الأوروبية، ورغم أنه ليست هناك أرقام لعدد من قتلوا أو سجنوا أو انتهكت كراماتهم وإنسانيتهم في مسارات الهجرة غير الشرعية، فإن أعدادهم وفق التقديرات كبيرة جدا، والذين نجحوا في مساعيهم قليلون جدا.
وبغض النظر عن مسارات اللجوء، شرعية كانت أو غير شرعية، فإن الواصلين إلى بلدان الملجأ، يوضعون في ظروف صعبة في أغلب البلدان التي وصلوا إليها، وأغلبهم يحتاج إلى نحو عام للتحول إلى الإقامة العادية، ثم يمضي عاما آخر أو أكثر، إذا رغب في استكمال مجيء عائلته وأولاده، إن استطاع توفير مثل هذه الفرصة.
خلاصة القول، أنه إذا كان لجوء السوريين، هربا من موت ودمار محقق بسبب سياسات نظام الأسد وتشكيلات مسلحة متطرفة تشبهه أو تماثله، فإن الطريق إلى اللجوء ليس محدودا ومحاطا بالشروط الصعبة وبالوقت الطويل والمعاناة فقط، بل إن معاناته في بلدان الملجأ صعبة، وتحتاج إلى زمن طويل، قد يدمر بعضا من الروح، التي حملها اللاجئ السوري الخارج من بلده، والوضع في هذه الحالة، إنما يطرح على المنظمات والبلدان الراغبة في مساعدة السوريين على تجاوز كارثتهم، وتأمين ملجأ آمن وسهل لهم سواء كان مؤقتا أو دائما، وأن تعيد النظر في سياساتها وممارساتها وطبيعة تعاملها مع الحاجة السورية، التي هي حاجة إنسانية ليس إلا.
 ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
اسوأ ما يمكن ان نفعله هو ان نرد على داعش بمنطق داعش، او ان نظل نفكر في «الصندوق» الذي وضعتنا فيه ، نحن عندئذ لن نقع في محظور تسويقها فقط وانما سنخضع لشروطها ونغرق في تفاصيل الخلاف معها ، ونعتبرها قضيتنا الاولى ، وهي بالتأكيد ليست كذلك.
داعش ليست أكثر من «بالون» تعمد البعض النفخ فيه حتى تحول إلى غول كبير ، وجرى استثماره بشكل مدروس فتصورنا انه وحده من يقرر مستقبلنا ، فيما اصبحت قضية التطرف موضوعا اساسيا لنقاشاتنا الخاصة والعامة، لدرجة ان استحضار داعش والتهديد بها تجاوز الدول الى الافراد، وكأننا فرغنا من كل مشكلاتنا ولم يبق يزعجنا سوى هذا الوباء الجديد.
فكرة داعش ولدت في الاصل ميتة ، لانها اعتمدت الموت كخيار ، وبالتالي فهي تتناقض مع فكرة الحياة، ومن المتوقع ان تتلاشى تدريجيا او تأكل نفسها بنفسها، والمقاتلون في التنظيم بعضهم خرج من السجون وبعضهم جذبته غرائز القسوة والرغبة في النكاية والانتقام، لكنهم سرعان ما اكتشفوا ان الهدف الذي اجتمعوا عليه مجرد وهم ، وان السجون التي خرجوا منها - على اختلافها - كانت افضل واكبر من السجن الجديد الذي ذهبوا اليه باقدامهم او ارغموا على الدخول اليه.
داعش مجرد اسم حركي لافكار عدمية وجدت من بعض المجموعات التي وحدتها « محنة» الاحساس بالظلم عنوانا يتحركون من خلاله، وهي بالتالي بدون افق سياسي وبدون مسوغات دينية وحواضنها الاجتماعية طارئة ومؤقتة ولهذا لا مستقبل لها ، ونحن متى اردنا قادرون على طي صفحتها واشهار وفاتها ، لكن البعض للاسف ما زال يعتقد بانها الترس الذي يمكن ان يستخدمه لتخويف الشعوب من خياراتها واقناعها بقيول المصير الذي يراد لها ، ودفعها الى الانتقام من نفسها بذريعة الانتصار على غزاتها ، انها مجرد لعبة لادامة الصراع على السلطة وتقسيم الغنائم وتبادل الادوار والوظائف.
الرد على داعش ضروري لكنه يحتاج الى منطق آخر ، لا بد اولا ان يعتمد على رفض الانجرار الى ساحة الحرب باسم الدين ، هذه الساحة التي قررتها داعش للعراك والنقاش، فالصراع مع التنظيم وافكاره هو صراع ضد التخلف والاستبداد والقتل والارهاب ، وهو بالتالي يخضع لمنطق الدولة وليس منطق الدين، ويجب ان نتعامل معه كقضية سياسية لا دينية، ولا بد ثانيا ان نتحرر من اعتماد داعش كقضية محورية لانها في الحقيقة ليست كذلك ، فهي تعبر عن طفرة وحالة استثنائبة والمنتسبون لها ليسوا اكثر من ضحايا او مرضى ، وبالتالي فان امتداد حواراتنا حولها واجراءاتنا اتجاهها سيجعلها طرفا وندا ، وسيمنحها مشروعية لم تحلم بها.
بدل ان تأخذ داعش شبابنا الى الماضي وجراحاته يفترض ان نذهب معهم الى المستقبل وتحدياته، وبدل ان نرد على الاسئلة التي الزمتنا بها او وجدنا انفسنا مضطرين للرد عليها يفترض ان نصمم لابنائنا اسئلة واجابات تتناسب مع وعيهم وطموحاتهم ، ومع قضايا عصرهم ومستجداته ومع خرائط الانسانية المفتوحة على الحياة لا على الموت ، وعلى الحرية والعدالة لا على القهر والاستعباد.
خذ مثلا ،الرد على رواية «الخلافة» التي اشهرتها داعش في وجوهنا ، اليس من الواجب ان يتجاوز اشكالية الموقف الفقهي ولاحقا الحركي الذي يرى ان « الخلافة» هي الاطار السياسي المشروع والوحيد للدولة , الى رد سياسي معاصر يتعلق بتقديم نموذج «الدولة» العادلة التي تستوعب اشواق ورغبات المواطن - لرؤية الصورة العملية للاسلام الحقيقي كدين وللدولة المدنية المعاصرة كأطار ونظام حكم وادارة.
خذ ايضا، الرد على سؤال «الفراغ» الذي وجدته داعش وحاولت ان تملأه في سوريا والعراق ,الم يكن من الضروري ان نخرج من فوضى التعميم وان نحدد مسارين واضحين للرد واحد ديني فني وهو مسار افتقاد اهل السنة لمرجعية تمثلهم واطار يستوعبهم , ومسار اخر سياسي هو تغول السلطة التي حكمت باسم المذهب والطائفة الذي ادى الى انهيار الدولة في المناطق التي استولت عليها داعش وتمددت فيها , وما ولده من فراغ استغلته لبسط نفوذها ، وبالتالي فان الاجابة على سؤال هذا «الفراغ» تحتاج الى اجراءات حقيقية سواء على صعيد «المرجعية» السنية الغائبة و المفقودة او على صعيد الدولة العربية التي انتهت صلاحيتها و تهدمت بنيتها واختزلت في القبيلة والفرد والطائفة بحيث اصبحت بحاجة الى انتاج جديد وفق رؤية تتناسب مع العصر ومستجداته.
خذ ثالثا، الرد على التربة التي خرجت منها هؤلاء الذين تقمصوا صورة الاسلام ولبسوا عباءة الخلافة ، وعبروا عن « مكبوتات تراكمت في «الذات « العربية المسلمة ولم تجد من يصرفها في قنوات صحيحة وحضارية ، اليس من الاجدى ان نعترف بان هؤلاء مهما اختلفت ( جغرافيا) خروجهم سواء من دولنا التي استثمرت كل طاقاتها في انتاج الظلم و المظلومين، و التطرف و المتطرفين ، او من الدول الاخرى التي تغذت على منطق ( الخوف من الاسلام) واعملت سكاكينها في جسد عالمنا الاسلامي ذبحا و سرقة وعدوانا، هؤلاء خرجوا من دائرة واحدة وهي الانتقام من التاريخ والحاضر ،والاصرار على تدمير الذات والاخر، ولاشيء بيدهم سوى ( القتل) فهو اسهل طريقة ( للتغيير) واسرع وسيلة للرد.
بمثل هذه الردود العملية التي تنتصر لمنطق العقل والعصر والمستقبل يمكن ان نواجه داعش وغيرها من دعاة افكار التطرف وعصابات القتل ، وان نرد على مزاعمها وممارساتها بدل ان تجرنا الى الخندق الذي حفرته لنا وتلزمنا بالجلوس على الطاولة التي صممتها بنفسها، للحوار معها حول الموضوع الذي قررته ووفق شروطها ايضا.
 ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
غافل الصبي عامل المقهى وتسلل يجول بين الطاولات. تلفّت قلقاً ينتظر قرار طرده. عينان متوسلتان ويد صغيرة ممدودة. انصاع الى رغبة من أشاروا عليه سريعاً بالابتعاد. علّمته التجربة تفادي الإفراط في الإلحاح. ثمة من أشفق وتجاوب. كنت في زاوية المقهى مع الصحف. سألته إن كان يرغب في فنجان من الشاي فرفض. أغلب الظن انه خاف ان يرجع عامل المقهى، وهذا يعني ببساطة التعنيف والطرد.
سألته وأجاب. اسمه أحمد، وعمره تسعة اعوام. قُتِل والده في غارة. نَزَحت والدته مع أولادها الخمسة من قرية في محافظة حمص الى لبنان في رحلة مضنية. رفض الرد بدقة عن مكان إقامة عائلته.
منذ إطلالة «داعش» صار النازح متهماً أو مشروع متهم. صار مخيفاً وخائفاً. بعض البلديات يمنع «تجوّل الأغراب» بعد السابعة مساء. الشبان يتعرضون في أحيان كثيرة لعمليات دهم، خصوصاً إذا كانوا ملتحين.
يقول أحمد إن والده لم يكن محارباً، وإن النار التهمت بيتهم الصغير، ولم يكن أمامهم غير لبنان. لجأت العائلة الى قرية، ثم طُرِدت منها. لم يكن أمامها غير تكرار النزوح. ولم يكن أمامه غير التسوُّل. وإن شقيقاً له يجول في أماكن اخرى. وإن الأماكن صارت اقل وداً، وتتشدد في رفض المتسوّلين. وإنه وشقيقه يسلّمان امهما مساء حصيلة نهار الشقاء الطويل.
يتابع أحمد جولته وعذاباته. حديث اللاجئين السوريين مفتوح بقوة في لبنان حيث يقترب عددهم من مليون ونصف مليون لاجئ. تسمع ان التجارب تشير الى ان عدداً غير قليل من اللاجئين يميل الى البقاء في بلد اللجوء، اذا أمضى فيه اكثر من ثلاث سنوات. وتسمع ان البلدات والأحياء التي فرّ منها اللاجئون لم تعد موجودة، وأن اعادة اعمار سورية تحتاج مئتي بليون دولار إذا توقفت الحرب اليوم. تسمع ايضاً ان يأس اللاجئين يجعلهم هدفاً سهلاً لقوى التطرف. وثمة من يذهب أبعد فيقول إن بقاء مئات الالآف من السوريين في لبنان يشكل اضافة الى العبء الاقتصادي إخلالاً بالتوازن الديموغرافي، خصوصاً بين السنّة والشيعة إذا أخذت أيضاً في الاعتبار وجود نصف مليون لاجئ فلسطيني. وهناك من يميل إلى تحميل السوريين مسؤولية تزايد الصعوبات المعيشية وعمليات الإخلال بالأمن.
كانت عمّان محطتي الثانية بعد بيروت. وجدت موضوع السوريين ينتظرني هناك. مليون ونصف مليون سوري لجأوا الى الأردن. وجودهم يُربك الدولة القليلة الموارد التي استقبلت من قبل نازحين فلسطينيين وعراقيين. ضاعفت موجة اللجوء السوري الضغط على النظام الصحي والنظام التعليمي فضلاً عن شحّ المياه. ظروف النازحين تثير المخاوف من تفشي التطرّف في صفوفهم. طول إقامتهم ينذر بنزاع يومي على اللقمة مع بعض سكان البلد الأصليين.
يميل بعضهم إلى القول إن الانفجار السوري أشد هولاً من الانفجار اليوغوسلافي، وإن سورية التي كنا نعرفها لم تعد قابلة للترميم. لا حاجة الى التفاصيل. قرأت في صحيفة في عمان ان الشرطة ألقت القبض على خلية لتزويج القاصرات السوريات تديرها سيدة سورية. فاقت عذابات السوريين عذابات الآخرين.
كنتُ سمعت الحديث ذاته في اسطنبول قبل أشهر. عدد السوريين في تركيا يوازي عددهم في لبنان، تداخل وجودهم هناك مع التوتر السنّي - العلوي. هناك من يعتقد بأن إصرار اردوغان على المنطقة الآمنة يرمي الى إعادة توطينهم فيها، وعلى أمل التعجيل في إسقاط النظام.
هجّرت الحرب السورية ستة ملايين في الداخل، وقذفت بخمسة ملايين الى بلدان الجوار. عددهم يوازي عدد سكان دولة. ظروف عيشهم مأسوية. المساعدات الدولية تتراجع والبلدان المضيفة تنوء تحت الأحمال. يضاف الى ذلك ان سورية خسرت بهجرتهم جيلاً كاملاً من الشباب وأعداداً كبيرة من المتعلمين والمعتدلين والعلمانيين. خير دليل على يأس السوريين تلك الجثث الضائعة في البحار في محاولة الوصول الى أوروبا عبر قوارب الموت.
متى يرجع السوري؟ الى اين سيرجع ؟ الى أي سورية؟ ومن يعيد إعمار بلدته وحيّه؟ لسنا في نهايات الحرب. سينتظر اللاجئون طويلاً. سيواصل احمد وأشباهه التسوُّل في لبنان والأردن وتركيا والعراق وغيرها. ستغرق سورية أكثر في دمها. سيغرق اللاجئون والنازحون أكثر في يأسهم. وستلتهم البحار مزيداً من جثث السوريين.
متى يرجع السوري الى سورية؟ ومتى ترجع سورية الى سورية؟ سمعت كلاماً مقلقاً من رجل واقعي. قال:» انسَ سورية القديمة، لقد قُتِلت في الحرب. والدليل ان زائراً حمل الى عاصمة كبرى مشروعاً لسورية الفيديرالية».
 ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
تتدافع أطروحات الحلول السياسية بشأن سورية، وتتراكم على طاولة المهتمين المتصلين بالدبلوماسي ستيفان دي ميستورا، مباركةً خطواته وداعمةً له بدراسات وإحصائيات، تؤكد نجاعة طرحه تجميد مناطق الصراع وتثبيت واقع الهدن، انطلاقاً من إدراك تلك الدراسات عمق الانتكاسات الحادة في المستويات الاجتماعية والاقتصادية، والتي جعلت من الصراع الهوياتي في سورية صراعاً يفتح المجال لمستويات عنيفة، تهدّد التجذّر الحضاري والأصيل لهذا البلد، خصوصاً في ظل ما يفرزه الفعل العسكري من تشظٍ للجغرافيا والديمغرافيا السورية وتجاذبات وتحاربات، من شأنها تدمير ما تبقى من الدولة، وتشويه العلاقات البينية بالبنية السورية، لتغدو علاقات مصدرها التعنت والإلغاء والتغييب ونسف الآخر.
وجوهر معظم تلك الحلول يدور حول أمرين، الأول: الهدن، لا سيما مع تحولها من ديناميكية محلية، لجأ إليها أطراف الصراع الداخلي (النظام والمعارضة)، لخدمة مصالحهما الآنية والبعيدة المدى، إلى مقاربة أممية عبّر عنها المبعوث الأممي، استيفان دي مستورا، في خطته المتمحورة حول تجميد القتال في مناطق محددة، وتوقيع اتفاقات هدن بين طرفي الصراع، أملاً بأن يفضي ذلك إلى حل سياسي. الأمر الثاني: أولوية مكافحة الإرهاب، انسجاماً مع استراتيجية الفاعل الأميركي باعتبار ظهور الجماعات العابرة للحدود وتمددها مهدداً أمنياً لدول المنطقة والإقليم، كما أنه مهددٌ لطرفي الصراع، كون مشروعه يتعدى الجغرافيا السورية، ويتعدى النظام وأهداف الثورة السورية.
ومع واقعية مبررات الدراسات الدافعة باتجاه المضيّ تجاه القبول بمبادرة دي ميستورا، إلا أن توظيف نتائج الاستبيانات للهدن في الأروقة السياسية، بشكل يخرج نتائج البحث عن سياقها، ويجتزئ منه المبتغى سياسياً فقط، تجعل عملية البحث العلمي خاضعة لمعايير سياسية غير موضوعية، بالإضافة إلى أن استغلال الملف الإنساني المرافق عمليات الهدن في عمليات التطويع السياسي، وسوقه ليكون مدخلاً لحل سياسي، يفضي إلى حل عادل للقضية المجتمعية السورية، سيكون من شأنه إنتاج مقاربات مغلوطة في رؤية سياسية تميل مع طرف ضد آخر.
وفي هذا الصدد، لا بد من التركيز على حقيقتين، تجاهلهما السياسي عند قراءته مثل هذه الدراسات. تتعلق الأولى بتحليل أثر الخصائص المحلية (البيئة الحاضنة) على المواقف من الهدن على كل من الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي أفرزته الهدن، ويؤكد هذا التحليل أن الهدن لم تؤد الدور الذي كان مأمولاً منها، في إعادة العلاقات الاجتماعية للسكان المحليين إلى وضعها الطبيعي، بحكم استمرار التضييق المفروض على مناطق الهدن، بالإضافة إلى قلة حجم المكتسبات التي حققتها اتفاقيات الهدن للسكان المحليين، في قطاع الخدمات، وخصوصاً الطبابة والتعليم، وأنها اقتصرت على ما يمسّ الحياة آنياً. والثانية: عدم ضمان الهدن قيم العدل والحرية والكرامة للإنسان، حيث يؤكد الواقع عدم وجود تغيير ملحوظ في سلوكيات قوات النظام، وما تضم من ميليشيات ذات ولاء عابر للحدود. وهذا ما يبقي عوامل التوتر كامنة، ويشير إلى هشاشة اتفاقيات الهدن، ويضعف الأمل بأنها آلية قادرة على توفير البيئة المواتية لإطلاق عملية سياسية تنهي الصراع.
وخلاصة لواقع مناطق الهدن، يمكن القول إن الهدن لم تكن اتفاق تلاقٍ للمصالح، يوطئ للانفراج والتلاقي السياسي، وإنما كانت اتفاق وقاية شرٍّ، لم يغيّر جوهر علاقة النظام بالمجتمع، تلك العلاقة القائمة على الإكراه من خلال القمع.
وبالتالي، ما يحاول دي ميستورا الدفع به بهذا الخصوص يحتاج مزيداً من الأعمال التمهيدية، تضمن، أممياً ودولياً، تحسين شروط الهدن وتوثيقها واحترامها، ويقترح، هنا، أن تكون تحت الفصل السابع.
ولا شك أن استمرار الصراع السوري، من دون السعي إلى تبني أدوات الحل، هو أكبر مغذٍ وداعم لخطاب تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال يعتمد على استراتيجية استغلال المفرزات في شرعنة الطموحات التي تنمو خارج القيم الدينية، وحتى الإنسانية، وصوغها في إطار قائم على خطاب متستر بالدين، ذي أهداف تعبوية، ضد "عدو صفوي وصليبي"، ونصرة لـ"سني مظلوم ومهمّش"، بهدف التأثير على موارده البشرية الحالية أو المستهدفة.
كما أن الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب تحتوي على تناقضات عدة، لن تسهم، بشكلها الحالي، في تحجيم الإرهاب، ولن تبدد المخاوف الأمنية لدول المنطقة كافةً، إن لم ترتبط هذه العملية بمسار موازٍ قائم على تجفيف المصادر المسببة للإرهاب، والتي تزيد من مظلومية المجتمع السوري، حيث إن هذه الاستراتيجية خاضعة لمعايير أمنية، تفرضها جيوسياسية سورية، وليس وفق معايير متطلبات الحلول السياسية والاجتماعية السورية.
" الهدن لم تكن اتفاق تلاقٍ للمصالح، يوطئ للانفراج والتلاقي السياسي، وإنما كانت اتفاق وقاية شرٍّ، لم يغيّر جوهر علاقة النظام بالمجتمع "
ووفقاً لأعلاه، يفرض السؤال التالي نفسه: كيف غدت مكافحة الإرهاب شرطاً ملزماً لأي مبادرة، خصوصاً عندما يكون هذا الشرط خاضعاً لبوصلة التحالف الضبابية فقط؟ وهنا تفيدنا الإجابات التاريخية في محاربة هذا "العدو" بأنه لن يتم تحجيمه وإلغاء فاعليته، إلا بأدوات مجتمعية وباستقرار اجتماعي، أي إن بداية نهاية التنظيم تبدأ مع تشكيل هيئة حكم انتقالي، تعيد للعجلة السياسية الداخلية حركتها التي ستنسجم مع الآمال المجتمعية، وبدورها سترفض أي مشروع يعيدها إلى حقبة الصراع والاقتتال، وستسهم في الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وتبقى أدوات المبعوثين الأمميين أسيرة سياسات الفاعلين الدوليين، وهو ما يحدّد ويقلّص هوامش المرونة المتّبعة منهم، ويجعل مهامهم السياسية صعبة للغاية، فكوفي أنان بدأ مهمته بنزعة براغماتية، وطرح نقاطه الست التي تضمن انتقالاً سياسياً للسلطة، وفشلت المهمة على الرغم من التأييد الإعلامي لها. وتابع المهمة الأخضر الإبراهيمي بأداء سلبي، وتستر على مماطلة نظام الأسد وروسيا وإيران، وعمل على دفع الأطراف إلى تفاوض مباشر فشل، ولم يثمر شيئاً، على الرغم من حضور المجتمع الدولي في هذا المؤتمر، وها هو دي ميستورا يطرح مبادرته المعللة بالواقعية، والمؤيدة بدعم أوروبي، وهي تثبيت هدنٍ محلية لا أكثر، من دون أن يقدم ضمانات لعدم تلاعب النظام بالهدن، بابتزازه المعونات الإنسانية من غير توثيق يتمتع بشرعية الأمم المتحدة والقوانين الدولية. بالإضافة إلى تجميد مناطق الصراع، ناسفاً بالمعنى الحقيقي جوهر اتفاق جنيف، كإطار للعملية التفاوضية المفضية إلى حلٍ سياسي.
ينبغي ألا يشكل طرحنا أعلاه مدخلاً للإحباط، عبر الاستكانة وعدم السعي إلى امتلاك أدوات سياسية واقعية، تفضي إلى حل سياسي عادل شامل، بقدر ما أنه محفّز موضوعي لتجاوز الأخطاء التاريخية في سيرورة المقترحات الأممية لحل الأزمة في سورية، وتأكيدٌ على أهمية ونجاعة تشكيل هيئة حكم انتقالية مركزية، تحسن وتضمن مناطق الهدن المدارة ذاتياً، وتبدأ بعملية انتقال سياسي.
 ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
من الواضح أن تغييرات طرأت على خريطة «سايكس- بيكو» في أعقاب اندلاع حرب الإرهاب في العراق وسورية وعليهما.
تقارير صحافية مصدرها أمريكا وأوروبا تشير إلى سيطرة «الدولة الإسلامية ـ داعش» على نحو ثلث مساحة العراق، وان «الدولة» و»النصرة» تسيطران أيضا على نحو ثلث مساحة سوريا. سواء كانت هذه التقارير دقيقة او مغالية فإن الأهم من المساحة المسيطر عليها هو عدد السكان والمواقع الإستراتيجية المشمولة بالسيطرة، ذلك ان معلومات متعددة المصادر تتقاطع في ان عدد سكان محافظات غرب العراق وشرق سورية، التي باتت تحت سيطرة «الدولة الإسلامية» يناهز العشرين مليوناً.
إلى ذلك، فإن المناطق التي تسيطر عليها «الدولة الإسلامية» عابرةٌ للحدود التي رسمتها خريطة «سايكس – بيكو» بين العراق وسورية. فهي تقع بين نهري دجلة والفرات، وتحتوي بحيرات وسدوداً مائية وآبار نفطٍ ومصافي ومرافق مائية وكهربائية عامة. كما يشكّل امتدادها الجغرافي اسفيناً يفصل جيوسياسياً جنوب شرق سوريا عن جنوب غرب العراق وبالتالي عن ايران.
ثمة رأيان في الجهة التي تعبث بخريطة «سايكس ـ بيكو» على النحو المبيّن آنفاً. الاول يشير إلى «الدولة الإسلامية» تحديداً ويدلل على صحة حكمه بالبيانات المتعددة الصادرة عنها، التي تشي بأن مخططها يرمي للسيطرة على بلاد الرافدين وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، بما فيها السعودية وإمارات الخليج واليمن. كما أوحت أخيراً بأن مخططها يشمل ايضاً ليبيا ومصر وتونس. ويكتسب هذا الرأي صدقية إضافية بالمحاولات المتكررة التي يقوم بها أمراء «الدولة الإسلامية» ودعاتها للاستحصال على بيعة من قادة التنظيمات «الجهادية» في شتى بلاد العرب لـِ»الخليفة» ابي بكر البغدادي.
الرأي الثاني يعتبر الولايات المتحدة الجهة التي تعبث بخريطة «سايكس– بيكو» ، ويقدّم أدلة لافتة في هذا المجال. فهي دعمت تنظيمات «جهادية» عدة ناشطة في شرق سورية وشمالها، وسارعت إلى دعم اقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي عندما تعرّضت عاصمته اربيل لهجمة من قوات «الدولة الإسلامية» خلال الصيف الماضي، وسرّبت مذّ كان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن عضواً في مجلس الشيوخ، مخططاً يرمي لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، كردية وسنيّة وشيعية، ودعت لإنشاء وتسليح وتدريب «جيش عشائري خاص» للمحافظات السنيّة في غرب العراق واستدعت وفداً منها إلى واشنطن للبحث معه في تفاصيل التنفيذ، واشتركت بشخص سفيرها السابق في كرواتيا (الخبير في اجراءات تقسيم يوغسلافيا السابقة) في وفد اوروبي– امريكي زار محافظة الحسكة السورية، لحث القوى الكردية الناشطة فيها على التعاون مع سلطات اقليم كردستان العراق، بعيداً من حكومة دمشق، وسكتت إن لم تكن شجعت «لواء اليرموك» التابع لـِ»الجيش السوري الحر» على الانضمام ميدانياً إلى قوات «الدولة الإسلامية» في مناطق الجولان السورية المجاورة لخط الفصل مع منطقة الاحتلال الإسرائيلي، وتغاضت عن توريد السلاح والرجال إلى التنظيمات «الجهادية» في سورية عبر تركيا.
سواء كانت «الدولة الإسلامية» أو الولايات المتحدة هي الجهة التي تعبث بخريطة «سايكس بيكو»، فإن ذلك لا يحول دون تلاقي الطرفين وتعاونهما على تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، لأن إقامة دولة انفصالية بين دجلة والفرات من شأنها تحقيق مصالح وازنة لكلٍ من الولايات المتحدة و»الدولة الإسلامية» على النحو الآتي:
اولاً، إضعاف كلٍ من حكومتي بغداد ودمشق، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، الامر الذي ينعكس ايجاباً على هدفين ثابتين لواشنطن، هما حماية مصالحها في المنطقة ودعم أمن «اسرائيل»، بالإضافة إلى هدف ثالث هو تفكيك بلاد الرافدين وبلاد الشام والسيطرة عليهما من دون أن يمسّ ذلك بالضرورة بمصالح «الدولة الإسلامية».
ثانياً ، تمكين التنظيمات «الجهادية» كما تلك التابعة لـِ»المعارضة السورية المعتدلة» من اقامة «منطقة عازلة» على طول خطوط الفصل الممتدة على مدى 75 كيلومتراً من الحدود مع لبنان في الغرب إلى الحدود مع الاردن في الجنوب. إن اقامة هذه المنطقة العازلة تخدم مصالح الولايات المتحدة و»اسرائيل» و»الدولة الإسلامية» بدعمها أمن «اسرائيل» وإضعاف أمن سورية ما يفيد الدولتين الاولى والثانية، وايجاد موطئ قدم وموقع تقاطع مع «اسرائيل»، ما يفيد الدولة الثالثة ويمكّنها من المشاركة في اي مفاوضات لتقرير مستقبل المنطقة.
ثالثاً، فصل سورية جيوسياسياً عن ايران بإقامة دولة ـ اسفين فاصلة في محافظات العراق الغربية ومحافظات سورية الشرقية تمتد من الحدود مع تركيا في الشمال إلى الحدود مع الاردن في الجنوب ما يؤثّر سلباً في دور سورية كحلقة ربط استراتيجية بين ايران وقوى المقاومة المتعاونة معها في لبنان وفلسطين المحتلة.
رابعاً ، فصل الاردن عن العراق وربما عن سورية ايضاً، الامر الذي يبقيه اسير ارتباطٍ جبري مع «اسرائيل»، استراتيجياً واقتصادياً، فضلاً عن وضع «الدولة الإسلامية» الموجودة على حدوده الشرقية والشمالية في مركز قوي لدعم القوى الإسلامية المؤيدة لها في الداخل الاردني.
خامساً، تهديـد قـوى المقاومة في لبنان بدعم القوى «الجهادية» المواليـة لـِ»الدولة الإسلامية» لإقامة «منطقة عازلة» عبر الحدود اللبنانية – السورية بين منطقة القلمون السورية ومنطقة البقاع الشمالي اللبنانية، ومحاولة التمدد شمالاً للوصول إلى منطقة عكار وبالتالي إلى البحر المتوسط.
قد تبدو هذه المخاطر والتحديات بعيدة المنال او تنطوي على قدْر من المغالاة، لكن احتمال قيام تعاون مباشر او غير مباشر بين الولايات المتحدة و»الدولة الإسلامية» يبعث فعلاً على القلق ويستدعي التفكير الجدّي بخطة متكاملة للمواجهة.
درهم وقاية خير من قنطار علاج.
 ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
٢٢ ديسمبر ٢٠١٤
قد تكون المرحلة الراهنة التي يحياها عالمنا العربي فريدة نوعها في تاريخه الحديث. فهي كما لو كانت مرحلة تصفية عارمة لما سبقها، بل ربما حفلت كذلك بمقدمات وبوادر لمرحلة أخرى آتية. فهي بهذا المعنى ليست حقبة انتقالية، وإن كانت حافلة بأمارات الماضي كما بأمارات القادم المجهول كذلك. إذ إن الوقائع اليومية لا تحمل دلالاتها مقدماً. وهو المراقب المتخصص الذي يمكنه أن يضفي عليها ما يشاء من رموز الدلالات. حتى تلك المتناقضة فيما بينها.
فلم يعد من السهل أن توصف المرحلة بالثورية، ولا بالفوضوية، ولا باللامعقولية والعبثية، فهي لها كل صفات هذه التصنيفات، ولكنها حاملة معها احتلافاتها بل نقائضها. قد تبرز واقعة (داعش) كما لو كانت ذروة اللامعقولية، لكن التمعن الهادئ في تشكلها سوف يكشف أن لها أسبابها ومقدماتها. ذلك أن لا معقولية داعش ليست سوى رد على لا معقولية المصير العام الذي آلت وتؤول إليه كوارث الحاضر المحدقة بأهم أقطار المنطقة. كأنما تبرز داعش كتجسيم مادي عضوي سفاح وفاعل لهذه اللامعقولية الجبارة المسيطرة، والممسكة بتلابيب كل حراك عمومي، مرشح لإحداث تغيير ما في حياة الناس، في نظمهم السياسية أو الاقتصادية أو التربوية. فمنذ أن حالت طلائع الثورات الربيعية، تفتَّق الواقع الاجتماعي سريعاً عما سيكون له من تماهيات مع مصطلح الثورة المضادة. ولقد أمكن تعميم هذا المصطلح على مختلف القوى والحركات التي لا مصلحة لها في أي تغيير لخارطة الواقع القائم، فكيف يكون أمرها مع مشروع التغيير الأكبر الذي تبشر به ثورة عارمة حقيقية. غير أن النجاح لم يكن حليفَ أية ثورة مضادة حاولت اجتثاث جذور الحراك الجماهيري، وإن أوقعت تجارَب محلية هامة في مسلسل من الانتكاسات، بل استطاعت الغدر ببعض هذه الثورات كلياً وإسقاطها في أسوأ كوابيسها، كحال كل من الثورة السورية والليبية. حتى يمكن القول إنه لم يكن لتظهر داعش لو لم تكن الثورة المضادة قد بلغت أوج قوتها، بما توشك بعدها على الانهيار التام إن لم تطلق صاعقتها الكبرى. فتعلن نوعاً من حرب دولة قائمة وقادرة، تكتسح ساحات شاسعة من سورية والعراق، وتبني كياناً سلطانياً، نموذجاً وهمياً للدولة العربية الإسلامية الكبرى الشاملة، كما تدعيه.
المرحلة المدعوة بالانتقالية تفقد تسميتها تلك إذ تخرج عن تصنيفها في سياق الاسم العام للربيع العربي. تغدو مرحلة انتقالية في سياق المشروع المضاد كلياً لذلك الربيع البائس. بينما تجيء ثورة داعش هذه كأنها صناعة متكاملة بأيدي مخططين ومهندسين بارعين، فهي مخلوق سياسوي مفتعل، فاقد أصلاً لأسبابه الطبيعية، لكنه متوفر على عوامل تقنية، تمنحه مناعةً خاصة، قد لا تتمتع بأمثالها ثورات ربيعية ناشئة في كنف ظروف طبيعية ومزوّدة بمشروعية تاريخية مسبقة. وبناء على هذا الاختلاف الجذري في أصول النشأة قد يوحي التفاؤليون لأنفسهم بأن لا مستقبل للمشروع الداعشي، بينما كل المستقبل هو من حظوظ هذا الربيع رغم تعثّره وتعرّضه لمختلف العداوات المعروفة ضد حريات الشعوب.
إذا كان العرب يعيشون اليوم، وللسنة الرابعة على التوالي، أنفاقاً مظلمة من مصطلح المرحلة الانتقالية، فليس هناك ثمة وعي وطني أو قومي قادر على استيعاب الحالة الراهنة. بل يبدو لكل مشروع وعي من هذا المستوى أنه واقع مقدماً تحت طائلة الوقائع التي لا يمتلك عنها أية معرفة ولو جزئية، فليس بمقدوره البتّة التدخل في مؤثراتها. كما لو أن المصير العربي أمسى مقبوضاً عليه في مركب، ومقذوفاً به في لُجَج من المصائر الأخرى، الغيبية، لكنها الحاسمة. لقد نسي المرفأ الذي انطلق منه، ولا يدري إلى أية مرافئ أخرى هو متجه. وهل لا تزال على بعض الشواطئ ثمة مرافئ تؤوي الضالين من مراكب العواصف التائهة.
مرحلة الانتقال، ليست هي عنوان الضياع وحده، لكنها تتحول إلى جملة مسالخ بشرية، تلك التي ترمي بلحومها الحية يومياً على جوانب دروبها المكتظة بوحوش الغابات المندسة منذ دهور تحت أديم الحضارات الزائفة، فمن هو المرتحل المتبقي لما بعد هذه (الانتقاليات) وتجاربها الرهيبة. ليس غريباً أن يتخلّى معظم الجيل العربي الحالي عن أسئلة المستقبل. فالزمن في هذا الشرق المدلهم قد انحنى وتقوّس ظهره. لم يعد أمامه ثمة أفق يتجاوز مدى بصره. أمسى يدور حول ذاته. لا بديل لهذا الحاضر سوى الحاضر الأسوأ منه. هكذا تريد (داعش) أن تؤطر عالمها باعتباره آخر العوالم الممكنة، حتى وإنْ كان هو العالم المستحيل في ذاته.
ما كانت تعنيه المرحلة الانتقالية مع هبوب أول ثورة ربيعية هو الحاجة العملية التي يتطلبها التغيير بين إسقاط النظام القديم، والشروع في توفير شروط الحكم الديمقراطي ونظامه الدستوري الجديد. كان الاصطلاح الانتقالي يهدف إلى أدلجة هذه المسافة الشاقة بين لحظتي الهدم والإعمار في الفعالية الثورية. كان المطلوب النفسي هو تهدئة الوجدان الجمهوري وتدريبه على تحمل انحرافات الطريق والتمرن على تجاوز عقباته ومؤامراته. لكن ما حدث كان فجائياً ودافعاً يومياً إلى اليأس وتعميقه من هاوية إلى أخرى، فلم تنجح أية ثورة من الأربع المعلنة في استكمال طريقها ما بين لحظتي الهدم والبناء. ذلك أن الهدم كان وحده هو الذي يولّد أبناءه وأحفاده حاملين سلالته وخصائصه. أما البناء فإن وعوده مؤجلة تارةً، ومستبعدة تارةً أخرى، بل ومنسية في النهاية. كانت مرحلة الانتقال تتهاوى إلى أنفاقِ متاهات، تتكشّف عن عقد دفينة من أمراض اللاوعي الجمعي. كان المجتمع المنتفض يتعرّى عن عيوبه الدهرية الدفينة. كانت «الوحشية» جاهزة لممارسة فظائعها. فما (ينتقل) إليه المجتمع الثوري هو سلسلة أفخاخ ضد «نواياه الحسنة». لم تكن هي الثورة التي تنضج بذورها، وتصعّد فروعَها، وتُنَضج ثمارَها، أمست مرحلة الانتقال أقرب إلى كونها مرحلة انحلال. تراقصت على أطلالها رموز عنيفة عائدة إلى مصنفات الثورات المضادة التي عرفتها أو لم تعرفها مهالك التاريخ المدونة أو المحجوبة.
ولادة داعش أخيراً هي المحصلة التركيبية لأعطال المرحلة الانتقالية، هي صيغة التركيب الكيماوي لعناصر تلك الأعطال. لكنها تأتي مضاعفة الشدة والقوة والفعالية. داعش لم تعد تقبل بالجريمة النسبية، لم تعد تقبل بالأعطال العرضية، لم تعد تتساهل مع الصدف العفوية. لم تعد تنذر الأفراد والدول والأحزاب والميليشيات الأخرى بنيران جهنم. لم يعد أمراً شاذاً أن يتلاقى خصوم الأمس واليوم، أن يأتلف أعداء العقيدة والتنظيم، أن يجتمع الغرب والشرق، أن تقوم حرب عالمية ضد تنظيم اسمه داعش. فهو لا يوزع أخطاراً متناثرة، إنه قادم بالخطر المطلق، ومع ذلك لا يتجرأ أنواع أعدائه على التوحد الواضح ضده خشية البطش غير المحدود وهم فرادى أو مجاميع مهلهلة دائماً.
منذ أربع سنوات يسيطر حديث موسم واحد اسمه الربيع العربي. لكن سريعاً لم يعد هذا الاسم يعني سوى كل نقائضه ـ لماذا لا يختصره وحش واحد اسمه داعش. فالجميع يمتلكون لديه حصصاً معينة ومعتّقة. وهو الوحيد الذي يكاد يمتلكهم جميعاً. إنه القابض على مفاصل غريبة عجيبة لانتقالاتهم العبثية في كل حين، ونحو كل اتجاه. لا يمكنهم القضاء عليه، وإلا قضوا على مبرر وجودهم.
 ٢١ ديسمبر ٢٠١٤
٢١ ديسمبر ٢٠١٤
تتحول منظومة الأسد -يوما بعد آخر- إلى جزر منعزلة تفتقد التواصل فيما بينها، حيث تخوض في بعض المناطق حربا انتحارية دون أمل في الفوز بها. وعلى وقع تلك التطورات، تتشكل خريطة سوريا المستقبلية عبر ترسخ خطوط القتال والمواجهة بين الأطراف، وعلى طول الجغرافيا تتشكل لوحة منحازة بدرجة كبيرة إلى هذا التطور واحتمالاته الممكنة.
تكشف معارك ريف إدلب الجنوبي، وهروب كتائب بشار الأسد من هذه المنطقة، عن مؤشرات مهمة على التشكل الجديد لمسرح المعركة القادمة في سوريا، ذلك أن انتقال هذه المنطقة من سيطرة النظام بالمعنى العسكري تعني إعادة تعريف الحرب الجارية هناك.
فهذه المنطقة كانت تمثل عقدة وصل لوجستية مهمة تجتمع فيها خطوط إمداد النظام على أكثر من اتجاه، بين الجنوب والشمال، والوسط والشرق والغرب، بمعنى أنها كانت من الناحية الرمزية تعزز مقولة سيطرة النظام على مفاصل سوريا وتدعم توجهاته في استعادة ما خسره على مختلف الجبهات.
"تكشف معارك ريف إدلب الجنوبي وهروب كتائب الأسد من هذه المنطقة عن مؤشرات مهمة على التشكل الجديد لمسرح المعركة القادمة في سوريا، ذلك أن انتقال هذه المنطقة من سيطرة النظام بالمعنى العسكري يعني إعادة تعريف الحرب الجارية هناك"
في المقاربة المباشرة للميدان، يمكن تصنيف الإنجازات التي حققتها الفصائل المسلحة للمعارضة ضمن الإنجاز الإستراتيجي لكونها تحقق حتى اللحظة تموضعا في مساحة واسعة يسمح أولا بوجود منطقة انطلاق للثوار ومنطقة حركة، ومن ثم إمكانية المناورة بالقوى والوسائط وإمكانية الاختباء وإمكانية الإمداد.
وحاليا، طرق الإمداد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وبعمق عدة كيلومترات، متواصلة بشكل كامل. وقد حققت الفصائل المسلحة هذا الإنجاز الإستراتيجي في ظل ظروف عسكرية معقدة نتيجة قيام قوات النظام بتركيز نقاط دفاع أساسية وعلى أكثر من نسق وجرى تشبيكها مع مواقع النظام غربي حماة، وربطها بإحكام مع الساحل الذي يعتبر الخزان البشري لقوات النظام، إذ طالما كان يجري تجهيز حملات الغزو على مناطق وسط سوريا من تلك المناطق، وتحديدا مصياف وسقيلبية.
وقد أفاد النظام من شبكة التضاريس المعقدة ما بين سهل وجبل في تعزيز وجوده في هذه المناطق، إلى جانب لجوئه إلى تكتيك تقطيع الأوصال في الريفين الجنوبي والشمالي لإدلب، في محاولة لعزل الثوار وجعل تواصلهم صعبا، وخاصة مع ريف حماة الشمالي.
إذن.. كيف ولماذا حصل هذا الانهيار المفاجئ لتشكيلات النظام في هذه المنطقة، رغم أن الكثير من المراقبين كانوا يتحدثون عن قرب استعادة النظام لزمام المبادرة في حلب، وعن تدخل إيراني مكثف لإعادة تنظيم مسرح المعركة، وتولي العقيد سهيل الحسن الذي يعتبره أنصاره "القائد الإستراتيجي الخارق"؟
ثمة سياق عام فرض هذه النتيجة الحاصلة، ذلك أن الحرب المديدة غيرت كثيرا من شكل الصراع بعد أن تم تدمير البنية التي وفرت قدرات السيطرة لنظام الأسد، من قبيل المواقع الإستراتيجية، والعدد الكبير من عناصر الجيش، واحتكار الكثافة النيرانية. هذه المعطيات تبدلت كلية ولم يعد بالإمكان إعادة إنتاجها على الأرض، على الأقل في الأمد المنظور، فالنظام خسر البنية التحتية التي تساعده في إنجاز عملية السيطرة أو الاحتفاظ بمواقعه، وخسر رؤوس التلال والجبال التي كان يسيطر عليها في أغلب المناطق، وخسر غالبية طرق مواصلاته وإمداده، وخسر عددا كبيرا من جنوده وقادته المحترفين، وصار يزج بالمعركة بعناصر لا خبرة لديها.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم الثوار حزمة كبيرة من التكتيكات التي أربكت قوات النظام ولم تجد لها حلولا من خلال بنيتها الكلاسيكية، فقد أبدع الثوار في صناعة الكمائن والهجمات السريعة وقنص طرق الإمداد، واستعملوا أسلوب الحصار والإنهاك لتشكيلاته البعيدة نسبيا عن المراكز، كما شتتوا جهوده من خلال عمليات صغيرة ومتفرقة، وقد أثر ذلك بشكل تراكمي مع طول فترة الحرب.
"يفيد مشهد الجبهات المتداعية في الجنوب وفي الوسط والشمال والشرق إلى تراجع قوة التحالف المؤيد لنظام الأسد في الميدان، وتحوله إلى موقف دفاعي صرف"
هل وصلت جهود داعمي النظام إلى حدها الأقصى جراء تراكم حالة الاستنزاف التي أصابتهم، وبالتالي ضعفت قدرتهم على ضخ التغذية في شرايين النظام الأسدي، أم اهترأت شرايين النظام نفسه، وبالتالي لم يعد قادرا على استيعاب المساعدات ضمن هيكليته التي باتت أقرب إلى التمزق؟
يفيد مشهد الجبهات المتداعية في الجنوب "درعا والقنيطرة" وفي الوسط "القلمون والبادية وأرياف حمص وحماة وإدلب" وفي الشمال "حلب وريفها"، وفي الشرق "دير الزور"، بحقيقة مهمة وهي تراجع قوة التحالف المؤيد لنظام الأسد في الميدان، وتحوله إلى موقف دفاعي صرف، وهذا يتناسب بدرجة كبيرة مع تراجع قدرات النظام على مدى سنوات الحرب الأربع، وحصول تطورات دراماتيكية غيرت تماما من أهداف تلك الأطراف، بما فيها النظام نفسه.
يبدو المشروع الإيراني واقعا في ورطة توسع الانتشار من اليمن إلى لبنان وما يترتب على ذلك من تكاليف لا طاقة لطهران بتحملها، والأغلب أنها ستقبل بواقع تقاسم النفوذ في سوريا، وربما في العراق أيضا، مع كل من دول الخليج وتركيا وأميركا، مع قناعتها بالحصول على الحصة الوازنة إستراتيجيا، كأن تسيطر على مناطق النفط في العراق والساحل في سوريا.
أما روسيا -ونتيجة للتعقيدات السياسية والاقتصادية التي باتت تواجهها- فتتجه إلى القبول بحصة من النفوذ والسيطرة عبر إنقاذها جزءا من نظام الأسد وتأهيل جزء من معارضة الداخل لحكم سوريا المستقبلي. وبالتزامن مع ذلك، ينكفئ حزب الله إلى الداخل اللبناني، أو يتراجع إلى مناطق حدودية للتقليل من حجم خسائره الكبيرة على الجبهات، وانسجاما مع حجم التمويل المتناقص الذي بات يتلقاه من إيران جراء التراجع الكبير في أسعار النفط.
وبالعودة إلى مسرح المعارك في سوريا، ينطوي المشهد اليوم على تعقيدات هائلة تصعب من أي إمكانية لوضع تقدير حقيقي لسير الأمور واستشراف مستقبل التطورات، ذلك أن جميع المؤشرات تؤكد استغراق هذا المشهد بحالة فوضى عارمة على كل الصعد والمستويات، بحيث تشمل هذه الفوضى كل البنى والجبهات المتقابلة. فجبهة الثوار باتت تضم ما يفوق الألف فصيل وتشكيل، أغلبها له أهداف متناقضة ويفتقر إلى وجود تنسيق فعلي وقيادات مشتركة وغرف عمليات موحدة، حتى على مستوى المناطق التي تعمل فيها هذه التشكيلات.
ولا تنجو الجبهة المقابلة من حالة الفوضى تلك، فبالإضافة إلى القوات الرسمية التقليدية، هناك تشكيلات موازية تحت مسمى "الدفاع الوطني" و"وحدات الحماية الشعبية"، وتشكيلات ذات طبيعة مناطقية وأخرى محلية أضيق، وهناك تشكيلات جهوية وطائفية "مسيحية ودرزية وشيعية"، فضلا عن الهيكلية العسكرية التي أنشأتها إيران في كثير من المناطق السورية. وكل فصيل ضمن هذه التشكيلات له ارتباطات محددة وأهداف مختلفة وتمويل مختلف المصادر، بعضها أصبح تمويله ذاتيا عن طريق فرض إتاوات وبيع المواد الغذائية للمناطق التي يحاصرونها وبيع السلاح للمعارضة، وبالتالي فإن تبعيتها لنظام الأسد وإمكانية ضبطها من قبل الأخير تبدو شكلية إلى حد بعيد.
"ذهبت بعض تفسيرات السقوط السريع لمعسكرات وادي الضيف والحامدية إلى أن الأسد أراد الاحتفاظ بمقاتليه، لأنه يرى أن الاحتفاظ بالسيطرة على كامل سوريا لم يعد هدفا واقعيا، وأن الأولوية الآن ستكون للدفاع عن دولته الخاصة"
ما سبق بات بمثابة حقائق قارة على الأرض السورية، لا يملك أي من الأطراف الداخلية والخارجية القدرة على تعديلها ضمن الصيغ المطروحة حاليا للمواجهة. ولا شك أن منظومة الأسد وحلفاءه جزء من تلك الأطراف التي تقع في خانة العجز عن تغيير هذه الوقائع، وتاليا فإن حلم استعادة السيطرة على سوريا صار مستحيل التحقق، مما يحتم على نظام الأسد في المرحلة المقبلة تعديل أهدافه والسير صوب أهداف أضيق، ولكنها أكثر فائدة وجدوى، وذلك عبر واحدة من صيغتين يصعب أن تكون لهما ثالثة:
- استمرار القتال ضمن صيغة التقطيع و"الجزأرة" على الأرض السورية، بمعنى بقاء جزر للنظام في دير الزور وحلب وإدلب ودرعا والقنيطرة. ولذلك فوائد إستراتيجية، منها إشغال معارضته وتفتيت جهودها في مساحة أكبر، وعدم السماح بملاحقته إلى مناطق نفوذه التقليدية، إضافة إلى ضمانه لعدم تحقيق تواصل بين معارضيه في أغلب المناطق.
ولذلك أيضا فوائد سياسية تتمثل في استمرار سيطرته الرمزية وظهوره بمظهر النظام الشرعي في سوريا، وذلك بهدف استثمار هذه الميزة والتفاوض المستقبلي عليها، رغم أن هذه الصيغة مكلفة وستضعه على خط انتكاسات مؤلمة ومتوقعة بشكل دائم، ورغم أن ذلك يعرضه لانتقادات حادة من بيئته التي باتت ترفض قتل أبنائها في ساحات لم يعد يهمها أمرها.
- ذهاب النظام باكرا إلى حماية "دولته الخاصة" من ريف حماة شرقا إلى ساحل المتوسط غربا، مع الاحتفاظ بحمص وطريق مواصلات إلى جزيرته في دمشق. وعبر هذا الاحتمال يستطيع النظام تجميع ما تبقى من قواته للدفاع عن دولته. وقد ذهبت بعض تفسيرات السقوط السريع لمعسكرات وادي الضيف والحامدية إلى أن الأسد أراد الاحتفاظ بمقاتليه، لأنه يرى أن الاحتفاظ بالسيطرة على كامل سوريا لم يعد هدفا واقعيا، وأن الأولوية الآن ستكون للدفاع عن "دولته الخاصة".
 ٢١ ديسمبر ٢٠١٤
٢١ ديسمبر ٢٠١٤
تحدث الرئيس الأميركي، رئيس القوة العظمى الوحيدة، لما يزيد على الساعة والنصف في مؤتمره الصحافي الخاص بنهاية العام دون أن يقول شيئا مفيدا بالقضايا السياسية، ودون أن يسأل سؤالا مهما! أفرط الرئيس أوباما في الحديث عن اختراق النظام الإلكتروني لشركة سوني الأميركية الشهيرة في هوليوود من قبل نظام كوريا الشمالية التي اتهمتها واشنطن رسميا بالوقوف خلف تلك العملية، لكنه، أي أوباما، لم يتحدث عن مفاوضات بلاده مع إيران، ولم يتحدث عن سوريا، ولا العراق، ولا روسيا! ولم يتحدث أوباما عن الصراع العربي الإسرائيلي، وخصوصا عندما بدأ بتلقي أسئلة الصحافيين، ومن المعلوم أن الأسئلة لا تطرح بشكل عشوائي بالبيت الأبيض، بل بترتيب، وآلية محددة، والدليل أن جميع من سمح لهم بطرح أسئلة على الرئيس كانوا من الصحافيات النساء!
صحيح أن قضية اختراق شركة سوني، وتعطيل بث فيلم «المقابلة» من قبل كوريا الشمالية هو الحدث يوم مؤتمر الرئيس، لكن العالم ليس «سوني»! وحدث عام 2014 ليس تعطيل بث فيلم كوميدي، بل هو حول تراجيديا إنسانية حقيقية بالعراق، وسوريا، وغيرهما.. هناك أرواح تزهق، ودول مهددة، وأمن دولي أمام مخاطر حقيقية، وعندما يقول الرئيس أوباما في مؤتمره الصحافي إن بلاده أكدت زعامتها بالعالم، فكان من المفترض أن نسمع أسئلة حول أبرز قضايا أميركا والعالم، ورؤية رئيس الدولة العظمى الوحيدة حولها، فلماذا تعثرت المفاوضات مع إيران، مثلا؟
كان يجب أن نسمع من الرئيس شرحا عن لماذا استقال أو أقيل وزير دفاعه؟ وما هي رؤيته للتعامل مع «داعش»؟ وكيف يرى مستقبل العراق؟ ولماذا عاد وقرر إرسال جنود للعراق، وأبقى قوات بأفغانستان؟ وكيف يمكن التصدي لجرائم الأسد؟ وموقفه مما حدث بأستراليا، وباكستان؟ ولماذا هاتف الرئيس المصري، فهل أدرك أوباما خطأه حيال مصر؟ وكان يفترض أن نستمع لأسئلة تطرح على الرئيس، أو على الأقل شرح منه، لعمق الأزمة مع روسيا، وتبرير للعقوبات الجديدة التي وقعها مع تجميدها، وما هو المطلوب من بوتين، وخصوصا بعد مؤتمره الصحافي الأخير؟.
وعليه فإن العالم كان ينتظر من الرئيس الأميركي الكثير بمؤتمره الصحافي، فهناك حليف يريد سماع تطمينات، وعدو يريد التأكد ما إذا كانت الإدارة الأميركية تعني فعلا ما تقوله على لسان مسؤوليها، فالعالم ليس شركة سوني وحدها، كما أن المجتمعات المقموعة بالعنف والأعمال الدموية الإجرامية، مثل ما يحدث بسوريا والعراق واليمن، وليبيا، وفلسطين، وغيرها، غير معنيين بأزمة فيلم سينمائي، فذلك ترف لا يمتلكونه، وقضية لا تهمهم، خصوصا أن الرئيس أوباما لم يوضح ماهية الرد المحتمل على كوريا الشمالية، ولم يسأل سؤالا جادا مثل: ماذا لو هاجمت كوريا الشمالية، إلكترونيا، النظام البنكي، أو الملاحة الجوية؟ أو: ماذا لو حذت إيران حذو كوريا الشمالية، إلكترونيا؟
ولذا، فإن على من يعتقدون ببابا نويل أن يتعشموا بحظ أفضل مما جاء به الرئيس أوباما للمجتمع الدولي في مؤتمر نهاية العام هذا!
 ٢١ ديسمبر ٢٠١٤
٢١ ديسمبر ٢٠١٤
لم يكن طرح دي ميستورا بريئا بأي شكل من الأشكال أو مقياس من المقاييس، في حال أخذنا في الاعتبار ردود فعل السوريين العاديين الذين يعرفون ماذا يريدون. والهدف الذين يطمحون إليه.
يعرف السوري العادي بكلّ بساطة أنّ ثلاث سنوات وتسعة أشهر من التضحيات لا يمكن أن تنتهي ببقاء بشّار الأسد في السلطة. هذا غير مقبول من السوريين أوّلا ومن الذين يقاتلون النظام ثانيا وأخيرا. بات الذين يقاتلون النظام والذين يدعمونه على علم تام بنقاط ضعفه وبالوسائل التي يستخدمها من أجل مزيد من المراوغة.
لعلّ أكثر من يعرف ذلك الجانب الروسي الذي ينسّق حاليا مع دي ميستورا الذي يحظى بدوره بدعم اللوبي السوري في الولايات المتحدة. وهذا اللوبي ليس بعيدا عن الأوساط الإسرائيلية التي لا تمانع في استمرار الحرب التي يشنّها النظام على شعبه إلى ما لا نهاية وذلك بغية التأكّد من أنّه لن تقوم لسوريا قيامة في يوم من الأيّام.
يعتبر سقوط المعسكرين اللذين كانا يعتبران من بين الأكثر تحصينا في سوريا حدثا في غاية الأهمّية. وادي الضيف نفسه كان يوصف بأنّه أقرب إلى أسطورة وقد فشلت محاولات عدة لإسقاطه في السنوات الثلاث الماضية، خصوصا أنّه كان في محاذاته من كان يتظاهر بأنّه يقاتل النظام، في حين أنّه كان في واقع الحال من العاملين لديه والداعمين له بكلّ الوسائل.
كان سقوط وادي الضيف والحامدية بحجم سقوط مطار الطبقة العسكري ومعسكر الفرقة 17 قرب دير الزور. كانت الفرقة التي تضمّ عددا كبيرا من الضباط والعناصر العلوية تعتبر من أهمّ الفرق التابعة للنظام ومن أفضلها تسليحا.
بعد الآن سيجد النظام والذين يدعمونه صعوبة في إيصال إمدادات إلى القوات التابعة له والتي تسعى إلى استعادة السيطرة على كلّ حلب، أو أقلّه على جزء أساسي منها.
في كلّ الأحوال، انكشف المبعوث الجديد للأمم المتحدة باكرا. لم تعد البضاعة التي يعرضها قابلة للتسويق، خصوصا أن الوضع على الجبهة الجنوبية، أي في درعا والغوطة ومحيط القنيطرة يتطوّر لمصلحة الثوّار، مع فارق أن حضور “الجيش الحرّ” على طول هذه الجبهة أفضل بكثير من حضوره في مناطق الشمال. ففي الشمال، هناك الوجود القوي لـ”جبهة النصرة” التي تعتبر جزءا لا يتجزّأ من الحركات المتطرّفة، علما أن سلوكها على الأرض ليس بسوء سلوك “داعش”.
باختصار شديد، لا تحتاج سوريا في الوقت الراهن إلى خطط من نوع تلك التي طرحها دي ميستورا لحلب. كلّ ما تحتاجه هو إلى وضوح في الرؤية من منطلق أن النظام السوري انتهى وذلك بغض النظر عن كلّ المساعدات التي تؤمّنها له كلّ من روسيا وإيران ومن يلوذ بهما. انتهى النظام السوري في اليوم الذي لم يجد فيه ما يواجه به المراهقين في درعا غير القمع. انتهى في اليوم الذي ثارت درعا ودمشق وحمص وحماة وحلب ودير الزور وحتّى اللاذقية.
انتهى النظام عمليا في اليوم الذي لم يعد سرّا أنّه نظام طائفي ومذهبي أوّلا وأخيرا وأنّه لولا تدخّل “حزب الله” والميليشيات الشيعية العراقية لمصلحته بطلب إيراني مباشر، ومن منطلق مذهبي بحت، لكانت العاصمة تحرّرت من سطوته منذ فترة طويلة.
هناك حرب مذهبية في سوريا، وإذا كان المطلوب تسمية الأشياء بأسمائها، لا يمكن للعلويين الانتصار في هذه الحرب، ما دامت الأكثرية الساحقة من السنّة ترفض استمرار هيمنتهم، كما ترفض استمرار هيمنة آل الأسد وأقربائهم على مقدرات البلاد. هناك بكلّ بساطة رفض شعبي سوري لبقاء البلد سجنا كبيرا ومزرعة لدى عائلة من العائلات والمحيطين بها من المنتمين إلى مذهب معيّن.
كشفت الثورة السورية حقيقة كلّ الشعارات، من نوع “الممانعة” و”المقاومة” التي استخدمها النظام من أجل تبرير وجوده طوال ما يزيد على أربعة وأربعين عاما. صار كلّ شيء ظاهرا للعيان في سوريا. لم يعد سوى سؤال واحد: من يريد إطالة عمر النظام الذي لا يمتلك ما يتحاور به مع شعبه غير البراميل المتفجّرة؟
الجواب الصريح أنّ لا قرار كبيرا، أقلّه إلى الآن، بتحرير دمشق. الدليل على ذلك ردّ فعل الرئيس باراك أوباما الذي تجاهل فجأة الخطوط الحمر التي وضعها عندما استخدم النظام السلاح الكيميائي في محيط دمشق صيف العام 2013.
في حال كانت الحاجة إلى صراحة أكثر، يمكن القول إنّه لا قرار أميركيا يسمح بتوجيه ضربة قاضية للنظام. هذا ما لا يدركه، أو ما يدركه تماما، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مثلما أنّه يتظاهر بعدم إدراك أن التطورات على الأرض تجاوزت طرحه.
الأخطر من ذلك، أنه كلّما بقي النظام في دمشق، كلّما قويت “النصرة” و”داعش” وكلّ القوى المتطرفة التي يعتقد النظام أنّها تخدم مصلحته نظرا إلى أنّها تظهره في مظهر من يشارك فعلا في الحرب الدولية على الإرهاب.
يقول الواقع عكس ذلك تماما. يقول الواقع إنّ أي اطالة للمأساة السورية عبر الامتناع عن وضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ تفضي إلى الانتهاء من النظام ومن على رأسه، هو أفضل خدمة للتطرّف والمتطرفين الذين سيزداد عديدهم بعد نجاح “النصرة” في إسقاط معسكر وادي الضيف، في وقت تولت مجموعات أخرى على رأسها “حركة أحرار الشام” أمر معسكر الحامدية. كلّما تحققت انتصارات من هذا النوع، زاد عدد السوريين المنضمّين إلى التنظيمات المتطرفة. هل جاء دي ميستورا إلى سوريا لتنفيذ هذا المخطط الذي لا تبدو الإدارة الأميركية بعيدة عنه؟ بكلام آخر، هل جاء من أجل إطالة الحرب في سوريا، بما يكفل تفتيتها نهائيا؟ لعلّ هذا أسوأ ما في الموضوع السوري هذه الأيّام…
 ٢١ ديسمبر ٢٠١٤
٢١ ديسمبر ٢٠١٤
لم تعد قدرة وكفاءة وفعالية المجلس العسكري التابع لتنظيم الدولة الإسلامية موضع شك وجدل، فقد برهن للجميع أنه يمتلك خبرة نظرية وعملية واسعة ويتوافر على رؤية استراتيجية صلبة. ولم تكن نجاحات التنظيم العسكرية وليدة المصادفات البحتة، كما لم تكن نتيجة المؤامرات المحضة، فقد عمد المجلس العسكري منذ تأسيسه على وضع جملة من الخطط والاستراتيجيات المحكمة، كما أن عملية السيطرة على الموصل وعدد من المحافظات السنية في العراق جاءت تتويجا لجهوده المتواصلة.
فقد أعلن المجلس في يوليو/ تموز 2012 عن بدء خطة باسم "هدم الأسوار"، تتضمن عددا محددا من "العمليات العسكرية / الغزوات"، وبعد مرور عام على الإعلان عن الخطة، تمكن المجلس العسكري في 21 تموز/ يوليو 2013 من تحرير قرابة ستمائة معتقل من قادة التنظيم من خلال شن هجوم مزدوج على سجني "أبو غريب"، الذي يقع غرب بغداد، وسجن التاجي في شمالها.
مع الإعلان عن انتهاء خطة "هدم الأسوار"، وضع المجلس العسكري للتنظيم خطة جديدة تهدف إلى السيطرة المكانية على المحافظات السنيّة في العراق، والتمدد والسيطرة على المحافظات السورية، وقد أطلق على الخطة الجديدة اسم "حصاد الأجناد"، في 29 تموز/ يوليو 2013، نفذ خلالها جملة من العمليات انتهت بعملية مركبة ومعقدة أسفرت عن سيطرته على مدينة الموصل في حزيران/ يونيو 2014، وانهارت أمام مقاتليه أربع فرق عسكرية عراقية بسهولة فائقة في عدة مدن ومحافظات عراقية، وقد تكرر ذات السيناريو في سوريا عندما انهارت قوات النظام السوري في محافظة الرقة كما حدث مع الفرقة 17، ومطار الطبقة العسكري، والأمر نفسه حدث مع انهيار قوات البيشمركة الكردية أمام تقدم جنود تنظيم الدولة، قبل أن تتدخل القوات الجوية الأمريكية لصد واحتواء تقدم التنظيم في العراق في الثامن من آب/ أغسطس، ثم بناء تحالف دولي واسع لمنع تقدم التنظيم في سوريا بدءا من 22 أيلول/ سبتمبر الماضي.
تدرك الولايات المتحدة قوة وصلابة التنظيم ونواته الصلبة في المجلس العسكري وصعوبة تفكيكه وهزيمته، ولذلك لم تعد تحتفي كثيرا بمقتل زعمائه وقادته كما كانت تفعل مع اصطياد رؤوس قادة تنظيم القاعدة، فعندما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في 18 كانون أول/ ديسمبر الماضي مقتل عدد من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في ضربات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، لم تحتفل كعادتها وجاء بيانها متواضعا، حيث قال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع: "أستطيع أن أؤكد أنه منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، نجحت ضربات هادفة نفذها التحالف في قتل عدد من كبار قادة ومسؤولين من مستوى أدنى في جماعة الدولة الإسلامية"، ولم يحدد البيان هويات القتلى أو مواقع الضربات، وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن القتلى سقطوا نتيجة "سلسلة من الضربات الجوية التي نفذت خلال هذا الشهر على عدة أيام"، وقال: "أستطيع أن أؤكد أنه منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر أتاحت الضربات الهادفة للتحالف قتل حاجي معتز وعبد الباسط وهما من كبار قادة الدولة الإسلامية".
حاجي معتز المعروف باسم أبو مسلم التركماني، هو قائد المجلس العسكري ومنسق الهجوم على الموصل، وهو الرجل الثاني في التنظيم بعد أبو بكر البغدادي، ومع ذلك لم تصدر عن الولايات المتحدة أي نظرة متفائلة بتأثير مقتله على التنظيم، الأمر الذي تعاملت معه جماعة الدولة الإسلامية ببساطة شديدة، والتزمت بسياستها القائمة على التكتم منذ بدء ضربات التحالف.
يعتبر المجلس العسكري المكوّن الأهم داخل تنظيم الدولة الإسلامية، نظرا لطبيعة التنظيم العسكرية، ولا يوجد عدد محدد لأعضائه بحسب قوته وتوسعه وقوته وضعفه ومساحة نفوذه وسيطرته، ويتكون تاريخيا من 9 أعضاء إلى 13 عضوا، وقد بدأ استخدام تسمية الجهاز بالمجلس العسكري عقب مقتل نعمان منصور الزيدي، المعروف بأبي سليمان الناصر لدين الله، الذي شغل منصب وزير الحرب في مايو/ آيار 2011.
يشغل قائد المجلس العسكري منصب نائب البغدادي، وكان الزرقاوي يحتفظ بالمنصبين، ثم تولى منصب القائد العسكري أبو حمزة المهاجر كوزير للحرب في حقبة دولة العراق الإسلامية وإمارة أبي عمر البغدادي، وفي ولاية الأمير الحالي أبو بكر البغدادي تولى منصب القائد العسكري حجي بكر، وهو سمير عبد محمد الخليفاوي، ثم شغل المنصب بعد مقتله في سوريا في كانون ثاني/ يناير 2014 أبوعبدالرحمن البيلاوي، وهو عدنان إسماعيل البيلاوي، الذي قتل في 4 حزيران/ يونيو 2014، حيث تولى رئاسة المجلس العسكري أبومسلم التركماني، وهو فاضل أحمد عبد الله الحيالي، المعروف باسم "أبو معتز"، و"أبو مسلم التركماني العفري"، الذي كان في ولاية نينوى. ويتكون المجلس العسكري من قادة القواطع، وكل قاطع يتكون من ثلاث كتائب، وكل كتيبة تضم 300 -350 مقاتل، وتنقسم الكتيبة إلى عدد من السرايا تضم كل سرية 50 - 60 مقاتل.
ينقسم المجلس العسكري إلى هيئة الأركان وقوات الاقتحام، والاستشهاديين، وقوات الدعم اللوجستي، وقوات القنص، وقوات التفخيخ، ومن قيادات المجلس العسكري أبو أحمد العلواني: وليد جاسم، وعدنان لطيف حميد السويداوي، المعروف بــ"أبي مهند السويداوي"، أو "أبي عبد السلام"، ومن المرجح تعيين أبو أحمد العلواني خلفا لأبي مسلم التركماني في منصب قيادة المجلس العسكري، وقد تم ضم القائد العسكري عمر الشيشاني إلى عضوية المجلس، ويقوم المجلس بكافة الوظائف والمهمات العسكرية، كالتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المعارك، وتجهيز الغزوات، وعمليات الإشراف والمراقبة والتقويم لعمل الأمراء العسكريين، بالإضافة إلى تولي وإدارة شؤون التسليح والغنائم العسكرية.
ويعمل المجلس العسكري إلى جانب المجلس الأمن وهو أحد أهم المجالس في تنظيم الدولة الإسلامية وأخطرها، إذ يقوم بوظيفة الأمن والاستخبارات، ويتولى رئاسته أبو علي الأنباري، وهو ضابط استخبارات سابق في الجيش العراقي، ولديه مجموعة من النواب والمساعدين، ويتولى المجلس الشؤون الأمنية للتنظيم، وكل ما يتعلق بالأمن الشخصي لـ"الخليفة"، وتأمين أماكن إقامة البغدادي ومواعيده وتنقلاته، ومتابعة القرارات التي يقرها البغدادي ومدى جدية الولاة في تنفيذها، ويقوم بمراقبة عمل الأمراء الأمنيين في الولايات والقواطع والمدن، كما يشرف على تنفيذ أحكام القضاء وإقامة الحدود، واختراق التنظيمات المعادية، وحماية التنظيم من الاختراق، كما يقوم بالإشراف على الوحدات الخاصة كوحدة الاستشهاديين والانغماسيين بالتنسيق مع المجلس العسكري. ويشرف المجلس على صيانة التنظيم من الاختراق، ولديه مفارز في كل ولاية تقوم بنقل البريد وتنسيق التواصل بين مفاصل التنظيم في جميع قواطع الولاية، كما أن لديه مفارز خاصة للاغتيالات السياسية النوعية والخطف وجمع الأموال.
تبرز أهمية المجلس العسكري من طبيعة تركيبة تنظيم الدولة المسلحة، إذ يقسم مناطق نفوذه إلى وحداتٍ إدارية يطلق عليها اسم "ولايات"، وهي التسمية الإسلامية التاريخية للجغرافيا السكانية، ويتولى مسؤولية "الولايات" مجموعة من الأمراء، وهي التسمية المتداولة للحكام في التراث السياسي الإسلامي التاريخي، ويبلغ عدد الولايات التي تقع ضمن دائرة سيطرة التنظيم أو نفوذه 16 ولاية، نصفها في العراق، وهي: ولاية ديالى، ولاية الجنوب، ولاية صلاح الدين، ولاية الأنبار، ولاية كركوك، ولاية نينوى، ولاية شمال بغداد، ولاية بغداد، ونصفها الآخر في سوريا، وهي: ولاية حمص، ولاية حلب، ولاية الخير (دير الزور)، ولاية البركة (الحسكة)، ولاية البادية، ولاية الرقة، ولاية حماة وولاية دمشق، وتقسّم "الولايات" إلى "قواطع".
خلاصة الأمر أن تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر الحركات الجهادية العالمية تطورا على المستوى الهيكلي التنظيمي والفعالية الإدارية، ويعتبر المجلس العسكري الأهم نطرا لطبيعة التنظيم المسلحة، فقد تطورت أبنية الدولة التنظيمية بالاستناد إلى المزاوجة بين الأشكال التنظيمية الإسلامية التقليدية، التي تكونت مع مؤسسة الخلافة، وتنظيرات الفقه السلطاني الذي يؤسس لمفهوم الدولة السلطانية، إذ يقوم على مبدأ الغلبة والشوكة والإمارة، إلى جانب الأشكال التنظيمية الحداثية لمفهوم الدولة الذي يستند إلى جهاز عسكري أمني وآخر إيديولوجي بيروقراطي، ومنذ السيطرة على الموصل تضاعف عدد أعضائه ليصل إلى أكثر من (100) ألف مقاتل، من العراقيين والسوريين، ويضم في صفوفه أكثر من (9) آلاف مقاتل عربي ومسلم أجنبي، إلا أن البنية الأساسية لقوات النخبة تصل إلى حدود (15) مقاتل، ولذلك لم تعد سياسة قطع الرؤوس التي تتبعها الولايات المتحدة كافية في زعزعة تماسك تنظيم الدولة الإسلامية.
 ٢١ ديسمبر ٢٠١٤
٢١ ديسمبر ٢٠١٤
اعتادت الأنظمةُ السياسية الشمولية على التمسح بالـ شعب. كل كلمتين يقولهما فريقُ الخطباء الذين يمثلون هذه الأنظمة ثالثتهما: شعب.
إذا كان ذهنك مشغولاً بعملٍ ما، وبجوارك راديو يبث خطاباً لأحدهم، تستطيع أن تلاحظ وجود إيقاع (رتم) للخطاب، هو كلمة (شعب)، تأتي في موضع محدد من كل جملة يقولها الخطيب.
كان حافظ الأسد من ألدّ أعداء الشعب السوري، إلا أنه لم يكن يتوقف عن التغني بالـ شعب! ولئن كانت دول العالم تسمي المجالسَ التشريعية برلماناً، أو مجلساً نيابياً، أو مجلساً للعموم، فإن البرلمان السوري قد سمي، بإيعاز من حافظ الأسد: مجلس الشعب.
فلان كاتب الشعب، وعلان فنان الشعب، وأما حافظ الأسد فهو، بحسب ما غنى جورج وسوف في سنة 1992، حبيب الشعب، وأمل الملايين.
بشار الأسد الذي أصبح رئيساً للجمهورية العربية السورية رغماً عن أنف الشعب، تحدث في خطاب القَسَم، مطولاً، عن الشعب، وحينما انطلقت الثورة ضده، من درعا، وأعطى لجنوده صلاحيات مطلقة في قتل أبناء الشعب، واعتقالهم، وسحلهم في الشوارع، وإذاقتهم أقسى صنوف العذاب؛ لم تطاوعه نفسه أن يخاطب الشعب بحديث متلفز، بل ذهب إلى مجلس الشعب الذي يُعرف باسم "مجلس التصفيق والدبكة"، فوجد الدبكة، بالفعل، معقودة أمامه، وأعضاء المجلس يعترضون طريقه بالهتاف والتصفيق، وترداد عبارة (الله، سورية، بشار وبس).. وفي أثناء الخطاب، راح هو يشوبر بيديه ويضحك (مثل الهبلان)، وراح أولئك الإمَّعاتُ يقاطعونه بعبارة (الله، سورية، بشار وبس)، ووقتها جادت قريحته فارتجل عبارة:
- أنتم تقولون الله، سورية، بشار وبس، وأما أنا فأقول: الله، سورية، (شعبي) وبس.
كان عدد الشهداء في اليوم الثلاثين من مارس/آذار 2011، حينما ألقى بشار الأسد ذلك الخطاب، في حدود الألفين، وكان الشعب السوري حزيناً جداً، ومرعوباً من احتمالات المستقبل، ينتظر من هذا الشخص الذي فُرض عليه بالقوة أن يقول شيئاً يؤدي إلى خلاصٍ ما، وبطريقة ما.. فلما رآه يتوقف عن الكلام كل خمس دقائق ويضحك (ويتكركر)، نزل إلى الشارع، بمئات الألوف، بل وبالملايين، واضعاً دمه على كفه، مؤمناً، أكثر من قبل بكثير، بأن الوقت حان للتخلص من هذه السلالة الكريهة، مهما بلغت التضحيات.
استبسل نظام الأسد، في تلك الفترة، من أجل إظهار أن (الشعب) معه، فكان يأمر مخابراته وحواشيه ومؤيديه بالنزول إلى الشوارع، وحمل الصور واللافتات التي تقول إن (الشعب) مستعد أن يتخلى عن حياته وروحه، في سبيل أن يبقى هو جاثماً على صدر الشعب.
كنا، نحن المعارضين، نظهر على الفضائيات، وتوجه إلينا الأسئلة حول ما يجري في سورية، فنقول إنها ثورة (شعب).. وتظهر في عمق الشاشة صور لمئات الألوف من أبناء الشعب السوري، وهم يرددون الهتافات التي تدعو إلى رحيل بشار الأسد، ولا ينسون والده، مؤسس جمهورية الرعب، حافظ الأسد، من لعناتهم.
وكان مؤيدو الديكتاتورية السوريون، إضافة إلى مؤيديه اللبنانيين، يظهرون على الفضائيات، ويشيرون إلى مسيرات التأييد، ويقولون: الشعب مع بشار، أنظروا، ها هو (الشعب)، حتى إن النائب اللبناني الأسبق ذي الوجه البسام، وئام وهاب، ظهر مرة على قناة (ANB)، وقال إنه مستغرب مما يقال بأن هناك في الشام ثورة، وأضاف: أنا الآن أتيت من الشام، ما فيها ثورة ولا ما يحزنون.
الخلاصة: لا شك في أن الحديث عن إرادة الشعب تدخل في باب الإنشاء الخطابي. والحقيقة أنني لم أسمع ناطقاً باسم النظام، أو باسم المعارضة، يقول الحقيقة، وهي: أن قسماً من الشعب يثور على نظام الأسد، وقسماً آخر يؤيده، وقسماً ثالثاً لا يريد أن يبقى النظام، ولكنه، في الوقت نفسه، لا يريد أن تحكمه المنظمات الجهادية التي تطرح نفسها بديلاً لهذا النظام.