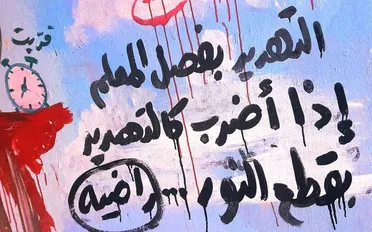هل يستمر التوافق الروسي ـ التركي في سورية؟
كان تقارب روسيا وتركيا، أخيرا، في سورية ضرورة استراتيجية لكلا الطرفين، بعدما اكتشفا، خلال فترة القطيعة السياسية التي استمرت ثمانية أشهر عقب إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أنهما بحاجة إلى بعضهما، وأنه من دون تفاهم مشترك لن تستطيعا تحقيق أهدافهما في سورية.
تعرّضت أنقرة، في العامين الماضيين خصوصا، إلى تصدّع جيوسياسي، نتيجة انهيار ميزان القوى المحيط بها في سورية، بفعل الانكفاء الأميركي والهجوم الروسي. وترتب على ذلك ليس تراجع حضورها في الملف السوري فحسب، بل أصبح هذا الملف بعد تضخم الحالة الكردية السورية عبئا كبيرا يثقل الحكومة التركية، ويهدد أراضيها في الداخل. في المقابل، توصلت موسكو إلى قناعةٍ خلال فترة القطيعة نفسها، وهي في عز صولاتها وجولاتها العسكرية في سورية، إلى أنه من دون تفاهم مع أنقرة، فإن الجهود الروسية قد لا تتحقق، أو تحتاج على الأقل إلى فترات زمنية طويلة، لن تكون في مصلحة الكرملين.
كشفت القطيعة السياسية هذه حاجة الدولتين بعضهما إلى بعض، في ظل توتر شديد يجمعهما تجاه الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة. ومن هنا، بدأ التلاقي بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، إلى أن توّج في لقاء سان بطرسبورغ بين الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في أغسطس/ آب. ولم يكن ذلك اللقاء عنوانا لعودة العلاقات السياسية فقط، بل كان بمثابة القمة الملحة التي أسست لتفاهماتٍ استراتيجية بينهما في سورية، عبرت عن نفسها أولا بدخول تركيا إلى الشمال السوري، في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، تحت عنوان عملية "درع الفرات"، بعدما منعت أنقرة، طوال الأزمة السورية، من الدخول إلى الشمال السوري، وثانيا مع ابتعاد تركيا عن ملف حلب، وثالثا مع "إعلان موسكو" حول الهدنة العسكرية، ورابعا اجتماع أستانة.
تطلب ذلك نزول الطرفين من على شجرتهما العالية: وافقت تركيا على خفض سقف خطابها السياسي تجاه الأسد، ووافقت على هدنةٍ عسكرية، ثم وافقت على مشروع عزل جبهة فتح الشام، وغيرها من الفصائل المدرجة تحت لائحة الإرهاب، ووافقت، أخيرا، على إدخال فرقاء سياسيين جدد في وفد المعارضة للمفاوضات.
في المقابل، وافقت موسكو على الاعتراف بفصائل الجيش الحر والفصائل الإسلامية المدعومة من دول إقليمية، لا سيما "أحرار الشام" و "جيش الإسلام" اللذين كانا في قائمة اللوحة السوداء لروسيا، كما أكدت موسكو أن حل الأزمة السورية لا يكون إلا عبر المسار السياسي والمرجعيات التي تم التوافق عليها دوليا، ووافقت موسكو ضمنيا على ضرورة التخفيف من حدة الدور الإيراني في سورية.
شكل وقف إطلاق النار واجتماع أستانة ذروة التعاون الروسي ـ التركي. لكن، سرعان ما طفت الخلافات بين الجانبين سريعا مع الانتقال من المستوى العسكري إلى المستوى السياسي.
وقد حاول الروس، مستفيدين من الاندفاعة التركية، إضعاف المعارضة السياسية، عبر إدخال قوى أخرى، هي أقرب إلى النظام منه إلى المعارضة، في خطوةٍ تهدف إلى كسر احتكار الهيئة العليا للمفاوضات المرجعية السياسية للمفاوضات. لكن أنقرة وجدت أن المضي في المسار الروسي سيضعف حضورها السياسي في الملف السوري بشكل عام، على الرغم من حصولها على مكاسب عسكرية ذات أهمية كبيرة في حماية أمنها القومي.
هنا بدأ التباين الروسي ـ التركي، خصوصا في ما يتعلق بتوسيع وفد المفاوضات التابع للهيئة العليا للمعارضة، وأدركت تركيا أن الروس يحاولون ضعضعة الهيئة العليا للمفاوضات، عبر تقوية الفريق العسكري على حساب الفريق السياسي، أي بعبارة أخرى منح فريق أستانة العسكري قوةً تُجاري فريق الرياض، وربما تفوقه أولا، وعبر إدخال منصاتٍ سياسيةٍ أخرى ثانيا.
ومن هنا، كانت اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات مع الائتلاف الوطني من جهة، واجتماع الرياض من جهة أخرى، محاولة تركية ـ سعودية للتخفيف من الاندفاعة الروسية، وتلطيف مطالبها من دون المواجهة معها، أو رفض كل مطالبها. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى مسألة المرجعية السياسية للمفاوضات، وإذا كانت تركيا قد وافقت على إعلان أستانة الذي استبعد بيان جنيف كاملا، فإنها تحاول عرقلته بطرقٍ غير مباشرة، تاركة هذا الملف للمعارضة والرياض.
ومما ينبئ بارتفاع حدة التباينات بين الجانبين، وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة البيت الأبيض في الولايات المتحدة، ومحاولته الانفتاح على تركيا، بعد جمود سياسي استحكم العلاقات التركية ـ الأميركية خلال السنوات الأخيرة من حكم باراك أوباما، وبدأ التغير الأميركي ملحوظا تجاه تركيا مع ارتفاع مستوى الدعم الجوي للتحالف الدولي عملية "درع الفرات" في مدينة الباب في الأيام الماضية. ثم جاء التنسيق بين الجانبين لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة دليلا على أهمية تركيا بالنسبة للولايات المتحدة، ليس فقط في محاربة الإرهاب، وإنما أيضا في عموم المشهد العسكري في الشمال السوري، وخصوصا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة التي طالما دعت إليها تركيا خلال السنوات الماضية.
قد تشكل المنطقة الآمنة بداية الافتراق الروسي ـ التركي، حيث ترفض موسكو إقامة مناطق آمنة، قبيل اكتمال المشهد العسكري في عموم سورية، وهو المشهد الذي عملت بجد على رسمه وتحديده، ولا تقبل أن تتشكل هذه المناطق في الشمال السوري، خصوصا من البوابة التركية. وقد جاء الرد من موسكو سريعا على إعلان تركيا موافقتها تحويل منطقة "درع الفرات" إلى منطقةٍ آمنة، حين أعلن مدير القسم الأوروبي الرابع في وزارة الخارجية الروسية "أن موسكو ترى أنه من غير الصحيح اعتبار أنه لا توجد لدى تركيا أهدافها الخاصة في سورية إلى جانب محاربة داعش".
المشكلة التي تواجه صناع القرار في أنقرة أن السياسة الأميركية تجاه سورية لا تزال غامضة، ولن تخاطر تركيا برمي الثمار التي حققتها من البوابة الروسية سريعا، لكنها في المقابل لن تتخلى عن إقامة المنطقة الآمنة، لأسباب كثيرة بعضها مرتبط بالشأن التركي الداخلي، وبعضها مرتبط بالشأن السوري. وستحاول تركيا تحقيق أهدافها باستخدام سياسة ناعمة ومرنة، تقرّبها من واشنطن، ولا تبعدها عن موسكو في الوقت نفسه، وهي سياسة صعبة في ظل العودة الأميركية إلى الواقع السوري، وما هو واضح إلى الآن أن التعاون التركي الروسي بلغ ذروته، وستكشف المرحلة المقبلة مدى صلابة هذا التعاون، والحدود التي قد يصل إليها.