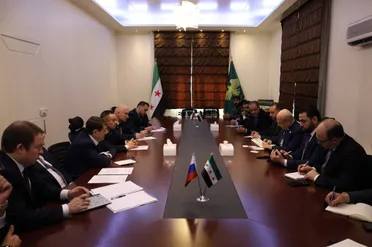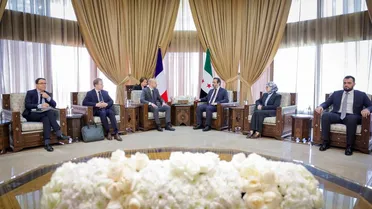مجتمع قوي، معارضة ضعيفة
حتى مارس/ آذار من عام 2011، كانت تسيطر على الأوساط الثقافية والسياسية فكرة ترى أن النظام في سورية قوي والمجتمع ضعيف. وكان من الوعي السائد أن النظام نجح في تسطيح عقل السوريين، وتدمير قيمهم ونواظم عيشهم، وخصوصا الوطنية منها، ومزق مجتمعهم إلى مجموعاتٍ لا رابط بينها غير الخلاف، وحفر هوة واسعة بين نخبه المتناحرة وكتلته الكبرى غير المسيسة، التي تشترك في سكوتها المطبق على الاستبداد، الذي تتعرّض له وهي مكتوفة اليدين، على الرغم مما تعانيه من تدهور في معاشها، وانهيار في مكانتها، وغربة عن الشؤون العامة. في المقابل، كانت السلطة تبدو متماسكةً وقادرة على احتواء أي ظاهرة تبرز عند قاع المجتمع، فهي موحدة، تنصاع لشخصٍ لا يخرج أحد من منتسبيها على ما يراه ويقرّره، ومن الذي يمكن أن يفكر، ولو مجرد تفكير، بالخروج عليه قائدا مطاعا لدولة عميقة تضم ملايين الموظفين والمخبرين، يساندها جيش جرّار يؤمر فيطيع، تربطه عصبيات مركبة، همّ قيادته الرئيس إثارة الشقاق في جسد الهيئة المجتمعية العامة، وتنظيم وحدة القلة المؤيدة له، واعتبار المواطنين سكان مستعمرة يمسك بخناقها.
بعد شهر الثورة في مارس/ آذار من عام 2011، تأكد أن هذه الصورة ليست صحيحة، وأن المجتمع ليس فقط غير ضعيف، بل هو أقوى من السلطة، وإلا لما حرّر، خلال أقل من عامين، قرابة ثلثي سورية، وطرد جيش النظام "القوي"، وشبيحته وأجهزته القمعية، منها، وتصدّى بنجاح لمن يساندونه من مرتزقة متعددي الجنسيات، انضموا إلى صفوفه، بينما كان جيشه "الوطني" يتصرف باعتباره قوة استعمارية داخلية، وليس مؤسسة عسكرية وطنية، منظمة وتحمي شعبها ودولتها.
بهذا الدور الاستعماري الداخلي، الذي استفز أعدادا كبيرة من مواطني سورية، ممن يمضون خدمتهم فيه، وبما أبداه الشعب من تصميمٍ على التمسّك بحريته هدفا لا يحيد عنه، تبيّن أن الجيش الذي كان يبدو متماسكا وموحدا لم يكن كذلك في حقيقة الأمر، وأنّ النظام الذي خطط، منذ سنوات، لمعركة شاملة يقتلع خلالها الشعب السوري من جذوره، بمجرد أن تصدر عنه صرخة احتجاج واحدة، لم يكن قويا بالقدر الذي حاول إيهام السوريين به، ولو كان قويا حقا لما استنجد بإيران وحزب الله عام 2012 وبالروس عام 2015، ودعاهم، في الحالتين، إلى النهوض بأعباء الحرب، عوضا عن عسكره الذين افتضحوا طائفيين، لا وطن لهم، لكنهم تهشموا وفقدوا القدرة على كسب أي معركةٍ، طوال نيف وعام في التاريخ الأول، وأيقنوا أنّ دمشق ساقطة لا محالة خلال شهرين في التاريخ الثاني، بينما لم يطلب الجيش الحر أي تدخل خارجي من أي طرف، وواجه، بقواه الذاتية، التصعيد الاستثنائي الذي تعرّض له في التاريخين، على الرغم مما وقع من تبدل في ظروف المعارك، نتيجة استخدام أسلحة حديثة ضده لم تعرفها أي حرب من قبل، وما تكبده الشعب الأعزل من خسائر جسيمة بسببها، وعاناه من حصار وتجويع وقصف عشوائي وأسلحة كيميائية، لو انصب عشر ما استهدفه من صواريخ على مليشيا الأسد لما بقي منها صافر نار.
واليوم، لا يستطيع أحد القول إن مجتمع سورية هزم، لأنه لم ولن يهزم، وإن النظام انتصر لأنه هزم مرتين في ثلاثة أعوام. فضلا عن أنّ هناك شهادات دولية تتحدث عن استحالة حله العسكري، والسبب: استحالة أن يتمكن جيشٌ لم يعد موجودا من كسب حرب، عجز عن خوض معاركها عندما كانت أوضاعه أفضل بكثير من وضعه المزري الراهن، بدليل نجاح قبضة "داعشيين" من الوصول خلال ساعات من مناطق ادّعى أنّه طردهم منها إلى مشارف حمص!
أثبت المجتمع السوري أنه قوي بذاته، لكنه ليس قويا بمن يمثلونه، ويعتقدون أنهم قادته، وأثبتوا، خلال نيف وسبعة أعوام، أنهم لم يكونوا في مستوى ثورته وتضحياته، ولو كانوا لسقط الأسد ونظامه منذ سنوات، ولما تكبد السوريون الخسائر الهائلة التي تعرّضوا لها. لذلك، يصح قولي مع القائلين: عندما أنظر إلى الشعب أقول هناك ثورة، وحين أنظر إلى النخب السياسية والعسكرية، أهز رأسي حسرة وأسفا.
ترى: أما حان الوقت كي نرتفع، نحن النخب، إلى مستوى شعب عصي على الهزيمة، ونوقف ما نبذله من جهود لخدمة أعدائه: عن وعي أو تفاهة؟