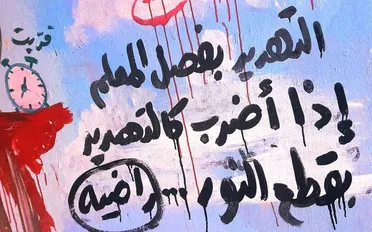سورية: الثورة والحرب والدمار و... ذكرى عيد الحب
طالت مأساة سورية حتى أضحت مجرياتها ذكريات حية وجروحاً لا تندمل. كلما بهتت صور بعض سيرتها الأولى ومعاناتها الملحمية وآمالها وأخطائها وتراجعت عن الانشغال الحالي، جاءت مآسٍ جديدة تبقي الصور نابضة في البال وتصل الحاضر بالماضي القريب بخيوط من نار ودم وخراب وخيبات أمل وتعطش إلى العدالة.
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية ذات عنوان مرعب «المسلخ البشري» عن إجرام ممنهج في سجون النظام السوري، وبشكل خاص سجن صيدنايا الرهيب، ما زال يلغ في دماء المعتقلين المخفيين تحت رادار الرقابة القانونية والدولية لسنين ولم تكشفه أي جهة من قبل. ثم أتت المنظمة وكشفت بعد سبر وتدقيق مطولين أن ما بين ٢٠ و٥٠ معتقلاً كانوا يعدمون اسبوعياً بعد محاكمات صورية، وتدفن جثثهم في مقابر جماعية منذ بداية الثورة عام ٢٠١١. قدر تقرير منظمة العفو عدد من قضوا بهذه الطريقة الرهيبة بما بين خمسة وثلاثة عشر ألفاً من المواطنين المعتقلين تعسفياً حتى نهاية ٢٠١٥، حيث يبدو أن معظم مصادر التقرير الأساسي (أربعة حراس وقاضٍ) غادروا مواقعهم ولم يعد ممكناً لهم الشهادة على هذه الممارسات.
لكن المنظمة ترجح أن الإعدامات لم تتوقف حتى اليوم، إذ لم يتغير من شروط ارتكابها شيء. أي أن أولئك الذين قضوا في السنوات الأربع الأولى من الثورة لم يتحولوا إلى فاجعة ماضية، ربما كان بالإمكان توجيهها نحو فعاليات نضالية أو ملاحقات قانونية أو بدايات لتسكين آلام من فقدوا حبيباً أو قريباً. بل يبدو أن الفاجعة مستمرة بلا توقف في أقبية السجون المظلمة، حيث لا رقيب ولا صدى للعذابات. وتبقى أعداد الضحايا تتراكم بعد أن توقفت كل المنظمات الدولية عن تسجيلها وتمحيصها ماعدا المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي وثق ما لا يقل عن ستين ألف ضحية للتعذيب، بمن فيهم أولئك الضحايا المشوهون بطرق مرعبة الذين سجلتهم عدسة المدعو «سيزار»، والذين تراوحت تقديرات أعدادهم بين الخمسة والستة آلاف ضحية.
كذلك الحال بالنسبة للتدمير الهائل الذي أصاب مختلف أنحاء البلاد (ما عدا الساحل ووسط دمشق لأسباب واضحة). تراجعت أسماء أماكن وأحياء مثل باب عمرو ودرعا البلد وجوبر وحتى داريا، التي نكأ التدمير الشديد الذي أصابها في بدايات الثورة الشاشات والقلوب، وحلت محلها حلب القديمة ومدن صغيرة في أدلب دمرها سلاحا الجو السوري والروسي وتكالب من كانوا أخوة وأصبحوا أعداءً عليها قصفاً وتفجيراً. وغداً ربما ستزيح خرابات غيرها من الأماكن صورها السائدة اليوم لتأخذ مكانها على شاشات التلفزيون وتقارير المنظمات الدولية، وفي خطابات المشيعين والشامتين في آن. ويبقى البلد ككل وكأنه على فوهة مفرمة لا تتوقف، تقضمها قطعة قطعة وتلفظها أطلالاً وحطاماً وتجبر أهلها على النزوح والتشتت والهجرة. وعلى رغم أن بعض شركات إعادة البناء من دول مولت القتال في سورية بل شاركت فيه مباشرة، مثل إيران، قدمت مخططات لإعادة البناء في مناطق مختارة من سورية، إلا أن المهزلة لا تغيب عن أحد. فالهدم بيد وادعاء إعادة البناء باليد الأخرى ليس فقط رياء ولكنه استثمار مضاعف تجنى منه الأرباح المادية على الطالع والنازل، وتتغير نتيجته خريطة البلد الديموغرافية والأيديولوجية.
أما مأساة اللاجئين فما زالت تتفاقم باستمرار تدفقهم من مناطق مختلفة إلى ملاجئ الداخل والخارج على السواء، وإن تراجعت قدرة ورغبة دول الجوار والشتات البعيد على الاستيعاب والترحيب. بعض المناطق التي هجرت حديثاً لم تعان هذه المشكلة في السنوات السابقة، ولكنها انضمت اليوم إلى المناطق المنكوبة ولحقتها في استفراغ معظم سكانها ودمار غالبية منشآتها، بخاصة مع احتدام الكر والفر في شمال البلاد وشمالها الشرقي بين داعش والنظام وحلفائه والجهاديين المختلفين والقوات الكردية والكردية-العربية وتلك المدعومة من تركيا. يختفي خلفهم كلهم ويغذيهم مالاً وحقداً وانتقاماً وقصر نظر ممولون متباينون من أعظم الدول إلى أقربها انتماءً ممن استمرأوا اتخاذ سورية مسرحاً لتجريب سياساتهم وإستراتيجياتهم ومبتكراتهم القاتلة.
معاناة لاجئي سورية تزداد لأن ضغط الهجرة خلفهم وإغلاق أبوابها أمامهم، بخاصة بعد قرار ترامب المتعنت والمتعجرف بإيقاف برامج الهجرة السورية إلى أجل غير مسمى، وضعهم في خانة حرجة وضيقة لا يبدو أن لها مخرجاً قريباً. ولكن هذه المأساة تحولت من مشكلة سورية إلى أخرى عالمية، ولا يبدو أن مضاعفاتها الممكنة ترشد صانعي قرارات التضييق على اللاجئين الذين يتعامون عنها ويفضلون الشعبوية والعنصرية على الإنسانية والقوانين الدولية. وتكبر أجيال من الأطفال السوريين في المخيمات بلا تعليم مناسب لكي تتخرج لاحقاً إلى مدارس البؤس واليأس والضياع وربما الإرهاب.
اليوم، ونحن على أعتاب عيد الحب الذي ابتدأ غربياً وأضحى عالمياً، أود لنا أن نتذكر، ونحن نغص بذكريات الثورة السورية الحية الآلام، ذلك الرجل الحلبي المجهول الاسم الذي سحله زبانية النظام في الشوارع قبل قتله في مثل هذه الأيام من ٢٠١٣، ثم صوروا جريمتهم ونشروها على اليوتيوب. حسام عيتاني كتب في «الحياة» يومها مقالاً بعنوان «فالنتين السوري» يهصر القلب (الحياة، الجمعة ١٥/2/٢٠١٣). فهذا الرجل المدمى والمعذب وشبه العاري والمربوط من ساعديه بحبل تجره سيارة عسكرية، يرفض أن يدل القتلة على عنوانه لكي يغتصبوا زوجته مقابل السماح له بتوديعها وأطفاله قبل قتله. وهو يجيب عن طلبهم الوقح وقهقهاتهم القميئة بوصف زوجته بعبارة رائعة في شغفها وإنسانيتها العميقة ذات النكهة المحلية: «بنت عمي وتاج راسي». ويتحول هذا البطل المجهول، على رغم ميتته المذلة والشديدة الإيلام، إلى شهيد الحب الأول بلا منازع وقديسه على غرار القديس فالنتين نفسه. ويضرب بشهادته مثلاً على النبل العادي والشعبي الذي لم تتمكن سنوات القهر الأسدي الطويلة من نزعها من وجدان الإنسان السوري البسيط، الذي سيبقى نبراساً على درب جلجلة سورية الطويل في استعادتها لأمان أبنائها وكرامتهم، وحريتهم في نهاية الأمر، على رغم أنف الحاضر المزري.