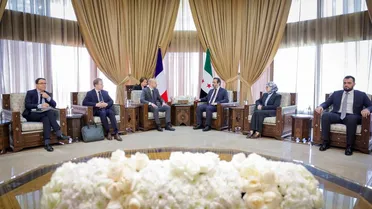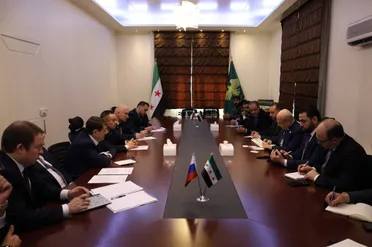الاحتلال اللغوي لسورية يوازي الاحتلال العسكري
فرضت الدول الثلاث التي تحتل سورية، مع اختلاف في طبيعة هذا الاحتلال وحجمه، لغاتِها التركية والفارسية والروسية على المواطنين السوريين في الأماكن الخاضعة لسيطرتها. وبذلك صار على الأطفال في هذا البلد العربي المنكوب، أن يتعلموا لغة أجنبية مفروضة عليهم، على حساب لغتهم العربية. وقد يُرغم هؤلاء الأطفال على تعلم لغتين على الأقل من اللغات الثلاث التي باتت اليوم هي السائدة في المناطق الخاضعة للهيمنة الشاملة من طرف الدول الثلاث. والمسألة إلى هنا ليست تقديم خدمات تربوية لقطاع واسع من الشعب السوري حرم من فرص التربية والتعليم، التي من المفترض أن تتيحها له حكومة بلاده، لو أنها كانت حرة، وليست تابعة للنفوذ الأجنبي، خصوصاً النفوذ الروسي والإيراني، ولكنها مسألة استقلال مغصوب ووطن منهوب، وتمهيد لفرض الهيمنة الأجنبية بالكامل على سورية لأطول فترة ممكنة.
حتى الاستعمار الفرنسي الذي فرض على سورية عقب الحرب العالمية الأولى، تحت مسمى الانتداب، لم يفلح في إلغاء اللغة العربية، وفي فرض اللغة الفرنسية بدلاً منها بالإكراه. وكانت قبله الدولة العثمانية تبسط نفوذها على الشام والعراق، مع استمرار اللغة العربية في النماء والانتشار بين الشعوب العربية في تلك المناطق أو «الولايات العربية»، كما كان يطلق عليها، على رغم مزاحمة اللغة التركية لها، فاحتفظت بأصالتها في حدود الإمكان، وظلت لغة الثقافة والفكر والأدب والشعر، وإنْ في حدود ضيقة، وتدرَّس بها العلوم الدينية، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدأ تدريس العلوم العصرية بها. ولعل مكتب عنبر، وهو المؤسسة التعليمية الرائدة والشهيرة في دمشق، خير مثال للحفاظ على اللغة العربية في سورية. ففي هذه المؤسسة درس وتخرج شخصيات كان لها حضور مؤثر في تاريخ سورية وقامت بأدوار متميزة في النهضة العلمية والثقافية.
إن إجبار الأطفال السوريين على تعلم اللغات التركية والفارسية والروسية فوق ترابهم الوطني، مع الضعف الملحوظ في تعليمهم اللغة العربية، هو بكل المقاييس، استلاب ثقافي كامل الأركان، وانتهاك صارخ لحق أصيل من حقوق الإنسان، بقدر ما هو إيذان بأن الوجود الأجنبي فوق الأراضي السورية، ليس له من نهاية في المديين المتوسط والطويل. الأمر الذي يؤكد أن الأزمة السورية لن تعرف انفراجاً، حتى وإن زعمت روسيا أنها في سبيلها إلى إيجاد «تسوية سياسية» لها. فما تلك التسوية السياسية المزعومة سوى شكل مبتكر من ترسيخ الوجود الروسي في سورية. ويقابل هذا الخطرَ الذي يهدد شخصية الفرد والمجتمع في سورية، عمليةُ التوطين التي تقوم على قدم وساق من طرف إيران، بإحلال جماعات أفغانية وباكستانية وأخرى إيرانية محل المواطنين السوريين الذين اقتلعوا من مواطنهم وأرغموا على النزوح إلى مناطق أخرى، خصوصاً إدلب التي باتت اليوم مستودعاً للنازحين من مدنهم وقراهم، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار المفضي إلى الدمار، لتتكرر مأساة حلب التي دمرت بالكامل، بإخراج جديد.
إن إفراغ سورية من شعبها وإخضاع مَن تبقى منه لعملية تشويه لهويته، إلى جانب إهدار كرامته، هما الخطر الحقيقي المحدق بهذا الشعب العربي الذي حمل لواء الحضارة العربية الإسلامية عقوداً متطاولة من الزمن، وكان أعلامُه الروادُ من أبرز البناة للنهضة العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ويتحمل النظام الطائفي الاستبدادي، المسؤولية الرئيسَة في تدمير سورية وإفراغ شخصيتها من مضمونها الحضاري العربي الإسلامي، إلى جانب المسؤولية التي تتحملها روسيا الاتحادية وإيران، في هذه المأساة الإنسانية التي لا يعرف العالم اليوم شبيهاً لها. أما تركيا، فهي وإن كانت تعلن عن انحيازها إلى انتفاضة الشعب السوري، إلا أنها انخرطت في تفاهمات غير واضحة مع روسيا يخشى أن تكون في الاتجاه المعاكس لإرادة الشعب السوري، وإن كان يقدّر لها أنها تأوي فوق أراضيها نحواً من ثلاثة ملايين من اللاجئين السوريين.
فإذا كان الاحتلال اللغوي يوازي، من وجوه كثيرة، الاحتلال العسكري، فإنه بطبيعته يساهم في تعزيز هذا الاحتلال، وفي إطالة أمده، حتى يصبح أمراً واقعياً.
الأدهى من هذا كله، أن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونيسكو، بل مجلس الأمن الدولي، في منأى مما يجري اليوم على الأراضي السورية من جرائم ضد الإنسانية.