 ١٠ مارس ٢٠١٥
١٠ مارس ٢٠١٥
انشغلت قوى المعارضة السورية في الشهرين الأخيرين ببحث جوانب مختلفة للقضية السورية. وكان الأبرز في هذه الانشغالات لقاءات وحوارات، حصلت في القاهرة وإسطنبول ومدن أخرى في أوروبا، كان الأهم فيها موضوع الحل السياسي في سوريا، وما يحيط به من تفاصيل وحيثيات، تجعله قابلا للتحقق، وممكنا للتنفيذ.
وانشغال قوى المعارضة بموضوع الحل السياسي، لا ينفصل عن التطورات المحيطة بالقضية، ووعي المعارضة للضرورات السياسية القائمة، التي في مقدمتها، ضرورة توافق المعارضة على موقف واحد من الحل السياسي، وقد كان في الظاهر موضوعا خلافيا بين قوى المعارضة السورية لوقت طويل، سواء في الخلاف على الموضوع، أو في الخلاف على بعض محتوياته وآليات تحقيقه.
ووسط خلافات المعارضة على الحل السياسي، يبدو أن الأخيرة أدركت أن القضية السورية أحيطت بموضوعات، يمكن أن تحولها من قضية أساسية ومركزية، باعتبارها قضية شعب يطالب بالحرية وبنظام ديمقراطي، إلى واحدة من قضايا أخرى، تتصل بها أو هي إحدى نتائج الصراع مع نظام الاستبداد، مثل قضية إرهاب «داعش» وأخواتها، التي مدت حضورها في سوريا والعراق وفي الأبعد منهما، ومثل قضية اللاجئين السوريين، وهجرتهم، التي صارت لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية في البعدين الإقليمي والدولي، ومثل قضية التحالفات والصراعات الدولية والإقليمية بروابطها مع الوضع السوري، وكلها قضايا، أخذت تحتل المشهد السياسي والإعلامي على حساب القضية السورية، وتهددها بالتهميش، وتدفعها خارج الاهتمامات الأساسية في المستويين الإقليمي والدولي.
وسط تلك الظروف الصعبة والمعقدة، يبدو أن المعارضة السورية قررت أن تؤكد حضورها في المستويين الخاص والعام من جهة، وفي مستوى القضية من جهة أخرى، وفي هذا السياق جاء فتح باب الحوار بين أطرافها، فكانت لقاءات المعارضة بما فيها من تحالفات وقوى وشخصيات مستقلة، وبدا أن الحوار حول الحل السياسي هو الأهم في موضوعات الحوار، خصوصا أن أطرافا إقليمية ودولية مثل روسيا والسويد ومصر وغيرها، رأت أن فتح باب الحوار حول القضية السورية يمكن أن يكون عملا يخدمها، أو يخدم القضية السورية في وقت تغيب فيه جهود جدية وحاسمة في التعامل مع القضية السورية وموضوعاتها الأساسية.
وبلورت اجتماعات المعارضة السورية في الشهر الأخير، وثيقتين أساسيتين حول الحل السياسي في سوريا، كانت أولاها «نداء من أجل سوريا» الصادرة عن اجتماع القاهرة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، والثانية وثيقة الحل السياسي التي أصدرتها الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في اجتماعها الأخير بإسطنبول أواسط فبراير (شباط) الماضي. وأهمية الوثيقتين تتصل بـ3 نقاط أساسية؛ النقطة الأولى، حضور أغلب قوى المعارضة في اجتماعي القاهرة وإسطنبول، وخاصة الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق وبداخلهما غالبية القوى الكردية، الأمر الذي يعطي مشروعية أكبر لخيار الحل السياسي ومحتويات الوثيقتين، خاصة أنه عزل محتوياتهما عن حوارات جرت في القاهرة بين الائتلاف وهيئة التنسيق، جرى في خلالها تبادل أوراق تم التوافق على محتوياتها، ومما يدعم هذه النقطة أن ندوة استوكهولم، التي عقدت قبل أسبوعين بحضور شخصيات من المعارضة، أيدت نداء القاهرة، وشارك بعضهم في اجتماعات الائتلاف الأخيرة.
النقطة الثانية، وهي توافق الوثيقتين الجوهري على ضرورة الحل السياسي، واعتبار وثيقة جنيف بنقاطها الست والقرارات الدولية الخاصة بـ«جنيف 2» ومحتوياتها، ولا سيما موضوع هيئة الحكم الانتقالي بصلاحياتها الكاملة على الأمن والجيش، وأهداف العملية السياسية بإقامة نظام ديمقراطي جديد في سوريا باعتبارها مرجعية الحل السياسي المرتقب.
النقطة الثالثة، والمتضمنة ضرورة القيام بخطوات تمهيدية من قبل النظام، تؤكد قبوله الانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى نتائج عملية مثل إطلاق المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وتيسير دخول ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كل المناطق السورية، إضافة إلى ضرورة وجود ضمانات دولية برعاية الحل ووصوله إلى نتائج عملية.
ولعله لا يحتاج إلى تأكيد، قول إن خطوات المعارضة في تبني الحل السياسي، ورسم خريطة طريق نحوه على اختلاف بعض تفاصيلها، هو أمر إيجابي من حيث التوجه المشترك للمعارضة من جهة، ومن حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، سواء لجهة معالجة القضية السورية، أو لجهة التزامه بما كان قد قرره في السابق، وساعد في دفعه للوصول إلى حل من خلال «جنيف 1» وما تلاه في «جنيف 2».
غير أن التطورات الإيجابية السابقة تحتاج إلى متابعة واستكمال نواقصها، التي يمكن أن يأتي في سياقها مجموعة من الخطوات الملحة والعاجلة، أبرزها العمل على عقد مؤتمر وطني سوري، يجمع أطراف المعارضة ويوحدها في رؤية واحدة ضمن وثيقة مشتركة حول الحل السياسي، ويمكن أن يقوم مؤتمر القاهرة المزمع عقده في أبريل (نيسان) المقبل بهذه المهمة، إذا أحسن الفريق المكلف بالتواصل لأجله والإعداد لأعماله فرصة مناسبة.
كما أن تنشيط الحوارات والاتصالات السورية والدولية حول الحل السياسي، ومؤتمر القاهرة، بين الخطوات الضرورية بهدف إيجاد حامل سياسي محلي ودولي للحل مستعد للذهاب في خطوات عملية وإجرائية، سواء عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر صيغة دولية من خارجه، إذا بقيت روسيا والصين على موقفهما في استخدام حق النقض في معالجة القضية السورية في مجلس الأمن الدولي.
لقد شرعت المعارضة السورية بعمل ما هو مطلوب منها من الناحية السياسية، وكرست في اجتماعاتها حول رؤية الحل السياسي، ما كان قد بدأه الائتلاف الوطني العام الماضي في الذهاب إلى مؤتمر «جنيف 2» للتفاوض مع نظام الأسد استجابة لرغبة دولية، وبهذا صار المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، إذا كانت دوله وهيئاته لديها القدرة على أن تسمع وترى بعد كل ما حصل ويحصل في سوريا.
 ١٠ مارس ٢٠١٥
١٠ مارس ٢٠١٥
إذا كانت فوضى الحقبة الراهنة، بأوسع المعاني التي تشملها كلمة «فوضى»، قد أطلقت تنظيم «داعش»، فهي أيضاً أطلقت أهاجي لـ «داعش» لا يكاد أحد يتعفّف عنها. لكنّ الأهاجي لا تصنع نقداً، سيّما حين ينحصر الهجّاءون - النقّاد في تناول النتائج، لا المقدّمات.
و»داعش» نتيجةٌ في آخر المطاف، لا مقدّمة، نتيجةٌ كان الاستبداد العسكريّ والمؤدلج أحد أبرز مقدّماتها.
من هنا، قد تكون المقارنة لافتةً بين الهجائيّة التي استُقبلت بها ولادة «داعش»، والاحتفاليّة التي استُقبل بها ذات مرّة أبوها الاستبداديّ، والذي لا يزال نقده العميق، بل مجرّد الإقرار بأبوّته، مسكوتاً عنه.
فقبل يومين، وهذا مثَل غير حصريّ، استرجعت سوريّة ذكرى الانقلاب البعثيّ الذي عُرف بـ8 آذار (مارس) 1963، والذي أسّس النظام المستمرّ مذّاك، على رغم التغيّرات والتحوّلات الضخمة التي عرفها من داخل الخليّة الواحدة.
وإذا راجعنا صحف تلك المرحلة وقعنا على أوصاف حظي بها ذاك الانقلاب من قبيل: «إنهاء العهد الانفصاليّ البغيض»، «القضاء على أوكار الخيانة والعمالة»، «إعادة الوحدة مع مصر»، «الاستعداد لتحرير فلسطين». وفقط بعد انفجار الخلاف بين البعثيّين وجمال عبد الناصر، بدأ الهجوم على الانقلاب إيّاه بوصفه «مؤامرة على الوحدة» و»خيانةً للقضيّة» و»تنفيذاً للمخطّط الاستعماريّ». لكنّ مدح الفترة الأولى، مثله مثل قدح الفترة الثانية، لم يلحظ مسألة الحرّيّة أو خيار السوريّين، ولم يجد فيها ما يستحقّ التوقّف والتأمّل.
شيء مشابه كان قد حصل قبلذاك مع الناصريّة. فلئن أثار انقلاب يوليو 1952 بعض الانتقادات في مصر والعالم العربيّ بسبب قضمه الحياة الحزبيّة، فهذا ما شرع يختفي مع تحقيق الجلاء في 1954، وخصوصاً مع حرب السويس في 1956. مذّاك صار كلّ نقد لعبد الناصر، تمسّكاً بالحرّيّة أو طلباً للديموقراطيّة، يُعدّ هرطقة وخيانة للعروبة ولزعيمها الأوحد.
وحين كان صدّام حسين يخوض حروبه يمنةً ويسرةً، بدا من المستحيل لمؤيّديه تأييده باسم الحرّيّة، وهذا بديهيّ، لكنْ بدا أيضاً من الصعب لمعارضيه معارضته باسم الحرّيّة. فهو قد يُعارَض لأنّه تنكّر للعروبة وتحرير فلسطين بحربه على إيران، أو لأنّه أخلّ بالتزامه حيال الجبهة الوطنيّة مع الشيوعيّين، أو لأنّه أضعف التضامن العربيّ بغزوه الكويت. أمّا الحرّيّة فلا ترد إلاّ في أسفل القائمة.
وهذا كي لا نذكّر بتجارب من العنف «الطليعيّ»، كحكم «الطبقة العاملة» في جنوب اليمن، والحروب التدميريّة التي استدعتها الثورة الفلسطينيّة، والتمجيد النيكروفيليّ لـ»المليون شهيد» في الجزائر. فهذه سياقات وأحداث لم تصدر فحسب عن قرارات مستبدّة، بل ضربت في العنف أرقاماً قياسيّة تبحث دائماً عمّن يكسرها. لقد تراكم، والحال هذه، فائض عنفيّ وإدمان على العنف، بل عبادة للاهوته باسم الثورة أو التحرير.
وقصارى القول إنّ نقد الابن الذي هو «داعش» لم يسبقه إلاّ الاحتفال بأحد أبرز آبائه، وهو الاستبداد، بينما لا يزال محرّماً حتّى الآن التعرّض للقضايا «المصيريّة» التي ولّدها الاستبداد الأب قبل أن يعمّمها. والأمر نفسه يصحّ في ما خصّ آباء «داعش» الآخرين من أفكار وممارسات قروسطيّة لا تزال تُصنّف في خانة المقدّس، ولا تزال تُعتَبَر بعضاً من «أصالتنا» و»خصوصيّتنا» الحميمتين.
لقد تناول «النقدُ» الرائج ابناً من دون أب، ومن دون نقد الإجماعات التي تلتقي حولها الكثرة الكاثرة ولا تشكّ بها إلاّ القلّة القليلة. والنقد الناقص، وهو أقرب إلى أن يكون هجاء، يسفّ أحياناً فيغدو كذاك النقد الوحيد الذي سمحت به بلاطات القرون الوسطى، والذي ما كانت لتسمح به إلاّ لأنّه... تهريج.
 ٩ مارس ٢٠١٥
٩ مارس ٢٠١٥
لا مبالغة في القول إن العالم يعيش أياماً إيرانية. يتصرف جون كيري كمن يلتفت باستمرار إلى ساعته. يلتقي نظيره محمد جواد ظريف ثم يجول موزعاً التطمينات كي لا نقول الضمادات. واضح أن الغارة التي شنها بنيامين نتانياهو على سياسة باراك أوباما لم تدفع الأخير إلى مراجعة حساباته. الأمر نفسه بالنسبة إلى ملاحظات الحلفاء ومخاوف الأصدقاء. توحي واشنطن بأن أقصى ما يمكن فعله هو السعي إلى اتفاق يمكن الدفاع عنه، وإقناع العالم به. تقول إن العقوبات أوجعت الاقتصاد الإيراني لكنها لم تمنع تقدم البرنامج النووي. تلمّح إلى أن البديل للاتفاق هو الحرب التي لا يريد أحد دفع أثمانها.
ثمة من يعتقد بأن الغرب وقع في الفخ الإيراني منذ سنوات حين ارتضى إعطاء الأولوية للملف النووي الإيراني، مكرساً تغاضيه عن الشق الأهم في البرنامج الإيراني، وهو الدور الإقليمي. بين الذين زاروا طهران في الأعوام الماضية من يعتقد بأنها مهتمة بامتلاك القدرة على صنع القنبلة أكثر من إنتاجها في الوقت الحاضر، وأنها تستطيع إرجاء موعد الإنتاج لأنها ليست مهدّدة بغزو خارجي تشكل القنبلة النووية «بوليصة تأمين» ضده. أول ما فعله أوباما كان إقناع إيران بأن أميركا لا تخطط لعمل عسكري ضدها، ولا تعتبر نفسها معنية بتغيير النظام الإيراني بالقوة.
أشغلت إيران الدول الغربية بمفاوضات البرنامج النووي وسرّعت عملية بناء الدور الإقليمي. في ظل المفاوضات النووية حرّكت بيادقها ببراعة. تكريس الدور لا يحتمل التأجيل. يمكن إرجاء ولادة القنبلة التي قد تأتي لاحقاً، لحماية دور كبير فرضته الوقائع الميدانية.
في ظل انشغال الدول الست بالاقتراحات والاقتراحات المضادة كانت إيران تُحدِث تغييرات كبرى على الأرض. كان أهم ما حققته منع سقوط النظام السوري. كان من شأن إسقاط هذا النظام أن يدمّر الاستثمار الإيراني الكبير في معركة الدور. من دون سورية الحليفة يصبح الدور الإيراني في لبنان محدوداً، كي لا نقول مهدداً. تنتقل المعركة بالكامل إلى المسرح العراقي، أي إلى مكان قريب من الحدود الإيرانية. ألقت طهران بثقلها في المعركة السورية ومنعت انتزاع الحلقة السورية من «هلال الممانعة». كانت المعركة السورية حاسمة، واضطرت إيران إلى تحريك جميع حلفائها أو التنظيمات التابعة لها لتقاتل في الداخل السوري، دفاعاً عن «تحفة» إيران في الإقليم.
يعيش الشرق الأوسط أياماً إيرانية بامتياز. هذا ما تؤكده أي قراءة واقعية للأوضاع. إذا شئتَ اليوم إعادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى صنعاء وإعادة تحريك الحوار بين اليمنيين، عليك أن تتفاهم مع قائد «فيلق القدس» العميد قاسم سليماني. التفاهم يعني أن تعترف لإيران بأنها صاحبة دور كبير في اليمن.
إذا أردتَ اليوم إقناع النظام السوري بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضات السورية، والبحث جدياً عن حل، عليك التفاهم مع سليماني. والتفاهم يستلزم بالتأكيد التسليم بأن إيران هي اللاعب الخارجي الأول على المسرح السوري. مفتاح الحل في سورية موجود في طهران لا في موسكو.
دعكَ من الحوار بين «حزب الله» وتيار المستقبل. ودعكَ خصوصاً من هذا الحوار الدائر بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والذي يؤكد هشاشة ما بقي من دور للموارنة. إذا أردتَ رؤية رئيس جديد للجمهورية في لبنان عليك التفاهم مع سليماني. والتفاهم يعني أن تعترف لإيران بدور استثنائي في لبنان، يفوق الدور الذي كان لسورية فيه.
دعكَ من التجاذبات داخل المكوّن الشيعي في العراق. ودعكَ من قدرة نوري المالكي على إحراج خلفه حيدر العبادي. إذا أردتَ تهدئة الصدامات بين المكوّنات في العراق عليك التفاهم مع سليماني. مفتاح الاستقرار على الأرض موجود في طهران لا في واشنطن، على رغم احتكار الطائرات الأميركية للأجواء العراقية. تكفي الإشارة إلى أن واشنطن حرصت قبل إرسال مستشاريها إلى العراق، على نيل ضمانات إيرانية لسلامتهم.
في المقابل هناك من يعتقد بأن الفتوحات الإيرانية أكبر من قدرة المنطقة على الاحتمال. تماماً كما أن القنبلة الإيرانية أكبر من قدرة الدول الست على الاحتمال. ويقول هؤلاء إن التمزقات في العراق وسورية ولبنان واليمن سابقة لظهور «داعش» ومرشحة للاستمرار بعده. وأن الاستقرار في هذه الدول يحتاج إلى استرجاع توازنات بين المكوّنات، أخلّت بها الانقلابات الإيرانية . وثمة من يجزم بأن الأيام الإيرانية مفتوحة على نزاعات مديدة بسبب «أزمة موقع السنّة في الهلال» والمخاوف التركية والخليجية ولأن «القبول بدورٍ لإيران شيء والقبول بزعامة إيران للإقليم شيء آخر».
 ٩ مارس ٢٠١٥
٩ مارس ٢٠١٥
قد كان الفن في عتمة الفقر الإبداعي طوال عقود حكم الأسد الأب و الابن، و ما يزال خارج نطاق الأمل من بعض الرقي فيه، حيث سُلِبَ معطفه الذي يقيه من صقيع السخافة و التصنّع، فتم تناسي كل أنواع الفنون و وضعها على الهامش حتى اعتقد المجتمع السوري بأن الدراما التلفزيونية السورية هي وحدها تُغني عن كل تلك الفنون السبعة، و هي وحدها القادرة على تمثيل سوريا فنيا و ثقافيا.
انتشر الوباء الفني حين جنّد الأسد كوكبة من الممثلين الذين كُرِّسوا للعمل في الدراما التلفزيونية، و تمتعوا بدعم كثيف من الأسد ذاته عندما أسس قناة سوريا دراما و شراء كافة الأعمال التي لم يتم بثها على القنوات الفضائية الأخرى، ربما لأنها تعتبر نوعا من التسلية و لسهولة مشاهدتها في كل بيت، لكن من ناحية أخرى، كان بمقدور الذي شجّع و ساند الدراما أن يعين و لو بقليل باقي الفنون المغلوب على أمرها و التي أُصيبت بغيبوبة لمدة ليست بقصيرة، بل كان باستطاعته أيضا أن يجعل شعبه يطّلع و ينفتح على العديد من الفنون المنسية و التي كانت على مدى التاريخ وسيلة للتعبير عن الأفكار و الآراء و المعتقدات، و أكثر جرأة لتسليط الضوء على مشكلات الإنسان و المجتمع، و اليوم مازالت قادرة هذه الفنون على إنعاش الفكر، مثل الرسم، النحت، الموسيقا، الرقص، السينما و المسرح الذي يعتبر هو الأب الروحي لكل الفنون.
الممثلون الذين صفقوا للأسد على هذه المبادرة "الحسنة"، لم يكترثوا و لو للحظة واحدة للمأساة التي ستقتحم ذوق المجتمع السوري و الكارثة التي ستهب علينا إذا اعطينا الدراما التلفزيونية أكثر من حقها، حتى وصل البعض إلى تقديس العاملين فيها. رجل المطر.. عمر أميرالاي الذي مات في الغياب دون أن يعرفه إلا القليل من الشعب السوري، كذلك سعد الله ونوس الذي ثارت كلماته على خشبة المسرح، و أسماء كثيرة عاشت و ماتت في مساحة ضيقة من وطنها، لأنها خلقت أعمالا و أفكارا لم تعجب الجنرال في بلدنا.
عملت هذه الأسماء على نقل تطلعات الشعب إلى الشاشة الكبيرة و تبنت كل آراء الشارع في المسارح و قصائد الشعر و اللوحات التشكيلية. لن أتجاهل الجهود التي برزت من شخوص مبدعة و التي حاولت أن تُدخل رؤية إخراجية سينمائية في أعمالها الدرامية التلفزيونية، لتعيد لها هيبتها بعيدا عن "الهشِّك بشِّك" الذي عكّر ذوق مجتمع بأكمله، أبرز تلك الأيقونات هو هيثم حقي الذي تمتع بإبداع راقٍ و تبعه حاتم علي الذي شكّل نموذجا سوريا حضاريا، أما على صعيد النصوص الدرامية هناك الكثير من كتاب السيناريو الذين رفعوا بكتاباتهم قيمة الدراما السورية، مثل يم مشهدي و سامر رضوان و أمل حنا و حسن سامي يوسف، التي كانت نصوصهم تخرج من قلب الشارع السوري و تُشعر المشاهد أنه أمام نص مختلف يفسر له الواقع بكل تفاصيله الحياتية المعقدة. جاءت الثورة السورية أيضا لتكشف لنا عن كذبة تسمى الدراما السورية، لتعيدها إلى حجمها الطبيعي و تعطي لكل من الفنون الأخرى حقها في التعبير و المشاركة في صنع فن سوري أكثر شياكة، عدد كبير من أفلام السينما اليوم التي مثلت الثورة السورية و تشارك في مهرجانات و توّجت بجوائز عالمية بارزة.
"ماء الفضة"، "العودة إلى حمص" و "بلدنا الرهيب".. اغتنت السينما السورية بهذه الأفلام التي كانت مرآة للإبداع. الطوفان سيغرق تفاهة البعث و سياسته، ليعيد الشعب السوري حياكة أيامه و مجده من جديد.
صالح ملص.
 ٩ مارس ٢٠١٥
٩ مارس ٢٠١٥
مع ارتفاع وتيرة قتال الإيرانيين وحلفائهم إلى جانب قوات نظام الأسد، وتولي الإيرانيين أيضا قيادة حروب القوات العراقية في تكريت وصلاح الدين، يدعو البعض إلى إعادة النظر في السياسة الحالية، والقبول بالتصالح مع نظام بشار الأسد.
وفي رأيي العكس صحيح، تماما. ربما كان التصالح مقبولا في بدايات الأزمة السورية، لكنه اليوم أسوأ قرار يمكن لأي حكومة عربية، خاصة خليجية أن تفكر فيه.
المشكلة ليست مع شخص الأسد بل مع ترِكتِه، وتوأمته مع نظام طهران، والبحر الهائل من الدماء التي أسالها. وقد كان الوعد حينها صادقا بمنحه فرصة الخروج، وحمايته من طالبي الثأر، وفتح صفحة جديدة مع بعض قيادات النظام وتشكيل حكومة انتقالية تجمع كل السوريين بطوائفهم وأعراقهم.
ولا يمكن النظر إلى الحرب في سوريا على أنها مشكلة سورية داخلية، ودون فهم المعادلة الإقليمية، وتحديدا الصراع مع إيران. وفي حال سايرت السعودية نصائح المصريين، أو دعوات المحللين، وقبلت بحل أو مصالحة يبقى فيها الأسد، فإنها تكون قد سلمت كامل الهلال، العراق وسوريا ولبنان إلى إيران! فهل يمكن لأي دارس علوم سياسية أن تفوته النتيجة الحتمية، وهي الهيمنة الإيرانية على شمال الخليج والسعودية؟!
حجة الانزعاج من تركيا و«الإخوان» و«داعش» صحيحة، لكنها ليست سببا لتسليم الإيرانيين سوريا والعراق. نحن في زمن فيه حروب متعددة، والخطر فيها درجات، الإيراني أعظمها، خاصة مع اقتراب عقد اتفاق النووي مع الغرب. وستترجم النتيجة إيران إلى شحنة هجوم غير مباشرة على خصومها على ضفة الخليج الغربية. ومهما وعدنا الأميركيون أنهم لن يسمحوا للإيرانيين بإيذاء جيرانهم فلا يمكن لنا تصديقهم، خاصة أننا نعرف أن قدرات الولايات المتحدة في منطقتنا تقلصت، وسياستها الجديدة صارت التوجه شرقا نحو الصين. لهذا فإن دعم المعارضة السورية المعتدلة سياسيا وعسكريا ضرورة قصوى لعرب الخليج، لحرمان الإيرانيين من سوريا، ناهيك عن كونها قضية إنسانية هي الأدمى في تاريخ المنطقة. لا يمكن للسعودية أن تتخلى عن عشرين مليون سوري مهما كانت الأسباب، ولا يمكن لها أن تغض النظر عن خطر التوسع الإيراني في بلاد الرافدين، ولا يفترض أن نقبل بنظرية مصالحة الأسد حيث لا مكان لها في حسابات الخليج العليا. هل يمكن للسعودية مصالحة الأسد الذي قتل ربع مليون إنسان من أجل محاربة عصابات داعش؟ مستحيل تماما. وكيف لنا إقناع العشرة ملايين مشرد الذين دكت طائرات الأسد بيوتهم وأحياءهم بالتخلي عنهم؟
أما بالنسبة لتركيا، فالمشكلة تتمثل في شخص رئيسها، الذي يسبب هذا الكم الكبير من الشقاق والإزعاج، لكنه وحكومته لم يفعلوا شيئا حتى لحماية مصالح بلادهم الهامة في سوريا، عدا حماية ثم جلب رفات سليمان شاه الذي شبع موتا من مئات السنين.
وعندما تأتي الساعة التي تصبح فيها القضية محل النقاش هي مصير الأسد في أي حرب أو حل سلمي مستقبلي، فإنه لا أحد سيهتم بمسألة الانتقام. فالتركيز اليوم هو على حلين متوازيين، دعم المعارضة المسلحة المعتدلة، الجيش السوري الحر، والثاني دعم أي حل سلمي يقوم على مصالحة كل السوريين، والمحافظة على النظام السوري دون قياداته العليا. ومن دون دعم الجيش الحر، فإن الحل السياسي لا يمكن فرضه بشكل عادل
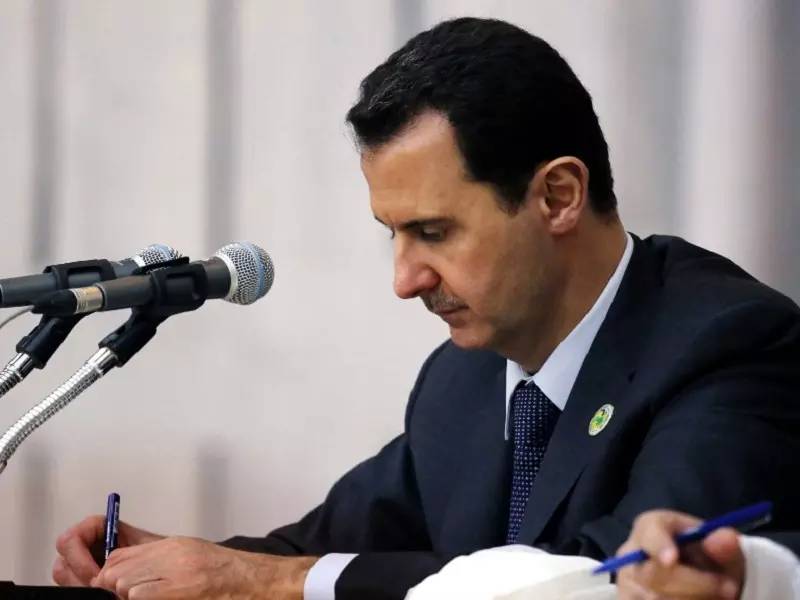 ٩ مارس ٢٠١٥
٩ مارس ٢٠١٥
يحاول مندوب الأسد في نيويورك بشار الجعفري القول الآن بأن الوقت قد حان كي تقبل أميركا والقوى الغربية الأخرى بأن بشار الأسد باق في السلطة، وأن تتخلى عما وصفها بأنها استراتيجية فاشلة تقوم على محاولة تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى جيوب طائفية.
ويقول الجعفري لوكالة «رويترز» عشية الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الثورة السورية إن الأسد مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وغيرها لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه يمكن للأسد أن يحقق الأهداف، لأنه قوي يحكم مؤسسة قوية هي الجيش، ويقاوم الضغوط منذ أربع سنوات. مضيفا أن الأسد «يمكنه تنفيذ أي حل»! هل هذا كلام دقيق؟ بكل تأكيد لا! هذه محاولة دعائية أسدية مفضوحة، وتتزايد الآن، والهدف منها هو القول إن الأسد أفضل من «داعش»، ولا بد من التعاون معه ضد الإرهاب، لكن الحقائق تقول إن «داعش» ما كانت لتتمدد، ومثلها «القاعدة» لولا جرائم الأسد، ولعبه بورقة الإرهاب والتطرف، خصوصا أن الأسد هو من أطلق سراح قيادات «داعش»، و«القاعدة» من سجونه، وهو الأمر نفسه الذي فعله نظام المالكي في العراق سابقا.
وهذا ليس كل شيء، حيث كشف مؤخرا عن مراكز تدريب إيرانية في سوريا لتدريب ميليشيات الحوثيين، وبإشراف إيراني تام، وليس لنظام الأسد أي سيطرة على ذلك، ورغم أن التدريب يتم في سوريا التي باتت مقسمة إلى أجزاء يتقاسمها حزب الله والميليشيات الشيعية الإيرانية من ناحية، تحت قيادة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بينما الأجزاء الأخرى في سوريا هي تحت سيطرة «داعش» و«القاعدة»، وجزء آخر تحت سيطرة الجيش السوري الحر. فأي قوة تلك التي بيد الأسد؟ وكيف يوصف بأنه الرجل القوي، بل هو الرجل الكارثة، وليس على سوريا وحسب، بل وعلى كل المنطقة، وحتى على المجتمع الدولي، خصوصا بعد الإعلان أول من أمس عن أن عشرة آلاف مقاتل أوروبي متطرف يتجهون إلى سوريا والعراق.
كل ذلك يقول لنا إن الأسد أساس المشكلة، وهو من حوّل سوريا إلى بؤرة تدريب، وتهريب، للإرهاب الإيراني، وغيره، فكيف يقال بعد كل ذلك إن الأسد هو الحل؟! الأكيد أن الأسد هو المشكلة، وهو الأزمة بحد ذاتها، وخطر الأسد لا يقل عن خطر «داعش»، و«القاعدة»، وحزب الله وإيران، والحقيقة التي سيدركها الجميع أن سقوط الأسد هو الحل، آجلا أو عاجلا، وهذا ما لا تحاول إدارة أوباما فهمه لأنها مشغولة لدرجة الهوس بالتفاوض مع إيران، ويبدو أن واشنطن وضعت ملف الأسد قيد الانتظار حتى الوصول إلى نقطة حسم بالتفاوض مع إيران، وهذا بالطبع يعد عامل هروب للأمام، لأن وقتها سيكون أوباما قد دخل مرحلة البطة العرجاء باقتراب نهاية فترته الرئاسية، وهذا يعني أن الكارثة ستكون أكبر على سوريا، والمنطقة، والمجتمع الدولي، لأن الأسد هو المشكلة، ولا يمكن أن يكون الحل.
 ٨ مارس ٢٠١٥
٨ مارس ٢٠١٥
علينا أن نُقرّ بأن بشار الأسد فعل المُتوقع منه منذ آذار 2011. فهو لا يتمتع بالخبرة والدهاء الكافي ليلعب بأدوات واستراتيجيات غير تلك التي أورثها له والده.
من يدقق في تلك اللحظات التاريخية التي مرّ عليها أربع سنوات، ويعالج الأمور بموضوعية، سيكتشف أن التاريخ في سوريا سار بالاتجاه المُتوقع له تماماً. فبشار الأسد كان وريث نظام، وليس صانع نظام، لذا لم يفعل أكثر من السير على النهج، ووفق الأدوات، المورّثة له.
كانت المفاجأة الحقيقية لو أن بشار الأسد سار على غير النهج الذي سار عليه في مواجهة الثورة السورية منذ بداياتها. أيضاً الطغمة المحيطة به، خاصة في أوساط العائلة، لم تفعل إلا المُتوقع منها. فهي طُغمة من الشخصيات الوريثة أيضاً، أياً منها لم يكن قد صنع ما وجد نفسه فيه، بنفسه. لذا جميعهم لعبوا وفق ذات النهج والأدوات المورّثة لهم.
أيضاً، الطغمة الأمنية المحيطة بالأسد وعائلته، لم تفعل إلا المُتوقع منها. فتلك الطغمة تدرجت في مناصبها في عهد حافظ الأسد، وتكونت شخصياتها وأدواتها وفق نهج الأسد الأب الذي وصل حدّ النضج خلال أزمة الثمانينات تحديداً. لذلك سلكت تلك الطُغمة نهج الثمانينات ذاته تقريباً، مع فروق محدودة في التفاصيل، لا في الخط العام.
النخب القريبة من النظام فعلت أيضاً المُتوقع منها، فالأسد الأب كان قد أتقن تجفيف البلاد من أي مجموعة منظمة، سياسية كانت أو طبقية أو آيديولوجية أو حتى دينية، إلا إذا كانت من صنيعة النظام، وتحت سيطرته المطلقة. فلا التجار والصناعيون فاجأوا المراقبين الحصفاء كثيراً في ردود أفعالهم، ولا المؤسسة الدينية الرسمية فعلت ما يُخالف ما جُبلت عليه. وبقيت وقفات البعض الشجاعة ضد قمع النظام استثناءات تؤكد القاعدة العامة.
منذ أربع سنوات وحتى اليوم، فعلت كل أطراف المأساة بسوريا المُتوقع منها. الشارع السوري تحرك في الأماكن التي يمكن أن يتحرك فيها بكلفة أقل، وكان أكثر تحفظاً في الأماكن الأكثر صعوبة. فلم تثُر دمشق بالصورة المأمولة. ولم يتخلَ سكان المدن الكبرى عن طبعهم المحافظ والميّال للاستقرار ومهادنة السلطات.
وحينما أوغل النظام في محاولات قمع الحراك السلمي في الأرياف والأطراف، كان حمل السلاح من قبل البعض نتيجة مُـتوقعة، بل ومرجحة. ورغم الإدانات النظرية لخط العسكرة في البلاد، فإن المُتوقع من المُنكل بهم أن يلجأوا لأية وسيلة تخفف من نير التنكيل بهم.
المنظّرون الذين طالبوا بعدم العسكرة، نسوا أن السوريين يفتقدون لعقود، الوعي السياسي، والثقافة السياسية، والأهم، التجربة السياسية. كما أنهم يفتقدون لعقود حنكة التنظيم السياسي.
في مجتمع جففت عقود الاستبداد نخبه وطبقاته من كل حراك مأمول، لا يمكن لأحد أن يتوقع غير رد الفعل.
القوى الإقليمية والدولية اللاعبة على الساحة السورية أيضاً، فعل كل منها المُتوقع منه، وحسب مصالحه. دول عربية أرادت تعقيد الموقف كي يكون درساً لشعوبها، وأخرى إقليمية أرادت استغلال الموقف لتحقيق آمال امبراطورية، وثالثة دولية وجدت في الفوضى المضبوطة، إلى حين، أفضل الوسائل لتحريك اقتصاد السلاح المؤثر في صنع القرار فيها، ومن ثم، مستقبلاً، تحريك شركات إعادة الإعمار التي تغذي رأس مالها.
في خضم كل ما سبق، كان من المُتوقع أن يلجأ المُنكل بهم إلى البعد الروحي لتبرير معاناتهم، ولشحذ هممهم. وكان من المُتوقع أن يخلق ذلك الظرف المُلائم لانتشار فيروس التفسير الطائفي للأحداث، ومن ثم سيادته على كامل المشهد. ووسط هذا الواقع، حيث الفوضى تعمّ، والحدود سائبة، كان من المُتوقع أن يُطل التطرف برأسه، في أبشع صوره.
كان من المُتوقع في مجتمع رصد فيه الجار جاره، في عهد الثمانينات، ليتربص به زلاته، حيث "للجدران آذان"، والجميع يخاف من "كتبة التقارير"، ألا يتماسك هذا المجتمع، وأن تطفو إلى السطح الأمراض الطائفية والمناطقية والطبقية، التي كانت شفهية في البيوت وفي اللقاءات المتجانسة فقط، لتتحول إلى سلوكية وفظة أثناء الاحتكاك بالشريك المغاير في الوطن.
قصة سوريا وفق ما سبق، كانت وما تزال مُتوقعة. تسردها قصص التاريخ في أكثر من بلد، وأكثر من تجربة. لذا فالمُتوقع أيضاً أن تسير الأمور، في قادم الأيام، وفق المُتوقع.
أن يسقط نظام الأسد في نهاية المطاف، وأن ينشأ نظام استبداد جديد، أقل وطأة نسبياً، لكنه أكثر فظاظة أحياناً. وأن يدوم هذا النظام الفترة المطلوبة لإشباع الرغبة للاستقرار المفقود خلال سنوات الأزمة، ومن ثم يحدث حراك آخر، تكون قياداته أكثر حنكة بحكم التجربة المريرة السابقة، وتكون قواعده أكثر وعياً بما قد تؤول إليه الأمور بحكم التاريخ القريب الذي علمهم، ويكون رد فعل النظام القائم حينها أكثر حنكة، ووعياً، حيال ما يمكن أن يحدث له ولحاضنته، إن سلوك الطريق ذاته الذي سلكه سابقه، وأن يُختتم المشهد، بعد عقود، كما اختُتم في تجارب عديدة سابقة، بديمقراطية لها طابعها الخاص، السوريّ، الذي يؤسسه أبناؤه كما يناسبهم، ويناسب تكوينات طيفهم.
لا ينفي ما سبق أن غير المُتوقع لن يحدث، فالتاريخ مليء بالمشاهد غير المُتوقعة، من قبيل "القيادات الكاريزمية" التي تغير مسار تاريخ بلدها مثلاً. في الحالة السورية لا شيء ينبئ بغير المُتوقع. أما الأفق الزمني لتتابع المشاهد وصولاً للخاتمة، فذلك هو غير المُتوقع الوحيد في التاريخ. في كل الحالات التاريخية، لا يمكن الجزم بالمدى الزمني المطلوب لإنضاج النقلات النوعية في حياة الشعوب والبلدان.
إذاً في سوريا، المستقبل مُتوقع، لكن متى نصل إليه، هو تحديداً غير المُتوقع.
 ٨ مارس ٢٠١٥
٨ مارس ٢٠١٥
كثرت المبادرات والخطط المطروحة لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية، دون أن تفضي إلى تخفيف وقع الكارثة التي أصابت سوريا والسوريين، وذلك بالرغم من مرور أربع سنوات على بدء الأزمة.
وتبدو الممكنات الفعلية للحل المأمول ومتحققاته بعيدة المنال وفق المعطيات الراهنة، إذ لا يزال النظام السوري يعتقد أن بإمكانه القضاء على معارضيه، والعودة بسوريا وناسها إلى ما قبل الخامس عشر من مارس/آذار 2011. وفي المقابل، هناك من يعتقد من المعارضين للنظام أن بالإمكان إسقاطه عسكرياً.
وقد بات واضحاً للجميع أن الأزمة الوطنية العامة تحولت إلى حرب كارثية تخوضها إيران والمليشيات الطائفية (اللبنانية والعراقية والأفغانية وسواها) التابعة لها، دفاعاً عن بقاء النظام الأسدي ومن أجل إعادة تثبيته بقوة السلاح، ورغماً عن إرادة غالبية السوريين.
انسداد الأفق
تفترض أبجديات علم السياسة أنه للتوصل إلى أي حلّ سياسي لأزمة سياسية ما، يتوجب على الأطراف المتصارعة أن تحتكم إلى حقل السياسة وأن توليه اهتماماً، أو أن يُفرض عليها حل سياسي تتوافق عليه مجموعة من القوى الدولية بوصفها ضامنة لإنجاح خطواته، كما حصل في مواضع عديدة من العالم مثل دول البلقان ولبنان.
وهو أمر لم يحصل إلى يومنا هذا في الأزمة السورية، فالنظام الأسدي -الجاثم على صدور السوريين منذ ما يقارب نصف قرن- لا يعترف بالسياسة ولا يسمح للسوريين بخوض غمارها، بل وجرّد المجتمع السوري من أية ممارسة سياسية بعد أن صادر فضاءه العام.
وجسدت مصادرته إغلاق الحقل السياسي ومنع التواصل والاجتماع العام، وبالتالي منع أي نقاش أو حوار بين عموم السوريين يمكنهم من خلاله أن يتناولوا فيه شؤونهم ومشاكلهم وهموهم، ويبحثون فيه عن ممكنات ومعالم طريق الانتقال السلمي نحو مندرجات دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تضمن المواطنة وحقوق المواطن، وتنهي احتكار السلطة والاستبداد المقيم منذ عدة عقود.
"تبدو الممكنات الفعلية للحل المأمول ومتحققاته بعيدة المنال وفق المعطيات الراهنة، إذ لا يزال كل من النظام السوري والمعارضين له يعتقد أن بإمكانه القضاء عسكريا على الطرف الآخر"
وأفضى انتفاء السياسة ومصادرتها إلى اغتيال صوت العقل لصالح الجنوح إلى نهج أمني وعسكري لا يعرف سوى لغة القمع والتوغل في استخدام العنف المنفلت من عقاله، والذي حصد -ولا يزال يحصد- أرواح مئات الآلاف من السوريين، بعد أن قسّم النظام السوريين إلى معسكرين: "واحد معنا، وآخر ضدنا".
وكان ينظر إليهم -ولا يزال- بوصفهم خانعين اضطروا للوقوف معه أو خونة يقفون ضده، وعليه فتجب تصفيتهم ومحاربته باعتبارهم جراثيم ينبغي القضاء عليها، حسبما وصفهم بشار الأسد في بدايات الثورة.
وعلى هذا الأساس، بدأ النظام منذ أربعة أعوام شن حرب شاملة على المحتجين الذين كانوا سلميين وعُزْلاً في بداية الثورة، ورفع شعار "الأسد أو نحرق البلد".. و"الأسد أو لا أحد"، للتعبير عن بدئه حرباً شاملة، وبالتالي فلا يمكن لمن يمتلك مثل هذا العقل والنهج أن يحتكم إلى السياسة، أو أن يقبل بحل سياسي للأزمة.
ولذلك عمل النظام على إفشال كافة المبادرات والمقترحات والخطط الهادفة إلى إيجاد حل سياسي منذ أربعة أعوام، بدءاً من محاولات من كانوا في صف أصدقاء النظام مثل قادة تركيا وقطر وفرنسا، ومروراً بمبادرة الجامعة العربية وإفشاله مهمة المراقبين العرب ثم إفشاله خطة كوفي أنان، ووصولاً إلى إفشال مفاوضات مؤتمر جنيف-2، واعتراف الأخضر الإبراهيمي بإفشال النظام السوري لمهمته.
محاولات دي مستورا
بعد فشل مؤتمر جنيف-2 واستقالة الإبراهيمي، عُيّن ستيفان دي ميستورا مبعوثاً أممياً إلى سوريا، وطرح مجموعة من الأفكار لا ترقى إلى مصاف مبادرة لحل سياسي في سوريا، وتهدف إلى نسف الأساس السياسي الذي نهض عليه "اتفاق جنيف-1" في 30 يونيو/حزيران 2012، والمتعلق بالتوصل إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات، وكذلك البنود الستة التي تضمنتها خطة كوفي أنان، بالرغم من حديثه عن أنه يستند إلى الاتفاق في تحركاته.
والبديل الذي قدمه دي ميستورا هو التركيز على "تجميد القتال" في مناطق محددة مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إليها، وذلك انطلاقاً من فهم يقوم على اختصار الأزمة السورية إلى مجرد أزمة إنسانية، تحقيقاً لمقولته التي تعتبر أن "المشكلة الأساسية في سوريا تكمن في الأزمة الإنسانية".
لا جدال حول أهمية المسألة الإنسانية في سوريا التي يجب أن يضمنها المجتمع الدولي دون نقاش أو تردد، إلا أن ما يطرحه دي ميستورا، يتضمن خروجاً عن المهمة الأساسية التي أوكلت إليه، والمتمثلة في تكثيف جهوده لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة ويلبي طموحات الشعب السوري.
حيث بدأ يتنصل منها شيئاً فشيئاً، فطرح جملة من الأفكار التي تبدأ من الأسفل، دون المساس برأس نظام الحكم، وتحدث في البداية عن تجميد القتال في أكثر من 15 منطقة سورية، ثم عاد وتراجع عن طرحه -بسبب معارضة النظام- ليقتصر على تجميد القتال في مدينة حلب.
"عمل النظام على إفشال كافة المبادرات الهادفة إلى إيجاد حل سياسي منذ أربعة أعوام، بدءاً من محاولات من كانوا في صف أصدقائه، ومروراً بمبادرة الجامعة العربية وانتهاء بإفشال مفاوضات مؤتمر جنيف-2 "
وبعدها راح يتحدث عن "إيجابية النظام" وترحيبه بخطته، ثم أطلق تصريحات وقام بعدد من الزيارات إلى دمشق تصب في سياق رفع مستوى التنسيق مع نظام الأسد إلى مستوى تعويمه وإعادة تأهيله بإعادة الاعتراف الدولي به، وجعله شريكاً في الحرب على داعش، بل واعتبره جزءا من الحل في سوريا.
كما طالب المعارضة بالتوحد مع النظام "لمواجهة خطر داعش الذي يتهدد الجميع"، مستغلاً انشغال المجتمع الدولي وتركيزه على الحرب ضد تنيظم داعش، ليسوق أفكاره كي تتناغم مع الجهود الرامية إلى تحويل كل الجهود نحو هذه الحرب.
وتجاهل دي ميستورا -عن قصد ودراية- دور الأسد في جذب الإرهابيين وتوفير ممكنات تمددهم، لكونه المسؤول عن إطلاق سرحهم من سجونه، ولانسحاب قوات جيشه من العديد من المواقع لصالحهم، حتى باتوا قوة لا يمكن تجاهلها.
حصاد الروس
وبدورها، استغلت روسيا الفراغ السياسي الذي أحدثه تراجع الإدارة الأميركية في التعامل مع الملف السوري، وظهر تحرك روسي شحيح المحصول، تجسد في زيارات واتصالات قام بها عدد من المسؤولين الروس، بدءاً من التنسيق مع المسؤولين في كل من طهران ودمشق، ومرورا بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا، ووصولا جولات ميخائيل بوغدانوف (نائب وزير الخارجية الروسي) في كل من إسطنبول وبيروت والقاهرة، التي التقى خلالها شخصيات في المعارضة السورية، وانتهاء إلى عقد لقاء تشاوري بموسكو في الفترة ما بين 26 و29 يناير/كانون الثاني الماضي، بين وفد من النظام وآخر من المعارضة التي يمكن وصفها بأنها معارضة من أجل النظام وليست ضده.
وظهر أن ما بذله الساسة الروس من جهود وما طرحوه من أفكار لحل الأزمة السورية لم يرقَ إلى مصاف مبادرة متكاملة لها مرجعية وأسس وخطوات محددة، ولم يحظ برعاية دولية من طرف الدول الفاعلة في الملف السوري. ولذلك، بدوا وكأنهم يستغلون فراغاً سياسياً يحاولون إشغاله، في ظل غياب الفاعلين الآخرين في الملف السوري عن القيام بأي فعل لحل أزمته الكارثية.
وارتكز التحرك الروسي حيال الأزمة السورية على تطلع الساسة الروس للقيام بدور وسيط يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، لكن حيثيات تحركهم مشدودة إلى طرف النظام، وتحاول إعادة تأهيله وتلميعه بالنظر إلى الدعم العلني الذي قدمته روسيا إلى النظام السوري -على مختلف الصعد- منذ بدء الثورة السورية.
ولا تبتعد حيثيات التحرك الروسي عن فرضية مفادها أن النظام والمعارضة وصلا إلى نهاية الطريق في الأزمة، وأن حالة من الاستعصاء باتت تسود الوضع، بعدما تبيّن أن قوات النظام غير قادرة على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، مما يعني أن النظام لم يعد يحكم كل سوريا.
"لا يمكن لخطة دي ميستورا أن تعالج الأزمة الكارثية التي أصابت السوريين، وهي تضاهي التحرك الروسي لأنها لا تنظر في مسببات الأزمة، وتتغاضى عن الحرب الشاملة ضد أغلبية الشعب التي بدأها النظام الأسدي منذ اندلاع الثورة السورية"
وفي المقابل، فإن المعارضة أيضاً أضحت غير قادرة على الاحتفاظ بجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها أمام هجمات النظام من جهة، وهجمات التنظيمات المتطرفة (خاصة "جبهة النصرة"، وتنظيم "داعش"، من جهة أخرى)، الأمر الذي يقتضي توحيد جهود المعارضة والنظام للوقوف في وجه التنظيمات والمجموعات الإرهابية.
ولا شك في أن الروس نسقوا تحركاتهم مع ساسة النظام الإيراني لتسويق حلّ سياسي للأزمة السورية يخدم النظام قبل كل شيء، ولم يفتهم التشاور مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لموسكو مؤخراً.
وربما، تكفل الأخير خلالها بإطلاع السعوديين على الطرح الروسي، وتسويق مقولة إن الحرب ضد داعش هي حرب ضد الإخوان المسلمين أيضاً، وأن لا فرق بين الاثنين باعتبارهما "تنظيمين إرهابيين" بالنسبة له، وبالنسبة للمملكة السعودية التي تصر على إيجاد بديل عن بشار الأسد.
وأظهرت حصيلة التحرك الروسي أن الساسة الروس يهمهم التركيز على الشكل دون الاهتمام بمضمون ما يطرحونه، لذلك انفضّ لقاء موسكو التشاوري السوري/السوري دون أن ينتج عنه شيء يذكر بشأن التوافق أو الاتفاق على خطوات أو حتى مقدمات لحلّ سياسي للأزمة السورية، التي باتت تشكل كارثة مدمرة ضربت البلد وناسه، وبصورة غير مسبوقة في التاريخ السوري قديمه وحديثه.
ويبدو أن ما زرعه الروس قد حصدوه، حيث إن اللقاء لم يحضّر له جيداً قبل المجيء إلى موسكو، ولم يتضمن أجندة أو خطة أو سقفاً للتحرك، ولم توجه الدعوة إلى الكيانات والتشكيلات السياسية السورية المعارضة وصاحبة التمثيل والتأثير الحقيقي في سوريا، إضافة إلى رفض العديد من المدعوين بصفتهم الشخصية المشاركة في اللقاء.
وإذا كان التحرك الروسي يلتقي مع خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، فإن واقع الحال يكشف أنه لا يمكن لخطة دي ميستورا أن تعالج الأزمة الكارثية التي أصابت السوريين، وهي مثل التحرك الروسي لأنها لا تنظر في مسببات الأزمة، وتتغاضى عن الحرب الشاملة ضد أغلبية الشعب التي بدأها النظام الأسدي منذ اندلاع الثورة السورية.
ويدرك المتابع للنهج الذي يتبعه النظام السوري وسلوكه وممارساته أنه لن يقبل بأي حل سياسي للأزمة إلا حين يعي تماماً أن نهايته قد اقتربت، وأن كرسي السلطة قد بدأ يترنح تحت بشار الأسد، أو في حال خضوعه لضغوط وتهديدات خارجية جدية يشعر أيضاً بأنها قد تودي بكرسي حكمه.
وهذا ما شاهدناه حين اضطر إلى سحب قوات احتلاله من لبنان الذي بقيت فيه ثلاثين سنة، وحدث الأمر أيضاً حين سلّم مخزونه من الأسلحة والمواد الكيميائية في صفقة روسية أنهت تهديد الولايات المتحدة الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية للنظام، وبالتالي لا يمكن أن يمتثل هذا النظام لأي حل سياسي بالطرق الدبلوماسية والوساطات، ومهما كثرت الخطط والمبادرات السياسية.
 ٨ مارس ٢٠١٥
٨ مارس ٢٠١٥
أظهرت جبهة النصرة منذ تأسيسها نهجا براغماتيا لافتا في التعامل مع تعقيدات المشهد السوري، وحاولت رغم صلاتها التأسيسة بالفرع العراقي المتمرد على تنظيم القاعدة المركزي تجنب الوقوع في صدام مع حواضنها الاجتماعية المحلية والتنسيق مع كافة الفصائل والقوى الثورية السورية على اختلاف إيديولوجياتها وتوجهاتها الفكرية والتنظيمية وارتباطاتها الإقليمية والدولية، وقد برهنت إبان صعودها عن قدرتها ومرونتها بالتكيّف مع المشهد الثوري المتقلب، وعلى الرغم من ارتباطها بتنظيم القاعدة إلا أنها حافظت على نهج معتدل نسبيا في تدبير الخلافات مع الفصائل المقاتلة المحلية، لكن صعود تنظيم الدولة الإسلامية وبروز التدخلات الإيرانية وتشكيل التحالف الدولي، عمّق من أزمة النصرة الإيديولوجية والتنظيمية باعتبارها حركة إرهابية، وباتت مستهدفة من كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية.
لعل مقتل القائد العسكري لجبهة النصرة أبو همام الشامي في 5 آذار/ مارس 2015، إلى جانب عدد من القيادات البارزة (أبو عمر الكردي، وأبو مصعب الفلسطيني، وأبو البراء الأنصاري)، يكشف عن عمق الأزمة التي تعاني منها جبهة النصرة، إذ لم تصدر النصرة بيانا يوضح ملابسات عملية قتله مع رفاقه، وهل هي بغارة جوية لقوات التحالف أم أنها بقصف لطائرات النظام أم بعملية من أحد الفصائل أم نتيجة لصراع داخل النصرة، أم هي عملية مركبة من جهات عديدة، وهل تؤسس عملية اغتيال الشامي مرحلة جديدة في مسار جبهة النصرة كما حدث عقب اغتيال أبو خالد السوري، فقد تزامنت عملية اغتيال أبو همام الشامي مع بروز الجدل حول إمكانية فك ارتباط جبهة النصرة مع تنظيم القاعدة والتكيّف مع الشأن المحلي، وإذا كان مقتل أبو خالد السوري قد حسم توجهات النصرة آنذاك باتجاه تعريف تنظيم الدولة الإسلامية كعدو تجب محاربته والذي كان يعارضه السوري، فإن الشامي كان يعارض تعريف حركات وفصائل مسلحة كحركة حزم وجبهة ثوار سوريا وغيرها كصديق، ولعل غيابه يفضي إلى دخول النصرة في تكيّفات وتحولات جديدة تشدد على هويتها السورية المحلية وحسم علاقاتها مع المقاتلين العرب والأجانب، وفق عملية تفضي إلى محاولة إعادة تأهيلها واستدخالها كقوة مستقبلية معتدلة.
يمثل أبو همام الشامي (سمير حجازي) أحد أهم القيادات الجهادية المعولمة داخل جبهة النصرة، فهو يتوافر على تاريخ جهادي حافل فقد عرف داخل تنظيم القاعدة بــ "فاروق السوري"، ذهب إلى أفغانستان أواخر تسعينيات القرن الماضي (1998-1999)، والتحق بأبي مصعب السوري لمدة عام في معسكر "الغرباء"، وعين أميراً على منطقة المطار في قندهار، وهو من القلائل الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة ممن تعاملوا مع أسامة بن لادن وأبو مصعب السوري وأبو مصعب الزرقاوي وأبو حمزة المهاجر، وقد بايع أسامة بن لادن الذي عيّنه مسؤولاً عن السوريين في أفغانستان، وشارك في بعض معارك القاعدة، وقد بعثه المسؤول العسكري للقاعدة مصطفى أبو اليزيد إلى العراق أثناء تحضير الولايات المتحدة لغزو العراق، ثم اعتقل على يد المخابرات العراقية وتم تسليمه لسوريا، التي أطلقت سراحه، حيث عاد إلى العراق واستلم منصب المسؤول العسكري لمكتب "خدمات المجاهدين"، إلا أن الأمن السوري اعتقله مجدداً عام 2005 ضمن حملة أمنية واسعة قام بها ضد متهمين ومتورطين بما وصفها بـ"أعمال إرهابية أو تنظيمات جهادية ودينية متشددة"، ثم أطلق سراحه مرة أخرى فغادر إلى لبنان، ومنه عاد إلى أفغانستان مجدداً، قبل أن تطلب منه قيادة القاعدة العودة إلى سوريا، وفي طريق عودته إلى سوريا اعتقل مجدداً في لبنان، لمدة خمس سنوات، وفور الإفراج عنه 2012 دخل سوريا والتحق بـ"جبهة النصرة"، وشغل منصب القائد العسكري العام للجبهة.
لقد حافظت جبهة النصرة على مدى سنوات على نهج يقوم على الحفاظ على علاقات ودية مع كافة فصائل الثورة السورية، وتجنبت الصدام مع كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية، وقدمت تطمينات عديدة بعدم فرض رؤيتها حول مستقبل سوريا واعتماد منهج الشورى في تدبير الخلافات وإدارة المناطق المحررة، والحرص على تقديم الخدمات والإغاثة للجميع، وعدم الانفراد في تحديد شكل الحكم، وتأجيل موضوع تطبيق الحدود وإقامة الشريعة، إلا أن ذلك لم يفلح في إعادة النظر بالتعامل مع النصرة كحركة إرهابية.
عندما تشكل التحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، كانت جبهة النصرة هدفا مفضلا لغارات التحالف الجوية منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفي الوقت نفسه بدأت الفصائل والقوى السورية الموسومة بالاعتدال من طرف الولايات المتحدة وحلفائها تنشط في تقديم خدماتها للحلول مكان الحركات الإسلامية الموصوفة بالتطرف والإرهاب، وبعد ستة أسابيع من بدء الضربات الجوية في سوريا حسمت جبهة النصرة والحركات الإسلامية أمرها بالتعامل مع حلفاء أمريكا وشركائها المحليين باعتبارهم "عملاء"، ودخلت مؤخرا جبهة النصرة في صدام مسلح في ريف إدلب، واستولت على معاقل كل من "جبهة ثوار سوريا"، وحركة "حزم"، وباتت المنطقة تقع تحت سيطرتها التامة.
انتصارات جبهة النصرة بقيادة أبو همام الشامي على الفصائل المعروفة بقربها من الولايات المتحدة حلفائها الإقليميين كانت مزعجة لقوات الحلفاء التي تعمل على بناء معارضة محلية سورية معتدلة، فهي تعيد إلى الأذهان صورة جبهة النصرة التي فقدتها منذ الخلاف والصدام مع أشقائها في تنظيم الدولة الإسلامية، عندما كانت تحقق نجاحات كبيرة، وتستقطب مقاتلين محليين وأجانب، وتتمتع بدعم واسع النطاق من الجهادية العالمية، فقد تمكنت النصرة حتى كانون أول/ ديسمبر 2012 من تنفيذ عمليات كبيرة، وأعلنت عن مسؤوليتها عن أكثر من 500 هجوم، منها سلسلة من الهجمات الانتحارية.
وبفضل تميزها عن جماعات الثوار العاملة في سوريا، فقد اكتسبت شرعية لدى أفضل المُنظرين الجهاديين في العالم، الذين دعوا المناصرين على المستويات الشعبية في جميع أنحاء العالم إلى المساعدة في تمويل الجماعة أو الانضمام إليها، وقتها لم تنتظر الولايات المتحدة طويلا على محاولة "جبهة النصرة" التعمية على هويتها وانتمائها، فقد أدرجتها على قائمة الإرهاب في 11 كانون أول/ ديسمبر 2012، واعتبرتها امتداداً للفرع العراقي للقاعدة والمعروف باسم دولة العراق الإسلامية. وكما فعلت إدارة أوباما آنذاك بمحاولة وأد صعود "جبهة النصرة" في المهد وعزلها من خلال تصنيفها كمنظمة إرهابية، هي الآن تعمل على وأدها عسكريا وتفكيكها استخباريا.
مقتل أبو همام الشامي ورفاقه واستهداف الجناح المعولم داخل النصرة ممثلا بمجموعة "خراسان" سوف يفضي إلى مزيد من التصدع في صفوف النصرة، وقد نشهد سلسلة من الانشقاقات، وبروز نهج مختلف في التعامل مع تطورات مشهد الثورة السورية والحالة الإقليمية والدولية المرتبكة، فالنصرة لا تتوافر على هوية إيديولوجية متجانسة ولا تنظيم مركزي متماسك، وهي في حالة مراجعة دائمة وأجنحة متصارعة وأهداف متبدلة، وخياراتها محدودة، ومعظم المقاتلين العرب والأجانب في حالة من الارتباك والشك وخياراتهم تتجه صوب الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، فحروب الأنصار أوشكت على نهايتها والحواضن الشعبية المحلية لم تعد كما كانت عليه، وبهذا فالنصرة كما عرفناها توشك على الأفول والزوال بانتظار سلالات جديدة عنوانها مفارقة تنظيم القاعدة وتأسيس معتدلي التحالف الدولي وأخرى تنتظر معانقة الدولة الإسلامية.
 ٨ مارس ٢٠١٥
٨ مارس ٢٠١٥
لم يخف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل حقيقة الموقف السعودي وعمقه بالنسبة الى موضوع السياسة التوسعية الايرانية في الشرق الاوسط، حين ألصق وصف "الاحتلال" بايران قائلا خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الاميركي جون كيري الذي كان يزور الرياض "ان ايران تحتل اراضي عربية وتشجع الارهاب". لقد كان موقفا قويا جدا، اذ لامس وضع ايران ووضعها في المرتبة نفسها مع اسرائيل التي توصف بدولة الاحتلال. ولكن بالرغم من قوة الموقف السعودي الذي رأى في سياسات ايران في العراق وسوريا واليمن ولبنان تهديدا مباشرا للامن العربي، فقد بدا الموقف الاميركي الذي عبر عنه الوزير جون كيري ضعيفا، بل انه في مكان آخر.
هذه ليست بداية الخلاف العربي - الاميركي حول الدور الايراني. فالخلاف مع ادارة الرئيس باراك اوباما لم يتوقف منذ بداية الثورة السورية في عام ٢٠١١، وخصوصا ان سياسة الادارة الاميركية الراعية لبقاء نظام بشار الاسد منذ البداية، والاكتفاء بمواقف كلامية لا طائلة منها، أدت الى نحر المعارضة السياسية السلمية والمعتدلة بداية، ثم المعارضة المسلحة المعتدلة مرة على يد النظام، ومرة أخرى على يد التنظيمات المتطرفة التي جرى فتح الابواب امامها لدخول سوريا بكل الاشكال، ولا سيما من جانب النظام وحلفائه الذين آثروا دخول التنظيمات مثل "داعش" وغيرها، وتدمير سوريا بأسرها على رؤوس اهلها، على مواجهة المعارضة السياسية او المسلحة المعتدلة.
في مطلق الاحوال، ثمة وعي عربي مستجد (تأخر كثيرا) لخطورة الاختراق الايراني للمنطقة. فمشهد قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني الذي يتجول بين العراق وسوريا ولبنان لادارة الحروب فيها، ولقيادة آلاف المقاتلين من ميليشيات مذهبية مختلفة، وصولا الى قوات نظامية، لم يحصل من قبل. ولم يحصل أن جاهر مسؤولون حكوميون او برلمانيون بسيطرتهم على عواصم خارجية كما جاهر الايرانيون. هذا لم يحصل حتى ايام السيطرة السوفياتية على اوروبا الشرقية. لقد كان سعود الفيصل في وصفه الاختراق الايراني بالاحتلال حاسما بالنسبة الى موقف السعودي، ولكنه في المقابل رحّب بالمفاوضات حول البرنامج النووي الايراني، معتبرا ان اي اتفاق يمنع ايران من حيازة اسلحة نووية يكون جيدا.
لقد تطور الموقف العربي من السياسات الايرانية على نحو كبير، ولكن لم يقترن الموقف بعمل جاد لانشاء تحالف عربي حقيقي لمواجهة "الاحتلال" كما سماه الامير سعود الفيصل. فحتى الآن لم يظهر اي تطور جذري على الارض في سوريا. وهنا بيت القصيد والاساس. فمن دون اسقاط نظام بشار الاسد، الحاق الهزيمة بالايرانيين وبميليشياتهم، وعلى رأسها "حزب الله" لن يكون ممكناً عكس المسار في الاتجاه الآخر، اي تحرير المشرق العربي.
لذلك يفترض العمل بجدية وبسخاء على خط بناء التحالف الرباعي السعودي - المصري - التركي - الاردني لاسقاط النظام من الشمال والجنوب، أيا يكن الموقف الاميركي. على الدول الاربع ان تحل خلافاتها وتتجاوز ادارة اوباما باسقاط نظام الاسد مهما كلف الامر.
 ٨ مارس ٢٠١٥
٨ مارس ٢٠١٥
انقلب السحر على الساحر، هذه المرة أيضاً، ووجدت الأطراف، التي تجاهلت الظاهرة الأصولية، أو حابتها ودعمتها بصور مباشرة، أو غير مباشرة، نفسها في مواجهة ما سكتت عنه، أو صنعته أيديها.
... لا أريد اتهام الخارج بالوقوف وراء تأسيس تنظيمات أصولية، على الرغم من كثرة المعلومات التي تؤكد ضلوع دول كبرى وإقليمية في تشكيل هذه التنظيمات ودعمها. لكنني لا أستطيع أن أكون ساذجاً إلى حدٍ يجعلني أصدق أن "داعش" هبطت إلى سورية من السماء، وأن من روجوا أصولية الثورة، عندما كان عدد الأصوليين في بعض تنظيماتها لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، لم يكونوا يعلمون ما يفعلون، وأن دولة عظمى رصدت أقمارها الصناعية، قبل خمسين عاماً، بدقة مذهلة محصول القمح والشعير في القارة الصينية الشاسعة، لم تلاحظ بما لها من أعين كونية ولواقط فضائية ومجسّات إلكترونية فائقة التطور ما يجري على أرض سورية وحدودها، وإن من يسجل من أميركا مخابرات سيارات الشرطة في روسيا لم يسجل مخابرات "داعش" وأضرابها.
ولا أصدق، أيضاً، أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الإرهاب كانت تجاهله، وتركه يستفحل إلى درجة تتحدى أقوى القوى المحلية، بما فيها جيش العراق الذي أشرفت أميركا على تدريبه وتسليحه طوال عقد، وبلغ تعداده، مع أجهزة القمع، قرابة مليون شخص، وامتلك من السلاح ما لم يمتلكه غيره، وجيش الإقليم في أربيل الذي كان، وما زال، يحظى بمزايا واضحة في التعامل الدولي مع منطقتنا. ولا أصدق، أيضاً، أن من يحصون أنفاس السوريين، كي يفرزوا الصالح منهم عن الطالح، لم يفكروا بخطورة الابتلاع الإرهابي الجيش الحر ومعظم المناطق التي حررها. أخيراً، لا أصدق، لأن هؤلاء الجبابرة لم يروا كيف كان الإرهاب يفتك، بأشد الصور تبجحاً وعلانية، بالعناصر والقوى الديمقراطية في مواضع انتشاره وسيطرته، وأنهم كانوا ضد ما يفعله.
هل كان الذين أمسكوا بقضيتنا، وساعدت سياساتهم عن نظام الأسد على تحويل ثورة حرية قام السوريون بها إلى اقتتال مفتوح، وسورية من دولة ربيع عربي إلى مكان تدار، من خلاله، صراعات المنطقة المتعددة بدماء شعبنا، يجهلون أن ما يفعلونه سيفضي إلى القضاء على القوى الديمقراطية، أو على أقل تقدير إلى إضعافها لصالح النظام والأصوليين/ الإرهابيين، وأن تلاشي هذه القوى وصعود التنظيمات التكفيرية، في وقت واحد، سيضعهم أمام تحديات صريحة ولا أسرار فيها، أم إن ما وقع هو ما خططوا، عن سابق عمد وتصميم، لإحداثه ونجحوا فيه؟ ألا نكون سذجاً إذا لم نطرح على أنفسنا هذه الأسئلة، ونستخلص منها النتائج الضرورية لإعادة تصويب مواقفنا تجاه القوى الإقليمية والدولية، التي مكنتها غفلتنا، وما زالت، تمكنها من الركوب على ظهورنا، وسوقنا إلى حرب نخوضها بالنيابة عن عسكرها؟
ليس صحيحاً أن الحرب على الإرهاب كانت في أولويات من أداروا مأساتنا، فقد سبقتها الحرب على الديمقراطية والديمقراطيين، التي تعاونوا فيها مع الأسد، وعانى شعبنا الأمرين منها، ونرى، اليوم، نتائجها في كل مخيم ومشرد ومهجر ومعتقل وميت تحت التعذيب ومقتول بالأسلحة المحرمة دولياً، من كيماوية وبراميل متفجرة وصواريخ فراغية وغازات سامة.
إذا كانت الحرب ضد الإرهاب صعبة وطويلة، فلأنها جاءت، بعد حرب أولى أضعفت وأنهكت قوى الاعتدال الديمقراطية، وأخرجت قواها الرئيسة من الصراع ضد الإرهاب، بعد أن حاربته بمفردها طوال نيف وعام. وما يجري، اليوم، هو انتقام النتائج التي ترتبت على سياساتهم منهم، وانتقام الديمقراطية من أعدائها الدوليين.
 ٧ مارس ٢٠١٥
٧ مارس ٢٠١٥
كلام قد لايعجب الكثيرين … ولكن هذا هو المشهد اليوم
الموالون و “المنحبكجية ” متفقون على شخص “الديكتاتور ” بشار الاسد ويلتفون حوله كقائد لهم ولم نسمع بصدامات مسلحة بين فصائلهم وقواتهم وهذا سبب بقاء مايسمى ب ” نظام ” إلى الان .
اما المشهد في صفوف ” الثواااار ” هم منشغلون بالقتال بين بعضهم البعض ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن صدام مسلح بين الفصائل المسلحة والاتهامات متعددة ! هذا على الجانب العسكري , اما على الجانب السياسي والثوري والنشاط على صفحات التواصل الاجتماعي ” للأسف ” لم تترك شخصية معارضة او ثائرة او ناشط او ناشطة الا وقلل من شأنها واحترامها و تم شتمها والتهكم عليها و وصلت الامور في كثير من الاحيان إلى حد التخوين و الاتهام العمالة , كأننا تخلصنا من النظام المستبد ونعيش في بلد ديموقراطي مستقر لاينقصه الا ممارسة اخر واسخف شكل من اشكال الديموقراطية وهو الشتم والنقد والتجريح والتهجم على أي شخصية تبرز ” سياسياً ” وتحاول ان تتقدم المشهد ,والتي يفترض بها ان تقود هذه المرحلة الصعبة ويقدم لها كل الدعم والعون ممن يدعون انهم ” جمهور الثورة ” كل ذلك لمصلحة من ؟ هنا نتكلم عن ( الشخصيات الوطنية المعارضة ) التي كانت تستحق الدعم والمساندة والنصح والعون والتي باتت اليوم بعيدة كل البعد عن مركز القرار و استبعدت او ابعدت مرغمة عن المشهد الثوري , هل يعقل ان تعجز الثورة السورية العظيمة عن تقديم شخصية قيادية يلتف حولها الناس ويتفق عليها الناس بعد اربع سنوات من التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري !؟ اين الخلل ؟ من المسؤول ؟
لم يترك رجل من المعارضة ولافصيل ولا حزب ولا ناشط ولا ثائر الا واختلفوا عليه و وجهوا له كل انواع واشكال النقد والتهكم والشتم, . من منا انساناً كاملاً وبلا اخطاء ؟!
صراعات وخلافات المعارضة الحاصلة اليوم , هي مرآة لحالنا جميعا نحن لسنا افضل حال منهم.
نحن ايضا نحتاج لإصلاح وإعادة تأهيل (تربوي ومجتمعي) وأخلاقي … المعارضة والنظام لم يأتوا من الفضاء الخارجي بل هم ابناء سوريا ويعكسون ثقافة وحال وفكر شريحة من الشعب السوري . هنا نتكلم عن فئة الفاسدين و الطامعين والمتصارعين والمتسلقين وعن جمهور الشتامين والمخونين والمشككين والغوغائيين ,
طبعا باستثناء النخبة من صفوة شباب وشابات سوريا الاحرار الذين اطلقوا هذه الثورة وضحوا بدمائهم وحاضرهم من أجل حريتنا جميعاً. فهؤلاء الأبطال هم اليوم إما في المعتقلات يعانون شتى أنواع التعذيب والذل والقهر ,أو استشهدوا في أجل الثورة وحرية الشعب السوري .ومن تجاوزه الموت أو الاعتقال من تلك النخبة الثائرة ,إما هاجر او تنحى جانبا , مندهشا مذهولا مما يحدث على الارض ,عاجز وسط فوضى السلاح والسياسة و فوضى ( الثورة ) الحاصلة اليوم , هو مازال ثائراً بقلبه وفكره لكن لاحول له ولاقوة . ومعهم من يقبع في مخيمات اللجوء وراء الحدود يعاني القهر والحسرة ولايملك من أمره شيء ولا أحد يسمع صوته , وهناك من يقبع في الداخل تحت سطوة النظام يعيش الرعب والخوف والقهر كل يوم , ومنهم من حمل السلاح ليدافع عن نفسه وترك للمصير المجهول دون دعم أو عون ,
كل هؤلاء ضاع صوتهم وسط الغوغاء الحاصلة بين جمهور الموالين المتفقين على قائدهم المجرم و بين جمهور ( المعاااارضين !!!! ) الذين لم ولن يتفقوا على رجل حتى لو كان ” منزلاً ” من السماء.
حين نتمكن من الاتفاف والالتفاف حول شخصية وطنية واحدة على الاقل في هذه المرحلة الحرجة والصعبة التي نعيشها منذ سنوات للعبور من هذا النفق , ان تمكنا من ذلك حينها ” فقط ” ربما سنقترب من تحقيق النصر والحسم الذي يبدو مازال بعيداً للاسف وفق المعطيات الحالية ,مالم نعمل جميعا على تغيرها بانفسنا اولاً , هنا نتكلم عن المرحلة الاولى من النصر وهي اسقاط النظام , فالدرب امامنا مازال طويل ويحتاج لجهد الجميع, فنصر الثورة السورية لن يكون بسقوط النظام فقط , امامنا ثورة كبيرة مابعد السقوط , ثورة بناء وتنمية وعمل واعادة ثقة وتضميد للجراح,
هذا طبعاً ان استبعدنا الصراع السياسي الذي سيحصل على السلطة , وما اهون الصراع السياسي امام الصراع العسكري المسلح , فيبدو وفق ما يحصل اليوم على الارض ,بات من غير المستبعد انه سيكون هناك صراع عسكري دامي بين الفصائل المسلحة متعددة الولاءات والقيادات .
لن يتغير المشهد الحالي لا اليوم ولا غداً ,مالم نجتمع على قلب رجل واحد وندعم بعضنا البعض ونثق ببعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض ونبتعد عن الانشغال بصغائر الامور , علينا العودة لثورتنا وعلمنا و شعاراتنا وما اقسمنا عليه , ونقف صفاً واحداً كما بدأنا , انتبهوا جيداً ولا تأخذكم الحمية والانسياق وراء الاوهام كونوا على يقين ان من يحمل السلاح وله مشروعه ” الخاص ” ورايته الخاصة وحلم دولته وامارته وتنظيمه واميره ومعهم الجمهور الذي يصفق لهم كل هؤلاء شركاء في تفريق الصفوف وضياع الثورة والحلم السوري بالحرية والعدالة والديموقراطية , نعم كل هؤلاء لاتعنيهم ثورتكم بشيء ولاتهمهم حريتكم و لا تضحياتكم , لاتنتظروا منهم شيء , هؤلاء ان كانوا “صادقين ” عليهم ان يعملوا لاجلكم ولمصلحتكم ويحققوا حلمكم وتطلعاتكم بالحرية , على هؤلاء ان ينضموا اليكم لااا ان تنضموا انتم اليهم , فأنتم الشعب وانتم المرجعية وانتم الشرعية وانتم اصحاب الثورة وانتم من اطلقها وانتم من قدمتم التضحيات ,
تماسكوا وعودوا كما بدأتم واتفقوا على قائد وطني “شريف ” فسوريا لا تخلوا من العظماء , دافعوا عن ثورتكم وكونوا اوفياء لتضحيات الشهداء والمعتقلين لنحقق النصر …






