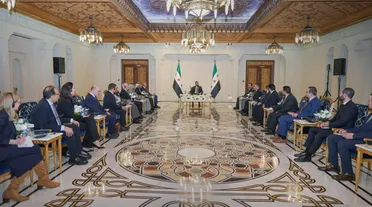عن عودة الإرادة السورية
القراءة الصحيحة للوضع الداخلي، والمعادلات الإقليمية والدولية المتشابكة معه، المؤثرة فيه، تمكّن السياسي من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، تماماً مثلما يكون الحال مع التشخيص السليم بالنسبة إلى الطبيب. أما إذا كانت القراءة خاطئة، فستكون النتائج المترتبة إليها هي الأخرى خاطئة، أو غير منتجة. وهذا ما حصل مع القيادة السياسية التي تصدّرت المشهد في بدايات ثورة الشعب السوري على نظام الاستبداد والإفساد.
فقد تصورت القيادة المعنية أن التغيير آتٍ إلى سورية، وأن العالم قد تغيّر، وبات مصير الديكتاتوريات في منطقتنا محسوماً لمصلحة شعوبها، لتتمكّن هذه الأخيرة من إعادة بناء مجتمعاتها من أجل مستقبل أفضل لأجيالها المقبلة، يضمن الفرص العادلة في ميادين التعليم والعمل والإبداع. وكان التصور هو أن كل ذلك سيكون في مصلحة الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.
ولكن ما تبين لاحقاً أن هذه القراءة كانت متفائلة أكثر من اللازم، لأنها لم تأخذ في الاعتبار موقع ودور سورية وأهميتها على صعيد ضبط المعادلات بين القوى الإقليمية والدولية، هذه القوى المتصارعة على المزيد من التحكّم بتوجهات المنطقة ومقدراتها.
ومن بين ما أدّت إليه القراءة الخاطئة تلك أن القيادة السياسية للثورة غضت النظر عن الأخطاء والممارسات غير السوية التي كانت تتمّ سواء ضمن المؤسسات السياسية، أم على المستوى الميداني العسكري الذي كان في واقع الحال خارج نطاق نفوذ السياسيين، وذلك لأسباب كثيرة لسنا بصدد تناولها الآن.
ومع الوقت تراكمت الأخطاء المعنية، وأصبحت ظاهرة لتؤدي بدورها إلى تحوّلات نوعية تراجعية، مهدت الطريق أمام تدخلات إقليمية ودولية استهدفت هندسة كيان جديد تحت اسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ليكون البديل عن المجلس الوطني السوري الذي كان يعبر عن أهداف الثورة السورية. فأصبح الكيان الجديد يجمع بين قوى الثورة والمعارضة من دون أن ينتبه أحدنا إلى أن الخطوة المعنية كانت مقدمة لإنهاء قوى الثورة، والإبقاء على قوى المعارضة بأطيافها المختلفة، لتختزل المسألة إلى مجرد خلاف بين نظام ومعارضة حول تقاسم السلطة. هذا في حين أن الثورة السورية جسّدت تبايناً وجودياً بين مشروعين: مشروع النظام المستبد الفاسد المفسد. ومشروع الشعب الثائر المتحور حول قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومع الوقت، غاب مصطلح قوى الثورة نهائياً عن المشهد، ليصبح مصطلح قوى المعارضة السياسية والعسكرية أو الميدانية هو المهيمن.
ومع تبدّل أولويات القوى الإقليمية، وتحكّم روسي شبه كامل بالملف السوري، بدأنا نرى معالم خطة مبرمجة، استهدفت إجراء تغييرات بنيوية ضمن هيكلية المعارضة السورية، وكان الهدف هو تغيير وظيفتها ودورها. فقد بات المطلوب منها التعايش مع النظام، إن لم نقل الاندماج فيه بهذه الصيغة أو تلك، وذلك بموجب رتوش دستورية، ستكون غالباً مجرد حبر على ورق، في ظل وجود نظام أمني قمعي مهيمن، متحكّم بمفاصل الدولة والمجتمع. على أن تكون التغييرات المعنية مقدمة لانتخابات عامة تحت إشراف دولي، يتم التسويق له منذ الآن. واللافت في الأمر أن القائمين على هذا التسويق يتجاهلون عن سابق قصد وتصميم عجز المجتمع الدولي، إن لم نقل تخاذله، عن إدانة جرائم هذا النظام الصارخة مثل الكيماوي والتصفية المبرمجة للمعتقلين، واستخدام سلاح الاغتصاب، وقصف المدن والبلدات السورية بنحو 70 ألف برميل على مدى سنوات وغير ذلك من الجرائم التي يبدو أنها قد باتت جزءاً من المألوف اليومي لعالم المصالح والحسابات.
ومن الواضح أن جرعات التخفيف، بالمعنى الكيماوي، التي تعرضت لها المعارضة السورية قد ساهمت في تضييق نطاق المناورة لديها، وأضعفت من قدرتها على رفض ما يعرض عليها من أشباه حلول، تتقاطع كلها حول شرعنة النظام القائم، مقابل فتات سلطوي لن يستفيد منه السوريون شيئاً.
اللحظة التي تواجه السوريين المعارضين، الذين يرفضون علناً، على الأقل، القبول بفكرة استمرارية نظام بشار، حاسمة ومفصلية. فهم إما سيسيرون مع قافلة المهللين لـ «الحل» الروسي، أو أنهم سيتخذون الموقف المناسب المنسجم مع تضحيات وتطلعات الشعب السوري، وسيرفضون الخنوع لما يُفرض عليهم، وهم يدركون قبل غيرهم طبيعته ومآلاته.
سوتشي على الأبواب. ومن المفروض أن يعقد بإشراف وتحكّم مباشرين من الجانب الروسي، وبالتفاهم مع النظام، وبمشاورة مع القوى الإقليمية التي أرغمها الغياب الأميركي على التواصل غير التقليدي مع الروس، حتى تكون بمنأى عن الموجات الارتدادية للزلزال الذي تشهده المنطقة بفعل التدخل الإيراني بمختلف الأشكال والأدوات.
هل سنقنع أنفسنا، ونشارك من باب ضرورة التعاطي الإيجابي مع المبادرات السلمية، ونلوذ بذريعة أخطار الكرسي الفارغ. وهذا فحواه ليس الإقرار بالهزيمة وحدها، بل الاعتراف بأحقية النظام، والتسليم بشرعيته، وتحميل من ثار عليه من السويين مسؤولية ما حدث.
علينا أن نميز في هذا السياق بين الموقف الشجاع الذي يعترف بعدم الانتصار، وبين الموقف الإنهزامي الاستسلامي الذي يروّج له بعضهم بهدف، شرعنة النظام، وإعادة تجديده.
ففي الحالة الأولى، لا بد أن نبحث في الأسباب والمقدمات التي كانت وراء الإخفاق من أجل تلافي السلبيات التي كانت، بصغيرها وكبيرها، ونؤسس لحركة وطنية شاملة، تمثل إطاراً يستوعب طاقات شبابنا الهائلة في الداخل والخارج، طاقات النخب السورية الثقافية والفنية والإعلامية والاقتصادية والمجتمعية، لتكون جميعها متفاعلة، مشاركة في حركة عامة، تلتزم المشروع الوطني المدني الديموقراطي الذي يكون بكل السوريين ولكل السوريين.
ومن نافل القول هنا أن نؤكد أن مشروعاً كهذا سيستغرق الكثير من الوقت والجهد، ويستوجب الكثير من التحمّل والتضحيات، ولهذا لن يكون جذاباً بالنسبة إلى المستعجلين اللاهثين بعقلية سحرية خلف ما يشبع عقدهم، ويستجيب نزواتهم ونزعاتهم.
لقد قدم السوريون تضحيات تعجز الأرقام والعبارات عن تحديدها وتوصيفها. ولكنهم مع ذلك لم ينتصروا، وليس في ذلك أي عيب أو نقيصة. لأن قوى الشر جميعها تكالبت عليهم. أما القوى الأخرى التي أعلنت صداقتها للشعب السوري، فقد لاذت بالصمت المريب.
لقاء سوتشي المقترح، المرتقب، لن يربك السوريين الرافضين لأي دور للنظام القائم، فهؤلاء قد اتخذوا قرارهم برفض المشاركة، وهذا القرار سيعيد اللحمة في ما بينهم، وتسترجع قضيتهم ألقها الأصيل؛ بعد تحررها من كل الشوائب والقيود المؤلمة.
الأمور كلها في منطقتنا في حالة غليان وتفاعل، ومن يدري، فقد يكون التحرك الشعبي الإيراني مقدمة للتحوّل الأكبر المنتظر.