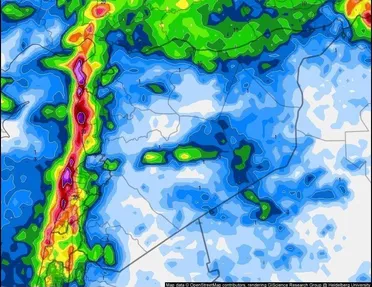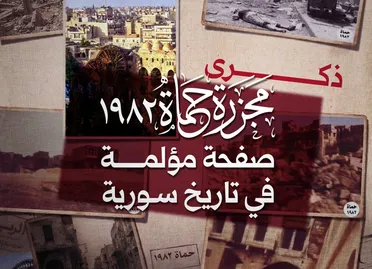"الترقيع السياسي": من خياطة الثياب إلى تطريز المواقف
منذ أن كنا أطفالاً، كنا نسمع كلمة "الترقيع" في سياق بسيط: عندما يتمزق جزء من قطعة لباس، يُصلَح برقعة ليبقى صالحاً للاستعمال، وإن كان لا يعود كما كان. ومع مرور الوقت، لم تعد الملابس المرقعة دليل فقر أو عوز، بل أصبحت في بعض الحالات موضة يتباهى بها البعض.
لكن مفهوم "الترقيع" لم يبقَ حبيس عالم الألبسة. لقد تسلل إلى المواقف والآراء، خاصة في القضايا المصيرية. ففي المعجم، يعني "الترقيع" إصلاح التمزق بإضافة رقعة، أي معالجة موضعية لا تُعيد الشيء إلى أصله. لكن الاستخدام المجازي للكلمة تطور، ليصف محاولات التراجع غير الكاملة، أو التبريرات المؤقتة لتفادي الإحراج أو المحاسبة. وغالباً ما يُستخدم لوصف من يبدّل رأيه بعد انكشاف الحقائق، دون اعتراف صريح بخطئه.
ترقيع المواقف في زمن الثورة
في سورية، منذ اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد في آذار/مارس 2011، ظهرت هذه الظاهرة بأوضح صورها. فقد انقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: من وإلى النظام وكرّس نفسه لتلميعه والدفاع عن جرائمه؛ من عارض ودفع الثمن غالياً من حريته وحياته وراحته؛ من اختار الصمت أو الحياد، ولو ظاهرياً.
الصنف الأول - من الموالين - ظل لسنوات يمجّد الأسد، باعتقاد أن بقاءه أبديّ، حتى فجّر الشعب السوري هذه "الأسطورة". عندها وجد كثير منهم أنفسهم في موقف محرج، فبدؤوا "الترقيع" لمواقفهم السابقة، بتبريرات من قبيل: "ما كنا نعرف بسجن صيدنايا". هذه العبارة تحديداً استخدمتها الممثلة سوزان نجم الدين، وشادي حلوة وغيرهم، كمحاولة لدرء اللوم عن أنفسهم.
وقد توالت التبريرات: "كنا خايفين"، "ما كان بإيدنا"، "ضللونا بالإعلام"… لكنها مبررات لا تكفي لمسح تاريخ من التواطؤ أو التبرير المباشر لجرائم لا يمكن تجاهلها. الخوف مفهوم في بعض السياقات، لكنه لا يجب أن يُستخدم ذريعة للصمت أمام القتل، أو لتبرير الاستبداد. ففي أحلك الظروف تُختبر المبادئ، وتُعرف معادن الناس.
التبديل لا الاعتراف
ما يلفت النظر أن كثيراً من هؤلاء "المرقعين" لم يتراجعوا بدافع ندم حقيقي، بل لأن اتجاه الرياح تغيّر. فاختاروا تبديل الموقف كما يُبدّل القميص، دون أي اعتراف بدورهم في نشر الوهم، أو اعتذار للضحايا الذين سقطوا بصمتهم أو مشاركتهم في بروباغندا النظام.
لقد أصبح الترقيع السياسي وسيلة لتبييض ماضٍ لا يُمحى بالكلمات، بل نوعاً من الكذب المقنّع، وتزويراً لذاكرة جماعية. حين يدّعي البعض أنهم كانوا مغيبين أو ضحايا تضليل، وهم في الحقيقة كانوا جزءاً من ماكينة التشويه، فإنهم لا يسعون للحق بقدر ما يهربون من المحاسبة.
حتى أن الترقيع ظهر ضمن وجهات النظر على المواضيع التي تُحظى بأهمي، فحين انتشرت قصة "خطف ميرا"، سارع كثيرون إلى تصديق الرواية وتبنّيها دون تحقق، فانهالت المنشورات الغاضبة التي تهاجم الحكومة وتدين وضع إدلب، معتبرين ما حدث دليلاً دامغاً على الفوضى والانهيار الأمني.
لكن ما إن كُشف لاحقاً أن القصة ليست سوى "هروب حب" لا علاقة لها بالاختطاف، حتى وجد أولئك أنفسهم في موقف محرج، فبدأ بعضهم بمحاولات ترقيع الموقف، تارة عبر التذرع بأن "النية كانت سليمة"، وتارة أخرى عبر تحويل اللوم على الإعلام أو على "الجهات التي لفّقت الرواية"، متناسين أنهم كانوا جزءاً من تضخيم الحدث دون تثبت. هذا المشهد يعكس أزمة في التعامل مع المعلومات، حيث تغلب العاطفة على التريث والعقل، وحيث يصبح "الترقيع" بديلاً عن الاعتراف بالخطأ.
لا مستقبل بلا مواجهة
مواجهة هذا "الترقيع" ليست بهدف الانتقام، بل بهدف تثبيت الحقائق، ومحاسبة أخلاقية لكل من ساهم، بصمته أو دعمه، في صناعة الألم السوري. لا يمكن بناء مستقبل سليم على رقعٍ وخيوط كاذبة، بل على الصدق، والاعتراف، والجرأة في مواجهة الذات، والاعتراف لا يُنقص من الكرامة، بل يمنحها. أما الترقيع، فمهما بدا أنيقاً، يبقى دليلاً على تمزقٍ لم يُعالج كما يجب.