 ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
خلاصة لقاء فيينا الرباعي بين روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية أن التسوية السلمية في سورية، المطروحة روسياً، ومقبولة أميركياً، تضمن بقاء الأسد، وتؤمن عدم سيطرة المعارضة على الدولة السورية، إن بقيت سورية دولة، غير أن مجريات لقاء فيينا ومحصلته ترتبط عضوياً بالزيارة التي قام بها بشار الأسد إلى موسكو، والتي حملت رسائل شديدة الأهمية والدلالة. فالإعلان عن الزيارة (ربما لم تكن الأولى منذ الثورة) يعني، مباشرة ومن دون أي تأويل، أن موسكو تمنح بشار دعماً مفتوحاً ومطلقاً، بل وتستطيع حمايته وتأمين خروجه من دمشق وحتى عودته سالماً غانماً. أما إتباع الزيارة بلقاء فيينا فمؤشر بالغ الدلالة، لجهة تقدم مكانة روسيا وموقعها إلى الأمام في معسكر دعم بشار، ما يعني ضمناً تراجعاً إيرانياً بالمسافة نفسها. وهو ما يؤكده غياب طهران عن لقاء فيينا، بعد أن كانت مرشحة، مع دول أخرى غُيبت أيضاً، للمشاركة في أي مشاورات سياسية جماعية.
ربما كان استبعاد إيران لتخفيف حدة اللقاء وتليين مواقف الأطراف الأخرى، خصوصاً السعودية وتركيا. أو لتأكيد أن روسيا عراب التسوية المطروحة بصيغة محددة، لا تقبل التفاوض، إلا في الهوامش، مثل المسائل الإجرائية ومواعيد التنفيذ. وهو ما يتسق مع الانطباع الذي تركته حزمة الاتصالات الهاتفية لبوتين مع عواصم الدول المعنية، من أن موسكو صارت المتحدث الرسمي باسم دمشق، بموجب الاستغاثة العسكرية، أو بالأحرى التفويض الذي تلقفته موسكو من دمشق مُرحبة.
وعلى الرغم من أن بوتين سعى، عبر تلك الاتصالات ثم لقاء فيينا، إلى تجميل التحرك السياسي الروسي برتوش منها استعداد النظام لتسوية سياسية، تتضمن إشراكاً للمعارضة "المعتدلة المسلحة"، إلا أن جوهر الخطوة الروسية الضاغط على المعارضة والدول الداعمة لها كان أكثر حضوراً وبروزاً من ذلك العرض الشكلي. وهو أمر مفهوم في ظل تواطؤ غربي، وتحديداً أميركي. ليس فقط بالنسبة لبقاء بشار، في مرحلة انتقالية غير محددة بدقة. لكن، أيضاً بالنسبة لطبيعة سلطة الحكم ومكوناتها، وتحديداً موقع المعارضة ودورها في تلك المرحلة. ولا غرابة بعد ذلك أن تمضي موسكو إلى ما هو أبعد، فتطلب من المعارضة، تحديدا الجيش الحر، المشاركة في الحرب على "الإرهاب" وإلا! وما قامت به الطائرات الروسية من قصف لمواقع الجيش الحر، وغيره من فصائل مسلحة لا ترتبط بتنظيم الدولة، ليس سوى بروفة لما يمكن القيام به ضد كل القوى التي تقاتل نظام بشار. وقد اختبرت موسكو بالفعل ردود الفعل على ما قد تباشره من عمليات ضد المعارضة، من أبرزها اختراق المجال الجوي التركي، والتحرش بالحضور العسكري الغربي. وكانت نتائج تلك الاختبارات مؤشراً إلى أن أياً من الدول، أو الأطراف التي أعلنت رفضها التدخل الروسي، ليست على استعداد لرفع سقف الرفض، إلى حد الدخول في مواجهة عسكرية ضد موسكو، ولو كان السبب في ذلك تعرّض قوات المعارضة لقصف مباشر، أو تنطع موسكو باستعراض عضلاتها الجوية على الحدود بين سورية وتركيا.
لا تكتفي الطبخة الروسية التي تقدمها للمعارضة بمرحلة انتقالية تحت رعاية بشار وإشرافه، وإنما تقرنها بالاصطفاف معه في مواجهة داعش وغيره من الجماعات الموسومة بـ "الإرهابية". أما إن رفضت المعارضة والدول الداعمة لها ذلك العرض، فسيعني ذلك، من وجهة النظر الروسية، الاصطفاف مع الجماعات "الإرهابية". وعندها، سيتم التعامل مع المعارضة، سواء الجيش الحر أو غيره، بنمط التعامل المسلح نفسه مع داعش، بأيدي دمشق وطهران وموسكو، تحت سمع واشنطن ولندن وباريس وبصره
 ٢٤ أكتوبر ٢٠١٥
٢٤ أكتوبر ٢٠١٥
الاتحاد الأوروبي منقسم حول كيفية التعاطي مع التدخل الروسي في سورية. وتكاد المواقف تتعدد بتعدد "الكتل" داخله. ويمكن أن نصنف الدول الأوروبية في ثلاث فئات أساسية. تتمثل الأولى في الدول الأوروبية ذات المواقف المحسومة سلفاً حيال روسيا، لأسباب تاريخية، وهي دول أوروبا الشرقية المعروفة، في معظمها، بعدائها لروسيا التي تعتبرها دائماً مصدر تهديد لأمنها. وازدادت مخاوف هذه الدول مع الصراع الأوكراني. وبالتالي، العملية تحصيل حاصل. ومن ثم فهي تقف وراء الأطراف الأوروبية الأكثر انتقاداً (الفئة الثانية) للتدخل الروسي في سورية، لكنها (كما هو حال بولندا)، ومنذ البداية، ضد التدخل الأوروبي في سورية. وعليه فالموقف من روسيا لا يحدد بالضرورة الموقف من مسألة التدخل.
تتكون الفئة الثانية من دول مثل فرنسا وبريطانيا، تتموقع حيال روسيا وفق مصالحها الاستراتيجية عالمياً، وليس بالضرورة بالنظر للشرق الأوسط، فهي خسرت مواجهتها مع روسيا في أوكرانيا، وتسعى إلى أن تنتقم لنفسها في سورية، بإفشال الاستراتيجية الروسية هناك. لكن، إلى حد الآن، روسيا هي من يحرز النقاط على حسابها. فدول هذه الفئة انطلقت، في البداية، من فرضيةٍ، ثم من مسلمةٍ، فحواها أن التدخل الجوي الروسي في سورية ليس لضرب داعش، وإنما لحماية نظام الأسد بضرب المعارضة. لذا، تقول هذه الفئة الثانية من الدول الأوروبية إن على روسيا أن تتوقف عن ضرباتها، أو تصوّبها ضد داعش، وأن تعمل على إيجاد حل سياسي للصراع الدائر في البلاد. وتتزعم فرنسا هذا الموقف، مطالبة برحيل الأسد شرطاً لإحلال السلام، فقد اعتبر رئيسها، الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن وضع الجلاد والضحية في المقام نفسه، وهو منطق سليم، لو أنه طبقه على بؤر توتر أخرى، مثل فلسطين. تحرك الفئة الثانية تحكمه، أيضاً، مصالح استراتيجية، بغض النظر عن التوافق بين الاعتبارات المصلحية والأخلاقية (دعم تطلعات الشعب السوري للحرية).
تتكون الفئة الثالثة من دول حتى، وإن تحفظت على الضربات الجوية الروسية، فهي لا تطالب بوقفها الفوري، كما أنها تتحفظ أيضاً على التدخل الجوي الفرنسي في سورية. وهذا هو موقف ألمانيا. ويبدو أن الأخيرة التي سبق أن عارضت التدخل في ليبيا في 2011 تتخوف من أن تجرّ فرنسا الدول الأوروبية إلى أن تتدخل كاتحاد في سورية، لتفتح جبهة خلافية ثانية مع روسيا، بعد الجبهة الأوكرانية. وترى ألمانيا أن التعامل مع روسيا ضروري، لتسوية سياسية للأزمتين، الأوكرانية والسورية. وتتخوف دول هذه الفئة الثالثة من أن يطيل التدخل من أمد الأزمة مستدلة بالتجارب السابقة.
الحقيقة أن الشغل الشاغل بالنسبة لمعظم، إن لم نقل كل، دول الاتحاد الأوروبي ليس كيفية إدارة الصراع، والموقف من التدخل الروسي، وإنما إيقاف تدفق اللاجئين السوريين. لذا، الهدف الأساسي بالنسبة إليها هو الاتفاق مع تركيا لاستقبال المهاجرين، ومراقبة حدودها للحد من تدفق هؤلاء. فحيثيات الحرب في سورية، في الراهن، ليست أولية قصوى، وإنما التوصل إلى صيغة مناولة، تقوم بها تركيا لحساب الاتحاد الأوروبي، في مجال تسيير تدفق اللاجئين، بالإبقاء عليهم
"مسألة المهاجرين واللاجئين شكلت المحور الأول والأطول للبيان الختامي للمجلس الأوروبي، فيما لم تحظ الأزمة السورية إلا بفقرة واحدة مقتضبة (ما قبل الأخيرة)"
على التراب التركي، وبتمويل أوروبي، على أمل عودة هؤلاء إلى ديارهم، بعد انتهاء الحرب. والدليل على ذلك أن مسألة المهاجرين واللاجئين شكلت المحور الأول والأطول للبيان الختامي (استنتاجات) للمجلس الأوروبي المنعقد منتصف الشهر الحالي، فيما لم تحظ الأزمة السورية إلا بفقرة واحدة مقتضبة (ما قبل الأخيرة). هذا يعني أن دول الاتحاد الأوروبي حاولت العمل فيما اتفقت فيه، تاركة ما اختلفت فيه إلى وقت لاحق. إذ اكتفت بالحد الأدنى من التوافق. فهي تُحمِّل، في بيانها، نظام بشار الأسد مسؤولية وفاة 250 ألف شخصاً وترحيل الملايين، بسبب الصراع في البلاد (نقطة اتفاق)، وترى أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سورية تحت النظام الحالي، ومادامت المطالب والتطلعات الشرعية لكل مكونات المجتمع السوري لم تؤخذ في الحسبان". هذه نقطة توافق أخرى، لكنها تعبر، في واقع الحال، عن خلافات جوهرية: صياغة هذه الجملة بهذا الشكل تعنى أن دولاً أوروبية لا تشترط رحيل الأسد، لإحلال السلام في سورية، وإنما تبقي الباب مفتوحاً لتسوية سياسية، يكون النظام جزءاً منها (وليس بالضرورة جزأها الأساسي). وهذا طبعاً يتناقض ومواقف دول مثل فرنسا. كما "يعرب المجلس الأوروبي عن انشغاله إزاء الهجمات التي تقوم بها روسيا ضد المعارضة والشعبين السوريين، وكذلك إزاء خطر تصعيد عسكري جديد". وهي صياغة دبلوماسية، تكاد تكون منقولة حرفياً عن بيانات مجلس الأمن وقراراته (يقول الاتحاد الأوروبي إنه يتحرك وفقها، حتى لا يقحم نفسه سياسياً وعسكرياً في الصراع السوري). فهي صياغة محايدة وتوفيقية، تم التوصل إليها حلاً وسطاً يرضي مختلف الأطراف الأوروبية، وإن كانت، في الواقع، انتصاراً لرأي أصحاب سياسية ضبط النفس، وعدم التورط في التدخل، أو في المواجهة مع روسيا بسبب سورية.
ونافل القول إنه إذا كانت الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا صراعاً استراتيجياً مع روسيا، فإنها لا تتفق على رفع الأزمة السورية إلى المقام نفسه، ويبدو واضحاً أن جلها ممتعض من توجهات بعض الدول (في مقدمتها فرنسا) لمقاربة الأزمة السورية، وفق المفردات نفسها والأزمة الأوكرانية.
 ٢٤ أكتوبر ٢٠١٥
٢٤ أكتوبر ٢٠١٥
صنع السوريون لأنفسهم في السنوات الأربع الماضية من عمر الثورة صورة بطولية في الشجاعة، في مقاومتهم الظلم والغطرسة والاستبداد، ومن أجل استعادة حريتهم وسيادتهم على وطنهم، بعد أن انتزعتهما منهم طغمة مغامرة، حولت سورية إلى مزرعة مستباحة لعائلة الأسد وأقاربه وأتباعه ورجال خدمته المطيعين. ولا أعتقد أن شعباً تعرض للمذابح، وحورب بجميع أنواع الأسلحة الفتاكة، بما فيها الكيميائية، وبقي يقاتل وحيداً على الرغم من إجماع دول العالم على عدالة قضيته، واضطر إلى أن يقاتل بلحمه الحي، كما فعل الشعب السوري.
أثبت السوريون أنهم، على الرغم من المظاهر المسالمة لثقافتهم ومدنيتهم، شعب أكثر شراسةً وجلداً ومراساً في القتال مما كانوا هم أنفسهم يتصورون. لكنهم، بمقدار ما أبدوه من الشجاعة والإنجاز في ميدان القتال، ظهروا، في المقابل، شديدي الضعف سياسياً، أو فاقدين الحد الأدنى من الخبرة في هذا الميدان. وربما قدم رئيسهم الشقي الذي اعتبر حرق الدولة والبلاد ثمناً معقولاً لقاء رحيله من الحكم مثالاً لا يجارى على ذلك. ونظرة سريعة إلى حصيلة كفاحهم السياسي، للسنوات الأربع الماضية، تظهر، بوضوح، أنهم، بمقدار ما حققوا من نتائج على الأرض، تراجعوا تراجعاً كبيراً في السياسة. فقد قهروا، بقوتهم الذاتية وصبرهم وعنادهم وتضحياتهم الغزيرة، نظاماً من أعتى النظم وأكثرها وحشية وانعداما للشعور بالمسؤولية، واستعداداً للقتل والإجرام من دون حساب، ودمروا قاعدة حكمه العسكرية والأمنية، حتى لم يجد أمامه حلاً سوى الاستنجاد بالأجنبي.
بدأ الأمر بميليشيا حزب الله الذي تحدى النظام نفسه، وأظهر احتقاره له، عندما أعلن أنه دخل لإنقاذ نظام بلغ تعداد جيشه وميليشياته قبل دخوله أكثر من 700 ألف مقاتل بين قوات نظامية وأمنية وشرطة وشبيحة من مختلف الأنواع. لكن، سرعان ما اكتشف حزب الله صاحب "الانتصارات الإلهية" عجزه، فاستنجد بالميليشيات العراقية، المشحونة حتى الانفجار، بالأحقاد الطائفية وإرادة القتل والتمثيل بالسوريين المدنيين الذين قيل لهم إنهم أعداء الدولة والدين وعملاء إسرائيل. ولم يلبث الحرس الثوري الايراني نفسه حتى وجد نفسه مضطراً للتدخل، حتى لا ينهار وضع النظام الذي صار حبيس منطقةٍ لا تتجاوز مساحتها 16% من مساحة الجمهورية. ومع ذلك، لم يوقف انهيار النظام القاتل الذي تفكك وفقد توازنه إلا التدخل الروسي الذي يكاد أن يكون قد كلف بوضع حد للمأساة من جميع الأطراف.
لكن، بموازاة هذه الإنجازات المذهلة على الصعيد العسكري، لم يكف الموقف السياسي للمعارضة وقوى الثورة عن التراجع منذ ثلاث سنوات، وبوتيرة متسارعة، فبعد أن كانت أغلبية الدول تعلن تأييدها الشعب السوري، في كفاحه من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، حتى بلغ عدد الدول التي صوتت 140 دولة على قرار الجمعية العامة عام 2012، تحركها نواة قوية من تجمع أصدقاء سورية، وبعد أن نجحت المعارضة في عزل النظام تماماً، ومقاطعته وفرض العقوبات عليه، ودفعت بعدة قرارات إلى مجلس الأمن، تدين سياساته الإجرامية، وتوصلت، على الرغم من الفيتو الروسي الجاهز، إلى بيان جنيف الأول الذي يعترف بأنه لا مخرج من دون الانتقال إلى نظام جديد، وبعد أن صار التأكيد على تنحي الأسد شرطاً لأي
"بينما يستعيد الأسد مواقع سياسية كثيرة فقدها، تخسر المعارضة دعماً سياسياً ودبلوماسياً، كنّا نعتقد أنه أصبح ثابتا"
تسوية سياسية، وحصد المجلس الوطني السوري اعتراف أكثر الدول في المنظمة الأممية، وهو ما ورثه في ما بعد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ممثلاً للشعب السوري، وتم طرد النظام من جامعة الدول العربية، ها نحن نشهد اليوم تراجعاً عالمياً متزايداً عن دعم المعارضة والائتلاف، وعودة بعض العلاقات الدبلوماسية الخفية مع النظام، بعد إعلان الحداد على تجمع أصدقاء سورية، وتحوير قضية السوريين من قضية تحررية إلى حرب أهلية وطائفية، وتخاذل دول عديدة أعلنت دعمها القوي حقوق السوريين، وارتداد عديد منهم، مع الوقت، عن مواقفهم السابقة، حتى وصلنا، اليوم، إلى وضع أصبح حلفاء الثورة أنفسهم يدعون فيه إلى تسوية سياسية بشروط دنيا، ويعلنون استعدادهم لقبول بقاء الأسد فترة مؤقتة ضماناً للتوافق الدولي، ويفكرون في تسوية لا تشترط الخروج المسبق لمن اتهمته المنظمات الإنسانية بقيادة حرب إبادة جماعية. لم تكن مواقع المعارضة مهددة، على الصعيدين الداخلي الوطني والدولي، كما هي اليوم. وبينما يستعيد الأسد مواقع سياسية كثيرة فقدها، تخسر المعارضة دعماً سياسياً ودبلوماسياً، كنّا نعتقد أنه أصبح ثابتا، ليس في الغرب فحسب، ولكن، لدى بعض حلفائنا العرب أيضا.
الشجاعة ليست بديلاً عن السياسة
السبب الرئيسي لهذا التراجع السياسي الذي شهدناه، والذي يتعارض تماما مع التقدم العسكري الذي أنجزته تضحيات المقاتلين غير المحدودة على الأرض، هو ضعف منظومة عملنا السياسية، إن لم نقل تهافتها في جميع مستوياتها التنظيمية والتواصلية والإعلامية. والتجسيد الأبرز لهذا التهافت هو عدم القدرة على تثمير التضحيات الهائلة، وترجمتها في مكاسب سياسية، وهدر حيوات مقدسة من دون نتائج تذكر، بينما كان مؤكداً أن تؤدي مثل هذه التضحيات، لو رافقتها سياسة فاعلة، إلى وضع حد لنظام الأسد، على الأقل منذ ثلاث سنوات.
أما سبب تهافت سياساتنا في الثورة والمعارضة، فهو قصورنا السياسي، وتقديرنا السلبي لمفهومها، وتصورنا أننا، بقوة عزيمتنا وشجاعة رجالنا واستعدادهم للشهادة من دون ثمن، سوف نحطم كل الحواجز التي صنعها النظام، ونقضي عليها، عاجلاً أو آجلاً. وهذا ما حصل. لكن، ما واجهنا هو أنه بعد تحطيم النظام لم نعرف كيف نحل محله، ونقيم نظاماً جديداً، ولم
" بعد تحطيم النظام لم نعرف كيف نحل محله، ونقيم نظاماً جديداً، ولم نقنع الدول بنا بديلاً له"
نقنع الدول بنا بديلاً له. والسبب هو بالضبط افتقارنا لمفهوم السياسة وغياب منظومة العمل السياسي الفاعلة. هكذا، وجدنا أنفسنا أمام جدار لا يخرق، هو رفض المنظومة الدولية التي لا يمكن لسلطةٍ أن تقوم وتستقر من دون اعترافها وإدماجها فيها، ورفض عالمي معلن لاستلام المقاتلين السلطة، بل للسماح لهم بإسقاط ما تبقى من النظام أو بوراثته. ونحن نراوح في مكاننا منذ سنتين الآن، وندور حول مشروع توليد قيصري لتسوية سياسيةٍ فرضت علينا، تقوم على الجمع بين الجلاد والضحية، بين نظام فاقد أي شرعية، بعد إبادته شعبه وإحراقه بلده، ومعارضة تتمتع بالشرعية الدولية، لكنها غير قادرة على استلام السلطة، وكسب ثقة المنظومة الدولية شريكاً جديداً فيها. وهذا ما ساهمت فيه، أيضاً، سيطرة بسطاء شيوخ الدين الذين لا معرفة لهم بخبايا السياسة، على التوجيه والتنظيم. باختصار، استهنا بفعل السياسة، وبالغنا في إيماننا بمفعول البطولة الجسدية، ونسينا قول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان. والرأي هو عين السياسة. وهذا ما حصل لإخوتنا الفلسطينيين قبلنا في المرحلة الأولى من المقاومة الفتحاوية أيضا.
لن نستطيع أن نقطف ثمار تضحياتنا العظيمة كشعب بالشجاعة والتضحية وحدهما من دون سياسة. وتتطلب السياسة التصور الواضح للشروط السياسية للمعركة التي نخوضها، وليس للشروط العسكرية فحسب. وتحديد أهدافنا النهائية وأهدافنا المرحلية بدقة، وتنظيم تحالفاتنا الدولية ومعرفة درجة رهاننا على كل منها، وتنسيق جميع مواردنا الداخلية والخارجية، لتحقيق أهدافنا، وذلك كله يستدعي، قبل أي شيء آخر، احتفاظنا بسيطرتنا على قرارنا الوطني الذي من دونه لن نستطيع أن نبلور خطة عمل، ولا أن نتابع تنفيذها ونراكم مكتسباتنا في الميادين الداخلية والخارجية، ونبني صدقيتنا لبنة لبنة، ونكتسب ثقة السوريين والدول الأخرى وعمق علاقتنا بها، حتى نستطيع، عندما يتهاوى النظام، أن نستفيد من الشرعية التي اكتسبناها بتضحياتنا، لانتزاع تأييد المجتمع الدولي لحقنا في إعادة بناء الدولة التي تنسجم مع القيم والمبادئ التي خرج من أجلها السوريون، وضحوا بأبنائهم وبناتهم من دون حساب، دفاعاً عنها. ومن الواضح أن مشكلتنا لا تنبع، الآن، من عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعية مطالبنا، وإنما من عدم ثقته بقدرتنا على إدارة الدولة وتسييرها، حسب القيم والمعايير المعروفة، وشكّه في أن يؤدي تسليمه لنا بانهيار النظام إلى حالة من الفوضى والاقتتال بين القوى المعارضة نفسها، أو إلى سيطرة قوى ذات رؤى ومسالك متطرفة، تتعارض مع مفهوم الدولة والسياسة والقيم التي تجسدها في العصر الراهن لصالح مشاريع تعيد المنطقة إلى تقاليد القرون الوسطى ومنطقها.
لا سياسة وطنية من دون قيادة موحدة
أصل أزمة المعارضة هو قصورنا السياسي، وجوهر هذا القصور وصلبه كامن في غياب القيادة السياسية الوطنية، وانعدام مفهومها. فلا سياسة وطنية تعنى بمصير البلاد، لا بجانب منها، من دون قيادة مركزية تعد الخطط، وتتابع تنفيذها، وتقبل المحاسبة والمراجعة للخطط والتوجهات الخاطئة، وتحدد الخيارات، وتتخذ القرارات، وتكون مسؤولة عن تنفيذها، وتقبل المحاسبة عن أعمالها. وقد ساهمت في الإجهاز على مفهوم القيادة السياسية في بلادنا، من جهة أولى، أنظمة الانقلابات العسكرية والمخابراتية التي جعلت من الرئيس زعيماً ملهماً يعمل خارج مفهوم الالتزام والمسؤولية، ويشكل صنماً معبوداً يغطي على أخطاء نظامه كله، ويمنع المحاسبة عنها، بل يقضي على مفهومها نفسه. ورسخها، من جهة ثانية، تنطع وجاهات وشخصيات دينية عديدة للقيادة السياسية، من دون إلمام بقضاياها ومنطق عملها وأساليبها، وخلط بعض التشكيلات السياسية المتدينة بين مفهوم القيادة السياسية التي لا معنى لها، من دون المسؤولية والتفكير المنطقي والعقلاني، والإمارة الدينية، وتحويلها القائد إلى أمير، مطلق الصلاحية، يقود جماعته على هواه، أو ما يعتقد أنه يتماشى مع أحكام الدين وأوامره. وفي كل الحالات، لا ينظر للقيادة وظيفة تفترض خبراتٍ، وتنفيذ مهام وتنسيق قوى وعلاقات يشغل عليها، وتحتاج إلى مساعدة فريق من العاملين، وإنما مواهب فطرية، لا تحتمل التفكير ولا النقاش، وظيفتها استتباع الأفراد والتفنن في تطوير آليات صنع الأتباع وتطويعهم بكل الوسائل، العنفية والسحرية، للحصول على خضوعهم وتسليمهم الأعمى للقائد، القيصر أو الأمير، لا بلورة تصورات وتحديد أهداف ووضع الاستراتيجيات المعقولة، وإيجاد السبل لتحقيقها، وتوجيه الأفراد وتنظم عملهم وتعبئة مواردهم.
لكن مشكلة القيادة عندنا لا تقتصر على غياب معنى القيادة السياسية، والانحطاط بمفهومها إلى
"تفتقر الثورة إلى قيادة تفكر من منظور وطني، وتضع في اعتبارها مصالح سورية الدولة والمجتمع بأكملهما، وتعمل على توحيد عمل القوى المعارضة"
مستوى الوجاهة التشريفية، أو الزعامة الاستتباعية، إنما تتجسد، أكثر من ذلك، في غياب القيادة الوطنية، أي التي توجه وتخطط وتنظم وتنسق الموارد والعلاقات، لتحقيق أهداف وطنية تتعلق بمصير الدولة، ومستقبل المجتمع بأكمله. ولا شك في أن الثورة أنجبت قيادات فصائلية، ومحلية، من نموذج العمدة أو المختار أو الزعيم الذي يجمع حوله بعض الموالين، أو نموذح أمراء الحرب. لكن، ما تفتقر إليه حتى الآن هو قيادة تفكر من منظور وطني، وتضع في اعتبارها مصالح سورية الدولة والمجتمع بأكملهما، وتعمل على توحيد عمل القوى المعارضة، وتنظيم استخدامها حسب خطة واضحة ومتكاملة، وتملك الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة والتمثيل والصدقية. ولا يمكن لمثل هذه القيادة أن توجد وتحظى بالنفوذ والمصداقية، ما لم تكن قيادة موحدة، أو على الأقل لها نفوذ على القسم الأهم من القوى الفاعلية على ساحة الصراع، العسكري والاجتماعي.
وجود قيادات متعددة يعني، بالضرورة، رؤى متباينة ومتضاربة وأجندات خاصة متنافسة، تعكس مصالح متباينة، وصراع القيادات، كل على حدة، على وجودها ونفوذها، حتى لو تبنت خطاباً وطنياً كاذباً. وهذا ما نحن فيه بالضبط: قيادات كثيرة ومتناحرة تعني، ببساطة، غياب القيادة المركزية التي تعبر عن إرادة وطنية جامعة، وتحظى بثقة وتأييد أغلبية شعبية.
إذا كانت تضحيات السوريين غير المحدودة، وصبر الشعب الذي تحمل أقسى الظروف، واضطر نصفه تقريبا إلى التشرد واللجوء، قد منعت النظام وحلفاءه في الحقبة الماضية من تحقيق أي مكاسب عسكرية، فإن التدخل الروسي الراهن يشكل منعطفاً خطيراً، ومصدر تحديات مصيرية، لن يكون من السهل الرد عليها من دون رأب هذا الصدع، والخروج من حالة الفوضى والتشتت وغياب القيادة السياسة، أي غياب التوجيه الوطني الشامل والتنظيم العقلاني للموارد العسكرية والبشرية. ولا يكمن هذا التحدي في طابعه العسكرية فحسب، فلن يستطيع الروس، مهما فعلوا، أن يقضوا على قوى المعارضة، وإنما بشكل أكبر في طابعه السياسي.
فبعد نجاحهم في حماية النظام وتثبيت دفاعاته، وتشتيت جزء من قوانا المقاتلة، لن يضيعوا وقتاً طويلاً في انتزاع المبادرة السياسية لدفع الأطراف إلى تسوية سياسية، يكونوا هم أنفسهم العراب الرئيسي، إن لم يكن الوحيد لها، وقد بدأت المفاوضات، بالفعل، من وراء الكواليس، وهي تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية. وهذا هو فحوى اللقاءات التي يستضيفها الكرملين، والتي شملت المملكة العربية السعودية وتركيا بشكل رئيسي، بعد التفاهم مع طهران، لإبعادها عن محور العملية السياسية، مع تطمينها على مصالحها، في ضمان ألا يكون النظام المقبل في سورية معاديا لها، أو مدخلا لتصفية حزب الله في لبنان.
والغائب الأكبر في هذه المفاوضات الأولية، لكن الحاسمة، هي قوى الثورة والمعارضة التي لم تحظ إلا بلقاءات عابرة لمبعوث الرئيس الروسي مع شخصياتٍ لا جامع بينها. وإذا لم تنجح المعارضة، في الأسابيع القليلة المقبلة، في الخروج من تقاليدها القيادية البائسة، وإحداث ثورة في أسلوب عملها، بحيث تتحول من نموذج القيادات الفصائلية المتنافسة والمتنازعة على النفوذ إلى قيادة وطنية واحدة تتحدث باسم سورية ومصالحها الوطنية القريبة والبعيدة كدولة، لا باسم هذا الفصيل أو ذاك، ولا هذه الجماعة الايديولوجية، أو تلك، الإسلامية أو العلمانية، وإذا لم يظهر قادة الفصائل أنهم رجال دولة، وليسوا أمراء جماعة، ويكونوا بالفعل على قدر من التنظيم والحنكة السياسية التي تؤهلهم ليصبحوا طرفاً رئيساً، وممثلين لعموم شعبهم في مفاوضات معقدة وصعبة، تشكل سورية فيها عقدة تقاطعات مصالح متباينة ومتناقضة، ويحتاج التوصل إلى حل نهائي، أو طويل المدى، إلى البحث عن توازنات استراتيجية دقيقة، ربما لن يكون في الإمكان الوصول إليها من دون وضعها، هي نفسها، ضمن مفاوضات إقليمية ودولية موازية، مرتبطة بها، لكن أيضا بملفات ومسائل أخرى اقتصادية وسياسية وعسكرية، أقول إذا لم ننجح في ذلك، سوف نكون الخاسر الأكبر في هذه المفاوضات، وسنصبح هدفاً لتفاهم جميع القوى المتفاوضة ضدنا.
ليس من الممكن، الآن، وربما لن يكون من الممكن أبداً توحيد الفصائل، ولا القوى السياسية التي نشأت على هامش الثورة، وهي اليوم بالعشرات، لتكوين قوة منظمة فاعلة مركزية. لكن الممكن والمطلوب والعاجل أن يتحمل الفاعلون الرئيسيون الذين يحتلون مسؤوليات القيادة في مختلف الميادين، وبرهنوا، في السنوات الخمس الماضية، على قدراتهم على مسؤولية القيادة الوطنية، ويعملوا معا على ترتيب أوضاع المعارضة، بجميع تشكيلاتها. وليس هناك حل، في نظري، لمسألة القيادة في المعارضة السورية سوى أن يقوم هؤلاء القادة في الفصائل المسلحة، وفي أوساط المجتمع المدني، الأكثر فاعلية وموثوقية وقدرة، بتشكيل مجلس قيادة واحد للمعارضة، مع تعيين ناطق رسمي له، وضم من يثقون بهم من أصحاب الخبرة والكفاءة والشخصيات السياسية والوطنية، في ائتلاف المعارضة وخارجه، إلى عضويته، وطرح برنامج عملهم وجدول أعمال وطني على السوريين عموماً لا نزال نفتقر إليها حتى الآن، يمكن نقاشها والتفاعل معها. وهذا يعني، بالتأكيد، أن يرتقي هؤلاء جميعا، بتفكيرهم السياسي وسلوكهم، إلى مستوى القادة الوطنيين الذين يفكرون بمصير سورية وشعبها، وليس بمصيرهم الشخصي، أو مصير فصائلهم أو أحزابهم أو تجمعاتهم، مهما كان نوعها. وهذا هو الشرط الأول، كي لا تتحول التسوية السورية المطروحة اليوم في موسكو إلى تقاسم المصالح والنفوذ بين الدول الإقليمية والكبرى على حساب حقوق الشعب السوري الأساسية، وعلى أجساد أنبل أبنائه ومقاتليه.
 ٢٤ أكتوبر ٢٠١٥
٢٤ أكتوبر ٢٠١٥
الظهور المفاجئ للرئيس السوري في موسكو يمكن النظر إليه من جهتين، تبعا لخلفيات ودوافع وأهداف تلك الزيارة القصيرة التي لم يعلن عنها إلا بعد وصول بشار الأسد إلى دمشق.
فإن تمت الزيارة بناء على دعوة روسية كما قيل في الأخبار، فإن ذلك يعني استعراضا للقوى تقوم به روسيا، نافخة من جديد في بوق تمسكها بالأسد الذي يشكل وجوده في الحكم من وجهة نظر روسية ضمانة لاستمرار الدولة.
غير أن تلك الزيارة يمكن أن تنطوي على واحد من أكبر أسرار القضية السورية لو أنها تمت بناء على طلب من الأسد نفسه للقاء القيادة الروسية.
في تلك الحالة يكون الأسد قد قرر أن يقول الكلمة التي يعتقد أن الروس يودون سماعها منه شخصيا، من غير أن تصل تلك الكلمة – السر إلى أسماع القيادة السورية.
فالرئيس السوري ظهر في الشريط الإخباري وحيدا في اللقاء. وهو ما يمكن أن يُحاط بالكثير من علامات الاستفهام. كان لافروف حاضرا، لمَ لم يحضر المعلم وهو مهندس السياسة السورية الخارجية؟ المسألة كلها تتعلق بالأسد شخصيا. فهل ذهب الرجل إلى منقذيه لمناقشة مصيره؟
لا أعتقد أن روسيا قد تدخلت عسكريا في سوريا من أجل أن تضحي بحليفها. وما يقوله الروس عن عدم تمسكهم بالأسد شخصيا ينبغي أن لا يؤخذ على محمل الجد. ذلك لأن نظام الأسد الأب، ومن بعده الابن، هو النظام العربي الوحيد الذي ظل وفيا للروس، فلم تتعرض مصالحهم في سوريا للهزات كما حدث لها في ليبيا والعراق ومصر.
سوريا التي ظلت حريصة على علاقتها الإستراتيجية مع روسيا هي سوريا النظام الذي يقوده الأسد. وما يعرفه الروس جيدا عن طبيعة ذلك النظام يعزز تمسكهم بالأسد، باعتباره ضمانة لاستمرار وجودهم في المنطقة.
ولأن الروس لا يبيعون ولا يشترون أوهاما، فإنهم يدركون جيدا أن بقاءهم في المنطقة لن يكون مؤكدا إلا من خلال صيانة وتدعيم وجودهم في سوريا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إعادة تأهيل النظام الحاكم في سوريا، بعد أن تم استضعافه. لم يكن اللقاء رسميا. وهو ما فهمه الكثيرون خطأ.
فسوريا الدولة لم تكن موجودة في ذلك اللقاء من خلال رمزها الرئاسي. كان الأسد وحده هناك، وهو ما يعزز الفكرة التي تفيد بأنه ذهب إلى موسكو لعرض موقف شخصي بحت، لا علاقة له بما تطرحه سوريا رسميا في المحافل الدولية، أو شعبيا في وسائل إعلامها.
هذا لا يعني أن الأسد قد قرر أخيرا ومن موقع الإحباط أن ينساق إلى المنطق الذي يربط الحلول السياسية للمعضلة السورية برحيله عن السلطة. فالرجل اليوم وإن ظهر بمظهر التلميذ المطيع أمام معلمه هو أقوى مما كان عليه في المراحل السابقة، يوم كان هناك تحالف دولي وإقليمي يضغط عليه مثل كماشة. لقد خفف الكثير من الأطراف من لغتهم المعادية.
أما على الأرض وهو الأهم، فإن التدخل الروسي قد سمح للجيش السوري بالكثير من أوقات الراحة واستعادة النفس وفتح أمامه أراضي، لم تكن استعادتها ممكنة، بعد أن ملأت بالجماعات والتنظيمات الإرهابية.
غير أن كل ذلك لا يعني إمكانية أن يعاد تأهيل النظام من غير أن يقدم النظام تنازلات، يجدها الروس مناسبة لقيام مرحلة انتقالية، لا أثر للجماعات الإرهابية فيها.
أهذا ما حمله الأسد إلى موسكو بنفسه؟
يبدو أن أوراقا مهمة من الملف السوري صارت في عهدة الرئيس بوتين، وهو ما سيكشف عنه اللقاء الدولي – الإقليمي المرتقب الذي قد يكون بداية لمنعطف حقيقي في المسألة السورية.
ستتبدد في ذلك اللقاء كل الأوهام التي تم التعامل معها في المراحل السابقة باعتبارها نوعا من البداهة، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة الاتفاق على قرار بحسم موضوع المنظمات الإرهابية. بالنسبة للغرب لا تزال طرق الإرهاب سالكة في اتجاه الشرق.
 ٢٤ أكتوبر ٢٠١٥
٢٤ أكتوبر ٢٠١٥
بدخول القوات المسلحة الروسية والطيران الحربي الروسي إلى ساحة المعركة في سوريا، يكتمل مشهد الحرب الكونية الصغرى في منطقتنا، وتتدفق التحليلات حول ما يمكن أن يحصده هذا الإقليم من نتائج مرة، مع استمرار تطاير المفرقعات وأزيز الطائرات. الإشكالية التي يواجهها المتابع هي اختلاط «الرغبات» بـ«الحقائق» في الاقتراب التحليلي لساحة المعركة المحتدمة.
من نافلة القول إنه في الوقت الحالي، الذي سوف يمتد على الأقل لأشهر من الآن، ليست هناك حلول في الأفق تبدو للناظر لتوقف حمام الدم، مهما كانت حدة نظره، على عكس المثل السوري المشهور بأنها «لن تصغر قبل أن تكبر».. فهي لن تصغر في القريب حتى لو كبرت. تعالوا نطالع المشهد بشكل بانورامي، ومجرد إلى حد ما من العواطف.
المعركة في سوريا تُغير الوضع «الجيوسياسي» كما لم يتغير منذ الحرب العالمية الأولى، والنهايات المتوقعة مفتوحة على احتمالات كثيرة. قراءة التدخل الروسي في سوريا تعني أنه بعد أربع سنوات ونيف، وصل ثلاثي نظام الأسد وحزب الله ودعم إيران إلى طريق مسدود، على الرغم من كل التخريب الذي قام به هذا الثلاثي. ما نعرفه أن التدخل الروسي جاء كما يقال علنا بطلب من نظام الأسد! ولكن هذا الطلب لم يكن بعيدا عن رغبة طهران وتمنيات موسكو! كما أن تصريحات الروس الأخيرة تقول إن تدخلهم «لحماية مصالحهم»! في وقت انتهى فيه الاستعمار منذ زمن، وأفاقت الدول على أن «التجارة» مع الدول المُستعمرة السابقة أفضل بكثير من «استعمارها المباشر بالقوة العسكرية».. فأي مصالح تحققها البندقية؟
يبدو أن التصريحات الروسية ليست خارجة عن السياق تماما، ويجب قراءتها كالتالي: «نحن لا يهمنا الأسد بقدر ما يهمنا عدم امتداد (الإرهاب) إلى ساحتنا».. ذلك يقال بصوت خفيض، والمسكوت عنه «فشل الولايات المتحدة والتحالف الغربي في كسر شوكة (الإرهاب)»! ربما هذا الأمر يفسر كلمة «مصالح» التي جاءت على لسان أكثر من مسؤول روسي رفيع. لقد صرف حزب الله وقوات فيلق القدس الإيرانية وقوات النظام بجانب «الشبيحة» كل جهدهم لتركيع الشعب السوري، وبناء نظام قمعي على غرار ما هو موجود في طهران، لكن دون نتيجة ملموسة. في هذا السياق قامت إيران بإنشاء الفرقة الأجنبية (على غرار الفرق الأجنبية العسكرية التي شهدتها فرنسا وبريطانيا في الحرب العظمى الثانية). الفرقة الأجنبية الإيرانية مكونة من عناصر في أغلبها غير إيرانية، منها باكستانية وأفغانية وعراقية ولبنانية، لها نفس الانتماء الطائفي ومستعدة للقتال بالثمن المناسب. السبب في إنشاء هذه القوات هو فقد النظام السوري رمزيته الوطنية. لم يعد النظام السوري ونخبته في أعلى السلطة السياسية في نظر جمهور واسع من السوريين «متحالفًا مع قوى أخرى» فقط، بل، وهذا مهم في نظر أغلب الظهير الشعبي السوري، أصبح النظام «عميلاً»، وهو أمر له تداعيات في الضمير الوطني السوري، أيًا كانت انتماءات الفرق المختلفة.
أول اعتراف بسقوط قتيل إيراني في الساحة السورية كان في فبراير (شباط) 2013، وكانت قوات حزب الله قد دخلت سوريا تقريبا بالتزامن مع سقوط القتلى الإيرانيين. كان دخولها، كما قالت ماكينة حزب الله الدعائية، من أجل «الدفاع عن مراقد الأئمة»، وانتهى بها المطاف لزيادة مراقد قتلاها في مناطق لبنان وقراه الفقيرة! خطأ الإيرانيين القاتل في سوريا أنهم أرادوا أن يكرروا سيناريو تدخلهم في العراق، فقد صرفوا الدولارات واشتروا العقارات وتنافسوا في الحصول على الصفقات من الدولة السورية، وركبوا الأمن السوري على غرار الأمن الإيراني، وهو أمر لم يقرأ الإيرانيون فيه خريطة الديموغرافيا السورية التي يشكل فيها السنة 80 في المائة على الأقل، كما لم يفقهوا تاريخ السوريين الوطني.
لم تستطع الفرق الأجنبية الإيرانية - المذهبية تغيير الموازين في الساحة السورية، وفقد النظام أكثر من ثلثي الأرض، فجاءت قوات السيد فلاديمير بوتين للمساعدة. كان دافع بوتين الأساسي هو رفع شعبيته في وطنه، خاصة بعد أن فقد أوكرانيا كليا لصالح المعسكر الغربي، وأصبح حلف الناتو ملاصقا للحدود الروسية الشرقية، ومُني أيضًا بحصار اقتصادي على خلفية شريط ليس له أي ثقل استراتيجي في شرق أوكرانيا، وسكانه أغلبيتهم من الروس. حتى جزيرة القرم لم تكن نصرا مؤزرا للروس، لأنها بالأساس روسية!
على تلك الخلفية نجد مفهوما جديدا يدخل التداول في الساحة العالمية، وهو «عسكرة السياسة»، أي ما تفقده في السياسة يمكن أن تحصل عليه باستخدام العسكر. طلعات بوتين الجوية في الأجواء السورية تتراجع، وتكيفت المعارضة السورية مع تلك الهجمات بسرعة، كما أعيد التفكير في الجانب المناوئ للنظام السوري، وأعني به الغربي، خصوصا الأميركي والتركي والعربي، من أجل مواجهة المتغير الجديد. كانت أولى الخطوات السماح لقوى المعارضة السورية بالحصول على أسلحة نوعية، كان بعضها معلنا، فلا يمكن أن يكون هناك فعل إلا ويكون له رد فعل مضاد. ما فات الروسي أن يعرفه أنه تدخل في حرب شبه مذهبية، وهذه الإشارة لم تفت مجلة سياسية غربية رصينة، حيث قالت «الإيكونوميست» الأسبوع الماضي وببنط عريض «بوتين بطل الشيعة».
حتى الآن لم يظهر مشروع سياسي لدى الروس، ولا يمكن أن يظهر لدى طهران، التي ترى في المشهد السوري أنه مماثل في الشكل لمظاهرات إيران عام 2009 (الثورة الخضراء)، وأنه يمكن قمع السوريين، كما فعلت وقتها، إن لم يكن بالفرق الأجنبية على تعددها فبالطائرات الروسية.. وهي قراءة أكثر من خاطئة. حتى الساعة الروس والإيرانيون يقرأون في نفس مخطوطة الكتاب القديم، كتاب الإمبراطورية السوفياتية وإمبراطورية كورش العظيم.
الروس ينتظرون إبادة الشعب السوري حتى يستسلم، والإيرانيون وفرقتهم الأجنبية (بها عرب أيضًا) ينتظرون ظهور المهدي المنتظر! ويتضاحك أنصار النظام السوري مستبشرين بقدوم الروس! ما لم يتحقق في أكثر من أربع سنوات لن يتحقق في أشهر (كما صرح الروس بأن بقاءهم لن يتجاوز ذلك)، وما لم تحققه القومية الفارسية لن تحققه الشيفونية الروسية، فكلتاهما - مع أنصار النظام السوري - تتوقع أن تخرج عليها الشمس صباحا من الغرب، وهي تشرق دائما مع الشعوب!
آخر الكلام:
لا أعرف عن أي دولة يتحدث الروس للإبقاء عليها في سوريا، بعد أن حطم نظام الأسد كل المؤسسات، وحوّل المدن والقرى السورية إلى خرائب، وقتل مئات الآلاف وشرد الملايين.. فأي دولة سوف تبقى بعد ذلك؟!
 ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
يصعب، بعد اقلّ من شهر على انطلاق العمليات العسكرية الروسية في سورية التكهن بما تريده موسكو التي استقبلت بشّار الأسد من اجل ايجاد افق سياسي لهذه العمليات. هل بدأ فلاديمير بوتين يستوعب انّ لا حلّ سياسيا في سورية قبل التخلّي عن وهم اسمه «شرعية» النظام القائم وعلى رأسه بشّار الأسد؟
في الإمكان الحديث عن «شرعية» في اي مكان في العالم باستثناء سورية التي تعاني اوّل ما تعاني من غياب الشرعية فيها منذ نشوء الكيان، اللهمّ الّا اذا استثنينا مراحل قصيرة في فترة ما بعد الإستقلال وفي السنوات التي سبقت الوحدة مع مصر في العام 1958.
لا شرعية من ايّ نوع كان في سورية. هل يستطيع الرئيس بوتين اقناع بشّار الأسد بذلك وأنّ ليس امامه سوى الرحيل وأنّه ليس جزءا من حلّ من اي نوع كان؟
المحزن انّه كان في استطاعة روسيا، عن طريق المساهمة في قيام نظام شبه معقول في سورية، حماية مصالحها. هذا اذا كانت لديها مصالح، باستثناء مخزون الغاز السوري ومنع تمرير الغاز الخليجي الى المتوسط عبر الأراضي السورية. كان ذلك ممكنا في بداية الثورة السورية، لو لم تزوّد موسكو بشّار بكلّ ما من شأنه متابعة حربه على شعبه، وذلك في وقت كانت ايران، ولا تزال، تدفع ثمن السلاح المستخدم في حرب الإبادة التي يتعرّض لها السوريون.
كلّما طالت الحرب في سورية، طالت احتمالات تفتيت البلد، خصوصا بعدما تبيّن ان التدخلين الإيراني والروسي يقومان على اسسس ذات طابع مذهبي اوّلا واخيرا. بالنسبة الى روسيا، ان «المصالح القومية» تعني، اضافة الى الإهتمام بالغاز، المحافظة على المؤسسة العسكرية التي يسيطر عليها ضباط علويون تعلّموا في الأكاديميات السوفياتية ثمّ الروسية وتخرّجوا منها.
بالنسبة الى ايران، لا همّ آخر غير المحافظة على بشّار الأسد من منطلق انّه يمثّل حكما عائليا وعلويا في الوقت ذاته. حكمٌ قَبِل ان يكون تابعا كلّيا لـ«الوليّ الفقيه» في طهران.
هذه التبعية، جعلت الأسد الإبن مختلفا الى حدّ ما عن والده الذي حافظ على نوع من التوازن في العلاقة بين سورية من جهة وايران والدول العربية من جهة اخرى. هذا لا يعني باي شكل ان نظام حافظ الأسد لم يكن علويا، يسعى الى الثأر، بمقدار ما انه كان يعني ان الأب كان حريصا على ايجاد دور له بين العرب وايران.
كان يلعب هذا الدور، علما ان العرب عموما كانوا يعرفون في العمق مدى انحيازه لايران وخطورة لعبته ذات الطابع المذهبي التي كان لبنان احدى الساحات الي تجلّت فيها بوضوح ليس بعده وضوح.
كذلك، تكشّفت هذه اللعبة من خلال انحيازه الى جانب ايران في حربها مع العراق بين 1980 و1988، وهي حرب كان كلّ اهل الخليج يقفون خلالها مع بغداد، ليس حبّا بصدّام حسين ونظامه، بل حفاظا على التوازن الإقليمي لا اكثر.
تسعى روسيا في الوقت الحاضر الى انقاذ نظام سقط قبل سنوات عدة. هل بدأت تعي أنّ انقاذ النظام يعني اوّل ما يعني خروج بشّار من السلطة؟ قد يكون السؤال الأكثر دقّة هل يمكن للنظام ان يستمرّ من دون الأسد الإبن؟
سقط هذا النظام، الذي لم يمتلك شرعية يوما، في اليوم الذي تمرّدت فيه درعا نظرا الى انها كانت ترمز الى الحلف الذي اقامه حافظ الأسد مع سنّة الأرياف. اقام هذا الحلف لتغطية نظامه العلوي من جهة ولإيجاد توازن مع سنّة المدن الكبرى، اي دمشق وحلب وحمص وحماة، من جهة اخرى.
كانت هناك في سورية شرعية شكلية قامت في الأصل على ترتيبات معيّنة، في الداخل والإقليم. عرف حافظ الأسد كيف يدير هذه الترتيبات وكيف يتحكّم بها، مستفيدا الى ابعد حدود من مغامرات صدّام حسين التي توجّها بغزوة الكويت في العام 1990. فقدت الشرعية الشكلية مع بشّار الأسد آخر ما كان يمكن ان يحافظ عليه من ارث والده، خصوصا بعد دخوله في مواجهة مع سنّة الأرياف وبعدما سلّم قراره لإيران. كان الدليل على ذلك تغطيته عملية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه والتي بات معروفا من نفّذها على الأرض والظروف الإقليمية التي احاطت بها فضلا عن اندراجها في سياق المشروع التوسعي الإيراني الذي بدأ يأخذ بعدا جديدا مع الإجتياح الأميركي للعراق في ربيع 2003.
تلعب روسيا لعبة خطرة بالتنسيق مع ايران. يدل على خطورة اللعبة بدء سقوط قتلى روس في الأراضي السورية. انها لعبة خطرة لسبب في غاية البساطة يتمثّل في سعيها الى فرض نظام لا شرعية له على الشعب السوري بالقوّة. اقصى ما يمكن ان تحقّقه روسيا هو انتصارات عسكرية في المدى القصير. تستطيع روسيا المساعدة في الإنتصار على الشعب السوري. ولكن ماذا بعد؟
في المدى الطويل، يمكن لروسيا استكمال ما بدأته في الماضي البعيد، اي منذ خمسينات القرن الماضي. قامت ابان الحرب الباردة بكلّ ما يمكن القيام به من اجل اضعاف سورية وتحويلها الى بلد تابع لها. نجحت احيانا واخفقت في احيان اخرى رغم كل استثماراتها في بلد تُعتبر قيادته البعثية المسؤول الأول عن توريط مصر في حرب الأيام الستّة في يونيو 1967.
بين روسيا وايران، لن تعود سورية يوما دولة موحّدة. كلّ ما تستطيع موسكو تقديمه، في حال لم تقتنع بضرورة رحيل الأسد الإبن، هو مزيد من التعميق للشرخ الطائفي والمذهبي. ما نشهده هو مساهمة روسيا في اعادة رسم خريطة الدول وحتّى خريطة الشرق الأوسط كلّه. فـ«داعش» الذي تدّعي روسيا محاربته هو الحليف الأوّل للنظام السوري. لولا النظام السوري ولولا السياسة الإيرانية في العراق، لما كان «داعش» اصلا.
بات كلّ ما يمكن قوله ان اطالة الأزمة السورية، في ظلّ الهجرة المستمرّة للسوريين من بلدهم، لا يصبّ سوى في مزيد من الإنهيارات تطال البلد وتطال كلّ مؤسساته، بما في ذلك المؤسسة العسكرية التي لا تزال موسكو تراهن عليها. هذا الرهان في غير محلّه.
هذا عائد أوّلا واخيرا الى أنّ هذه المؤسسة لم تلعب يوما الدور المطلوب منها على الصعيد الوطني، خصوصا عندما غيّر حافظ الأسد تركيبتها على نحو جذري، بما يتوافق مع النظام القمعي الذي اقامه والمعتمد اساسا على طائفته العلوية والتحالفات التي بناها مع سنّة الأرياف والأقلّيات.
بين روسيا وايران، ضاعت سورية، لا لشيء سوى لأنّه لا يمكن البناء على وهم، اسمه نظام بشّار الأسد. هذا النظام لم يعد يصلح سوى لشيء واحد هو الإنتهاء من سورية. هل هذا ما تريده روسيا، المتحالفة مع اسرائيل، في حربها المشتركة مع ايران... على الشعب السوري؟
بعد زيارة بشّار لموسكو وجلوسه منفردا في حضرة بوتين، ثمّ اتصال الرئيس الروسي بالملك سلمان بن عبد العزيز، سيتبيّن ما اذا كانت روسيا تسعى بالفعل الى حل سياسي في سورية. مثل هذا الحلّ لا يمكن ان يبصر النور الّا اذا خرج بشّار الأسد... الى منفاه الروسي.
 ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
حتى لا تدمر سورية بالكامل. وردت هذه العبارة على لسان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في معرض دعوة أطراف إقليمية ودولية للقاء من أجل بحث الوضع في سورية. وقال كيري إنه ينصح بضرورة إيجاد مخرج، حتى لا تدمر سورية بالكامل. يستدعي كلام الوزير الأميركي تسجيل ملاحظتين مهمتين، الأولى أن هذا التحذير يأتي بعد اشتداد القتال في سورية، بسبب التدخل الروسي الذي وفر للنظام السوري تغطية عسكرية وسياسية، نقلته من طور الاحتضار إلى التقاط الأنفاس والعودة إلى مسرح الأحداث. والثانية أنه يمكن للمراقب أن يلتقط من هذا الكلام أن سورية مرشحة للتدمير بالكامل، في حال عدم حصول تفاهمات تحول دون ذلك.
يجب عدم الاستخفاف بالنقطة الثانية، وهي جديرة بالتوقف أمامها بالنظر إلى ما آل إليه الوضع السوري خلال أربع سنوات من الحرب، التي شنها النظام ضد الشعب، بشتى أنواع الأسلحة، وحين لم ينجح في القضاء على الثورة، ذهب للاستعانة بالروس الذين أخذوا على عاتقهم إنجاز المهمة، وهذا ما يلاحظ من خلال التدخل الروسي السافر الذي يركّز منذ ثلاثة أسابيع على العمل وفق سياسة الأرض المحروقة، ويعتمد على مبدأ "غروزني" (ما لا يتم تحقيقه بالقوة، يتم باستخدام مزيد من القوة). ولذلك، يحشد الروس كل أنواع الأسلحة من أجل تحقيق نصر عسكري ساحق ضد الثورة السورية، في مدة أقصاها ستة أشهر، وهم لا يعملون من أجل تغيير موازين القوى على الأرض التي مالت، في الأشهر الأخيرة، ضد النظام وحلفائه الإيرانيين، بل للقضاء كليا على قوى المعارضة السورية المسلحة. وفي طريقهم، لا يكترثون بالآثار التي تترتب على ذلك، لا المادية ولا البشرية، وهذا ما يفسر أنهم لا يراعون أي حساب للبشر والعمران، وقد ارتكبوا مجازر عديدة بحق المدنيين، حيث سقط حوالى 400 قتيل في 20 يوما، من دون أي موقف دولي، أو حتى تغطية إعلامية ترقى إلى مستوى الحدث الخطير بكل المقاييس الذي يمكن وصفه بالإبادة والتدمير.
والملاحظ أنه ليس هناك أحد يقف في وجه الروس، على المدى المنظور، سوى مجموعات عسكرية سورية من المعارضة، ذات تسليحٍ لا يسمح لها بمواجهة الطيران والصواريخ التي يتم إطلاقها من البوارج الروسية. وبالتالي، فإن الحديث عن معركة متكافئة أمر مفروغ منه، وغير مطروح من دون موقف نوعي سريع من حلفاء المعارضة وتزويدها بأسلحة مضادة للطيران، وطالما أنه ليست هناك مؤشرات توحي بأن هذا التطور سوف يحصل، فالمطروح، هنا، ليس أن تكون المعركة متكافئة أم لا، بل هو منهج التدمير الروسي الذي عبر عن نفسه، قبل أيام، بإلقاء مناشير من الجو في حلب، تطالب السكان بإخلاء المناطق التي توجد فيها قوات للمعارضة، لكي تباشر روسيا بقصفها، وهذه المناطق تخضع، منذ عامين أو أكثر، للقصف بشتى أنواع الأسلحة من النظام، ويريد الروس اليوم تدميرها بالكامل، حتى تتم السيطرة عليها. ونظراً لما بلغته المأساة السورية من قسوة، فإن بعضهم قد لا يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، ولا يضعه في نصابه الصحيح.
تحذير الوزير الأميركي من تدمير سورية بالكامل له عند بعضهم، اليوم، وقع الحديث عن التقسيم أو التهجير الجماعي للسوريين قبل عامين. حينذاك، لم يكن أحد يتخيل حصول الأمرين، لكن تطورات الأحداث جاءت بما يفوق الحسابات كافة. ولذلك، ليس من المستبعد أن نقف، بعد سنة، على الأطلال لنترحم على بلد كان اسمه سورية. وبذلك، يتحقق تهديد الأشاوس "الأسد أو نحرق البلد".
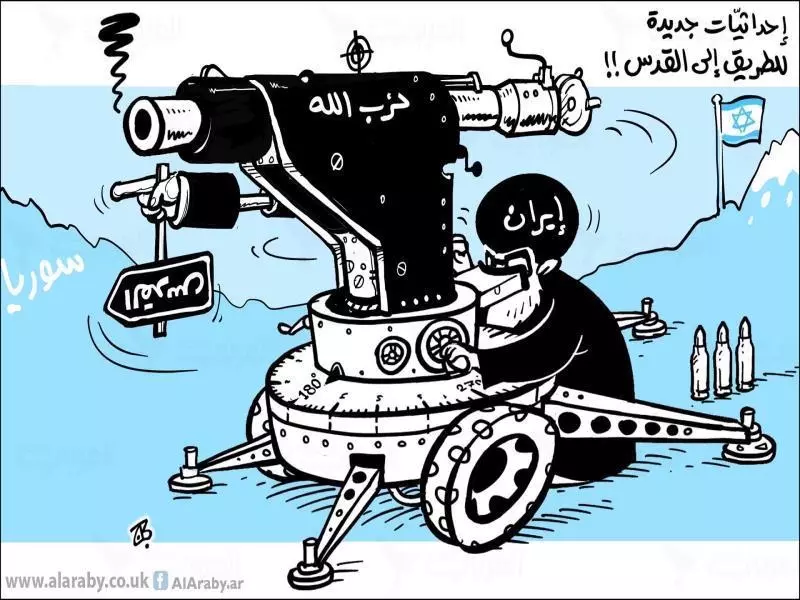 ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
لعل واحدة من أهم خصائص الثورة السورية أنها كاشفة فاضحة لمواقف كثيرين، من الذين تاجروا عقوداً بالشعارات، وزاودوا بها على الجميع. ويندرج في خانة هؤلاء جماعات، كحزب الله اللبناني، وتيارات قومية ويسارية عربية، تماهت مع بطش النظام السوري بحق شعبه، وسوّغت له جرائمه، على أساس أنه يتصدى لـ"مؤامرة كونية" ضد "محور الممانعة".
طبعاً، لم يتورط كل القوميين واليساريين العرب في جريمة تأييد نظام بشار الأسد ضد شعبه، فكثير منهم أصحاب مبدأ وموقف أخلاقي، وهؤلاء اختاروا الانحياز للمبدأ على حساب المصالح الذاتية، أو ما يزعم أنه انتماء فكري. ولكن، وكما أنك تجد في صفوف المعممين والملتحين من باع مبادئه وأخلاقياته، كما الحال، كذلك، في صفوف بعض من يزعمون أنهم ليبراليون، على الرغم من تأييدهم حكم العسكر والانقلاب على إرادة الشعوب، فإنك تجد في صفوف القوميين واليساريين من فعل الأمر نفسه. أبعد من ذلك، إنك تجد أن كثيرين ممن يزعمون القومية العربية، أو اليسارية إيديولوجيا، قد قدموا انتماءهم للطائفة، وتحديداً الشيعية، عندما جاء الأمر إلى سورية، مهمشاً الإيديولوجيا، أو محاولاً تطويعها في خدمة حسابات طائفية.
من مفارقات هذا الصنف من القوميين واليساريين، أنهم أيّدو ورحبوا بالغزو الإيراني، عملياً، لسورية، على أساس أن إيران هي أُسُّ "محور الممانعة"! لم يتباكَ هؤلاء على عروبة سورية المُضَيَّعَةِ، وسيادتها المبددة، ووحدة أراضيها المهددة، ولم يستثرهم مشهد الدماء والتشريد الذي لحق بالسوريين، والدمار الذي حَلَّ في ديارهم، ذلك كله في سبيل الحفاظ على حكم شخص وعائلة وطائفة. أيضاً، لا زال هؤلاء يقفون وراء حزب الله، على أساس أنه "حزب المقاومة"، ولا زالوا يصفون أمينه العام بـ"سيد المقاومة"، مع أن مقدار من قتلهم الحزب من السوريين أضعاف أضعاف من قتلهم من الإسرائيليين، دع عنك أن بوصلة حزب الله انحرفت، منذ نحو خمس سنوات، لتصبح الطائفة أولويته، لا المقاومة.
ولا يتوقف تهافت هؤلاء عند ذلك الحد، بل تجدهم يعلنون الولاء لإيران، ويتخذون من طهران مَحَجّاً لهم، وهم لا يتورّعون عن كيل عبارات المديح والتقريظ لها، متناسين مزاعم انتمائهم القومي واليساري، المتناقض جوهرياً مع كُنْهِ الدولة الإيرانية ونظام حكمها. ومن مفارقات لافتة في هذا السياق أن هؤلاء القوميين واليساريين الذين يعيبون دوماً على ما يسمى تيار "الإسلام السياسي السني"، وتحديداً، الإخوان المسلمين، "ثيوقراطيتهم"، لا يشرحون لنا منطق تأييدهم الدولة "الثيوقراطية" الوحيدة على وجه هذه البسيطة، وهي إيران. ففي إيران، يحكم المرشد الأعلى للثورة وَيَسُودُ، بناء على مقولات دينية مذهبية، تزعم أنه الوَلِيُّ عن "الإمام الغائب"، الذي هو ظِلُّ الله في الأرض.
ثالثة الأثافي عند صنف أدعياء القومية واليسارية هؤلاء تأييدهم الغزو الروسي لسورية. وهم إن فعلوها اليوم، فقد فعلها بعضهم في الأمس أيضا، عندما أيدوا غزو الاتحاد السوفييتي
"التيار الذي يجمع بين بيادق إيران واعتذارييها، فإن العداء لإسرائيل بالنسبة له ليس أكثر من مشجب، يعلقون عليه طائفيتهم، ومصالحهم، وانحيازهم لإجرام نظام بحق شعبه"
أفغانستان أواخر سبعينيات القرن الماضي. بالنسبة لهؤلاء، ومعهم إيران وحزب الله، روسيا حليف لـ"محور المقاومة" لا غازٍ محتلٌّ لسورية. بالمناسبة، هذا ما يقوله زعيم حزب الله، حسن نصر الله، نفسه، ولمن أراد التوثق فليعد إلى مقابلته، أواخر الشهر الماضي، مع قناة المنار التابعة للحزب. المهم، يرى هؤلاء أن روسيا حليف ضد الإمبريالية الأميركية، و"الإرهاب"، من دون أن يملكوا ذرة من مصداقية وجرأة للحديث عن روسيا، أيضا، قوة إمبريالية، جاءت إلى سورية، حفاظاً على مصالحها، ضمن صراع القوى الكبرى على النفوذ والهيمنة في منطقتنا. أمَّا موضوع دَكِّ الطائرات الروسية المدنيين السوريين، وسحقهم وسفك دمائهم، فإنه عند هؤلاء مبرر في سبيل إحباط "المؤامرة الكبرى" على "نظام الممانعة"! ما يريده هؤلاء أن نقبل منطقهم الأعوج، أنَّ في دعم روسيا اليوم، ولو على جماجم السوريين، ترجيحاً لكفتها في مقابل الولايات المتحدة. يعني وكأن هؤلاء يقولون لنا فلنغير "الخازوق" الذي نجلس عليه إلى "خازوق" آخر.
بالنسبة لذلك التيار الذي يجمع بين بيادق إيران واعتذارييها، فإن العداء لإسرائيل ليس أكثر من مشجب، يعلقون عليه طائفيتهم، ومصالحهم، وانحيازهم لإجرام نظام بحق شعبه. تراهم يشبعون الجميع ردحاً أن إسرائيل وحدها هي العدو، على الرغم من أن "نظام الممانعة" ما فتئ يحاول خطب وُدِّها، في حين لم يتردد حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني في القول، في تصريح مشهور له لوكالة فارس، العام الماضي: "إذا أراد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، تغيير النظام السوري، فإن أمن إسرائيل سينتهي".
لم يثر التصريح السابق، الكاشف الفاضح، من مسؤول إيراني، أي قلق أو ردة فعل لدى اعتذاريي إيران ونظام الأسد وحزب الله، في صفوف بعض القوميين واليساريين العرب، فهم أعماهم الانحياز والمصالح، والانتماء الطائفي في حالة آخرين بينهم.
يطالبنا هؤلاء أن نقبل مقاربتهم القائلة إن دماء العراقيين والسوريين واليمنيين التي تسفكها إيران وأدواتها "حلال"، في حين أن الدماء الفلسطينية التي تسفكها إسرائيل "حرام". هل تهويد القدس حرام، في حين أن "تَأْرينَ" دمشق وبغداد وصنعاء حلال؟ جرائم إيران وروسيا في سورية لا تقل عن جرائم إسرائيل في فلسطين، ودم السوري لا يقل طهارة وحرمة عن دم الفلسطيني. أيضاً، لا تقل روسيا إمبريالية وإجراماً عن الغرب، وجرائمها في سورية لا تقل عن جرائم الولايات المتحدة في العراق.
نافلة القول، إنه، وكما انفضح حال كثيرين ممن يزعمون الإسلامية والليبرالية والقومية واليسارية في مصر، فإن يساريين وقوميين عرباً كثيرين انفضح زيف مزاعمهم وإيديولوجيتهم في سورية. فمن يقف في صف الغزوين، الإيراني والروسي، وفي صف نظام الأسد، لا يقل إجراما عمن يقف في صف إسرائيل وراعيها الأميركي.
 ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
زادت إيران زيادة ملموسة من تدخلها العسكري في سورية، بالتوازي مع تحول الدور الروسي من دعم النظام الأسدي بالسلاح والمال والخبرات إلى تحمل العبء الأكبر من القتال المباشر ضد الجيش الحر وفصائل المقاومة الأخرى.
حسّن التدخل العسكري الروسي وضع إيران، ومنحها خياراتٍ لم تكن متاحة لها، أهمها الاستقواء بروسيا دولة كبرى لرد الضغوط الأميركية، التي كان من المرجح أن تتعرّض لها بعد الاتفاق النووي، وأن تطاول برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي. بتدخل موسكو عسكرياً في سورية، صار في وسع طهران الانتقال إلى موقع، يتيح لها قدراً فاعلا من التوازن في علاقاتها مع الجبارين، يشبه ما سبق لحافظ الأسد أن مارسه عقدين ونيفاً، ومكّنه من اللجوء إلى أميركا لصد الضغوط الروسية، وإلى روسيا لتفادي الضغوط الأميركية. اليوم: وبسبب ضعف موقفها، تجد موسكو نفسها مجبرةً على قبول إيران شريكاً يصعب التخلي عنه أو الاختلاف معه، لأن ذلك يمنح واشنطن فرصة دق إسفين بينهما يزعزع الدور الروسي الذي يحتاج إلى قوة إيران البرية، من أجل استكمال جهوده الجوية والبحرية، العاجزة بمفردها عن إحراز انتصار ستتعين بنجاحه وفشله مواقف الداخل الروسي من بوتين وسياساته، وجدية دور موسكو العالمي التي ترتبط من التدخل فصاعداً بحتمية تفادي فشل، إن وقع قوّض مكانة الكرملين في الواقع الدولي الراهن، ومكانة بوتين وسياساته داخل روسيا وخارجها.
في المقابل، تجد واشنطن نفسها أمام وضع يقيد قدرتها على المناورة، ولا يترك لها خياراً أفضل من تغيير سياساتها الراهنة حيال الصراع الداخلي/ الإقليمي/ الدولي عامة، والمقاومة السورية السياسية والعسكرية ضد النظام وحلفائه الإيرانيين والروس خصوصاً. يبدو هذا التغيير اليوم محدوداً، على الرغم من وجود إشارات توحي باختلاف أولويات أميركا بعد التدخل عنها قبله.
من هنا، تجد واشنطن نفسها، في ظل قوة العلاقة الروسية/ الإيرانية، وسلبية خياراتها تجاه الثورة السورية، أمام الميل إلى منافسة روسيا على خطب ود طهران، ما دام تحسين علاقاتها مع الكرملين يجعل من الصعب على البيت الأبيض مواصلة سياساته السورية والإقليمية الراهنة، التي عادت عليه بمكاسب حقيقية في الحقبة المنصرمة، لكن التدخل الروسي يطرح عليها تحدياً سيكون من الصعب عليه مواجهته، من دون تغيير مواقفه من المقاومة السورية، أو إغراء إيران بالتخلي عن روسيا، في مقابل تعاون يلبي مصالح ملاليها، ويجيز سعيهم إلى دور مهيمن في المنطقة بين جبال هندكوش في أفغانستان وجنوب لبنان.
بقول آخر: بقدر ما توثق إيران علاقاتها مع روسيا، تزداد حاجة أميركا إليها، وبقدر ما ترتبط
"قدر ما توثق إيران علاقاتها مع روسيا، تزداد حاجة أميركا إليها، وبقدر ما ترتبط بالسياسة الأميركية تتعاظم حاجة موسكو إلى التحالف معها"
بالسياسة الأميركية تتعاظم حاجة موسكو إلى التحالف معها، على نقيض ما يعتقده قطاع واسع من متابعي الصراع الإقليمي والدولي في منطقتنا، وتدخل روسيا العسكري في بلادنا. ولعله من الجلي أن مصلحة إيران في التحالف مع روسيا هي، حالياً، أكبر من مصلحتها في التحالف مع واشنطن، إلا إذا ضمن الأميركيون لها علاقات استراتيجية مع إسرائيل، تقوم على تقاسم وظيفي بينهما للنفوذ والسيطرة على المشرق العربي وبعض بلدان الخليج، تعزّز منافعه اتفاق بوتين ونتنياهو على دور إسرائيل العسكري في سورية ولبنان، وما فتحه من أقنية تواصل وتفاهم أمر واقع بين تل أبيب وطهران.
هل ستنجح أميركا في احتواء تحالف الأمر الواقع الروسي/ الإيراني؟. بكل تأكيد، إن هي تحالفت مع المقاومة السورية وأمدتها بما يلزم لتقويض قدرة روسيا على مواصلة الصراع العسكري، ولاحتواء إيران وإنهاكها. عندئذ، ستتمكن واشنطن من إجبار الملالي على الانصياع لإرادتها، وستستكمل ما بدأته بالاتفاق النووي من تحجيم دورهم في منطقة هي، إلى اللحظة، الأكثر أهمية في العالم، سواء فيما يتصل بمزاياها الاستراتيجية، أم بثرواتها الطبيعية وحاجاتها التنموية ورساميلها، أم بمكانتها من العالم الإسلامي ودورها في الصراع بين الشمال والجنوب، وبين الدوائر الحضارية والدينية في عالم اليوم.
هل تنتقل واشنطن من إدارة الصراع إلى ممارسة ضغوط كاسحة على قوتيه المقابلتين لها في سورية والمنطقة، عبر علاقة "هجومية" مع المقاومة العسكرية والمعارضة السياسية السورية، يبدل اعتمادها معطيات الصراع، ويحسم معركة دولية وإقليمية وسورية طال انتظار حسمها، يعني التقاعس عن التفاعل بروحٍ هجومية معها السماح لروسيا وإيران بالخروج سالمتين غانمتين من فخٍّ، يمكن أن يكمن فيه هلاكهما؟
 ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
"نعم أنا كنتُ سلفياً جهادياً، وحُبست على هذه التهمة في سجون النظام، واليوم أستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر لشعبنا أننا أدخلناكم في معارك دونكيشوتية كنتم في غنى عنها، أعتذر أننا تمايزنا عنكم يومًا، لأنني عندما خرجت من السجن الفكري الذي كنت فيه واختلطت بكم وبقلوبكم، قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عندما قال (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)، أعتذر منكم أعتذر، وإن شاء الله قابل الأيام خير من ماضيها لثورتنا ولإسلامنا".
أبو يزن الشامي، القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية، استشهد في 9/9/2014.
“ في الحقيقة ما زلت أظن أن هذا الشعار "تحكيم الشريعة" هو من أكثر الشعارات تضليلاً عن مفهوم الشريعة نفسه "
(1)
في آخر كلمة نُشرت للشهيد الحبيب (أبو يزن الشامي)، تكلم فيها بعفوية شجاعة - كما يليق بمن اعتذر من الشعب السوري عن أنه كان يوماً ما سلفيّاً جهاديّاً - عن ملاحظته على نقاشات الجهاديين (أو الإسلاميين حسب التفريق المنتشر والمضلل ما بين إسلاميين وجيش حر) في الفضاء الافتراضي، يقول إنه راجع صفحته وصفحات الرموز المعروفين من حركة أحرار الشام أو غيرها ضمن الوسط الجهادي، فلم يجد كلاماً عن مآسي الناس أو أشلاء المجازر أو آلام النازحين، لم يجد وجدان الآلام، أو الشفقة المعلنة، وإنما كل "نقاشاتنا" عن شكل الدولة والعقيدة والعلمانية وهذا الكلام.
وقالها كطرفة محزنة ومنبّهة طبعاً على هذه المسافة مع قضية الشعب والواقع نفسه، والفارق بين ما يشغل الجهاديين والسلفيين وما يشغل عموم الثوار والشعب نفسه المشغول برحلة الآلام.
(كتنويه ضروري: لا شك أن تأثر الحركة بالسلفية الجهادية تضاءل بشكل مستمر بالتوازي مع الانزياح الثوري والإصلاحي الذي شهدته مع القادة الراحلين وقد كتبتُ عن الحركة مادتين تشكلان إضاءة على دينامية التحول والتنوع داخل الحركة: "يوم استشهد الأحرار" المنشورة في منتدى العلاقات العربية، و"أحرار الشام بعد عام طويل" المنشورة في مركز عمران للدراسات، وليس هدف هذا المقال الحديث عن الحركة).
(2)
تقول حنه أرندت (التي أدين لها بملء أسابيع بل أشهر طويلة من هذه السنة) أنه منذ الثورة الفرنسية (1789) أصبحت "الشفقة" هي السمت والدافع الرئيس لرجال الثورات، وهذا ينطبق بلا شك على ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، الشفقة على من يكابدون الظلم والفقر والعجز، والتعاطف/ التماهي اللامحدود مع "المعاناة" البشرية، ولكن هذا الأمر لم يكن هو نفسه في الثورة الأميركية السابقة عليها، حيث لم تعرف أميركا "المعاناة"، بقدر ما كانت بلد الحلم السعيد بالوفرة حيث لا يعرف الناس الفقر (ترى حنه أن وجود هذا النموذج كان أحد المحفزات العميقة للثورات الأوروبية، يمكن قول الأمر نفسه عن الربيع العربي ضمن سياقاته الخاصة، والذي كان ضمن نتائجه أو مآلاته التصاعد الدراماتيكي في البروباغندا العدائية للغرب وموجات اللجوء إليه في الوقت نفسه)، ولذلك لم تكن الثورة الأميركية ثورة المعاناة بقدر ما كانت تمثل نموذج الثورة القانونية، ثورة الحقوق التي تمتد جذورها إلى الماغناكارتا في إنكلترا القرن الثالث عشر أو ثورة القراء في العراق القرن الهجري الأول، ولكنها تجد أساسها الملهم في روما القرون الأولى.
ولذلك لم يكن انتصار الثورة الأميركية إلا إعلان وثيقة الدستور، وليس هزيمة قوات الامبراطورية البريطانية، ولا نصب المشانق لحكام العهد السابق أو الثوار الخائنين (كما فعل روبسبيار فيما بات يعرف بعهد الإرهاب).
ورغم التشابه ما بين حقوق الإنسان المقدسة التي توجبها طبيعة البشر وتضمنها كلمة الله في الدستور الأميركي، وما بين حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة في الثورة الفرنسية، إلا أن ما كان ذا دلالة على لائحة قانونية وتنظيمية وهيكلية إدارية مفصلة للدولة في أميركا، كان شعاراً تعبوياً للسلطة والشعراء في فرنسا، وباسم "الإرادة العامة" أو إرادة الشعب التي اقتبسها روبسبيار من الرومانتيكي الحالم جان جاك روسو، تم قمع الشعب نفسه، لأنه لم يحمل مدلولاً قانونيّاً وإجرائيّاً محدداً كالانتخابات أو أغلبية مجلس الشيوخ مثلاً.
(3)
هل أن السلفية الجهادية أو التيار الجهادي المعولم أو تنظيمات الإسلام السياسي (مع فارق الدرجة بين هذه التصنيفات) نتيجة ضمور "الشفقة" لصالح "التشريع" كدافع للصراع، تنتمي إلى نموذج الثورات القانونية السابق على "ثورات المعاناة" كما تمثلت في الثورة الفرنسية؟
إحدى خيانات المثقفين الشائعة هي البحث عن جذور أعمق لموضوعاتهم، والسعي لمنح هذه الموضوعات غايات أخلاقية كلية قد لا تنتمي إليها ولا يقتنع بها الفاعلون أنفسهم بالضرورة، وهذا نتيجة التوهم المثير للشفقة أن قيمة الباحث تتعلق بقيمة موضوعه، فيسعى دوماً إلى تضخيم حجم وخطورة هذا الموضوع، وكثير ممن يكتبون عن داعش كخط مواجهة للكولونيالية والامبريالية وتصحيح أوضاع السنة في المشرق العربي (...الخ... الخ.... الخ) هم كذلك.
في الحقيقة الموضوع هنا شائك قليلاً، ولا يمكن تعميم حكم فيه، ولا تعميم حكم "غياب الشفقة" هذا، فما يغيب في التداول ليس ذاته ما يغيب في الشعور أو دوافع الأفعال، خاصة أن مظلومية المسلمين ما زالت تمثل البداية الأكثر شيوعاً لمبررات النفير للقتال (ولكن استمرار هذا الدافع يحتاج مبرراً أقوى لاحقاً يتمثل بتحكيم الشريعة)، عدا عن التنوع الكبير الذي تخفيه هذه المصططلحات الجامدة.
لا أريد هنا الإسهاب كثيراً في هذا الموضوع، ولا غايتي منح جواب نهائي عنه، ولكن الملاحظ أن "تطبيق الشريعة" ليس مفهوماً قانونيّاً هنا ولا تشريعياً ولا شرعياً حتى، بقدر ما هو شعار تعبوي في خدمة الاصطفاف السياسي المطلوب، وليس ذا مدلول إجرائي أو غاية تشريعية، لأنه محض شعار يدل على وجود كفر نريد محاربته بتحكيم الشريعة، وتحكيم الشريعة هنا لا يستحضر المدونات الفقهية الكبرى (الأم أو المبسوط أو المجموع...الخ) ولا المجلة القانونية العثمانية ولا القانون العربي الموحد ولا حتى "التشريع الجنائي في الإسلام" لعبدالقادر عودة، بقدر ما هو "كلام" عن تطبيق الحدود ونشر النقاب وهدم القبور وبعض الصور والاستيهامات التاريخية مثلها.
واعتراض "ثورات الشريعة" هذه على السعودية كاشف لهذه المفارقة، والموقف من السعودية أحد الامتحانات الأكثر ذيوعاً لحيازة شرعية في التيار الجهادي (السلفي/ المعولم)، لأن الاعتراض على السعودية هو العلاقة بأميركا، وليس تطبيق القانون، الذي يمثل الصورة المطابقة (بل الملهِمة) لتحكيم الشريعة كما يتخيلونه حسب "الشرعية النجدية" التي تصبح مقياساً لإسلام المجتمعات، وإن بشكل أكثر حِرفية وتأصيلاً وعلمية بأضعاف مقارنة بالخبرات الشرعية الضئيلة في التنظيمات السلفية الجهادية عامة.
في الحقيقة ما زلت أظن أن هذا الشعار "تحكيم الشريعة" هو من أكثر الشعارات تضليلاً عن مفهوم الشريعة نفسه، وعن الالتفات لإشكاليات التشريع ونقاشاته الحقيقية، عدا عن أنه يمارس ذات النقلة القاتلة في تفكيرنا من "الخطر الحقيقي على المسلمين" إلى "الخطر المتوهم على الإسلام".
إن انتقال شعار تنظيم القاعدة في سورية (جبهة النصرة) من "جبهة النصرة لأهل الشام" إلى "ما خرجنا إلا لنصرة هذا الدين" دلالة على هذه النقلة.
وإن استثنينا "الجيش الحر" والفصائل الثورية بعامة، وهو المفهوم الذي يجمع الفصائل الثورية التي لم تنتم إلى السلفية الجهادية أو التيار الجهادي المعولم وما زالت تتبنى قضية الثورة السورية وإسقاط النظام المجرم لا قضية تنظيمها الأيديولوجي المغلق، وهذه الفئة هي الغالبة على القوة المقاتلة في الثورة السورية وعلى قوتها الناعمة أيضاً التي تتمثل في أنصارها وداعميها ومجالها الرمزي، رغم أن التأثر بالمزايدات السلفية الجهادية قد وصل إلى هذه الفئة أيضاً..
فكأننا لم نعد نعبأ بالظلم الذي يقع على الناس، لم يعد الألم والدم البشري المسفوح على الطرق يشكل دافعاً حقاً للقتال، ولا مبرراً كافياً له، وليس لدينا مشروع قانوني واضح - ولا غير واضح - يتضمنه شعار "تطبيق الشريعة" بالمقابل لنناضل لأجله.
مرتكزات هذا الخطاب أو السايكولوجيا الجهادية إذن أن هوية الإسلام هي المهددة، والنظام العالمي البديل عن الخلافة والمهيمن على دول المسلمين وحقوقهم هو العدو، ولا شك أن مظلومية المسلمين في أنحاء العالم تشكل الدافع الأبرز للتوجه نحو الجهاد، ولكن تطبيق الشريعة كغاية تضمن استمرار هذا الدافع و "قطف ثمرات الجهاد" إضافة إلى "التهديد الدائم" على الإسلام نفسه سيجعل من المسلمين و"الإسلاميين" المنافسين عقبة وعدواً في هذا الطريق.
(4)
أين يقع هذا الشكل المتداخل والمتعدد للتنظيمات الجهادية التي تحمل لواء ثورات الشريعة ضمن نماذج الثورات في التاريخ إذن؟ .. يقع عندنا، والآن، وهذا المهم.
-
 ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
يُظهر الإعلام الروسي أن التدخل العسكري في سورية لا يرتبط بـ "مصالح خاصة"، وأنه يهدف إلى منع سقوط نظام بشار الأسد "الذي يواجه الإرهاب". أي أنه يوضح أن ما تقوم به روسيا هو "مهمة إنسانية" (وربما لوجه الله). لكن رئيس الوزراء والرئيس السابق، ديمتري ميدفيديف، أشار، أخيراً، إلى أن هذا التدخل لم يأتِ لدعم الأسد، بل "حماية للمصالح الروسية" التي قال إنها تتعلق بمحاربة الإرهاب هناك، قبل أن يأتي إلى الأرض الروسية. وهذا ما أعاد تكراره فلاديمير بوتين، حيث باتت لازمة لتبرير التدخل العسكري في سورية، وكأن الأمن القومي الروسي يبرر تدمير سورية بحجة الإرهاب.
هذا تقليد هزلي لما قاله جورج بوش الابن، حين قرر احتلال كل من أفغانستان والعراق، كما أن مجمل الكلام عن "الحرب على الإرهاب" تقليد للخطاب الأميركي. ولا شك في أن روسيا هي إمبريالية تقليد، وهزلي. لهذا تكرر ما قالته إمبريالية "أعرق"، أي أميركا. وأيضاً لا شك في أن الهدف هو نفسه الذي أرادته أميركا، أي السيطرة والاحتلال. لكن، سيكون الأمر هزلياً كذلك.
هنا نعود إلى الحديث عن "مصالح روسيا" التي غطاها ميدفيديف بالحرب على الإرهاب، لكنها أبعد من ذلك، وغير ذلك، حيث لا نجد أن الغارات الروسية تطاول الإرهاب (داعش والنصرة، على الأقل كما قررت الأمم المتحدة)، وهي مصالح جوهرية لبلد يحاول أن يلعب دوراً إمبريالياً.
أولاً، حصلت روسيا مقابل حماية النظام دولياً عبر استخدام الفيتو على مصالح اقتصادية مباشرة، تمثلت في احتكار استغلال النفط (كان بيد شركات أميركية) والغاز (كان سبب الصدام مع فرنسا بعد أن أُعطي لشركة أميركية وكيلها محمد مخلوف)، ثم الغاز المكتشف في البحر المتوسط. وأيضاً مشاريع اقتصادية كبيرة، وقّع عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حينها، قدري جميل، في شهر أغسطس/آب سنة 2012. وبهذا حصلت روسيا على احتكار اقتصادي كبير، سواء باستغلال النفط والغاز، أو في فرض اعتبار سورية سوقاً لسلعها ومجال استثمار أموالها، إضافة إلى احتكار تصدير السلاح الذي هو ضرورة لروسيا. وهذا احتكار إمبريالي بامتياز، وشروطه لا تختلف عن كل احتكار إمبريالي.
ثانياً، حصلت روسيا على حق وجود قاعدة بحرية في طرطوس، كانت قد أنشئت بداية ثمانينيات القرن الماضي، لكنها أغلقت نتيجة اعتراض أميركي، وبالتالي، أصبحت القاعدة متاحة للخدمة بعد توسيعها. وكما ظهر أن روسيا فرضت إنشاء قاعدة برية جوية في اللاذقية. وبالتالي، فرضت وجوداً عسكرياً دائماً في سورية، هي بحاجة إليه في ظل الدور العالمي الذي تعتقد أن عليها أن تقوم به. فهذا الوجود العسكري يسمح بتعزيز الوجود العسكري البحري في البحر الأبيض المتوسط، ومحاولة فرض هيمنتها فيه، في سياق سعيها إلى أن تكون "وريثة" أميركا المنسحبة من "الشرق الأوسط"، وبالتالي، السعي لكي تعزز وجودها الاقتصادي السياسي والعسكري في هذه المنطقة.
بالتالي، إذا كان قد أصبح لروسيا مصالح اقتصادية في سورية، فإن وجودها العسكري يسمح لها بأن تكون سورية مرتكزاً لهيمنة أوسع في "الشرق الأوسط". وهذا ما دفعها إلى "عقد تحالف أمني" مع كل من الأنظمة في إيران والعراق وسورية، بما يؤشر إلى بدء تشكيل تحالف سياسي عسكري تحت هيمنتها.
هذه هي مصالح روسيا التي فرضت عليها التدخل العسكري في سورية، ومن ثم التحكم في مسار النظام، ومحاولة توسيع ذلك للسيطرة على مجمل المنطقة. إنها مصالح إمبريالية في سياق الميل التوسعي الذي باتت الاحتكارات الروسية بحاجة إليه، لكي تراكم أكثر، وتعزّز قدرتها العالمية في مواجهة الاحتكارات الأخرى. بالتالي، يتضمن تقليد الخطاب الذي يكرره الروس تقليد السياسة الإمبريالية الأميركية في السعي إلى السيطرة والاحتلال. هذا هو قدر كل إمبريالية! لكن الأمر الآن لا يعدو أن يكون هزلياً.
 ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
أغلب الظن أن سيد الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبتلع اقتراح الرئيس بشار الأسد أن «يقرر الشعب السوري» مصير بلاده. أغلب الظن أن بوتين استدعى ضيفه ليلاً ليطلب جردة حساب بما يمكنه أن يقدِّمه، لإيجاد مخرج من الحرب، في مقابل إنقاذ النظام. لم تكن ملامح المضيف توحي بثقته بما سمعه من الزائر الليلي الذي يتمسك بإصرار برغبته في انتظار قرار «يتخذه الشعب» الذي نُكِب بالكيماوي والبراميل المتفجّرة والمرتزقة، في حرب وحشية هجّرت الملايين، وأبادت 300 ألف إنسان.
أبلغ الأسد بوتين امتنانه الشديد لتدخُّل الكرملين في المرحلة العصيبة للنظام السوري، لكنه بدا كمن يقايض «عاصفة السوخوي» بمجرد قاعدة عسكرية ضخمة للروس في اللاذقية، أو يظن أنه سدّد الحساب كاملاً، وما على الروس إلا مواصلة الحرب الجوية لسحق كل المعارضين لنظام الأسد.
وإن لم يكن مستبعداً اقتراب موسكو من مرحلة «تأهيل» بشار لتطلق مشاورات التسوية والمرحلة الانتقالية فيما هو في الحكم ولو لفترة، فالأكيد أن الكرملين لا يبتلع نظرية أن لا حل سياسياً إلا بعد سحق «الإرهاب»، ورفع كل الفصائل الجهادية راية الاستسلام. وإذ بدا أكيداً أن بوتين يستبق المشاورات الدولية- الإقليمية بالضغط على الأسد لكي يمتنع نظامه عن عرقلة جهود موسكو، الساعية الى تزامن قطار «التسوية» مع القبضة العسكرية، فالأكيد ايضاً أن الكرملين بعدما كفَّ يد طهران عن توجيه دفة الحرب في سورية، يبادر إلى تكليف نفسه مهمة وقف الاستنزاف العبثي المستمر فقط لإبقاء الأسد في الحكم.
الدب الروسي الذي أثخنته جروح العقوبات الغربية بعد حرب أوكرانيا، لا يقدّم خدمات مجانية لنظام ستكون رموزه مطلوبة في محاكمات دولية... ومقاتلات «سوخوي» كالبراميل المتفجّرة لا توزّع الورود على السوريين في حلب وحماة واللاذقية وحمص. ما لا يداخله الشك هو أن الروس اختاروا لحظة عسيرة في مسار الحرب السورية، ليحوّلوه لمصلحتهم، في إطار الصراع الدولي على النفوذ. أما ذريعة خوض الحرب على «الإرهاب» بعيداً عن الحدود لحماية الداخل، واستباقاً لوصول «داعش» إلى روسيا وحدائقها الخلفية، فهي مقاربة لا تصمد طويلاً بمفردها.
تدرك موسكو مثل واشنطن وحلفائها الأوروبيين، أن تسوية في سورية تقصي رموز النظام الذين تورطوا بجرائم حرب، وتطوِّر مؤسسات الدولة، ستكون كفيلة بتوحيد الجهود في مواجهة «داعش». وإن كان التباين الروسي- الأميركي على حالة من التأزُّم والتشنُّج، فسيد الكرملين يسعى إلى توجيه رسالة إلى إدارة الرئيس باراك أوباما، فحواها يتعدى التحدّي لإظهار قدرة موسكو على الردع، وعلى انتزاع الحل.
وهكذا، يستعدّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقاء نظرائه الأميركي جون كيري والسعودي عادل الجبير، والتركي فريدون سنيرلي أوغلو في فيينا، وطرح أوراق تسوية بالتدرُّج. الإجماع مجدداً هو على استبعاد «داعش» وأخوات «القاعدة»، لكن العقدة هي مصير الأسد. وإن كانت موسكو ماضية في تدمير أنفاق «الخلافة» في سورية، فهي أعطت إشارات إلى عدم رغبتها في حرب بلا أهداف واضحة، وهذه تحديداً كانت في صلب جردة الحساب التي طلبها بوتين من زائره الليلي.
باختصار، لا مقايضة ولا مهادنة مع «داعش»، إنما ايضاً لا حرب بلا نهاية، ولا غطاء جوياً مجانياً تهبه موسكو لإبقاء الأسد في السلطة. بوتين يريد إشراك «كل القوى» السورية في الحل، وهو ما لا يحتمله حليف ضعيف، لم يجد للتعبير عن امتنانه لخدمات روسيا أفضل من القول إن تدخُّلها حال دون سيناريو مأسوي!
فلنتخيّل أن كل ما حصل وما تشهده سورية من فظائع لم يقترب بعد من المأساة. كارثة الانفصال عن الواقع تدمّر مزيداً من مدن العرب وحواضرهم، وبوتين لن يتولى حتماً مهمة توفير «المخرج الآمن» للأسد، لمجرد مراعاة مصالحهم، أو رغبات الأميركيين.
سيد الكرملين يتحرك بحسابات القيصر، كل حلفائه في سورية يتخبطون في مستنقع الهدف الروسي الأخير.
وبعيداً من تمنيات رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ببقاء الأسد أطول فترة ممكنة في روسيا، أو حتى لجوئه إليها، لا يمكن بوتين أن يحتكر فرض الوقائع، ولا التحكُّم وحيداً بمسار الحرب والحل في سورية. ورغم «عاصفة السوخوي» الروسية، وبدء تعديل ميزان القوى، لا يفلح حلفاء النظام في دمشق في إخفاء ملامح مآزقهم وتوتُّرهم.
وأما تركيا أردوغان فلعلها لا تلتقط أنفاسها، في ظل أخبار سيئة، آخرها مشروع «الكانتون» الكردي في شمال سورية.






