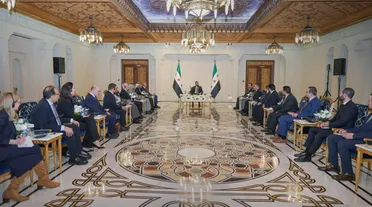دروب الجلجلة السورية السبعة
المشاهد التي انتشرت على عدد من المنصّات الإخبارية، وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بموت نحو 17 سورياً بجمرة البرد الحارقة التي تعرض لها هؤلاء اللاجئون على الحدود المشتركة مع لبنان، أيقظت في نفوس الملتاعين بفظائع الحرب، المتواصلة منذ نحو سبع سنوات، فيضاً من صور موتٍ لا حصر لها، محفورةٍ عميقاً في الذاكرة، ومسجلةٍ بالصوت والصورة، بفعل ما دهى السوريين من موت زؤام، تعدّدت أشكاله، وتنوعت أساليبه، على أيدي قوى دولية وإقليمية متصارعة، وجماعات محلية متنافسة بالحديد والنار، فيما كان للنظام الدكتاتوري الأقلوي القابض على مقاليد الجيش والأمن وعدة الحرب، حصة الأسد من هذا الموت الجماعي الذي لم يكابد مثله أي شعب آخر في المحيط المجاور بكل تأكيد.
كنت أعتقد أن الموت في أقبية التعذيب هو أشد رهبة على النفس، وكنت أرى كذلك أنه أكثر أشكال القتل إيلاماً على الإطلاق، بينما كان بعضٌ من محاوريّ يعتقد أن الموت بالتجويع، أو بالسلاح الكيميائي والغازات السامة، أو القضاء تحت قصفٍ بالبراميل، ناهيك عن نيران المدافع والصواريخ، أو غير ذلك من صنوف ترويع وتهجيرٍ تعد ولا تحصى، أشد مرارة من الموت البطيء على أيدي جلاوزة أجهزةٍ مدرّبةٍ على القتل بدم بارد، وذلك كله إلى أن شاهدت تلك الصور التي أضافت إلى الذاكرة المستباحة مشهداً غير مسبوق من مشاهد الموت، الذي ظل يلاحق السوريين في الداخل وفي الخارج، في البر وفي البحر، حين يمم مئات الآلاف منهم وجوههم نحو أوروبا، للنجاة بأنفسهم من طاحونة الموت الدائرة في الديار.
ومع أن عدد الذين قضوا نحبهم تجمداً كان قليلاً، ويكاد لا يذكر، قياساً بأعداد من يقتلون يومياً على أيدي النظام الأسدي و"داعش" والمليشيات الإيرانية، فضلاً عن طائرات موسكو وصواريخ واشنطن، وغيرهم من القتلة الأوغاد، إلا أن مشهد الموت بجمرة الثلج حصراً بدا أشد وقعاً على الضمائر من كل ما سبقه من طرائق قتل بالجملة والمفرق، إن لم نقل إنه كان أكثر فجيعة من كل ما عداه، بما في ذلك الموت في الأقبية الباردة والمسالخ البشرية، مثل سجن صيدنايا سيئ الصيت، لا سيما وأن الموت تجمّداً جاء متزامناً مع موجة برد قارسة، اكتسحت شرق المتوسط كله، وبالتالي فقد أدرك الناس، والحالة هذه، ولمسوا خلال معانتهم الطفيفة، ما معنى أن يقضي المرء نحبه بفعل لفح زمهرير الشتاء الحارق في العراء.
على هذه الخلفية المثيرة للخواطر، تواردت إلى الذهن حكاية الجلجلة الثاوية عميقاً في الوجدان العام، وبدا الموت متعدّد الأشكال، الذي لا يزال يداهم السوريين صبحاً ومساءً، وفي كل حين، أقرب ما يكون إلى تلك الواقعة التاريخية الرهيبة، التي حمل فيها السيد المسيح صليبه على ظهره، وسار به على ما يعرف اليوم "طريق الآلام" يوم الجمعة العظيمة، من موقع قرب باب الأسباط في شرق القدس القديمة، إلى الصخرة التي صلب عليها في جنوب غرب المدينة، حيث أقيمت كنيسة القيامة في ما بعد، وصارت منذ ذلك الحين أقدس مكان يحج إليه المسيحيون المؤمنون، فيما يعبر السوريون جلجلتهم منذ سبع سنواتٍ حافلاتٍ بكل أشكال الموت، من دون أن يحفل بموتهم الموثق بمقاطع الفيديو، والمبثوث من عين المكان، أحد من بني جلدتهم، إلا من كاتب هنا أو مثقف هناك.
نشرت، قبل أيام، صحيفة إلكترونية جادة ورصينة، تصدر تحت اسم "عنب بلدي"، وهي صحيفة سورية معارضة، قائمةً طويلةً من طرق الموت التي جرّبها السوريون، دون غيرهم من بني البشر، تضمنت سبع طرق رئيسة، واحتوت على أعداد من قضوا بكل طريقةٍ على حدة، حيث تصدر القصف بالبراميل والمدفعية والصواريخ، على مدى السنوات السبع الماضية، أكبر أعداد الضحايا على الإطلاق، برقم بلغ نحو 16.4 ألف شخص، تلاه الموت غرقاً بعدد بلغ 15 ألفاً، ثم التعذيب حتى الموت بعدد بلغ أيضاً 13 ألفاً، وبعد ذلك الكيميائي (1420)، الحرق (1000)، الجوع (700) أغلبهم في محيط دمشق، وأخيراً كان الموت بجمرة الثلج بالعدد المذكور آنفاً.
إذ يبدو أن تكرار مشاهد القتل على نحو يومي، وعلى مدار أيام السنوات السبع هذه، قد ثلم، إن لم نقل بلّد المشاعر الإنسانية لدى أكثرية الناس، الذين اعتادوا رؤية جثث السوريين على طرقات شوارع مدنهم وقراهم، بل وتحت الركام وبين الأنقاض، وعلى سطح الماء في أعالي البحار، الأمر الذي جعل من عشرات آلاف المشاهد والصور المنقولة من خلال عدسات الهواتف المحمولة مجرد مشاهد اعتيادية روتينية متكرّرة، من يوميات حربٍ تبدو بلا نهاية منظورة، في ساحةٍ مفتوحة أمام قوى إقليمية ودولية متطاحنة على النفوذ، خصوصا منذ بدأت هذه القوى المتوحشة حربها على ظاهرة الإرهاب، ووجدت ضالتها المنشودة في تنظيم الدولة الإسلامية، الذي قدم ذريعةً مثاليةً لاستباحة الأرض والأجواء السورية، حتى وإن ذهبت حيوات آلاف السوريين ثمناً للقضاء على هذا الإرهاب.
وأحسب أن ما فاقم مشاعر الناس السلبية في الجوار العربي تجاه ما بدا مثل موتٍ عبثي لا طائل من ورائه، كان اقتتال الفصائل الجهادية في ما بين بعضها بعضا، ووقوع خسائر بشرية واسعة بين المقاتلين أنفسهم، وبين المدنيين المحاصرين، لا سيما في الغوطة الشرقية التي شهدت أسوأ أشكال الاقتتال بين فصائل مطوّقة من أربع جهات، وتقصف من جانب النظام بلا هوادة منذ نحو خمس سنوات. ومع ذلك، لم تتورع تلك الفصائل المهدّدة بالاجتياح والترحيل إلى إدلب، عن الوقوع في الشرك المميت، وراحت تتبادل القصف والاختطاف والإغارات، في مشهد ضرب مشاعر المتضامنين مع الثورة في الصميم، وجعلهم أقل انفعالاً مع فيض الأخبار المروّعة، وأدنى تعاطفاً مع أشرطة الصور المؤلمة، المتدفقة عبر فضاء العالم الافتراضي، طالما أن السوريين المعارضين يقتلون أنفسهم على مثل هذه الطرقة المجانية الحمقاء، التي لم تدخل في قائمة "عنب بلدي".
خلاصة القول، إن الموت على الطريقة السورية القاسية قد بلغ حداً يثقل على الضمير المشترك والوجدان العام، ويدعو إلى الرثاء، وإن هذه الكارثة الإنسانية الرهيبة فاقت كل ما وصلت إليه الكوارث العربية المتنقلة من العراق إلى ليبيا، مروراً باليمن والصومال، وحتى فلسطين، لا سيما إذا ما أضفنا إلى القائمة الطويلة عشرات آلاف المعتقلين والمخفيين قسرياً، وملايين النازحين واللاجئين الهائمين في كل الديار، وحدث ولا حرج عن الدمار والخراب والإفقار، وما انتشر من كراهية وأحقاد متبادلة بين سائر المكونات، إلى الحد الذي يمكن معه القول إن ما يجري في منطقة عفرين لن يكون نهاية المطاف مع الأسف الشديد.