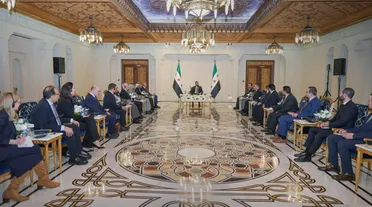هـل أخطأ سعد الحريري؟
يوم وجد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري نفسه محاصراً بجو سياسي داخل حكومته، مناقض لخطه وللمبادئ التي ورثها من والده الشهيد رفيق الحريري، غادر بيروت إلى المملكة العربية السعودية، ومن هناك، من العاصمة الرياض، أعلن استقالته عبر الشاشة التلفزيونية.
كانت تلك الاستقالة بموقعها، وبمضمونها، حدثاً استثنائياً في تاريخ لبنان. وكانت أسبابها واضحة ومحددة من دون شرح مطوّل: الحكم بات صعباً بالضغوط على الحريري من داخل ومن خارج.
وجاءت تلك الاستقالة بعد ساعات من زيارة وفد إيراني رسمي على مستوى عال برئاسة مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية الدكتور علي أكبر ولايتي في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ولم تكن لتلك الزيارة غاية سوى وضع علامة على أن إيران حاضرة في مركز القرار اللبناني، وكان لا بدّ للزائر من إطلاق «صاروخ» سياسي من ردهة ديوان رئيس الحكومة اللبنانية على إسرائيل.
لم يكن رئيس الحكومة اللبنانية، ولا لبنان، بحاجة إلى ذلك «الدعم» الإيراني، ففي الخطب والكتابات والتصريحات اللبنانية والعربية ما يكفي ويزيد من تلك «الصواريخ» الإيرانية وسواها. لذلك اختار الحريري اللجوء إلى المملكة العربية السعودية لمراجعة حساباته الحكومية والسياسية قبل اتخاذ قراره. أي أنه لجأ إلى جدار يحميه. وهو إذ عاد بعد 19 يوماً إلى بيروت فاجأ اللبنانيين والأوساط الخارجية بقبوله تمني رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون الاحتفاظ بالاستقالة، وقد قبل التمني، وبات «رئيس الحكومة اللبنانية المعلق على الاستقالة المعلقة».
هل كانت خطوة الحريري موفقة؟.. يُرجى أن يكون الجواب أنه عاد من أجل سلامة لبنان والحفاظ على مصالح اللبنانيين، ولهذه الأسباب وافق على الاحتفاظ بالاستقالة.
وسؤال آخر: هل نال سعد الحريري وعوداً من رئيس الجمهورية، ومن رئيس مجلس النواب، بأنه سيتمكن مع حكومته، وفيها وزراء العهد ووزراء «حزب الله»، من تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحي، الإنمائي، الاقتصادي، الاجتماعي، والمالي؟
وهل سيتمكن من ضبط سياسة وزير الخارجية لتتلاءم مع سياسة لبنان التقليدية بالحفاظ على سلامة العلاقات مع الدول العربية على قاعدة احترام سيادة واستقلال كل دولة، وعدم التدخل في شؤونها، مع التزام بنود ميثاق الدفاع العربي المشترك في مواجهة إسرائيل؟
إن هذه القاعدة التي استقرّ عليها لبنان لا تحول دون تصديه منفرداً لأي عدوان إسرائيلي عليه، خصوصاً أن جيشه وقد بات محصناً ومدرباً ومتمكناً من خبرته، وعتاده وعديده، واستعداده لحماية وطنه وشعبه، كما لا يحول دون انخراط مقاومته الشعبية المنظمة والشجاعة المدربة والمجربة في التصدي لإسرائيل؟
ثمّة تساؤلات مطروحة على رئيس الحكومة العائد إلى ديوانه لاستئناف مهماته ومسؤولياته. فاستقالته كانت خطوة كبيرة وخطيرة، والاحتفاظ بها مبادرة كبيرة وخطيرة، والمهم سلامة لبنان واستقراره وسلامة علاقاته مع الدول العربية، وضمان صموده، وتنفيذ ما أمكن من بنود برنامج الحكومة، وأهمها: الإصلاح، وأول الإصلاح تأمين الماء والكهرباء والصحة العامة، وسلامة الليرة، والعمل للفقراء ومتوسطي الحال، وقد باتوا الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني.
وكم ستطــول فــترة الاحتفاظ باستقالة الحكومة؟ قسم كبير من اللبــنانيين يتــنى على الحــريري اختصار المهل لكي يمتلك السلطة والقدرة على تنــفيذ وعوده، ثم إن المطلوب ليس «النأي بالنفس» إنما «النأي بلبنان» عن سياسة التهور والارتجال، وعن تعمد الشهرة على حساب حريات اللبنانيين ومصالحهم ومتطلبات عيشهم وأمنهم واستقرارهم.
المطلوب «النأي بلبنان» لتفادي أخطار التهوّر في الداخل، وفي المحيط العربي المتفجر، وإذا كان لا بد من «النأي بالنفس» فليكن النأي عن التخاذل والفساد، والإفساد في الدولة وبين الناس.
تعب اللبنانيون من الوصايات. بل ضعف إيمانهم بموطنهم. ففي مراحل سابقة كان الأخ العربي الجار قد فرض نفســه وصياً عليهم، إلى درجة أن هذا الوطن العليل فقد قراره الــحرّ منــذ أن أطبق النظام السوري قبضته على بيروت، وصادر مفاتيح إدارتها السياسية والعسكرية وشؤونها المـــحلية بكل تفاصيلها، بدءاً بالمختار، وصولاً إلى السرايا ومجلس النواب، فالقصر الجمهوري. حدث ذلك في الربع الأخير من القرن الماضي، وتحديداً في السنة الخامسة من ولاية الرئيس الأسبق سليمان فرنجية (1970–1976).
لم يبق من أقطاب تلك المرحلة سوى عدد قليل. لكن الذين عايشوا زمن الردع ومـــعاهدة «الأخــوة والتــعاون والتنـــسيق» لا يزال منهم مئات الألوف الذين يتابعون تطوّر أوضاع وطنهم عبر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، ومن نكبة إلى نكبة، ومن شــهيد إلى شهيد، وصولاً إلى يوم رحيل الحاكم العسكري السوري الملقّب بـ «رئيس جهاز الأمن والاستطلاع»، وقد غادر بيروت في ذلك اليوم من شهر آذار (مارس) 2005، حاملاً بندقية المقاومة تذكاراً مهدى إليه من جبهة المقاومة اللبنانية. وبرحيله انتهى زمن الوصي السوري على لبنان.
ولأن الزمن لا يفصل بين وصي وآخر، إلا بالتاريخ، لم يشعر اللبنانيون بأنهم استردوا حرية قرارهم بالكامل، لأن ثلاثين سنة من الوصاية الـــثقيلة علـــيهم كانت قد أخذت قسطاً طويلاً من أعمار أجيالهم الشـــعبية والسياسية والأمنية والثقافية، خصوصاً أن الوصي كان قد ترك بينهم مصطلحات ثقيلة للوطنية والقومية والعروبة، وحتى الديموقراطية، والحرية، والمدنية، ولا تزال قيد التداول والالتزام.
ويتذكر اللبنانيون وسواهم من العرب والفرنسيين وسائر الأوروبيين تلك الحملة التي رافقت سعد الحريري من بيروت إلى الرياض، وما رافقها من معلومات وعناوين: الحريري سجين، ومعزول، ومحبط، وممنوع من السفر، ومن استقبال أفراد عائلته، ومن الاتصال بهم، أو الاستعلام عنهم، حتى أنه لا يعرف شيئاً عن أحوالهم... إلى أن ظهر في باريس، وفي باحة قصر الإليزيه، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استقباله بمراسم الرؤساء للضيف الآتي من عاصمة المملكة العربية السعودية في طريقه إلى مدينته وعاصمته بيروت.
ما فعله الرئيس ماكرون كان تعبيراً عن مضمون ميثاق مدني حضاري بين فرنسا ولبنان عبر التاريخ القديم، حتى في زمن الانتداب، أو الاستعمار.
ولعلّ ماكرون عثر في أرشيف «الإليزيه» على وثيقة فرنسية- لبنانية يعود تاريخها إلى زمن الانتداب، وهذا مقطع منها مترجماً إلى العربية:
«التــكرّس للــخير الــعام ضرورة لكم، يا شباب لبنان، وأنتم اليوم في مرحلة إعادة البناء. وهذا الواجب العظيم يتخذ معنى مباشراً، وملحاً، لأن أمامكم وطناً عليكم أن تبنوه على هذه الأرض الرائعــة المــجبولة بالتاريخ، إذ يجدر بكم أن تبنوا دولة، لا لتتقاســموا وظائفها فقط، وتمارسوا رموزها، بل لتعطوها خصــوصية حـــياتية وقــوة داخـــلية، فمــن دونها لن تكون إلا مجموعة مؤسسات فارغة. لذا يجب أن تعمــلوا لتخــلقوا وتنــمّوا شــعوراً عــاماً هو الانصياع الإرادي من كل واحد منــكم للمــــصلحة العامة. هذا هو الــشرط الموجب لسلطة الحكام وللعدالة الحقيقية في المحاكم. وللنظام العام في الشارع، وللضمير المهني للموظفين. فلا دولة من دون تضحيات، ومن التضحيات خرجت دولة لبنان».
هذا الكلام ليس لبنانياً. إنه مقطع من خطاب للجنرال شارل ديغول وجهه إلى شباب لبنان زمن كان في بيروت ممثلاً لسلطة الانتداب الفرنسي، وكانت المناسبة رعاية حفل تخرّج دفعة من طلبة الجامعة اليسوعية في بيروت. وقد جاء ذلك الخطاب في زمن كانت عبارات الحرية والديموقراطية والعدالة تغيب عن خطب المسؤولين الفرنسيين واللبنانيين. والواقع أن نخباً من القيادات السياسية اللبنانية الوطنية كانت قد درست وتخرّجت في زمن الانتداب الفرنسي ثم ثارت عليه، وكرّست شطراً كبيراً من حياتها لقضايا لبنان والعروبة.
اللبنانيون يناضلون ويصمدون كي لا يكون حظ وطنهم من سوء حظ فلـــسطين وقضيتها الحية منذ نحو سبعة عقود، كانت ولا تزال، ذخيرة حية للسياسة وللجهاد وبناء الزعامات والقيادات والاستثمار في بعض الدول والأنظمة والأحزاب، حتى صارت مثل «مسمار جحا» يحق لحامله أن يدخل به البيوت التي تستهويه فيغرز مسماره في صدور جدرانها ويعلق عليه «القضية»، ومعها السلاح والخطاب الثوري.
بذلك المسمار، دخل الوصي الإيراني لبنان، وصار من أهل البيت. بل رفع ما يسمى «الكلفة» بينه وبينهم.
لكن الإيراني يدرك أن ذلك النوع من التصريحات لا يفيد لبنان، ولا يفيد إيران، بل يبني جدراناً من الشك والبغضاء بينها وبين اللبنانيين الذين، بمعظمهم، ينشدون الصداقة والتعاون مع من يتفهم قضيتهم ويحترم وطنهم وشعبهم، ودولتهم، حتى وإن كان بعضهم ضد سياستها في الداخل والخارج.
فاللبنانيون اليوم لا يحتاجون إلى صواريخ حربية، ولا إلى صواريخ سياسية تأتيهم من إيران، أو من أي جهة أخرى. كل ما يحتاجون من إيران حسن العلاقات والاحترام المتبادل.