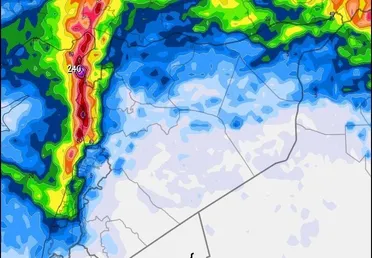بين بائع "الأقلام" وهارب بـ"روح" ابنته يتكشف ازدواجية الإنسانية في العالم على حقيقته
لا قبح يضاهي قبح "الانسانية" التي يدعيها العالم ككل و ذلك المتحضر و كذلك الذي يضع نفسه في مرتبة المثقف، فهنا للإنسانية كل الأسماء المشينة و ليس لها من حروفها أي معنى إلا "المذمة" و "الاهانة"، فالمشهد ذاته يتغير و يتلون تبعاً للمصالح و البرستيج لا تبعاً للحالة و الحاجة.
أثار قبل زمن صورة لرجل سوري حاملاً لطفلته النائمة على كتفه وهو يبيع الأقلام باحثاً عن ما يسد به رمق عائلته، أثارت موجة من التعاطف العابر للقارات و تم التجييش و التجميع للأموال ، في مشهد انساني مهيب و مجلل أعطى ثمراته من خلال انتقال الرجل من باحث عن لقمة عيش تسد رمق الحياة إلى مانح لها، في وقت تناطحت الرؤوس بحثاً عن ظهور في لوحة الإنجاز وكمشاركين في صورة التخليد، في وقت لم تجد هذه الرؤوس مكاناً لها إلا تحت التراب أمام مشاهد أخرى من القسوة ما تجعل قضية بيع الأقلام عبارة عن "سياحة" هادئة على شاطئ الرغد.
اليوم و أمام صورة أحد رجالات حلب و هو حامل لابنته المذعورة و التي وصلت لأطراف الموت نتيجة القصف، أمام هذا المشهد الذي ينتزع قلوب الفقراء و المستضعفين المشتركين في ذات المصاب ، بينما يغيب المشهد تماما أمام أؤلائك الذي استنهضوا جيوشهم الإعلامية وملأوا صفحاتهم ندباً و ألماً على مشهد من القسوة قد نشهده في أي زمان و مكان و بات اعتياد على الشعب السوري، و لكن مشهد الموت مهما بات روتينيا يبقى غير اعتيادي و يحتاج لنقل دائم و متصاعد لا يعرف التباطؤ أو التراجع ، أو الانشغال عنه بأمور تخف أهمية كمشهد سحب فلذة كبد من فك موت فتك بمئات الآلاف دون رحمة أو شفقة و الأهم دون وجود أو إيجاد رادع، بل دائما المحفز هو الحاضر.
أمام مشهد بائع الأقلام و هذا الذي يحمل ابنته ماراً من بين أسنان الموت، تتكشف الانسانية "القذرة" للعالم أجمع الذي قرر أن يصم آذانه و يعمي عيونه عن الأسباب و يركز على البكاء على الأسباب و يعمل على تخفيفها بشكل مؤقت و جزئي دون أن ينهيها أو يوقف أسبابها.
ونعود لسؤالنا الذي بات هو المؤرق الأكبر لنا ماذا لو كان هذا مشهد حامل ابنته اليوم في حلب قد حدث في انقلاب لشاحنة في احدى الدول الأوربية، و ما ذا لو كان هذا الرجل من طائفة ما أو دين ما ، وطبعاً لا أقترب اطلاقاً من "السنّة" خصوصاً و "المسلمين" عموماً و "العرب" بعموم أشمل.