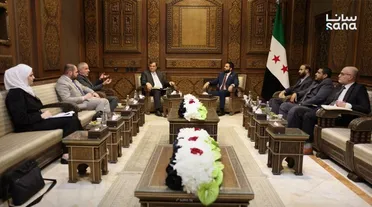"بشار الأسد" وعلماء الدين: من التدجين إلى المواجهة
عُرف عن المخلوع "بشار الأسد"، كأبيه من قبله، سعيه للهيمنة المطلقة على جميع مفاصل الدولة السورية، من السياسة والاقتصاد إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولم تكن المؤسسة الدينية استثناءً من هذه السيطرة. فقد أدرك مبكراً الدور الحيوي الذي يلعبه رجال الدين في التأثير على الناس، خاصةً في مجتمع متدين بطبيعته كالمجتمع السوري، فسعى لإخضاعهم لتكريس بقائه في الحكم.
من حافظ إلى بشار: تدجين الدين لخدمة الطغيان
اتبع بشار النهج نفسه الذي سار عليه والده حافظ الأسد، الذي عمل على احتواء الرموز الدينية الكبرى في سوريا، مثل مفتي الجمهورية أحمد كفتارو والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وقد لعب هذان العالمان دوراً بارزاً في تلميع صورة النظام خلال محطاته الدموية، وعلى رأسها مجزرة حماة عام 1982، التي ارتكبتها قوات حافظ الأسد بحق آلاف المدنيين، في سياق حربه مع جماعة الإخوان المسلمين.
سار بشار على الخطى ذاتها، فحرص على الظهور إلى جانب رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب، مروجاً لنفسه كحامٍ للتعددية الدينية ومدافع عن الأقليات، بينما كانت أجهزة المخابرات تُصدر التعليمات للأئمة والدعاة بالدعاء له على المنابر، خاصة في خطب يوم الجمعة، في محاولة لشرعنة استبداده باسم الدين.
الثورة: سقوط القناع عن تحالف الطغيان والدين
مع اندلاع الثورة السورية في شهر آذار/مارس عام 2011، انقلبت المعادلة. فجرائم النظام الوحشية وسلوكه القمعي الهمجي جعل من الصعب على كثير من العلماء التزام الحياد أو التبرير. وهنا تباينت المواقف: منهم من بارك جرائم النظام صراحةً واعتلى المنابر مدافعاً عنه، خوفاً من أن يفقد مكانته، ومنهم من خضع خشية أن يتعرض للفظائع التي لحقت الأبناء الثائرين، ومنهم من اختار المنفى حفاظاً على حياته وحياة أسرته بعد أن تبنى موقفاً مناصراً للثورة، ورفض سياسة القتل والترهيب.
لكن النظام استمر في استغلال رجال الدين الموالين له، فحوّلهم إلى أبواق تبرر القتل والاعتقال وتحرّم الخروج عليه، تحت ذريعة "الخروج على الحاكم"، رغم ما ارتكبه من فظائع تتنافى مع أبسط المبادئ الدينية والإنسانية.
مشايخ السلطان: فتاوى القتل والتضليل
أبرز هؤلاء ما يُعرف بـ"مشايخ السلطان"، الذين التفّوا حول بشار الأسد وأحاطهم بالامتيازات والنفوذ. من بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، الذي عرف بخطبه الممجّدة للأسد وإيران، وفتاويه التي أجازت قمع السوريين، حتى لُقّب بـ"مفتي البراميل".
ومنهم أيضاً خطيب المسجد الأموي مأمون رحمة، الذي بلغ به التهريج حدّ تشبيه الوقوف على جبل قاسيون بوقفة عرفات، وتعبيره عن استعداده لتقبيل أقدام عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني. هؤلاء المشايخ، بتواطؤهم وخطابهم التضليلي، ساهموا في تصوير المعركة على أنها "حرب كونية" تستهدف الوطن والدين، بينما كانت في حقيقتها حرباً لحماية كرسي الحكم الذي يوشك أن ينهار.
علماء قالوا كلمة الحق... ودفعوا الثمن
في المقابل، وقف علماء دين مستقلون في صف الثورة، ورفضوا المتاجرة بالدين. من بينهم: د. محمد راتب النابلسي، الشيخ عدنان السقا، الشيخ أحمد الصياصنة، العلامة محمد علي الصابوني، الشيخ سارية الرفاعي.
وقد كان للعلامة محمد علي الصابوني مواقف شديدة الوضوح، ووصف بشار الأسد بـ"مسيلمة الكذاب"، وأكدوا وجوب مقاومته، واعتبروا مواجهته جهاداً في سبيل الله. حيث وصف حسون بأنه "فتيل يشعل حرباًً طائفية"، ونعت مشايخ السلطة بـ"المنافقين والمذبذبين".
المساجد: منابر الثورة ومصدر رعب النظام
خاف الأسد من المساجد، ليس لأنها دور عبادة، بل لأنها أصبحت منابر للثورة. فقد انطلقت أولى المظاهرات منها، وارتبط يوم الجمعة بالحراك الشعبي الذي بات يخرج بعد كل صلاة. فبدأ النظام بمحاصرة المساجد، وأغلق بعضها، ثم تطور الأمر إلى قصفها وتدميرها، في سلوك يعكس حقده العميق على هذه المنارات التي بثت فيه الذعر.
مشايخ السلطة إلى الظل... وعلماء الثورة إلى النور
ومع تغيّر الواقع على الأرض، واهتراء صورة النظام البائد، وجد مشايخ السلطة أنفسهم في عزلة. بعضهم توارى عن الأنظار محاولاً حفظ ماء وجهه، وبعضهم حاول "التكويع" والالتحاق بركب الشعب، لكنهم لم يفلتوا من سخرية السوريين، كما حدث مع أحمد حسون.
في المقابل، عاد العلماء الذين نُفوا أو غادروا قسراً، فعادوا مكرّمين، كما حدث مع الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي استُقبل بحفاوة كبيرة، تعبيراً عن تقدير السوريين لموقفه ومبادئه.