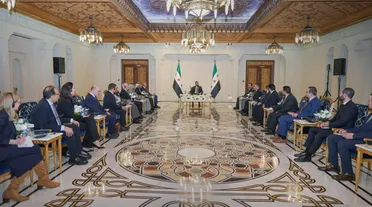عقدة الأسد
ذكرت لي إحدى المشاركات في فيلم وثائقي فرنسي عن اغتصاب الفتيات والنساء السوريات، المعتقلات أو المختطفات، سوف يُعرض في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري على قناة فرنسا 2، أن الطريقة الوحيدة لإقناع الضحايا بالبوح بما عانينه على يد الوحوش الضارية كانت تذكيرهن بأن هناك محاولات عديدة لإعادة تأهيل الأسد، وأن أحاديثهن سوف تساهم في العمل ضد هذا الاتجاه. وقد اعتبرن الإدلاء بشهادتهن على قناة تلفزيونية استمرارا لكفاحهن الطويل من أجل تحرير شعبهن من نظام الإرهاب والطغيان. وما من شكّ في أن فكرة إعادة تأهيل الأسد التي أصبح واضحا أنها الأكثر تداولا في الأوساط الدولية، حتى التي لا تتردّد في وصفه مجرماً، تثير مشاعر من غير الممكن ضبطها من الألم والبؤس والاحتجاج عند غالبية السوريين الذين فقدوا كل شيء، بسبب سياساته وخياراته الخرقاء والإجرامية، أبناءهم ووطنهم. وينظر إليها كثيرون على أنها إمعان في احتقار القيم الإنسانية، وتجديد الحرب ضد السوريين.
1
وبالفعل، لا أدري كيف يمكن لرجال دولةٍ وديمقراطيين أن يفكروا لحظة في أن من الممكن المراهنة من جديد على الشخص الذي كان السبب الأول في إطلاق شرارة الحرب ضد شعبه، منذ الأيام الأولى للثورة، من أجل إعادة السلم الأهلي، وتدشين حقبة جديدة في تاريخ سورية، من المفروض أن أساس جدّتها هو قطعها مع حقبة الأسد السوداء وتاريخها وقيمها ومؤسساتها وطرق إدارتها، وقبل أي شيء رموزها. والغريب أننا عندما نتحدّث عن ذلك مع الدبلوماسيين والسياسيين الغربيين، لا نجد أحدا منهم يجد ذريعةً واحدةً تخفف من مسؤوليته، أو تبرّر سلوكه. بالعكس، إنهم يعترفون جميعا، بما في ذلك الروس في بعض اللقاءات، بأنه المسؤول الأول عن الكارثة الإنسانية والحضارية التي تشهدها سورية، وأن ما قام به من أعمال القتل المنظم والقصف الأعمى واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا لا يمكن أن يصدر عن رجلٍ لديه الحد الأدنى من النضج والاتزان. وبعض المسؤولين الدوليين الكبار، إن لم يكن معظمهم، ينظرون إليه إنسانا أحمق ومجرما خطيرا، قادرا على ارتكاب أبشع الجرائم للاحتفاظ بالحكم.
لكن في كل مرة يطرح هذا الموضوع، وبعد التأكيد على عدم صلاحية الأسد للقيادة، لا قبل الثورة ولا بعدها، يخرج السؤال الذي رافق المعارضة والثوار منذ بداية المشاورات مع من أطلقوا على أنفسهم اسم أصدقاء الشعب السوري: ما هو البديل؟
ليس هذا الطرح جديدا، فقد كان يطرح علينا منذ الأيام الأولى لتشكيل المجلس الوطني. ومع بدء عملية بناء علاقاتنا الدولية مع المجتمع الدولي، تحت تأثير انقسام المعارضة، أو بالأحرى الأصوات النشاز التي كانت تشوش على قيادة المجلس الوطني، ليس لخلافاتٍ سياسية في الواقع، وإنما لحساسيات شخصية على الأغلب. وكان جوابي الدائم على هذا السؤال أن المعارضة ليست هي، ولا تطلب أن تكون البديل عن بشار الأسد ونظامه، وليس من المهم كثيرا انقسامها. فليس المطلوب استبدال حكم طغمةٍ بحكم طغمة أخرى، ولا ديكتاتورية الأسد بديكتاتورية غليون أو أي شخص آخر، ولكن إقامة حكم يقرر فيه الشعب مصيره، وينتخب هو نفسه ممثليه، ويمكن له أن يغيرهم في أي وقتٍ يدرك أنهم لا يخدمون مصالحه، ولا يلبون طموحاته. بمعنى آخر، البديل هو من طبيعة مؤسسية، يقوم على تغيير بنية السلطة وممارستها، لا على تغيير رجالها. ولو افترضنا أن الشعب مال إلى انتخاب رجالٍ كانوا من النظام القديم، فهو حر في ذلك. وهذا ما حصل في البلدان التي كانت تابعةً للاتحاد السوفييتي السابق، حيث حصل الحزب الشيوعي في بعضها على الأغلبية في مراحل الانتقال الأولى. لكن المهم أن ذلك حصل ضمن بنيةٍ ديمقراطيةٍ وتعدّدية للسلطة، تسمح بتغييرهم هم أيضا في دورةٍ لاحقة.
وكنت أصر على أن المفاوضات بشأن المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن تكون مفاوضاتٍ على تفاصيل الحكم ودقائقه، لأن المعارضة ليست ممثلةً للشعب، وإن مثلت، في أحسن الأحوال، الثائرين في صفوفه، ولكن على شروط التعاون من أجل إيصال السوريين إلى مرحلةٍ يستطيع فيها الشعب نفسه أن يقرّر مصيره، وأن ينتخب ممثليه، ويشكل الحكومة التي يريدها، والتي يستطيع هو أيضا إقالتها، وسحب الثقة عنها وتبديلها، في انتخاباتٍ نزيهة وحرة. وهذا يعني أن البديل ليس المعارضة، وإنما مجلس شعب منتخبٍ وممثل للشعب. وهذا المجلس هو الذي سيقود سورية ما بعد الأسد، لا المجلس الوطني، ولا المعارضة، ولا شركاؤها من أنصار النظام في المرحلة الانتقالية. وكل ما يطرحه المبعوث الأممي اليوم من نقاشٍ بشأن الدستور ورؤية سورية المستقبل من وثائق نهائية لا معنى له، وهو يستجيب لمطالب الروس الذين يريدون أن يلغوا المرحلة الانتقالية بموازاة إلغائهم تغيير النظام، واستبدالها بتفاهمٍ نهائيٍّ بين المعارضة والسلطة على الحكم القادم من وراء الشعب، وضد مصالحه. المطلوب مبادئ دستورية لقيادة المرحلة الانتقالية فحسب، قبل إيصال الحكم إلى الشعب وجمعيته الوطنية التي لها وحدها الحق في أن تصوغ الدستور النهائي، وتتفق على المبادئ فوق الدستورية أيضا.
لكن هذا الطرح الذي يركّز على إيصال الحقوق إلى أصحابها، أي إلى تطبيق مبدأ ممارسة الشعب حقه في تقرير مصيره في انتخاباتٍ حرّة ونزيهة، وما يريد الروس قطع الطريق عليه بتكريس اتفاقاتٍ مسبقة ونهائية بين المعارضة والنظام، لم يستطع أن يقاوم للأسف طويلا متطلبات الدبلوماسية الدولية التي لا تريد أن تسمع كثيرا، وربما لا تؤمن بأن فرضية الحل الديمقراطي، المقبول والمطلوب في كل مجتمعات الأرض، يصلح لسورية. وبعد استقالتي من رئاسة المجلس، ومع إصرار الغرب والشرق، بما في ذلك الدول الصديقة، على فكرة البديل الجاهز، دخل السوس إلى فكر المعارضة التي أضعفت موقفها بالاعتراف بأنها لا يمكن أن تكون بديلا، ولا تملك البديل، بدل أن تؤكد أنها لا هي ولا الأسد ونظامه البديل، وإنما الشعب وجمعيته الوطنية المنتخبة. وهذا ما كانت تحتاجه الدبلوماسية الدولية، لقطع الطريق على المرحلة الانتقالية، والاتجاه إلى فكرة المشاركة في حكومةٍ واحدة، أو ما تسمى وحدة وطنية.
2
الواقع أن المطالبة المسبقة والشاملة ببديل، بمعنى بطاقم حكومي جاهز ومؤسسات بديلة، يحل محل طاقم الأسد ومؤسساته، لم تطرح على أي ثورة أو حركة احتجاج في العالم، فهي تستبطن أمورا عديدة.
أولا، أن من الممكن بناء قوة جاهزة ومنظمة سياسية، أو كتلة قادرة على الحكم وحدها منذ البداية. ولا أدري كيف يمكن لهذه القوة السياسية المنظمة والقادرة على استلام الحكم أن تتكون في ظل ديكتاتورية فاشية وهمجية، في الوقت نفسه، تُخضع الأفراد إلى مراقبةٍ يومية، وتحرّم أي شكل من التواصل بينهم، الفكري والسياسي، وتُخضعهم لمحاكمةٍ دائمةٍ وتجرّدهم من أي حماية سياسية أو قانونية. وأول برهان على ذلك روسيا المنتفضة على النظام السوفييتي نفسها.
وتستبطن ثانيا استبعاد أن يكون الشعب صاحب السيادة والصلاحية في اختيار ممثليه في انتخاباتٍ حرّة ونزيهة، أي أيضا الاعتقاد بأن الشعب السوري ليس على مستوى من النضج يسمح له بممارسة حقوقه السيادية. وهذه هي الفرضية وراء فكرة مؤتمر شعوب سورية الذي أعلن الروس عن عقده في حميميم، ثم نقلوا مكانه إلى سوتشي، ولا يزال غامض المصير. وبينما تهدف مفاوضات جنيف للتوصل إلى تفاهم بين الحكم والمعارضة على صيغةٍ للانتقال السياسي من سنة ونصف السنة إلى سنتين، تشكل مدخلا لتطبيع الحياة السياسية، والدخول في نظام الديمقراطية الذي يكرّس سيادة الشعب، وحقه في تقرير مصيره بحرية، يفترض مؤتمر شعوب سورية حوارا بين المكونات الإثنية والطائفية والعشائرية السورية، يلغي إشكالية الانتقال من جذورها، ويفتح باب الحوار بين جماعاتٍ مختلفةٍ ومتنابذةٍ على تقاسم المناصب، ويفضي، لا محالة، إلى تحييد الدولة، وإحلال إدارات محلية مكانها، تضمن لكل قوة احتلت جزءا من الأرض السورية الاحتفاظ بنفوذها ووصايتها في المنطقة التي بسطت سلطتها عليها. ولو حصل ذلك، لكانت طهران التي تتمتع بحضور أوسع وأكثر عمقا، سياسيا وعسكريا وبشريا، اليوم في البلاد، هي صاحبة الكلمة الأولى، والسيطرة الأكبر على الحكومة والإدارة وجميع المرافق الاقتصادية والخدمية في الدولة السورية القادمة.
ويستبطن هذا الطرح ثالثا أن ما يرمي إليه الحوار والمفاوضات ليس الانتقال الذي أعلنته الثورة نحو نظام ديمقراطي، يلبي مطالب الحرية والكرامة والتطلع إلى ملاقاة قيم العصر. وإنما التمثيل الشامل والميكانيكي لجماعات الهوية، وإلغاء مفهوم المواطنة التي تقوم على حكم القانون والمساواة بين الأفراد، وقبل ذلك حرية الفرد ومسؤوليته السياسية لصالح مفهوم العصبية الأهلية الجمعية، الطائفية والإتنية. وهو النظام الذي فرض، حسب المنطق نفسه، في لبنان، وبعده في العراق، والذي يكرّس إعادة تنصيب زعماء العشائر والقبائل ووجهاء المناطق والقوميات على الدولة والسياسة، وتوريث مناصبهم لأبنائهم، وإلغاء أي فرصةٍ لتكوين نخبة وطنية سياسية، تتناغم مع مفهوم الدولة، وهو ما يهدف إلى إجهاض أي حياة مدنية حقيقية، ودفع السوريين إلى الانشغال بصراعات هويةٍ وتنازع على مناصب الدولة والإدارة، لا تنتهي، بدل مساعدتهم في الارتفاع على الانقسامات العمودية، وتوسيع قاعدة التعاون بين الأفراد، بصرف النظر عن انتماءاتهم الأهلية، وتوحيد القوى والجهود من أجل تحديث المجتمع السوري، وتطوير مؤسساته المدنية والسياسية، وتعميق روح الوطنية والقيم الإنسانية الكونية.
ويستبطن رابعا أن الوظيفة الرئيسية لنظام سورية القادم ليس تجاوز النقائص والعيوب التي حالت دون تفاعل أبناء الشعب السوري، وتكون إرادة وطنية فعلية، وهو ما عبّرت عنه شعارات الثورة، وأولها "واحد واحد الشعب السوري واحد"، ولكن إقامة نظام من الطبيعة نفسها التي جسدها نظام الأسد، والتي لا تهدف إلا إلى تلبية المطالب والمصالح الخارجية، والاستقواء بأصحابها لعزل الشعب السوري سياسيا، وتقويض وحدته وإرادته الوطنية. ما يعني أن ما هو مطلوب للخروج من الحرب والدمار والخراب ليس مصالحة الشعب السوري مع نفسه وتاريخه، وحل الإشكالات التي دفعته إلى الثورة والحرب، وإنما زرع بذور نزاعاتٍ لا تنتهي، ولا يمكن السيطرة عليها. وأن وظيفة النظام المنشود ليست خدمة السوريين ورعاية شؤونهم، كما هي وظيفة النظم السياسية، أو أغلبها، وإنما خدمة الأطراف الخارجية التي تضمن بقاء النظام وحمايته واستمراره. وهذه كانت وظيفة نظام الأسد الذي استمد قوته ونفوذه وفرص استمراره من اشتغاله على ضبط السوريين وتحييدهم، وشل إرادتهم لحساب دول وحكومات ومصالح أجنبية. وهذا ما جعل من مسألة تغييره أو استبداله، عندما فشل في تحقيق مهامه، وانتفض السوريون ضد سياساته، مسألة إقليمية ودولية وعالمية خارجة عن إرادة السوريين.
لم تترك موسكو، التي تعمل صاحب تفويض دولي في المفاوضة مع المعارضة، فرصةً من دون أن تستغلها لقطع الطريق على خيار الانتقال السياسي الديمقراطي، والسعي إلى إغراق مسألة سيادة الشعب السوري بمسألة التعددية الإثنية والطائفية والسياسية، والدفع في اتجاه حلٍ يقوم على تقاسم السلطة بين الجماعات الأهلية وتقسيم البلاد إلى أقاليم ذاتية الإدارة بعد أن فشلت في فرض الفيدرالية.
3
لا ينبع التذكير الدائم بغياب البديل، كما قد يخطر إلى البال، من القلق على مستقبل سورية، أو على نجاح عملية الانتقال السياسي فيها، ولا من الاعتقاد بالفعل بغياب شخصيات قادرة على الحكم، أو عن الخوف من عقم المجتمع السوري وعجزه عن إنتاج "شخصية فذة" مثل بشار الأسد، ولا من عدم إمكانية الحؤول دون عمليات الانتقام الجماعي، أو انهيار مؤسسات الدولة، أو الدخول في الفوضى، كما يزعم بعضهم. ولكنها تنبع من الخوف من أن لا تتمكّن القوى التي كانت وراء الأسد، واستفادت من حكمه، وعقدت صفقاتٍ كبرى معه على حساب حرية الشعب السوري، وحقوقه وتقدمه وأمنه، من إيجاد البديل المطابق له. أي في الواقع من أن لا تتمكن هذه القوى من ضبط الأوضاع السورية في إطار نظام ديمقراطي، يعكس إرادة الشعب وتطلعاته، ويعمل لخدمة أهدافه والدفاع عن مصالحه، ويعمّم نشر روح الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة في ربوعه. وهو ما كان سائدا قبل عهد الانقلابات العسكرية، والذي جعل من السوريين، في حقبة الخمسينيات، في طليعة حركة الكفاح التحرّري والاجتماعي الذي خاضته الشعوب حديثة الاستقلال في العالم. فالبديل المطلوب للأسد وحشٌ مثله مستعدٌّ، لقاء ضمان استمراره في السلطة وتوريث الحكم لأبنائه، لقتل شعبه وتحويل سورية إلى معتقل جماعي، وجاهز للقيام بجميع المهام القذرة، الداخلية والخارجية، التي قبل بتنفيذها نظام الأسد، غالبا بمبادرته الخاصة، خلال نصف قرن، وضمنت استقرار النظام الإقليمي والدولي القائم على تجميد الحياة في المنطقة، وحرمانها من أي فرصة للتعاون من أجل التقدم والتنمية والتطور الاجتماعي والسياسي والفكري، في سبيل الحصول على رضى الدول الكبرى وتلبية مصالح وكلائه، بصرف النظر عن مصالح السوريين، وعلى حسابها في أغلب الأوقات. ولأن هؤلاء الوكلاء ليسوا واثقين من قدرتهم على تدجين الشعب السوري، بعد تضحياته الهائلة، وسوقه إلى إنتاج نظامٍ شبيه بنظام الأسد، وقادر على أداء مهامه الداخلية والخارجية، كما فعلوا في بلدان الربيع العربي الأخرى، فليس لهم خيار سوى الدفاع حتى آخر نفسٍ عن إعادة تأهيل الأسد نفسه، حتى لو كانت قناعتهم بعدم صلاحيته، وربما بسبب ضعفه، بل موته السريري نفسه أيضا.
ليس المطلوب "دوليا" في سورية نظاما ديمقراطيا مدنيا، يضمن وحدة الشعب وتفاهمه على قواعد واضحة وثابتة وكونية للشرعية وتداول السلطة، ويمكن للشعب أن يختار ممثليه ويستبدلهم بحرية، كما الحال في الدول الديمقراطية جميعا، وإنما المطلوب، كما تبين في السنوات الست الماضية، العكس تماما، أي نظاما يجرّد الشعب السوري من سيادته، ويفرض عليه خياراتٍ لغير مصلحته، تضمن الأمن والاستقرار والتوسع والازدهار لدولٍ بعينها في الشرق الأوسط، وتحفظ هيمنة الغرب، وروسيا جزء منه، على عالم الشرق والإسلام والعرب الذي يبدو أكثر فأكثر مرتعا للقوى المتمرّدة والمتطرّفة والثائرة. وليس هناك بديل عن الديكتاتورية الفاشية المتهاوية تحت ضربات الثورات العربية، للحفاظ على هذه المصالح الكبرى والتوازنات، سوى نظم مقوّضة العزم والشرعية، ودول مفكّكة تلغي الشعب، وما له من قوة وكيان سياسيين، وتحل روابط المجتمعات، وتفتك بقيمها ورموزها، وتباعد بين أقاليمها وجماعاتها، أي سوى فرط عقدها وتحويلها إلى إثنيات وطوائف ومحليات، وتقسيم أراضيها إلى كانتونات ومناطق معزولة وعازلة، منطوية على نفسها، لا شاغل لها سوى التنازع على البقاء في منطقة محرومة وعاجزة عن إيجاد شروط التنمية، تعاني أكثر فأكثر من شحّ الموارد، ومن حروب أهلية دائمة، ونزاعات هوية، لا حل لها ولا تسوية فيها. هذا هو البديل الوحيد الذي يضمن، في الوقت نفسه، تحييد الشعوب، وإخراجها من معادلة القوة، والإبقاء على الأسد وأمثاله رؤساء وقادة لدولٍ لم يبق منها سوى الاسم، ومن وراء ذلك، تكريس المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية الكبرى التي حقّقتها الشراكة المدنّسة بين طهران وموسكو وتل أبيب وواشنطن وأتباعهما، عوائد الحرب التي فجّرها الأسد على السوريين نيابة عن الجميع، وبمساعدتهم، لسحق ثورة الحرية والفتك بأبنائها، وتشريدهم في كل بلاد المعمورة.
ما أنتج عقدة الأسد التي عطلت مفاوضات الحل السياسي ست سنوات متواصلة، ليس وجود الأسد وشخصه، أو النزاع على دوره، ولكن تصميم الفاعلين الإقليميين والدوليين على رفض خيار التحول الديمقراطي الذي يلبي تطلعات السوريين، ويضمن حقوقهم بالتساوي، من خلال انتخابات حرّة ونزيهة لممثليهم وقادتهم، الحقيقيين والشرعيين، والإصرار على الإبقاء على نظم استبدادية ليست بحاجة إلى أي توجيهٍ، أو ضغوط استثنائية، كي تقوم بتنفيذ مهمتها التاريخية في الدوس على رقاب الشعوب وتفكيكها، وإخضاعها بالقوة، وإن لم تستطع تشتيت شملها بحروب الإبادة الجماعية، المادية والسياسية معا. لتحقيق هذه المهام، الإبقاء على كواسر أثبتت قدرتها على الفتك، من دون أن يرفّ لها جفن، بشعوبها، هو بالتأكيد الخيار الصحيح لدولٍ تتصرف هي نفسها كوحوش ضارية.