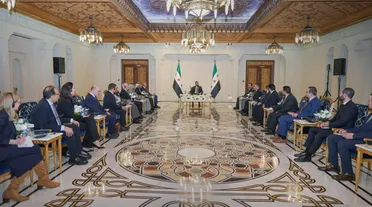إيران ودروس الربيع العربي
يتجسّد الوعي الشعبي الإيراني الغاضب على نظامه في أمرين: أولهما، أنه لم يستثن استطالات أو تدخلات إيران الخارجية من نطاق شعارات احتجاجاته، وأنه جعل النظام يقف في مواجهة مطالب شعبية، تعتبر الأولوية في برنامج أي نظام حاكم تجاه مواطنيه، من موضوع الفقر إلى البطالة والتنمية الاقتصادية، معتبراً تلك الاستطالات فساداً في إدارة موارده وقيمه، كشعب صاحب حضارة، وكشعب له أولوياته الداخلية. وثانيهما أنه ساوى بين الطبقة الدينية الحاكمة والجهاز الحكومي التنفيذي في تحميل مسؤولية ما آلت إليه بلادهم، حيث ظهر المشهد السياسي الإيراني ضمن منظور المنصّة الواحدة التي لا تستثني أحداً من غضب الشارع عليه، ولا تحتمي بجهةٍ ما من أخرى.
ما تقدّم يعني أن الإيرانيين المتظاهرين بدأوا من حيث وصلت إليه تجارب الآخرين، الذين سبقوهم إلى صياغة حراكهم، محاولين تجاوز الأخطاء، ومتوقعين سلفاً الثمن المطلوب لاستمرار دائرة غضبهم وتوسّعها. وهم بذلك يبدون على درجةٍ من وعي أفضل لطبيعة نظامهم الديكتاتوري وأدواته القمعية، بكل الخبرات المكتسبة لهذا النظام، لا سيما في شراكته بالمسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب وقتل المتظاهرين، وتدمير المدن السورية فوق رؤوس ساكنيها.
ربما تمنح هذه الوضعية الإيرانيين المتظاهرين ميزة لم يملكها السوريون مع بدء ثورتهم، حيث كانت معايرتهم للأمور تقتصر على تجربة الأسد الأب في تعامله مع أحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي. فعلى الرغم من بشاعة ما حدث ومأساويته، خلال تصدّي الأجهزة العسكرية والأمنية لحركة الإخوان المسلمين، 27 يوماً (فبراير/شباط عام 1982) في مدينة حماة، ووقوع عشرات آلاف الضحايا، إلا أن من قاموا بثورة 18 مارس/آذار 2011 ليسوا ممن يحملون تلك الذكريات، بحكم أعمارهم الشابة التي تتعامل مع التغيير باعتباره جزءا من صيرورة التاريخ الممتد، وتسعى إلى نيل حرية التعبير التي أطلق عنانها مسار العولمة وتكنولوجيا الاتصالات والتواصل الاجتماعي، كما راودهم تغلب أمنياتهم، أو أوهامهم، بأن الأسد الابن، صاحب التجربة في الحياة، لن يكون قادراً على ممارسة القمع الذي سبقه إليه والده، تحت عين الكاميرا وبثها المباشر. بيد أن ما جرى خلال السنوات السبع الماضية في سورية، وبدعم من نظام الملالي الإيراني، بمناصفة المسؤولية عن كل الجرائم المرتكبة، كان بحكم المفاجأة للسوريين، بشدّته واتساع رقعة ضحاياه من مدينة انطلاقة الثورة (درعا) إلى باقي مدن سورية ومناطقها، وقدرة آلة الحرب على التنقل بينها، وإيقاع مئات آلاف الضحايا بين قتل واعتقال وموت تحت التعذيب وتشريد وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة.
وإذا كان مبكرا فعلياً تصوّر مآلات ما يحدث من احتجاجات في مدن عديدة في إيران، وتاليا مدى قدرة هذه الأحداث على لملمة التمدّد الإيراني من محيطه الجغرافي خارج حدوده وانكفائه إلى داخل دولته، إلا أن هذه الاحتجاجات، في شكلها الممتد على مساحة واسعة، يمكنها أن تكون علامة جديدة في تاريخه، ينتقم فيها أبناء الذين شاركوا في الثورة ضد الشاه وأحفادهم، في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، من أولئك الذين خطفوا الثورة، لتأخذ منحاها الإسلامي الطائفي في أبشع صوره، بعد أن كانت ثورة العلمانيين والليبراليين والإسلاميين معاً.
هكذا، فإن استمرار المظاهرات وتوسّعها وامتدادها هو الخيار الأكثر احتمالاً، على الرغم من أن النظام الإيراني سيستخدم كل خبراته القمعية التي لم يكن يمتلك كل أشكالها الإجرامية في انتفاضة 2009، التي حدثت تحت سقف النظام، وبرعاية بعض رموزه، وفقاً لمفهوم الديمقراطية المبتورة في أنظمة الحكم الديكتاتورية التي تسمح باتهام كل الأدوات وانتقادها، منزّهة المرجعية الدينية عن الخطيئة، ومحمّلة المسؤولية للحكومة التنفيذية الفاسدة في طريقة وآليات عملها. ومعلوم أن الاحتجاجات الإيرانية آنذاك قامت بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية لمصلحة محمود أحمدي نجاد الذي استمر لولاية ثانية، ضد مير حسين موسوي الذي طلب السماح من النظام الحاكم لمسيرة احتجاجية على نتائج الانتخابات التي اعتبرها مزوّرة. وفي حينه، كان سقف الحراك معروفا، وكانت المظاهرة معروفة المسار والموقع، ما يعني أنه أرادها "صورة ديمقراطية" في بلدٍ تحكمه نخبة دينية تسلطية وقمعية، إلا أن الأمور شعبيا لم تكن على مقاس التنظير السلطوي، بحيث أن التمرّد الشعبي بدأ يختمر منذ ذلك الوقت، على الرغم من إخماده أمنياً وعسكرياً آنذاك.
على ذلك، فإن أي رهانٍ على فشل إرادة المتظاهرين الإيرانيين هو ضد طبيعة التطور، أو رهان معقود على تخيّل إرادوي لواقعٍ يفترض أنه ينضج بطريقة تدرجية. ولعل إيران تعطينا اليوم الدرس الذي يجب أن يعيه المتحمسون للربيع العربي، ومفاده بأن الثورات لا تسير باتجاه واحد نحو النصر المباشر. وحتماً، حيث إنها يمكن أن تتعثر حيناً، وأن تهمد أحياناً، وأن تتحوّل بفعل الظروف إلى مشهدٍ يخالف انطلاقتها الأساسية، كما حدث لثورة السوريين، التي تلونت من ثورةٍ شعبيةٍ، بالطرق السلمية، إلى ثورة مسلحة باستبعاد البعد الشعبي، ومن ثورةٍ تهدف إلى التغيير السياسي والحرية والديمقراطية إلى ثورةٍ يغلب عليها الخطاب الطائفي، ومن صراع بين شعب ونظام إلى صراع داخلي وخارجي، أي أن الحراكات الشعبية في إيران قد تتطوّر، ولكن وفقا لدينامياتها هي، ووفقا لكيفية رد النظام عليها، من دون وضع مراهناتٍ مبكرة أو في غير محلها.
هذا يعني أنه لا يمكن التعاطي مع المظاهرات في إيران على أنها ماضية حتى تحقيق هدفها بإسقاط حكم ولاية الفقيه، بحدّيه الديني والتنفيذي، إذ أنه من دون ذلك مواجهة عنف النظام في أقسى صوره التي قد تؤدي إلى انعطافاتٍ بمساراتها، وربما انكفاءاتٍ باتجاه مطالب حياتية معيشية، يقدّم النظام الوعود لحلها مرحلياً. مع ذلك، لا يعني هذا الوضع إخماد المطالب السياسية التي تؤسس لمرحلة حكم جديدة، يتطلع فيها الإيرانيون إلى استثمار ثرواتهم بتحسين واقعهم داخل حدودهم، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. ومنه طبعاً واقع الحريات الدينية، وتعزيز مكانة المرأة التي بقيت حتى اليوم (منذ 1979) تمثل انفكاك شراكة كل شرائح المجتمع الإيراني عن ثورته، بعد انتصار الشعب على شاهه. ذلك كله لن يحدث، على الأرجح، في ظل بقاء نظام إيراني يصرف ويبدد خارج حدوده مداخيل (وموارد) شعبه، ويتطلع إلى حكم أربع عواصم بالنار والحديد والأحزاب الموالية له، بينما هو يمارس العنف في بسط سيطرته على عاصمته طهران، لغياب مصداقيته وعدالته وبرنامجه الإصلاحي.